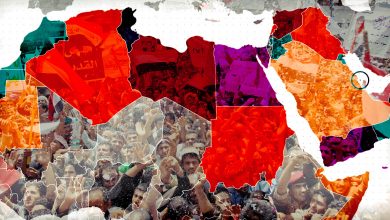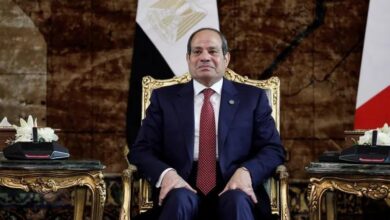تمهيد
في عددها الرابع ضمن المجلد 3، ربيع 2019، نشرت مجلة الأمن الدولي دراسة للمفكر الأميركي جون ميرشايمر بعنوان: محكومٌ بالفشل: صعود وسقوط النظام الدولي الليبرالي[1]، فيما يلي ترجمة النص الكامل لها.
الصادر بحلول سنة 2019، بدا واضحا بأنّ النظام الدولي الليبرالي صار في ورطة عميقة، فالطبقات التكنونية التّي تدعّمه تشهدُ حالة تحوّلٍ، ولا يوجد إلاّ الشيء القليل يمكن فعله لأجل إصلاحه وإنقاذه. في الحقيقة، فإنّ هذا النظام كان محتّمٌ عليه الفشل منذ البداية بما أنّه يحمل بذور خرابه في ذاته.
يُرعِب سقوط النظام الدولي الليبرالي النخب الغربية التّي بنته والتّي استفادت منه بالعديد من السبل، لقد اعتقدت هذه النخب بحماس أنّ هذا النظام بَقِي وسيظلّ قوة مهمّة في ترويج السلام والازدهار حول العالم. كما ألقى العديد منهم اللوم على الرئيس دونالد ترامب بسبب ما لحق به من فناء. على كلّ حالٍ، فقد أعرب ترامب عن ازدرائه للنظام الليبرالي أثناء حملته الانتخابية الرئاسية سنة 2016، ومنذ أن أمسك بالسلطة اتّبع ترامب سياسات بدا بأنّها صُمّمت بغية هدمه.
لكن قد يكون من الخطأ التفكير بأنّ النظام الدولي الليبرالي يعيش في ورطة بسبب بلاغة ترامب وسياساته وحسب. في الحقيقة، فإنّ هناك مشكلات أساسية أعمق تلعب دورا في ذلك، وهو ما يُفسّر سبب تمكّن ترامب بنجاح من تحدّي نظامٍ يحظى بتأييد عالمي تقريبا بين نخب السياسة الخارجية في الغرب. يتمثّل هدف هذا المقال في تحديد نمط النظام الدولي الذّي سوف يحلّ مكانه.
أقدّم هنا ثلاثة أنماط من الحجج. أولاً، فلأنّ الدول في العالم الحديث تكون مترابطة بعمق بطرق متعدّدة، فإنّ النظم تكون ضرورية لأجل تسهيل التفاعلات الفعّالة وفي الوقت المناسب. هناك العديد من أنماط النظم الدولية، وأيّ نمط يصعد فهو يعتمد أساساً على التوزيع العالمي للقوة. لكن حينما يكون النظام أحاديَّ القطبية، فإنّ الإيديولوجيا السياسية للقطب الواحد مهمّة أيضا. يمكن للنظم الليبرالية الدولية أن تنشأ فقط في الأنظمة الأحادية القطبية أين تكون الدولة القائد دولةً ديمقراطية ليبرالية.
ثانيا، لقد قادت الولايات المتحدة نظاميْن مختلفيْن منذ الحرب العالمية الثانية وهما، نظام الحرب الباردة والذّي يُشار إليه على نحوٍ خاطئ في بعض الأحيان باعتباره “نظاما دوليا ليبراليا”، في حين أنّه لم يكن ليبراليا ولا دوليا، بل كان نظاما محدودا مقتصرا أساسا على الغرب، كما كان نظاما واقعيا في كلّ أبعاده الأساسية. لقد حمل بعضا من الملامح التّي كانت متّسقة أيضا مع النظام الليبرالي إلاّ أنّ تلك المميّزات كانت مرتكزة على منطق واقعي. في المقابل، فإنّ نظام ما بعد الحرب الباردة الذّي قادته الولايات المتحدة هو نظام ليبرالي ودولي، ولذلك فهو يختلف بطرق أساسية عن النظام المحدود الذّي هيمنة عليه الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة.
ثالثا، أمّا النظام الدولي الليبرالي لحقبة ما بعد الحرب الباردة، فقد كان مصيره الانهيار، لأنّ السياسات الأساسية التّي اتّكأ عليها مَعيبة ومُشوَّهة بشكلٍ عميق. إنّ عملية نشر الديمقراطية الليبرالية حول العالم والتّي تُعدّ مسألةً ذات أهميّة قصوى لأجل بناء هكذا نظام، لا تُعتبر عملية صعبة للغاية وحسب، بل إنّها تُسمّم في العادة العلاقات مع البلدان الأخرى وتقود في بعض الأحيان إلى حروب كارثية. تُعدّ النَزْعَة القومية (Nationalism) داخل الدول المستهدفة العقبة الأساسية لترويج الديمقراطية، كما أنّ سياسات توازن القوى تعمل كقوة كابحة مهمّة أيضا.
علاوة على ذلك، فإنّ ميل النظام الليبرالي إلى منح الاعتبار والامتياز الأكبر للمؤسّسات الدولية على حساب الاعتبارات الداخلية –للدول- وكذلك التزامه العميق بالحدود التّي يسهل إختراقها، إن لم تكن مفتوحة أساسا، كان له تأثيرات سياسية سامّة داخل الدول الليبرالية صاحبة القيادة نفسها، بما فيها القطب الأوحد الأمريكي. تتصادم هذه السياسات مع النزعة القومية عبر مسائل أساسية على غرار مسألة السيادة والهويّة الوطنية. ولأنّ النزعة القومية تُعدّ أكثر إيديولوجية سياسية قويّة في العالم، فإنّها تتفوّق على الليبرالية كلّما تصادم الإثنان، وهذا ما يُقوّض النظام في جوهره.
إضافة إلى ذلك، فإنّ العولمة المُفرطة التّي سعت إلى تقليص حواجز التجارة العالمية والاستثمار، أنتجت فقدان الوظائف، تدهور الأجور وارتفاع حالة عدم المساواة في الداخل بجميع أنحاء العالم الليبرالي. ثمّ تحوّلت هذه المشكلات إلى مشكلات سياسية، مؤديّة إلى مزيد من تآكل الدعم للنظام الليبرالي.
لذا قوّض الاقتصاد المعولم بشكل مفرط النظام بطريقة أخرى: فقد ساعد دولاً أخرى خارج القطب الواحد على النمو بشكلٍ أكثر قوة، الأمر الذّي بإمكانه أن يُقوّض القطبية الأحادية ويُوصل النظام الليبرالي إلى النهاية. هذا ما يحدث الآن مع صعود الصين الذّي يتسّبب، جنبا إلى جنب مع القوة الروسية المنافسة، في إنهاء حقبة الأحادية القطبية. سوف يقوم العالم الصاعد متعدّد الأقطاب على نظام دولي مبني على أسسٍ واقعية، والتّي سوف تلعب دوراً مهمّاً في إدارة الاقتصاد العالمي، التعامل مع مسألة الحدّ من التسلّح وكذا المشكلات العالمية المشتركة على غرار مشكلة التغيّرات المناخية. إضافة إلى هذا النظام الدولي الجديد، فإنّ الولايات المتحدة والصين ستقودان أنظمة محدودة (محصورة النطاق) والتّي سوف تُنافس بعضها بعضا في كلّ المجالات الاقتصادية والعسكرية.
ينتظم الجزء المتبّقى من هذا المقال على الشكل التالي. أوّلاً، أشرح ما الذّي يعنيه مصطلح “نظام” (Order)، ولِمَ تُعدّ الأنظمة ملمحاً أساسياً للسياسة العالمية. ثانيا، أصف الأنماط المختلفة للأنظمة والظروف التّي سوف يبرز في خضّمها نظام دولي ليبرالي. في ذات الصدد، أفحص في القسم الثالث ما الذّي يُفسّر صعود وسقوط الأنظمة الدولية. في القسم الرابع، أصف الأنظمة المختلفة للحرب الباردة. في الأقسام الثلاثة اللاحقة سأسرد تاريخ النظام الدولي الليبرالي. ثمّ في الأقسام الأربعة التالية لها سأشرح سبب فشله. سأناقش في القسم ما قبل الأخير كيف يبدو النظام الجديد في ظلّ التعدّدية القطبية، أمّا الخاتمة فتُقدّم مختصرا لحجّتي وبعضا من التوصيات.
ما هو النظام، ولماذا تُعدّ النظم مهمّة؟
النظام (Order) هو مجموعة من المؤسّسات الدولية المنتظمة التّي تساعد على إدارة وحكم التفاعلات بين الدول الأعضاء. يمكن للأنظمة أيضا أن تُساعد الدول الأعضاء على التعامل مع غير الأعضاء، فليس من الضرورة أن يتضمّن نظامٌ ما كلّ بلدان العالم. علاوة على ذلك، يمكن أن تشتمل النظم على مؤسّسات لها نطاقات عملٍ إقليمية أو عالمية، والقوى العظمى هي التّي تخلق وتدير هذه النظم.
تُعتبر المؤسّسات الدولية، التّي تُمثّل اللبنات الأساسية للنظم بشكلٍ فعّال، بمثابة القواعد التّي تضعها القوى العظمى وتتوافق على إتّباعها، لأنّها تعتقد بأنّ إطاعة هذه القواعد أمرٌ يصّب في مصلحتها. تنصّ القواعد على أنماط من السلوكات المقبولة وتحظر الأشكال غير المقبولة من السلوكات، وليس من المفاجئ أن تكتب القوى العظمى هذه القواعد بما يُناسب مصالحها الخاصّة، لكن حينما لا تتوافق هذه القواعد مع المصالح الحيوية للدول المهيمنة، فإنّ هذه الدول ذاتها تتجّه إمّا لتجاهل هذه القواعد أو إلى إعادة كتابتها. على سبيل المثال، أكّد الرئيس جورج بوش الابن في مناسبات عديدة قبل حرب العراق 2003 أنّه حتّى وإن إنتهك الغزو الأمريكي القانون الدولي، فإنّ “أمريكا سوف تقوم بما هو ضروري لضمان أمننا القومي… سوف لن أنتظر الأحداث في الوقت الذّي تجتمع فيه المخاطر”.
يُمكن أن يحتوي نظام ما أنماطاً عديدةً من المؤسّسات بما فيها المؤسّسات الأمنية على غرار منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي (NATO)، معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، أو حلف وارسو، كما يمكن أن يحتوي أيضا على مؤسّسات اقتصادية على غرار صندوق النقد الدولي (IMF)، اتفاقية التجارة الحرّة لشمال أمريكا، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي. يمكن أن يتضمّن أيضا مؤسّسات تتعامل مع مسائل البيئة على غرار اتفاقية باريس لمعالجة التغيّر المناخي، وأكثر المؤسّسات ذات المجالات المتعدّدة على غرار الاتحاد الأوروبي، عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة.
تُعتبر الأنظمة شيئا لا غنى عنه في الهيكل الدولي الحديث لسبيين إثنين. أولاً، إنّها تُدير العلاقات البينية بين الدول في عالم ذو إستقلالية عالية. تنخرط الدول في عدد هائل من النشاطات الاقتصادية، والتّي تقودها إلى إنشاء مؤسّسات وقواعد بإمكانها ضبط هذه التفاعلات وجعلها أكثر فاعلية. إلاّ أنّ هذا الاعتماد المتبادل ليس محصورا في الشؤون الاقتصادية وحسب، إنّه يتضمّن المسائل البيئية والصحية أيضا. على سبيل المثال، يؤثّر التلوّث الحاصل في بلد واحد حتما على البيئة في البلدان المجاورة، في حين أنّ آثار الاحتباس الحراري عالمية ولا يمكن التعامل معها إلاّ من خلال تدابير متعدّدة الأطراف. الأكثر من ذلك، فإنّ الأمراض القاتلة لا تحتاج إلى جواز سفر لعبور الحدود الدولية، مثلما أوضح ذلك بشكل جلّي وباء الإنفلوانزا الفتّاك ما بين 1918-1920.
تترابط الدول ببعضها البعض أيضا في المجال العسكري، الأمر الذّي يقودها إلى تشكيل تحالفات. لاستعراض خصمٍ ما يحظى بقدرات ردع هائل أو لأجل قتال فعّال من شأنه أن يؤدّي بهذا الردع إلى الانهيار، يجب على الحلفاء الاستفادة من قواعد تضبط الكيفية التّي سوف يتصرّف بها على الميدان جيشُ كلّ عضوٍ من هؤلاء والكيفية التّي تُنسِّق بها هذه الجيوش مع بعضها البعض. هناك حاجة كبيرة جدّا للتنسيق نظراً لأنّ الجيوش الحديثة تحظى بمجموعة واسعة من الأسلحة، لا يكون كلّ منها منسجما بالضرورة مع نمط تسلّح الحلفاء. فلننظر إلى الأسلحة الواسعة المتنوعة في الجيوش التّي صنعت حلف الناتو أو وارسو، ناهيك عن صعوبات تنسيق التحرّكات المتنوّعة للقوّات المقاتلة داخل هذه التحالفات. ليس من المفاجئ أنّ كلا القوتين العظميين حافظت على تحالفات مؤسّسة بشدّة -وفي الحقيقة نظمٌ مُمأسسة بشدّة- أثناء الحرب الباردة.
ثانيا، لا غنى عن الأنظمة (Orders) في الهيكل الدولي الحديث لأنّها تُساعد القوى العظمى على إدارة سلوك الدول الأضعف على النحو الذّي يتناسب مع مصالح القوى العظمى. وعلى نحو أخصّ، تُصمِّم الدول الأكثر قوةً مؤسّساتٍ بهدف تقييد أفعال الدول الأقل قوةً ومن ثَمّة لفرض ضغوط كبيرة عليها لأجل الانضمام إلى هذه المؤسّسات وإطاعة قواعدها أيّا ما كانت هذه القواعد. مع ذلك فعادةً ما تعمل هذه القواعد لصالح الدول الأضعف في النظام.
لعلّ المثال الجيّد لهذه الظاهرة نجده في جهود القوتيْن العظميين أثناء الحرب الباردة والرامية إلى بناء نظام منع الانتشار النووي. اتجاهاً نحو هذه الغاية، ابتكرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سنة 1968 اتفاقية عدم الانتشار النووي والتّي جعلت وبشكلٍ فعّال الأمر غير قانونياً لأي بلدٍ عضو يحصل على أسلحة نووية لم يكن يحظ بها آنذاك. من الطبيعي أنّ القيادة في موسكو وواشنطن ذهبت إلى أبعد الحدود لتحصل على أكبر عدد ممكن من الدول للانضمام إلى اتفاقية عدم الانتشار النووي. كما كانت القوتيْن العظميين بمثابة القوة الأساسية الدافعة التّي وقفت وراء تشكيل مجموعة الموردّين النووية سنة 1974 والتّي تهدف إلى إرساء قيود كبيرة على بيع المواد والتكنولوجيات النووية للبلدان التّي لا تحوز على أسلحة نووية ولكنّها قد تحاول الحصول عليها من السوق.
إلاّ أنّ المؤسّسات التّي شكلّت نظاما ما ليس بإمكانها أن تُجبر الدول القويّة على إطاعة القواعد إذا ما اعتقدت هذه الدول بأنّ إطاعة القواعد لا يصبّ في مصالحها. بعبارة أخرى، فإنّ المؤسّسات الدولية ليس لها روحٌ مستقلة عن أعضاءها وبالتالي فهي لا تحظ بالقوة لإخبار الدول القائدة بما يجب أن تقوم به، إنّها ببساطة أدوات في يدّ القوى العظمى. مع ذلك، فإنّ القواعد التّي تُعدُّ بمثابة جوهر أيّ مؤسّسة، تُساعد على إدارة سلوكات الدول، كما أنّ القوى العظمى تطيع هذه القواعد في أغلب الأوقات.
خلاصة القول، إنّه وفي عالم من الاعتماد المتبادل متعدّد الأوجه، فإنّ وجود نظام من القواعد يُعدُّ أمرا ضروريا لأجل خفض تكاليف المعاملات والمساعدة على تجسيد تفاعلات متعدّدة تحدث بين الدول. يلتقط الأميرال هاري هاريس (Harry Harris)، القائد السابق للقوات العسكرية الأمريكية في الباسفيك، هذه النقطة حينما يُشير إلى النظام الدولي الليبرالي باعتباره “نظام التشغيل العالمي” (The Global Operating System).
أنماط الأنظمة:
هناك فروقات مهمّة ثلاث بين النظم التّي عرفها الهيكل أو النسق الدولي (International System). الفرق الأول هو ذلك القائم بين الأنظمة الدولية والأنظمة المحدودة (International Orders and Bounded Orders). فلِيكون النظام نظاما دوليا ينبغي له أن يشتمل على كلّ القوى العظمى في العالم: من الناحية المثالية، فإنّ عليه أن يحتوي على كلّ بلدان النظام. على العكس من ذلك، تتكوّن الأنظمة المحدودة من مجموعة من المؤسّسات التّي تضّم عددا محدودا من الأعضاء، لا تتضمّن هذه المؤسّسات كلّ القوى العظمى، وتكون في العادة إقليميةَ النطاق. في أغلب الحالات تكون مهيمن عليها من قِبل قوة عظمى واحدة، رغم أنّه من الممكن أن تُشكّل قوتيْن عظمييْن أو أكثر نظاما محدودا بشرط أن تبقى قوة عظمى واحدة على الأقل خارجه. باختصار، فإنّ الأنظمة الدولية والمحدودة تُنشَأ وتُدار من طرف قوى عظمى.
ينصبّ اهتمام الأنظمة الدولية أساسا على تسهيل التعاون بين الدول. على وجه التحديد، فإنّها تُساعد على تعزيز التعاون سواء بين القوى العظمى في النظام أو بين كلّ بلدان العالم تقريبا. في المقابل، فقد صُمّمت الأنظمة المحدودة أساسا بهدف السماح للقوى العظمى المتنافسة بشنّ تنافس أمني ضدّ بعضها البعض، لا للدفع قُدما بالتعاون بينها. مع ذلك، فإنّ القوى العظمى التّي تقود الأنظمة المحدودة باتجاه العمل على نحو جادٍّ لأجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء تتولّى قهرهم إذا إستلزم الأمر ذلك. تُعدّ المستويات العليا من التعاون داخل النظام المحدود مسألة جوهرية لأجل شنّ تنافس أمني بين القوى العظمى المتعارضة. أخيرا، تُعدُّ الأنظمة الدولية سِمةً ثابتة للسياسة الدولية المعاصرة، في حين لا تُعتبر الأنظمة المحدودة كذلك، كما تكون الأنظمة الدولية الواقعية لوحدها مصحوبة بنظم محدودة.
يتعلّق الفرق الثاني الأساسي بالأنماط المختلفة للأنظمة الدولية التّي يمكن للقوى العظمى أن تُنظّمها، وهي أنظمة: واقعية، مُلحدة أو إيديولوجية “بما فيها الليبرالية” (realist, agnostic, or ideological “to include liberal” ). يعتمد أيّ نظام بالأساس على توزيع القوة بين القوى العظمى. تكمن المسألة الأساسية هنا فيما إذا كان الهيكل (أو النسقSystem/) ثنائي الأقطاب، متعدّد الأقطاب أو أحادي القطبية. إذا كان أحادي القطبية، فإنّ الإيديولجيا السياسية للدولة المهيمنة تكون مهمّةً أيضا لأجل تحديد نمط النظام الدولي المتشكّل. لكن، في القطبية الثنائية والمتعدّدة تكون الإيديولوجيا السياسية للقوى العظمى غير ذات صلة وأهميّة بشكل كبير.
الأنظمة الواقعية (Realist Orders):
يصير النظام الدولي –والمؤسّسات التّي شكّلته- نظاما واقعيا إذا كان الهيكل إمّا ثنائيَّ القطبية أو متعدّد الأقطاب، وسبب ذلك بسيط: فإذا كان هناك قوتين عظمتين أو أكثر في العالم، فسيكون بحوزتهما خيار أقلّ إلاّ التصرّف وفقا لإملاءات واقعية والانخراط في تنافس أمني ضدّ بعضهما البعض. يكون هدف هذه القوى هنا هو كسب القوة على حساب خصومها، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فإنّ هدفها هو ضمان عدم تحوّل ميزان القوى ضدّها وفي غير صالحها. تخضع الاعتبارات الإيديولوجية إلى اعتبارات أمنية في هذه الظروف. سيكون الأمر كذلك حتّى ولو كانت كلّ القوى العظمى –في هذه الحالة- دولاً ليبرالية. مع ذلك، يكون للقوى العظمى المتنافسة في بعض الأحيان حافز للتعاون. على كلّ حال، فإنّها تتحرّك في عالم يقوم على درجة عالية من الاعتماد المتبادل حيث تكون متأكدة بأنّها ستحوز على بعضٍ من المصالح المشتركة.
يساعد النظامان المحدود والدولي، اللذان يشتغلان جنبا إلى جنب في العالم الواقعي، القوى العظمى المتعارضة على التنافس والتعاون بينهما أيضا. على وجه التحديد، تُنشِئ القوى العظمى نُظمها المحدودة للمساعدة على شنّ تنافس أمني ضدّ بعضها البعض. على العكس من ذلك، فهي تُنشِئ النظم الدولية لتسهيل التعاون بينها، وفي العادة بينها وبين بلدان أخرى أيضا. إنّ المؤسّسات المُشكّلة للنظام الدولي مناسبة تماما لمساعدة القوى العظمى على الوصول إلى اتفاقيات حينما يكون لهذه الدول مصالح مشتركة. وبالرغم من هذا الاهتمام بالتعاون، فإنّ القوى العظمى تظلّ متنافسة والتّي تكون علاقاتها تنافسية في جوهرها. تكون اعتبارات توازن القوى دائما حاضرة، حتّى في الوقت الذّي تعمل القوى العظمى عبر المؤسّسات الدولية على التعاون مع بعضها البعض. وعلى وجهٍ أدّق لا وجود لقوة عظمى سوف تتجّه لتوقيع اتفاقية من شأنها أن تُقلّص قوتّها.
يُمكن في بعض الأحيان للمؤسّسات التّي شكّلت النظم الواقعية –سواء كانت أنظمة دولية أو محدودة- أن يكون لها ملامح متنافسة مع القيم الليبرالية، إلاّ أنّ ذلك لا يُعدُّ دليلا على أنّ النظام هو نظام ليبرالي. تحدث مثل هذه السمات فقط ليكون له معنى من منظور ميزان القوى. على سبيل المثال، يمكن أن تكون المؤسّسات الاقتصادية الأساسية داخل نظام محدود ما مُوجّهةً لتسهيل التجارة الحرّة بين الدول الأعضاء، لا بسبب حسابات ليبرالية ما، بل لأنّ الانفتاح الاقتصادي يُعتبر بمثابة السبيل الأفضل لتوليد قوة اقتصادية وعسكرية داخل هذا النظام. في الواقع، فإذا كان التخلّي عن التجارة الحرّة والتحرّك باتجاه نظام اقتصادي أكثر انغلاقا يكون ذا معنى استراتيجي أفضل، فإنّ من شأن أمرٍ كهذا أن يحدث في نظام واقعي.
الأنظمة المُلحدة والإيديولوجية (Agnostic and Ideaological Orders):
في حالة ما إذا كان العالم أحادي القطبية، فمن غير الممكن أن يكون النظام الدولي واقعيا. تحتوي القطبية الأحادية على قوة عظمى واحدة، وبالتالي وبحكم التعريف لا يمكن أن تكون هناك منافسة أمنية بين قوى عظمى، وهو شرط لا غنى عنه بالنسبة لأيّ نظام عالمي واقعي. نتيجةً لذلك، فإنّ القطب الأوحد له أسباب قليلة لخلق نظام محدود. على كلّ حال، فإنّ الأنظمة المحدودة صُمّمت أساساً لشنّ منافسة أمنية ضدّ قوى عظمى أخرى، وهو أمر غير ذي صلة في الأحادية القطبية. مع ذلك، من الممكن أن تكون بعض المؤسّسات في هذا النظام الدولي اللاواقعي مؤسّسات ذات نطاق إقليمي، في حين ستكون أخرى مؤسّسات عالمية حقّا من حيث نطاق عضويتها. لكن أيّاً من هذه المؤسّسات الإقليمية يمكن أن تكون مجتمعةً معاً لتشكيل نظاماً محدودا، بدلا من ذلك ستكون إمّا فضفاضة أو مرتبطة بإحكام مع المؤسّسات الأخرى المتواجدة في النظام الدولي السائد.
في القطبية الأحادية يمكن للنظام الدولي أن يتّخذ أحد الشكليْن –إلحادي أو إيديولوجي- وذلك حسب الإيديولوجية السياسية للدولة القائدة. تكمن المسألة الأساسية في ما إذا كان للقطب الأحادي إيديولوجية عالمية شمولية، الأمر الذّي يفترض بأنّ تُصدَّر قيمه المركزية ونظامه السياسي للبلدان الأخرى. فإذا ما إنطلق القطب الأوحد من هذا الافتراض، فإنّ النظام العالمي سيكون نظاما إيديولوجيا. بعبارة أخرى، سوف يحاول القطب الأوحد أن ينشر إيديولوجيته إلى أبعد مدى وأوسعه وأن يعيد صنع العالم على صورته هو، كما سيكون هذا القطب في موضعٍ أفضل لمتابعة هذه المهمّة نظرا لعدم وجود أيّ قوى عظمى يجب أن يُنافسها.
بالطبع، تحتوي النزعة الليبرالية داخلها (Liberalism) جنوحاً عالميا شموليا قويّا، والذّي ينبع من تأكيدها على أهميّة الحقوق الفردية. تُؤكِّد القصة الليبرالية، التّي تُعدُّ نزعةً فردانية في جوهرها، أنّ لكلّ شخصٍ حقوقا طبيعية غير قابلة للمصادرة. لهذا، يميل الليبراليون إلى الاهتمام بعمق بحقوق الشعوب عبر العالم بغضّ النظر عن البلد الذّي يعيشون فيه. لذلك، فإذا كان القطب الواحد ديمقراطيا ليبراليا، فإنّه سيحاول في الغالب خلق نظام دولي يهدف إلى إعادة تشكيل العالم على صورته هو.
كيف يبدو النظام الدولي الليبرالي؟ يجب على الدولة المهيمنة في النظام أن تكون ديمقراطية ليبرالية بشكل واضح، كما يجب أن يكون لها تأثير ضخم داخل المؤسّسات الأساسية التّي يعرفها النظام. علاوة على ذلك، يجب أن يكون هناك عدد كبير من الديمقراطيات الليبرالية الأخرى في النظام واقتصاد عالمي منفتح إلى حدٍّ كبير. إنّ الهدف النهائي لهذه الديمقراطيات الليبرالية، وبالأخصّ صاحبة القيادة منها، هو نشر الديمقراطية عبر العالم، مع تشجيع مزيدٍ من التواصل الاقتصادي وبناء مؤسّسات دولية قويّة وفعّالة بشكلٍ متزايد. جوهر المسألة، فإنّ الهدف هو خلق نظامٍ عالميٍ يتكوّن حصريا من ديمقراطيات ليبرالية منخرطة اقتصاديا مع بعضها البعض، مُقيّدة وملتزمة جميعا بجملة من القواعد المشتركة. أمّا الافتراض الأساسي الذّي يقف وراء ذلك فهو أنّ نظاماً كهذا سيكون خاليا من الحرب إلى حدٍّ كبير ومن شأنه أن يُولّد الازدهار لجميع دوله الأعضاء.
تُعتبر الشيوعية أيضا إيديولوجيةً عالمية شمولية بإمكانها أن تكون بمثابة قاعدة لبناء نظام دولي إيديولوجي. في الواقع، تتقاسم الماركسية بعضا من التشابهات المهمّة مع الليبرالية، ومثلما أوضح جون غراي (John Gray): “كلاهما إيديولوجيتان مستنيرتان تتطلّعان إلى حضارةٍ عالمية”. بعبارة أخرى، فإنّ كلاًّ من الليبرالية والشيوعية عازمتان على تحويل العالم. يرتكز البُعد العالمي الشامل للشيوعية على مصطلح الطبقة، لا مُصطلح الحقوق. يؤكّد ماركس وأتباعه على أنّ الطبقات الاجتماعية تسمو وتتجاوز المجموعات القومية وحدود الدولة. الأكثر أهمية، فإنّهم يحاججون بأنّ الإستغلال الليبرالي قد ساعد على تعزيز رابطة قويّة بين الطبقات العاملة في العديد من البلدان. وهكذا، فلو ربح الاتحاد السوفياتي الحرب الباردة وشعر بتلك الحماسة للماركسية سنة 1989، تلك التّي شعرت بها الولايات المتحدة تجاه الديمقراطية الليبرالية، فإنّ القادة السوفيات كانوا حتما سيحاولون بناء نظام دولي شيوعي.
إذا لم يكن للقطب الواحد إيديولوجيا عالمية شمولية، فلن يكون ملتزما بالتالي بفرض قيمه السياسية، حكم وإدارة نظم بلدان أخرى، سوف يكون النظام الدولي في هذه الحالة نظاما مُلحدا لا يُؤمن بشيءٍ من القيم (Agnostic Order). سوف تستمر القوة المهيمنة في استهداف الأنظمة –السياسية- التّي تتحدّى سلطتها، كما أنّها ستظلّ منخرطةً بعمق في إدارة المؤسّسات التّي تُشكّل النظام الدولي وكذا في قوْلَبة الاقتصاد العالمي ليتناسب مع مصالحها الخاصّة. إلاّ أنّها لن تكون مُلزَمةً بتشكيل السياسة المحليّة على المستوى العالمي. بدلاً من ذلك، فإنّ القطب الأوحد سيكون أكثر تسامحا وبراغماتيةً في تعاملاته مع البلدان الأخرى. لو أنّ روسيا، بنظامها السياسي الحالي كان لها أن تصير قطبا أوحداً، فإنّ النظام الدولي كان سيصير نظاما ملحداً (لا يؤمن بشيء من القيم)، ذلك أنّ روسيا لا تُقاد بإيديولوجيا عالمية شمولية. نفس الأمر يبدو صحيحا بالنسبة للصين، والتّي تُعتبر النَزعة القومية (Nationalism) فيها بمثابة المصدر الأساسي لشرعية نظامها السياسي، وليس الشيوعية. هذا لا يُنكر بأنّ بعض جوانب الشيوعية لا يزال لها أهميّة سياسية بالنسبة لقادة الصين، إلاّ أنّ القيادة في الصين تُظهر قليلاً من الحَمِيّة التبشيرية التّي تأتي في العادة من الشيوعية.
الأنظمة المتينة والهزيلة (Thick and Thin Orders):
قُمتُ بالتمييز حتّى الآن بين الأنظمة الدولية والأنظمة المحدودة، كما قُمتُ بتقسيم الأنظمة إلى أنماط واقعية، إيديولوجية وملحدة (لا تُؤمن بشيءٍ من القيم). وكطريقة ثالثة لتصنيف الأنظمة –سواءً كانت أنظمة دولية أو محدودة- نقوم بالتركيز على مدى إتّساع تغطيتها لأهمّ مجالات نشاطات الدولة. فيما يتعلّق بالإتّساع، فإنّ السؤال المركزي هو ما إذا كان لنظامٍ ما بعض التأثير على النشاطات الاقتصادية والعسكرية الأساسية لدوله الأعضاء. أمّا فيما يتعلّق بالعمق، فإنّ السؤال الأساسي هو ما إذا كانت المؤسّسات في النظام تُمارس نفوذا كبيرا على أفعال وسلوكات دوله الأعضاء. بعبارة أخرى، هل يمتلك النظام مؤسّسات قويّة وفعّالة؟
مع الأخذ بعين الاعتبار هذين البُعديْن، يُمكن للمرء أن يُميّز بين أنظمةٍ متينة (سميكة) وأخرى هزيلة.

يتكوّن النظام المتين من مؤسّسات ذات تأثير جوهري على سلوك الدولة في كلٍّ من المجالين الاقتصادي والعسكري، لذا يكون نظامٌ كهذا نظاماً واسعاً وعميقاً. في المقابل، يمكن للنظام الهزيل أن يأخذ ثلاثة أشكال أساسية. أولاًّ، يمكنه أن يتعامل فقط مع المجال الاقتصادي أو العسكري، لا كلاهما معاً. حتّى ولو أنّ هذا المجال كان يحتوي على مؤسّسات قويّة، سوف يظلّ يُصنّف باعتباره نظاماً هزيلاً. ثانيا، نظامٌ بإمكانه التعامل مع مجال واحدٍ أو حتّى كلا المجالين، إلاّ أنّه يحتوي على مؤسّسات ضعيفة. ثالثا، إنّه لمن الممكن، لكن من غير المرجّح، أنّ نظاما سوف ينخرط مع مجالات اقتصادية أو عسكرية إلاّ أنّه سيكون ذا مؤسّساتٍ قويّةٍ في أحد هذيْن المجالين فقط. بإختصار، يُعدُّ النظام الهزيل إمّا غير واسعٍ، غير عميقٍ بالكامل أو عميقا في أحد هذيْن المجالين الحاسمين فقط. يختصر الشكل الأول الأصناف المختلفة للأنظمة المستخدمة في هذا المقال.
صعود وسقوط الأنظمة الدولية:
لا وجود لنظام دولي يستمر إلى الأبد، الأمر الذّي يُثير سؤالاً عن: ما الذّي يُفسّر انهيار نظام قائم وصعود آخر جديد؟ إنّ العاملين الاثنين اللذّين يتسّببان في النظام السائد، توزيع القوة، والإيديولوجية السياسية للدولة القائد يُفسّران سبب سقوط الأنظمة الواقعية والملحدة، كما يُوضّحان نمط النظام الذّي يحلّ محلّهما. وفي الوقت الذّي يُساعد فيه نفس العاملان على تفسير تحلّل الأنظمة الإيديلوجية، فإنّ هناك عاملان آخران يلعبان عادةً الدور المحوري في التسبّب في انهيارها وهما النَزعَة القومية وسياسة توازن القوى.
تنهار الأنظمة الواقعية، التّي ترتكز على الثنائية القطبية أو التعدّدية القطبية، حينما تتغيّر أُسس توزيع القوة بطرقٍ جذرية. إذا ما تحوّل الهيكل الدولي من الثنائية القطبية إلى التعدّدية القطبية أو العكس، أو إذا ما انخفض أو ازدياد عدد القوى العظمى في هيكلٍ متعدّد الأقطاب، فإنّ النظام الناتج يظلّ نظاما واقعيا، حتّى وإن كان مختلفا في إعداداته وتركيبته، وبغضّ النظر عن عدد القوى العظمى في النظام، فسوف تظلّ هذه القوى حتما تنافس بعضها البعض لأجل القوة والنفوذ. لكن في حالة ما إذا أفسحت الثنائية القطبية أو التعدّدية القطبية الطريق للأحادية القطبية، فإنّ النظام الجديد سيكون إمّا نظاما ملحداً أو إيديولوجيا، وذلك بناءً على ما إذا كان القطب الواحد مُلتزماً بإيديولوجية عالمية شمولية أم لا.
تميل الأنظمة الواقعية إلى أن يكون بحوزتها قوة بقاء كبيرة، لأنّ التحوّلات الكبرى في ميزان القوة تكون عادة نتيجةً للنمو الاقتصادي المتفاوت بين القوى العظمى خلال مدّة طويلة من الزمن. إلاّ أنّ حروب القوى العظمى يمكن أن تقود في بعض الأحيان إلى تغيّر سريع في توزيع القوة العالمي بالرغم من أنّ أحداثاً كهذه تُعدُّ ناذرة الحدوث. على سبيل المثال، بعد الحرب العالمية الثانية تحوّل الهيكل (System) من التعدّدية القطبية إلى الثنائية القطبية، والسبب كان بشكلٍ أكبر راجع إلى الإنهزام المطلق لألمانيا واليابان وإلى التكلفة المضاعفة التّي تكبدّتها كلّ من بريطانيا وفرنسا، فصعد الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة باعتبارهما قطبيْن. علاوة على ذلك، فحينما تتغيّر الأنظمة الواقعية، فإنّها عادة ما تُفسح الطريق لأنظمة واقعية حديثةَ التكوّن –كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية- سبب ذلك بسيط وهو أنّ القطبية الأحادية أمرٌ ناذر الحدوث.
تميل الأنظمة الملحدة (التّي لا تُؤمن بشيءٍ من القيم) أيضا لأن يكون لها قدرة جوهرية على البقاء، ذلك لأنّ القطب الأوحد يقبل التباين أو عدم التجانس الكامن في الحياة السياسية والاجتماعية ولا يحاول تقريبا ممارسة الإدارة الفردية الصغيرة لسياسة كلّ بلدٍ على حِدا في العالم. يُساعد هذا النمط البراغماتي من السلوك على المحافظة على قوة المهيمن، إن لم يزدها. من المحتمل أن يبلغ النظام الملحد نهايته حينما تُفسح الأحادية القطبية الطريق أمام الثنائية القطبية أو التعدّدية القطبية، جاعلةً من النظام نظاما واقعياً، أو في حالة ما إذا عرف القطب الواحد ثورةً داخل الديار وتبنّى إيديولوجية عالمية شمولية، والتّي ستقوده بشكلٍ مؤكّد إلى صياغة نظام إيديولوجي.
على العكس من ذلك، فإنّ أيّ نظام دولي إيديولوجي ارتكز على إيديولوجيا عالمية شمولية، على غرار الليبرالية أو الشيوعية، فمُقدّرٌ أن تكون له فترةُ حياةٍ قصيرة، وسبب ذلك يرجع أساساً إلى الصعوبات الداخلية والعالمية التّي تتصاعد حينما يسعى القطب الواحد إلى إعادة صنع العالم على صورته هو. تعمل النزعة القومية وسياسة توازن القوى على تقويض الهندسة الاجتماعية اللازمة في البلدان المستهدَفة لأجل تغيير النظام، في حين تخلق النزعة القومية أيضا مشكلات كبيرة على الجبهة الداخلية للدول في مواجهة القطب الواحد وحلفاءه الإيديولوجيين. حينما تبرز مثل هذه المشكلات فمن المحتمل أن يستسلم القطب الواحد من مهمّة محاولة إعادة تشكيل العالم على صورته، أو بالأحرى التخلّي عن جهوده في تصدير إيديولوجيته إلى الخارج. بإمكانه حتّى أن يتخلّى عن هذه الإيديولوجيا تماما، وحينما يحدث ذلك يتوقّف النظام عن كونه إيديولوجيا ليصير ملحداً (لا يُؤمن بقيمٍ وجب تصديرها نحو الخارج) (Agnostic Order).
يُمكن للنظام الإيديولوجي أيضا أن يصل إلى النهاية بطريقة ثانية، إذ يُمكن لقوى عظمى جديدة أن تصعد، وهو ما من شأنه أن يُقوّض الأحادية القطبية ويؤدّي إلى هيكلٍ ثنائي أو متعدّد الأقطاب. في هذه الحالة، سوف يُعوّض النظام الإيديولوجي بأنظمة واقعية محدودة أو دولية.
أنظمة الحرب الباردة (1945-1989):
أدّى توزيع القوة العالمي من سنة 1945 إلى سنة 1989 إلى الثنائية الثطبية والتّي قادت إلى تشكيل ثلاثة نظم سياسية أساسية. لقد كان هناك نظام دولي عام وشامل تمّ إنشاؤه والمحافظة عليه بشكل واسع من قِبل الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة لغايات تسهيل التعاون بينهما حينما يكون لهما مصالح مشتركة. وبالرغم من هذا التأكيد على التعاون، فلم يكن النظام ليبراليا، حيث انخرطت القوتان العظميان في تنافس مكثّف طيلة فترة الحرب الباردة، كما كان النظام الذّي أنشأه متوافقا تماماً مع المصالح الأمنية لكلا الجانبين. علاوة على ذلك، فلم يكن الاتحاد السوفياتي ديمقراطيا ليبراليا، وفي الواقع كانت موسكو وواشنطن خصميْن إيديولوجيين. لقد كان هناك نظاميْن محدوديْن أيضا، إقتصر أحدهما بشكلٍ كبير على الغرب وتمّ الهيمنة عليه من قِبل الولايات المتحدة، أمّا الآخر فإنسجم مع بلدان العالم الشيوعي وتمّ الهيمنة عليه من قِبل الاتحاد السوفياتي، وكلاهما تمّ إنشاؤه من طرف القوتيْن العظمييْن لأهداف شنّ منافسة أمنية ضدّ بعضهما البعض.
لقد كان النظام الدولي القائم أثناء الحرب الباردة نظاما هزيلا، حيث لم يكن له نفوذ واضحٌ معلنٌ على سلوكات الدول –خصوصا القوى الكبرى- سواءً في المجال الاقتصادي أو العسكري لأنّ الغرب والعالم الشيوعي انخرطا في حدٍّ أدنى من الوصال الاقتصادي وحسب أثناء الحرب الباردة، لقد كانت هناك حاجة ضئيلة لبناء مؤسّسات لأجل المساعدة على إدارة تعاملاتهما الاقتصادية. لكن من الناحية العسكرية فقد كانت القصّة أكثر تعقيداً. فنظراً لأنّ الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي كانا عدوّيْن لدودين تنافسا لأجل القوة، فقد ركّز كلاهما على بناء أنظمة محدودة متينة تُساعد على شنّ هذا الصراع. لذلك، فلم تكن المؤسّسات العسكرية الأساسية التّي أنشأتها كلٌّ من القوتيْن العظمييْن –الناتو ووارسو- مؤسّسات دولية النطاق. فقد كانت بدلا من ذلك بمثابة العناصر الأساسية لنظم محدودة بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.
مع ذلك، فقد كان للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في بعض الأحيان أسبابا جيّدةً للتعاون والتفاوض بخصوص اتفاقيات التحكّم في السلاح والتّي خدمت مصالحهما المتبادلة. الأكثر أهمية من ذلك، فقد عملا معاً لصياغة مؤسّسات صُمِّمت لمنع الانتشار النووي، كما توصّلا إلى اتفاقيات هدفت إلى الحدّ من سباق التسلّح وإلى إذّخار الأموال أيضا، حظر الأسلحة الزعزعة للاستقرار، وتجنّب المنافسة في نطاقات على غرار القارة القطبية الجنوبية. أخيرا، فقد توصّلا إلى اتفاقيات هدفت إلى إرساء “خطط طريق” ومقاييس بناء ثقة. في خضّم هذا المسار، ساعدت موسكو وواشنطن على تقوية نظام الحرب الباردة الدولي، رغم أنّه ظلّ نظاما هزيلا.
لقد عارضت كلا القوتين العظميين مزيدا من الانتشار النووي بمجرّد امتلاكهما القنبلة. وبالرغم من أنّ الولايات المتحدة اختبرت أولّ سلاحٍ ذرّي سنة 1945 ثمّ تبعها الاتحاد السوفياتي سنة 1949، فإنّهما لم يضعا جملة مؤسّساتٍ من شأنها أن تحدّ بشكلٍ جدّي انتشار الأسلحة النووية إلى غاية منتصف السبعينيات. لقد كانت الخطوة الأولى باتجاه الأمام هي إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذريّة سنة 1957، مهمّتها الأساسية هي تعزيز الاستخدام المدني للطاقة النووية، لكن مع ضمانات تضمن أنّ الدول المستقبِلة للمواد والتكنولوجيا النووية لأغراض سلمية لن تستخدمها لإنتاج قنبلة. تمثّلت المؤسّسات التّي وضعتها القوتين العظميين لكبح الانتشار النووي في اتفاقية عدم الانتشار النووي (NPT) ومجموعة مورّدي المواد النووية واللتيْن أبطئتا بشكلٍ ملحوظ جنباً إلى جنب مع الوكالة الدولية للطاقة النووية انتشار الأسلحة النووية بعد سنة 1975.
بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي أيضا في متابعة اتفاقية مراقبة التسلّح في أواخر سنوات الستينيات والتّي حدّت من ترسانتهما النووية الاستراتيجية. تمثّلت النتيجة في معاهدة الحدّ من التسلّح الاستراتيجي (SALT I) سنة 1972، والتّي قلّصت عدد الأسلحة النووية الاستراتيجية التّي يمكن أن ينشرها كلا الطرفين (حتّى في المستويات العالية جدّا)، كما قيّدت بشدّة تطوير أنظمة مضادّة للصواريخ الباليستية. في سنة 1979، وقّعت موسكو وواشنطن معاهدة سالت 2 (SALT II) ، والتّي وضعت قيودا إضافية للترسانة النووية الاستراتيجية لكلّ طرف، على الرغم من عدم تصديقها عليها. عملت القوتين العظميين على إتّباع معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية أثناء الثمانينيات، إلاّ أنّها لم تدخل حيّز الفعل والتأثير إلى غاية المرحلة التّي أعقبت نهاية الحرب الباردة. أمّا معاهدة القوات النووية متوسّطة المدى المُبرمة سنة 1988، فكانت إحدى أهمّ اتفاقيات التحكّم في التسلّح والتّي حيّدت كلّ الصورايخ ذات المدى القصير والمتوسّط من ترسانات الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة.
تفاوضت القوتين العظميين على عدد آخر من الاتفاقيات والمعاهدات الأمنية الأقل أهميّة والتّي كانت جزءًا من نظام الحرب الباردة الدولي. تضمنّت نظام معاهدة أنتاركتيكا (المتعلّقة بالقطب الجنوبي) سنة 1959، معاهدة حظر التجارب الجزئية (1963)، اتفاقية الخط –الهاتفي- الساخن موسكو-واشنطن (1967)، معاهدة الحدّ من الأسلحة في قاع البحر (1971)، اتفاقية الحوادث الأمريكية-السوفياتي في البحر (1972)، مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا (1973)، ميثاق الأسلحة البيولوجية (1975)، واتفاق هيلسنكي (1975). كانت هناك بعض الاتفاقيات التّي تمّ التوصّل إليها أثناء الحرب الباردة على غرار ميثاق الأمم المتحدة حول قانون البحار الذّي تمّ توقيعه سنة 1982، إلاّ أنّه لم يُصادق عليه ويدخل حيّز الفعل إلى غاية سنة 1994، أي خمس سنوات بعد إنتهاء الحرب الباردة.
ربّما كانت الأمم المتحدة أكثر المؤسّسات وضوحا في نظام الحرب الباردة الدولي، إلاّ أنّها كانت ذا نفوذ ضئيل على سلوكات البلدان عبر العالم، والسبب راجع أساسا إلى التنافس بين القوتين العظميين والذّي جعل الأمر في الغالب مستحيلا لهذه المؤسّسة لتبنّي وفرض سياسات منتظمة.
إضافة إلى هذا النظام الدولي الهزيل، بنت كلٌّ من القوتين العظميين نظاما محدودا متينا للمساعدة في شنّ الحرب الباردة. تضمّن النظام المنقاد من قِبل السوفيات مؤسّسات تعاملت مع المسائل الاقتصادية، العسكرية والإيديولوجية. على سبيل المثال، فقد تمّ تأسيس مجلس الدعم المتبادل (COMECON) سنة 1949 لتسهيل التجارة بين الاتحاد السوفياتي والدول الشيوعية في أوروبا الشرقية. كان عهد وارسو حلفاً عسكريا تأسّس سنة 1955 لمواجهة الناتو بعدما قرّرت دول أعضاء الناتو دعوة ألمانيا الغربية للانضمام إلى التحالف. ساعد عهد وارسو أيضا موسكو على إبقاء حلفاءها بشرق أوروبا على الخطّ. أخيرا، أنشأ السوفيات مكتب المعلومات الشيوعي سنة 1947 باعتباره خليفة للأممية الشيوعية العالمية. لقد صُمّم كلاهما لاتنسيق جهود الأحزاب السياسية عبر العالم، وقد كانت الغاية الأساسية هي السماح للسوفيات تزويد إخوانهم الإيديولوجيين برؤاهم السياسية. لقد تمّ حلّ مكتب المعلومات الشيوعي سنة 1956.
كان النظام الغربي المحدود –من جهته- مهيمنا عليه من قِبل الولايات المتحدة والتّي شكلّته ليتناسب مع مصالحها الخاصّة. لقد تضمّن مجموعة كبيرة من المؤسّسات الاقتصادية على غرار صندوق النقد الدولي (1945)، البنك الدولي (1945)، الاتفاقية العمة للتجارة والجمركة (GATT, 1947)، لجنة تنسيق ضبط التصدير متعدّد الأطراف (CoCOM, 1950)، الجماعة الأوروبية (EC, 1950)، بالإضافة على الناتو على الجبهة الأمنية. وبالرغم من هيمنة الولايات المتحدة الليبرالية على هذا النظام المحدود، والتّي تضمّنت عددا من الديمقراطيات الليبرالية الأخرى أيضا، فقد كان نظاما واقعياً (Realist Order) من أعلاه إلى أسفله. لقد كانت مهمّته الأساسية خلق غرب قويّ قادر على احتواء وهزيمة الاتحاد السوفياتي وحلفائه في نهاية المطاف.
بالرغم من هذا التأكيد على الأمن، فقد كانت مسألة توليد وتعميم الازدهار نهايةً مهمّة في حدّ ذاتها للبلدان في هذا النظام المحدود. علاوة على ذلك، كان هناك بعض جوانب هذا النظام الواقعي منسجمة مع المبادئ الليبرالية. على سبيل المثال، هناك شكّ قليل بأنّ صنّاع السياسة الأمريكية شأنهم شأن الآخرين فضلّوا التعامل مع الدول الديمقراطية بدلا من الدول الديكتاتورية، إلاّ أنّ عملية ترويج الديمقراطية أثمرت دوما حينما تنازعت مع سياسة توازن القوى المملاة. لم تستبعد الولايات المتحدة الدول غير الديمقراطية من الانضمام إلى الناتو أو أبعدت البلدان التّي تخلّت عن الديمقراطية بعدما انضمت إليه، مثلما أظهر الحال مع اليونان، البرتغال وتركيا.
علاوة على ذلك، بالرغم من ميل واشنطن لتفضيل السياسات الاقتصادية التّي شجعّت التجارة الحرّة والاستثمار بين أعضاء النظام، فقد تمّ قيادة وتوجيه هذه السياسات في أغلب الأحوال من خلال اعتبارات استراتيجية. فمثلما أشارت جوانا غووا (Joanna Gowa): “فقد قاد الصراع شرق-غرب الولايات المتحدة إلى دمج السياسة العليا للأمن والسياسة الدنيا للاقتصاد وهو موضوع يُبرز بشكل متكرّر عمل هؤلاء الباحثين الذّين عرّفوا وطوّروا الحقل الفرعي للاقتصاد السياسي الدولي. في الحقيقة، أعدّت إدارة دواين إيزنهاور، التّي آمنت بشكلٍ عام بأنّ التجارة الحرّة هي السبيل الأفضل لخلق قوة اقتصادية وعسكرية، في منتصف الخمسينيات للسماح للجماعة الأوروبية لتصير كتلة اقتصادية مغلقة –وهذا لتقويض التجارة الحرّة- لأنّها ظنّت بأنّ ترتيبات غير ليبرالية كهذه سوف تجعل أوروبا الغربية شريكا أكثر قوة في الحرب الباردة. الأكثر من ذلك، فقد تمّ تحفيز خطّة مارشال أساسا لاعتبارات استراتيجية، مثلما أظهر سيباستيان روساتو (Sebastian Rosato) فإنّ سياسة القوة دعّمت صنع الجماعة الأوروبية سلفُ الاتحاد الأوروبي.
النظام الدولي الليبرالي 1990-2019:
بعدما انتهت الحرب الباردة وانهار الاتحاد السوفياتي، غدت الولايات المتحدة مع الوقت البلد الأكثر قوّةً في العالم. لقد وصلت “لحظة الأحادية القطبية”، والتّي تعني بأنّ أكثر العراقيل التّي بزرت بسبب المنافسة الأمنية بين القوى العظمى قد ذهبت. علاوة على ذلك، فإنّ النظام الغربي المتين الذّي أنشأته الولايات المتحدة للتعامل مع الاتحاد السوفياتي ظلّ سليما بشكلٍ مؤكّد، بينما سقط من جهته النظام السوفياتي بشكلٍ سريع.
لقد زال “الكوميكون” وحلف وارسو في صيف 1991، كما سقط الاتحاد السوفياتي شهر ديسمبر 1991. لم يكن مفاجئا أن قرّر الرئيس جورج بوش الأب أن يتولّى النظام الغربي الواقعي وينشره عبر العالم، مُحوّلاً إيّاه إلى نظام دولي ليبرالي. إنّ المؤسّسات التّي شكلّت النظام الدولي الهزيل المتعلّق بحقبة الحرب الباردة –هيئة الأمم المتحدة والعديد من اتفاقيات الحدّ من التسلّح- سوف يتّم إدماجها فيما اصطلح بوش على تسميته “بالنظام العالمي الجديد”.
تمتّعت هذه المساعي الطموحة الملحوظة بدعمٍ متحمّسٍ من الديمقراطيات الليبرالية في شرق آسيا وخصوصا في أوروبا الغربية، وذلك بالرغم من أنّه لم يكن هناك أيّ شكّ بأنّ الولايات المتحدة كانت صاحبة المسؤولية والعبئ. ومثلما أشار إلى ذلك جورج بوش سنة 1990 أنّه: “ليس هناك بديل عن القيادة الأمريكية”. أو مثلما أحبّت نائبة الدولة للخارجية مادلين أولبرايت والرئيس باراك أوباما القول بأنّ الولايات المتحدة “أمّة لا غنى عنها”. جوهر القول، لقد كان كلٌّ من بوش وخلفاؤه في البيت الأبيض عازمين على خلق نظام دولي جديد مختلف أساسا عن النظام الغربي الذّي كان قائما أثناء الحرب الباردة. على وجه التحديد، فقد أُلزموا بتحويل نظام واقعي محدود إلى نظام دولي ليبرالي. في الواقع، فقد جعلها بيل كلينتون واضحةً يوم سعى إلى الرئاسة سنة 1992 حينما قال بأنّ مصطلح سلفه المتعلّق بنظام عالمي جديد لم يكن مصطلحا طموحاً بما فيه الكفاية.
تتضمّن مسألة خلق نظام دولي ليبرالي ثلاث مهمّات أساسية. أولاًّ، لقد كانت حوهرية لتوسعت العضوية في المؤسّسات التّي شكلّت النظام الغربي، بالإضافة إلى نصب مؤسّساتٍ جديدٍ حينما تكون ضرورية. بعبارة أخرى، لقد كان من الأهميّة بمكان بناء شبكة مؤسّسات دولية ذات عضوية عالمية مارست نفوذا كبيرا على سلوك الدول الأعضاء. ثانيا، كان لزاماً خلق اقتصاد دولي منفتح شاملٍ ومتنوّع والذّي عظمّ من التجارة الحرّة، كما عزّز الحريّة المطلقة للأسواق. كان من المفترض أن يصير هذا الاقتصاد العالمي المفرط في عولمته أكثر طموحا في نطاقه من النظام الاقتصادي الذّي ساد وتغلّب في الغرب أثناء الحرب الباردة. ثالثا، كان الأمر حاسما في نشر الديمقراطية الليبرالية بنشاط وحيوية عبر العالم، وهي المهمّة التّي انكمشت باستمرار حينما كانت الولايات المتحدة تُنافس لأجل القوة مع الاتحاد السوفياتي. لم يكن هذا الهدف مرتبطا بالولايات المتحدة لوحدها، فقد إحتضن حلفاءها الأوربيين بشكل عام هذه المهمّة أيضا.
طبعا، فقد ارتبطت هذه المهام الثلاث بشكلٍ مباشر بالنظريات الليبرالية الأساسية عن السلام: المؤسّساتية الليبرالية، نظرية الاعتماد المتبادل الاقتصادي ونظرية السلام الديمقراطي. لذلك، ففي أذهان مهندسيها فقد كانت عملية تشييد نظام دولي ليبرالي قوي ومستدام مترادفة مع خلق عالم سلمي. منح هذا الاعتقاد الراسخ الولايات المتحدة وحلفاءها باعثا قويّا للعمل بدأب على خلق هذا النظام الجديد. كما كانت مسألة إدماج الصين وروسيا في هذا النظام بشكلٍ خاصٍ مسألةً مهمّة لأجل نجاحه، لأنّها صارت أكثر الدول قوة في النظام بعد الولايات المتحدة. كان الهدف هو غرزهما في أكبر عدد من المؤسّسات، دمجهما بشكل كامل في الاقتصاد الدولي المفتوح، ومساعدتهما في التحوّل إلى ديمقراطيات ليبرالية.
إنّ توسيع الناتو باتجاه أوروبا الشرقية لهو مثال جيّد عن عمل الولايات المتحدة وحلفائها على تحويل النظام الغربي المحدود إلى نظام دولي ليبرالي. قد يظّن أحدهم بأنّ تحرّك الناتو شرقا كان جزءًا من استراتيجية ردع كلاسيكية هدفت إلى احتواء روسيا العدوانية المحتملة. إلاّ أنّه لم يكن كذلك، لأنّ استراتيجية الغرب كانت موجّهة نحو تحقيق أهداف ليبرالية. لقد كان الهدف مرتبطا بدمج بلدان أروروبا الشرقية –وربّما روسيا يوما ما أيضا- في “جماعة أمنية” (Security Community) كانت قد تطوّرت في أوروبا الغربية أثناء الحرب الباردة. لا يوجد دليل بأنّ مهندسيه الأساسيين –الرؤساء كلينتون، بوش وأوباما- رأوا بأنّ روسيا بإمكانها اجتياح جيرانها وكهذا تطلّب الأمر ضرورة احتواءها، أو رأوا بأنّ القادة الروس لهم أسباب شرعية للخوف من توسّع الناتو.
عكست هذه المقاربة الليبرالية لتوسّع الناتو كيف باعت إدارة كلينتون هذه السياسة للجماهير الأمريكية والأوروبية. على سبيل المثال، حاجج نائب وزيرة الخارجية السيد ستروبي تالبوت (Strobe Talbott) سنة 1995 بأنّ ضمّ بلدان أوروبا الشرقية إلى الناتو –وإلى الاتحاد الأوروبي أيضا- كان بمثابة المفتاح لإنتاج الاستقرار في هذه المنطقة محتملة التقلّب السريع. “توسعةُ الناتو” كما حاجج تالبوت: “ستكون قوة لقواعد القانون سواءً داخل الديمقراطيات الجديدة لأوروبا أو فيما بينها”. علاوة على ذلك، فمن شأنها أن: “تُروّج وتُوطّد القيم الديمقراطية وقيم السوق الحرّ”، والتّي سوف تساهم في تحقيق مزيد من السلام.
لقد ركّزت الولايات المتحدة سياستها تجاه الصين في الحقبة ما بعد الحرب الباردة على ذات المنطق الليبرالي. على سبيل المثال، رأت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت بأنّ مفتاح إستدامة العلاقات السلمية مع الصين الصاعدة هو الانخراط معها، لا محاولة احتواءها على النحو الذّي سعت إليه الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفياتي أثناء الحرب الباردة. ادّعت أولبرايت بأنّ الانخراط (Engagement) سوف يقود إلى تنشيط عضوية الصين في بعض المؤسّسات الكبرى للعالم، كما من شأنه أن يُساعد على إدماجها في نظام اقتصادي تقوده الولايات المتحدة والذّي سيساعد حتما على تحويل الصين إلى ديمقراطية ليبرالية. بعدها ستصير الصين “طرفا مسؤولا” (Responsible Stakeholder) في النظام الدولي، متحفزّة بقوة للحفاظ على العلاقات السلمية مع بقية البلدان.
تُعتبر عقيدة بوش التّي تمّ تطويرها على مدار سنة 2002 واستخدمت لتبرير اجتياح العراق شهر مارش 2003 مثالاً لسياسة الولايات المتحدة الكبرى الهادفة إلى بناء نظام دولي ليبرالي. في خضّم الهجمات الإرهابية لأحداث 11 سبتمبر 2001، خلصت إدارة بوش إلى أنّ الفوز بما تمّ تسميته بالحرب العالمية على الإرهاب لا يتطلّب إلحاق الهزيمة بالقاعدة وحسب، ولكن أيضا مواجهة بلدان على غرار إيران، العراق وسوريا. كان الافتراض الأساسي لعملية الإدارة هذه هو أنّ النظم السياسية في هذه الدول المارقة المزعومة كانت مرتبطة بقوة بمنظمات إرهابية على غرار القاعدة، كما كانت عازمة على الحصول على أسلحة نووية، وبإمكانها حتّى منحها للإرهابيين.
إنّ الطريقة الأفضل للتعامل مع الانتشار النووي والإرهاب، حسب الإدارة الأمريكية، كان تحويل كلّ بلدان الشرق الأوسط الكبير إلى ديمقراطيات ليبرالية وهو الأمر الذّي من شأنه أن يُحوّل هذه المنطقة إلى منطقة سلام عملاق، وبالتالي القضاء على المشكلتين التوأم: الانتشار النووي والإرهاب. لقد أعلن بوش بأنّ “للعالم مصلحة في نشر القيم الديمقراطية”، لأنّ الأمم المستقرة والحرّة لا تُولّد إيديلوجيات القتل. إنّها تُشجّع السعي السلمي لحياة أفضل”.
بدا للعديد من المراقبين مطلع التسعينيات بأنّ الولايات المتحدة كانت في موضع مناسب جدّا لبناء نظام دولي ليبرالي. فقد كان لها خبرة وغيرة في بناء وإدارة النظام الغربي أثناء الحرب الباردة، كما كانت قوية بشكل ملحوظ مقارنة بمنافسيها المحتملين. كانت الصين في مراحل صعودها المبكّرة، أمّا روسيا فقد كانت تعيش مرحلة الكارثة التامّة، وظلّ الحال ذلك طيلة سنوات التسعينيات. كانت ميزة القوة الضخمة تعني بأنّ القطب الواحد بإمكانه أن يتجاهل بشكل كبير إملاءات واقعية والتصرّف وفقا للقيم الليبرالية، الأمر الذّي كان مستحيلا أثناء الحرب الباردة. كما كان يعني أيضا أنّ بإمكان الولايات المتحدة إقناع أو إكراه بقيّة الدول لإتّباع مراسيمها، وبالطبع كان هناك دوما إمكانية أن تستخدم واشنطن القوة لتحصيل ما تريد.
أخيرا، كان للولايات المتحدة وحلفاءها شرعية وفيرة في السنوات الأخيرة التّي أعقبت نهاية الحرب الباردة مباشرةً. فلم يفز هؤلاء بصراع طويل المدى وحسب، بل بدا أيضا أنّه لا يوجد بديل قيّم عن الديمقراطية الليبرالية والتّي بدت بأنّها النظام السياسي الأمثل للمستقبل المنظور. لقد كان هناك اعتقاد واسع في الغرب في تلك اللحظة بأنّ معظم بلدان العالم ستصير في نهاية المطاف بلدانا ديمقراطية ليبرالية، وهو الاعتقاد الذّي قاد فرنسيس فوكوياما إلى إستخلاص أنّ من شأنِ أمرٍ كهذا أن يكون “نهايةً للتاريخ”. علاوة على ذلك، فإنّ مجموعة واسعة من المؤسّسات الدولية التّي ساعدت على إنتاج ازدهار وفير في الغرب أثناء الحرب الباردة بدت بأنّها مناسبة بشكلٍ مثالي بأن تأخذ العولمة إلى خطوة تالية. جوهر القول، بدا وكأنّ الولايات المتحدة في موضعٍ مناسبٍ جدّاً لمتابعة الهيمنة الليبرالية، وهي سياسة خارجية تدعو إلى بناء نظام عالمي مبني على مبادئٍ ليبرالية.
أثناء التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة، بدا بأنّ الولايات المتحدة وحلفاءها على الطريق الأنسب لصياغة نظام دولي ليبرالي واسع النطاق. فمن المؤكّد فقد كانت هناك مشكلات، إلاّ أنّه وبصفة عامة كان النظام الناشئ يعمل على نحوٍ جديد. إلاّ أنّ قلّة من الناس توقّعت أنّه سيبدأ في الانحلال سنواتٍ قليلة بعد بداية الألفية الجديدة، وهذا ما حدث بالفعل.
السنوات الذهبية 1990-2004:
كانت جهود الولايات المتحدة وحلفاءها في إدماج الصين وروسيا بالمؤسّسات الاقتصادية الأساسية للنظام بعد نهاية الحرب الباردة جهودا ناجحة على العموم. انضمت روسيا إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سنة 1992، رغم أنّها لم تنظّم إلى منظمة التجارة العالمية حتّى سنة 2012. أمّا الصين فظلّت عضوا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ سنة 1980 حينما أخذت تايوان مكانا لها في هذه المؤسّستين. انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية سنة 2001. بالرغم من الانتقادات القاصرة بخصوص تايوان سنة 1997، فقد كانت بيجين وواشنطن بخلاف ذلك تحظيان بعلاقات طيّبة خلال سنوات التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة. بدا بأنّ مقاربة الانخراط بدأت تعمل بشكل جيّد. أيضا، فقد كانت العلاقات بين موسكو وواشنطن جيّدة أثناء هذه الفترة.
كانت القصّة في أوروبا إيجابية أيضا. كانت معاهدة ماستريخت الموقّعة سنة 1992 خطوة كبيرة في تعزيز الاندماج الأوروبي، وفي سنة 1999 ظهر اليورو الذّي نُظر إليه بشكلٍ واسع بأنّه دليل على أنّ الاتحاد الأوروبي له مستقبل مشرق. علاوة على ذلك، فقد أحدثت الموجة المبكّرة لتمدّد الاتحاد الأوروبي والناتو باتجاه أوروبا الشرقية بعضا من المشكلات، وذلك بالرغم من أنّ صنّاع السياسة الروس أبدوا معارضتهم لذلك بوضوح. أخيرا، انفصلت كلٌّ من تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفياتي بشكلٍ سلمي، إلاّ أنّ الوضع في يوغوسلافيا لم يكن كذلك، متسبّبا في حرب عبر البوسنا وكوسوفا والتّي كانت الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو بطئيين في الردّ عليها ووضع حدّ لها. إلاّ أنّ السلام البارد قد فُرض في نهاية المطاف في البلقان بحلول سنة 1999.
كانت التطوّرات في الشرق الأوسط الكبير أكثر إختلاطا، لكن حتّى هناك فقد بدا بأنّ المنطقة يجري دمجها ببطئ لكن بثبات في النظام الدولي الليبرالي. وقعّت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو شهر سبتمبر 1993، مُعطيةً الأمل بإمكانية الجانبين إيجاد حلّ سلمي لنزاعهما مع حلول نهاية العقد. قادت الولايات المتحدة، بتفويض من مجلس الأمن الدولي، ائتلافا واسعا من الحلفاء حقّق انتصارا عسكريا مذهلا على العراق مطلع سنة 1991، مُحرّرةً الكويت، مُضعفة الجيش العراقي بشكل كبير مُعرّيةً برنامج السلاح النووي السرّي لصدّام حسين، والذّي تمّ الإطاحة به لاحقا. مع ذلك إحتفظ نظام البعث بالقوة. لا تزال أفغانستان أيضا نقطةً ساخنةً والسبب أساسا كان سماح طالبان للقاعدة بالتخطيط لعمليّاتها هناك من دون التدخّل، بما فيها هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية. إلاّ أنّ حدث ذلك اليوم حثّ الولايات المتحدة لاجتياح أفغانستان شهر أكتوبر 2001، والإطاحة بطالبان، واضعةً مكانها نظاما مواليا للغرب. بعدها في مارس سنة 2003، غزى الجيش الأمريكي العراق وأبعد صدّام عن السلطة. لقد بدا في صيف سنة 2003 بأنّ عقيدة بوش، التّي هدفت إلى نشر الديمقراطية عبر الشرق الأوسط الكبير، على وشك العمل على النحو المنشود.
كان واضحا بأنّ الديمقراطية سائرة في خضم الحرب الباردة، مُؤكّدة كما يبدو إدّعاء فوكوياما أنّه لم يكن هناك بديلٌ قيّم عنها. وفقاً لمؤسّسة فريدوم هاوس، كانت هناك ما نسبته 34% من بلدان العالم بلدانا ديمقراطية سنة 1984. قفزت هذه النسبة إلى 41% بحلول سنة 1996 ثمّ 47% بحلول سنة 2006. على الجبهة الاقتصادية، ولدّت العولمة المفرطة ثراءً وفيراً عبر العالم بالرغم من حدوث أزمات مالية كبرى في آسيا سنة 1997-1998. إضافة إلى ذلك، تنامى الاهتمام بالملاحقة القضائية لمنتهكي حقوق الإنسان، الأمر الذّي قاد باحثا بارزا إلى كتابة كتاب عنوانه “شلاّل العدالة: كيف تقوم محاكمات حقوق الإنسان بتغيير السياسة العالمية”. على جبهة الانتشار النووي، تخّلت جنوب أفريقيا عن برنامج السلاح النووي سنة 1989، في حين وفي منتصف التسعينيات إستسلمت كلٌّ من بيلاروسيا، كازاخستان وأوكرانيا عن ترساناتها النووية التّي ورثتها عن الاتحاد السوفياتي وانضمت إلى اتفاقية الحدّ من الانتشار النووي (NPT). أمّا كوريا الشمالية التّي كانت في طريقها إلى تطوير أسلحة نووية مع مطلع التسعينيات، فقد وافقت سنة 1994 على توقيف برنامجها.
واجهت الولايات المتحدة وحلفائها بعضا من الانتكاسات أثناء سنوات التسعينيات. اختبرت الهند وباكستان أسلحة نووية سنة 1998، عانت إدارة كلينتون من فشل سياساتها في الصومال (1993) وفي هاييتي (1994-1995)، كما أنّها إستجابت بشكلٍ بطيئٍ جدّا للإبادة الجماعية في رواندا سنة 1994. فشلت الولايات المتحدة أيضا في إنهاء حروبٍ مُميتةٍ في الكونغو والسودان، في الوقت الذّي نمت فيه القاعدة بشكلٍ أكثر خطوة داخل حدود أفغانستان. مع ذلك، فبإمكان المرء أن يُقدّم حُجّةً قويّة بأنّ تقدّما هائلا تمّ إحرازه في قصير في نشر نظام دولي ليبرالي عبر العالم، وبأنّ الولايات المتحدة وحلفاءها سوف يكون بإمكانهم في نهاية المطاف إدماج البلدان المضطربة بأفريقيا وغيرها من المناطق في النظام الجديد وإحراز مزيدٍ من الخطوات الواسعة في دحر الانتشار النووي.
النظام الليبرالي يتّجه إلى الإنحدار 2005-2019:
مع منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، بدأت تشقّقات جديّة في الظهور بالنظام الدولي الليبرالي، والتّي اتسعت منذ ذلك الحين بإطراد، نظرا لما كان يحدث في الشرق الأوسط الكبير. بحلول سنة 2005، تأكّد الأمر بأنّ حرب العراق صارت كارثة، وبأنّ الولايات المتحدة لم يكن لها أيّة استراتيجية لإيقاف القتال، ناهيك عن تحويل العراق إلى ديمقراطيةٍ ليبرالية. في ذات الوقت، بدأ الوضع في أفغانستان يتدهور، إذ عادت طالبان من الموت وأخذت تستهدف الحكومة التّي نصّبتها الولايات المتحدة في كابول. راحت طالبان تنمو بقوة مع الوقت، وصارت الحرب في أفغانستان الآن هي أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، إذ دامت أطول من كلٍّ من الحرب الأهلية الأمريكية، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية مُجتمعةً. علاوة على ذلك، فليس هناك أيّ سبيل ظاهر للنصر بالنسبة للولايات المتحدة، إضافة إلى ذلك، فقد تابعت واشنطن وحلفاءها سياسة تغيير الأنظمة في ليبيا وسوريا، والتّي انتهت بالمساعدة على إثارة حروب أهلية فتّاكة في كلا البلدين. الأكثر من ذلك، وفي خضّم عملية المساعدة على تدمير العراق وسوريا، لعبت إدارتا بوش وأوباما دوراً حاسما في خلق الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، والتّي دخلت الولايات المتحدة في الحرب ضدّها سنة 2014.
بائت عملية أوسلو للسلام، التّي بدت ذات مرّةٍ بأنّها عملية واعدة، بالفشل، ولا يملك الفلسطينيون عملياً أملاً في الحصول على دولتهم الخاصّة. ومع مساعدة واشنطن يستمر القادة الإسرائيليون بدلا من ذلك في إنشاء إسرائيل الكبرى والتّي كما قال عنها رئيسي وزراء إسرائيلييْن سابقيْن ستكون دولة فصلٍ عنصري “آبرتايد”.
تُساهم الولايات المتحدة أيضا في الموت والدمار الذّي تعرفها الحرب الأهلية في اليمن، كما أنّها أعطت موافقتها حينما أطاح الجيش المصري بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في مصر سنة 2013. وبعيدا عن عملية إدماج الشرق الأوسط الكبير في النظام الدولي الليبرالي، لعبت الولايات المتحدة وحلفاءها عن غير قصد دوراً مركزيا في نشر اضطراب غير لبيرلي في هذه المنطقة.
أمّا أوروبا التّي بدت بأنّها ستكون “النجم الأكثر لمعاناً في المجرّة الليبرالية” أثناء التسعينيات، فقد عرفت ورطةً جدّيةً أواخر سنة 2010. لقد عانى الاتحاد الأوروبي من انتكاس كبير سنة 2005 حينما رفض المصوّتون الفرنسيون والألمان المعاهدة المقترحة بهدف إرساء دستور لأوروبا. كانت أزمة منطقة اليورو الأكثر تدميرا والتّي بدأت نهاية سنة 2009 واستمرت بعدها. لا تعرض الأزمة هشاشة اليورو وحسب، ولكنّها خلقت أيضا عداءً شديداً بين ألمانيا واليونان من بين مشكلات سياسية أخرى. وحتّى تجعل الأمر أسوء، فقد صوّتت بريطانيا شهر يوليو 2016 لأجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما تنامت الأحزاب اليمينية المعادية للأجانب بقوة أكبر عبر أوروبا. في الحقيقة، فإنّ الرؤى غير الليبرالية أساسا صارت شائعة مألوفة بين قادة أوروبا الشرقية. مثلما أشار مقال كُتب شهر يناير 2018 بالنيويورك تايمز: “قام الرئيس التشيكي بتسمية المهاجرين المسلمين بالمجرمين. وقال رئيس الحزب الحاكم الهولندي بأنّ المهاجرين أُناسٌ تملأهم الأمراض. وصف زعيم المجر المهاجرين بالسُّم.. أما وزير الداخلية اليميني المتطرّف الجديد في النمسا فقد اقترح تركيز وضع المهاجرين في مراكز الملتجئات، مع مُحاكاةٍ كاملة واضحة وبغيضة للحرب العالمية الثانية”.
أخيراً، بدأت حرب أهلية سنة 2014 في أوكرانيا الشرقية والتّي تسبّبت في انخراط روسيا التّي استولت على القرم من أوكرانيا شهر مارس 2014، الأمر الذّي تسبّب في تدهور جدّي في العلاقات بين روسيا والغرب. لقد بنى كلاهما قواته العسكرية في أوروبا الشرقية وانخرط بشكلٍ روتيني في تدريبات عسكرية صعدّت من الشكوك والتوتّرات بينهما. ترافقت هذه الأزمة، التّي تسبّب فيها توسعة الاتحاد الأوروبي والناتو بشكلٍ كبير، مع جهود الغرب في ترويج الديمقراطية في بلدانٍ على غرار جورجيا وأوكرانيا، بل وحتّى في روسيا ذاتها غير مُظهرة أيّ علامات على نهايتها في أيّ وقت قريب. ونظرا لهذا الوضع، تبحث موسكو عن فرص لبذر الشقاق في الغرب وإضعاف الاتحاد الأوروبي والناتو.
زادت الانشقاقات انفتاحا أيضا في العلاقات الأطلسية خصوصا مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض. يزدري ترامب أغلب المؤسّسات التّي شكلّت النظام الدولي الليبرالي، بما فيها الاتحاد الأوروبي والناتو، والتّي وصفها في تصريح مشهور له “بالعائق” أثناء الحملة الانتخابية سنة 2016. في رسالة أُرسلت إلى القادة الأوروبيين بعد فترة وجيزة من فوز ترامب، قال أحد كبار صنّاع السياسة في الاتحاد الأوروبي بأنّ الرئيس الجديد يُشكّل تهديدا حقيقيا على مستقبل الاتحاد الأوروبي. بعد أشهر قليلة لاحقا، مع مجرّد انتقال ترامب إلى البيت الأبيض، حذّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المعروفة بالتزامها الأطلسي الشديد من أنّ أوروبا قد لا يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة كما كانت تفعل من قبل. إذ قالت بأنّ على الأوروبيين: “أن يأخذو قَدَرهم بأيديهم على نحورٍ فعلي”. منذ ذلك الحين ساءت العلاقات الأطلسية، كما أنّ إحتمال حدوث تحوّل ما في المستقبل المنظور يبدو بعيد المنال. لم تُحدث الأزمة المالية لسنة 2007-2008 دماراً هائلاً لحياة العديد من الناس وحسب، ولكنّها أيضا إستدعت التسائل عن كفاءة النخب التّي تُدير النظام الدولي الليبرالي. وبالإضافة إلى التدهور الحاصل في العلاقات بين روسيا والغرب، فإنّ هناك علامات مقلقة عن صراعٍ محتمل مع الصين، والتّي تعزم على تغيير الوضع القائم المتعلّق ببحر الصين الشرقي، بحر الصين الجنوبي، تايوان، الحدود الصينية-الهندية. ليس مفاجئا أن تكون الولايات المتحدة الآن مهتمّةً أكثر باحتواء الصين بدلا من حملها على الانخراط. في الواقع، قالت إدارة ترامب مؤخّرا بأنّ قبول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية كان خطئا، في الوقت الذّي تُظهر فيه السياسة الحمائية لبجين بوضوح أنّها غير مستعدة لللعب وفقاً لقواعد هذه المؤسّسة.
أخيراً، فإنّ عدد الديمقراطيات الليبرالية عرف تراجعاً منذ سنة 2006، عكس الإتجاه الذّي بدا ذات مرّة غير قابل للوقف. فيما يتصّل بذلك، بدت الأوتوقراطيات الناعمة لتصير بديلاً جذّابا للديمقراطية الليبرالية، وهو التطوّر الذّي كان في الغالب لا مُفكّراً فيه مطلع التسعينيات. ومجّد بعض القادة فضائل الديمقراطية غير الليبرالية، في الوقت الذّي حكم فيه آخرون بلدانا ملتزمة بأنظمة سياسية قائمة على معتقدات دينية راسخة. بالطبع، فقد فقدت الديمقراطية الليبرالية بعضا من جاذبيّتها في الأعوام الأخيرة، على وجه الخصوص، بسبب النظام السياسي الأمريكي الذّي يبدو مختلاًّ في كثير من الأحيان. حتّى إنّ الباحثين الجدّيين صاروا قلقين بخصوص مستقبل الديمقراطية الأمريكية.
خلاصة القول، فإنّ النظام الدولي الليبرالي يتداعى.
ما الخطأ الذّي حدث؟
بغضّ النظر عن النجاحات المبكّرة للولايات المتحدة وحلفاءها في بناء نظام دولي ليبرالي، فقد حمل النظام بذور خرابه في ذاته. حتّى وإن كان صنّاع السياسة الغربيين أكثر حكمة في رعاية هذا النظام، فلم يكن بإستطاعتهم إطالة عمره بأيّ طريقة مُجدية. لقد كان مصيره الفشل نظراً لاحتوائه على ثلاثة عيوبٍ قاتلة.
أولاًّ، إنّ التدخّل في سياسات البلدان لأجل تحويلها إلى ديمقراطيات ليبرالية لهو أمرٌ غاية في الصعوبة، كما أنّ محاولة القيام بهكذا هندسة اجتماعية طموحة على الصعيد العالمي لهو أمر ذو نتائج عكسية بالفعل من شأنه أن يُقوّض شرعية المشروع نفسه. من المؤكّد في أغلب الأحيان أن تُسبّب النزعة القومية مقاومةً كبيرة داخل الدول المستهدفة بتغيير النظام. سوف تساعد سياسة توازن القوى أيضا في إعاقة المشروع في حالات معيّنة. سوف تقف الدول التّي تتخوف من تغيير النظام –أو غيرها من أشكال التدخّل الأمريكي- في صفّ واحد لأجل الدعم المتبادل والبحث عن طرق لإحباط الأجندة الأمريكية الليبرالية. لهذا السبب، ساعدت سوريا وإيران التمرّد العراقي بعد الغزو الأمريكي سنة 2003، كما ساندت كلٌّ من روسيا وإيران بعضهما البعض اقتصاديا، عسكريا وداخل المنتديات الدولية على غرار مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة.
ثانيا، يخلق النظام الدولي الليبرالي في نهاية المطاف شروطاً تُؤدّي إلى مشكلات سياسية خطيرة تتعلّق بالسيادة والهويّة الوطنية داخل الديمقراطيات الليبرالية نفسها، والأهمّ من ذلك هو أنّه حينما تفشل جهود تغيير النظام فإنّها تُنتج تدفّقاتٍ واسعة النطاق من اللاجئين إلى البلدان الليبرالية. مرّة أخرى، فإنّ السبب الأساسي للمشكلة هو النزعة القومية، والتّي تُعتبر بعيدةً عن الموت والاندثار حتّى في المجتمعات الليبرالية الخالصة.
ثالثا، لقد أنتجت العولمة المفرطة تكاليفا اقتصادية هائلة لعدد كبير من الناس داخل الديمقراطيات الليبرالية، بما فيها القطب الواحد (أي داخل الولايات المتحدة أيضا). كان لهذه التكاليف، بما فيها الوظائف المفقودة، الإنخفاض أو الركود في الأجور، عدم المساواة الملحوظة في الدخل، نتائج سياسية داخلية خطيرة، والتّي قوضّت أكثر فأكثر النظام الدولي الليبرالي. علاوة على ذلك، ساعد النظام الدولي الاقتصادي المنفتح على تغذية صعود الصين، والتّي قوضّت في نهاية المطاف، إلى جانب انبعاث روسيا، الأحادية القطبية التّي تُعدُّ بمثابة الشرط الجوهري لخلق نظام دولي ليبرالي.
مخاطر ترويج الديمقراطية:
إنّ أكثر المتطلّبات أهميّةً لأجل بناء نظام دولي ليبرالي هو نشر الديمقراطية الليبرالية إلى أبعد وأوسع مدى، والتّي نُظر إليها في البداية باعتبارها مهمّة مُجدية للغاية. تمّ الاعتقاد بشكل واسع في الغرب بأنّ السياسة تطوّرت إلى النقطة التّي لم يكن فيها بديل معقول للديمقراطية الليبرالية. إذا كان الأمر كذلك، فسوف تكون المهمة سهلةً بشكل نسبي لخلق نظام دولي ليبرالي، لأنّ نشر الديمقراطية عبر العالم سوف يُقابِل مُقاومة ضعيفة. في الواقع، سوف تُرحب أغلب الشعوب بفكرة العيش في ديمقراطية على النمط الغربي، مثلما بدا الأمر في أوروبا الشرقية بعد سقوط الشيوعية.
إلاّ أنّ هذه المساعي كان مصيرها الفشل من البداية. بادئ ذي بدء، لم يكن ولن يكون أبدا اتفاق عالمي حول ما الذّي يُشكّل النظام السياسي المثالي. يمكن لأحدهم أن يُحاجج بأنّ الديمقراطية الليبرالية لهي أفضل شكل للحكم (سوف أفعل ذلك شخصيا)، إلاّ أنّ الآخرين سوف يُفضّلون حتما نُظم حكم مختلفة. يستحق الأمر التذكير أنّه وخلال سنوات الثلاثينيات فضّل العديد من الناس في أوروبا الشيوعية أو الفاشية على الديمقراطية الليبرالية. يمكن لأحدهم أن يشير بعدها إلى أنّ الديمقراطية الليبرالية انتصرت في نهاية المطاف على هذين النزعتيْن. حتّى وإن كان هذا الأمر صحيحا، يُذكر تاريخ سنوات الثلاثينيات بأنّ الديمقراطية الليبرالية ليست هي النظام المحتّم مسبقا للأمور، وأنّه من غير المعتاد على النخب وجماهيرها إختيار أنظمة سياسية بديلة. لذلك، لا ينبغي التفاجؤ بأنّ الديمقراطيات الليبرالية تظهر الآن في أروروبا الشرقية، في الوقت الذّي تعتنق فيه الصين وروسيا نظم حكمٍ أوتوقراطية، وكوريا الشمالية نظام حكمٍ دكتاتوري، وإيران جمهورية إسلامية، كما تُفضّل إسرائيل بشكلٍ متزايد هويّتها اليهودية على سمتها الديمقراطية. لا ينبغي الإستغراب بأنّه لم يكن هناك يومٌ أبدا كانت فيه أكثر من 50% من بلدان العالم ديمقراطيات ليبرالية.
يجتمعُ هذا التعدّد في الرأي بخصوص الأمر الذّي يُشكّل النظام الأفضل للحكم مع النزعة القومية ليجعل من عملية نشر الديمقراطية الليبرالية عبر العالم عمليةً صعبة للغاية. على كلّ حال، تُعتبر النزعة القومية بشكلٍ ملحوظ قوة سياسية هائلة تُؤكّد بشكلٍ كبير على السيادة والتقرير الذاتي للمصير. بعبارة أخرى، فإنّ الدول القومية لا تريد أن تخبرها دولٌ قويّة أخرى كيف تُسير نظامها السياسي. لذلك، فإنّ محاولة فرض الديمقراطية الليبرالية على دول تُفضّل شكلا بديلا للحكم لهو أمرٌ من المؤكّد أن يثير في أغلب الأحيان مقاومة شرسة.
قتالٌ في حروبٍ خاسرة:
تقود محاولة بناء نظام دولي ليبرالي حتما إلى حروبٍ ضدّ قوى أصغر، وهي حروب تهدف إلى تحويل هذه الأهداف إلى ديمقراطيات ليبرالية. هناك حدودٌ كبيرة تتعلّق بمقدار الهندسة الاجتماعية لهذا النوع من القوى الكبرى بإمكانها السعي إليه في نظام ثنائي القطبية أو متعدّد الأقطاب، والسبب راجعٌ أساسا إلى أنّها يجب أن تتنافس مع بعضها البعض من أجل القوة والنفوذ. في الحقيقة فإنّ نشر الديمقراطية يحتّل أهميّةً ثانوية، إن لم يأتي في مرتبةٍ ثالثة من الأهمية، في الوقت الذّي سوف تسعي فيه الدول الليبرالية إلى دعم الحكومات الأوتوقراطية إذا كانت تتماشى ضدّ القوى الكبرى المنافسة، كما فعلت الولايات المتحدة بشكلٍ متكرّر طيلة الحرب الباردة.
لكن في الأحادية القطبية يجد القطب الواحد نفسه حُرّاً في خوض حملاتٍ تبشيرية لأجل جعل العالم أكثر ديمقراطية، والسبب راجع ببساطة لعدم وجود قوى كبرى منافسة يقلق بشأنها. لذلك فليس من المفاجئ أنّ الولايات المتحدة قاتلت في سبع حروب في السنوات التّي أعقبت نهاية الحرب الباردة، كما كانت تخوض حربيْن كلّ ثلاث سنوات طيلة هذه الفترة. إلاّ أنّ حروبا كهذه فشلت باستمرار في بلوغ أهدافها.
ارتكزت الجهود الأمريكية في استخدام القوة العسكرية لأجل جلب الديمقراطية للشرق الأوسط الكبير أساساً، حيث باءت بفشلٍ تلو الآخر. إجتاحت القوات العسكرية الأمريكية أفغانستان (2001) والعراق (2003) مع نيّة تحويلها إلى ديمقراطيات ليبرالية. لم تفشل القوات المحتّلة فقط في تحقيق هذا الهدف، ولكنّها انتهت أيضا إلى تعجيل حدوث حروب دامية أحدثت دمارا هائلا للحياة السياسية والاجتماعية في هذيْن البلدين. يتمثّل السبب الأساسي لهذا السجلّ الكئيب في صعوبة هذه الهندسة الاجتماعية واسعة النطاق في أيّ مجتمع، خاصّة وأنّه لأمرٌ مُضني في بلدٍ أجنبي تمّ إسقاط قيادته السياسية من السلطة للتّو. ستؤول الدولة المستهدفة إلى اضطراب، سوف تجد القوات الغازية نفسها تتعامل مع ثقافة غريبة، بل حتّى يمكن أن تكون عدوانية للديمقراطية الليبرالية. والأكثر أهميّة من ذلك، فمن المؤكّد أن تزيد المشاعر القومية بشكلٍ حادٍّ وأن تُولِّد تمرّداً ضدّ المحتّل، مثلما اكتشفت الولايات المتحدة ذلك في أفغانستان والعراق.
بالرغم من أنّ هذا التأييد الشعبي الفاشل المتآكل للنظام الدولي الليبرالي والشكّ الملقى بخصوص كفاءة قادته، فإنّهم لم يوقفوا القطب الواحد من محاولة نشر الديمقراطية الليبرالية عبر وسائل عسكرية مفرطة في حدّ ذاتها إلى أبعد الحدود. بدلا من ذلك، بحثت عن طرقٍ أقلّ تكلفة لإتمام هذه المهمّة، والتّي تعني فعليّا التخلّي عن فتح واحتلال الدول غير الديمقراطية وتوظيف استراتيجيات مختلفة للإطاحة بالقادة المستبدّين. وهكذا، حينما اندلع القتال بين الفصائل المتنافسة في ليبيا سنة 2011، وظّفت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون القوة العسكرية للمساعدة في إزاحة العقيد معمّر القذّافي عن السلطة. إلاّ أنّ القوى الغربية لم يكن لديها أيُّ سبيل لتحويل ليبيا إلى دولة سليمة، ناهيك عن تحويلها إلى دولة ديمقراطية ليبيرالية، مع أو من دون وجود قوّات على الأرض.
في سنة 2011، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشرق الأوسط أيضا للإطاحة بالرئيس بشّار الأسد عن السلطة في سوريا وذلك من خلال تسليح وتدريب الجماعات المتمرّدة التّي عارضته. إلاّ أنّ المجهود باء بالفشل. يرجع ذلك بشكلٍ كبير إلى روسيا التّي تحظى بروابط استراتيجية طويلة الأمد مع سوريا، والتّي تدخّلت سنة 2015 لإبقاء الأسد في السلطة. لقد أحبطت السياسة الواقعية (Realpolitik) الجهود الأمريكية في سوريا، لكن حتّى وإن تمّ خلع الأسد، فإنّ النتيجة النهائية كانت ستكون إمّا استمرار النزاع، كما هو الحال في ليبيا، أو تنصيبُ مستبّدٍ قاسٍ آخر، مثلما حدث في نهاية المطاف بمصر بعدما تمّ خلع الرئيس حسني مبارك مطلع سنة 2011. لم تكن الديمقراطية الليبرالية إمكانية جدّية، لكن كثرة القتل والفوضى كانت كذلك.
تحويل القوى الكبرى إلى أعداء:
أخيرا، فقد قادت الحملة العسكرية، التّي عزّزت محاولات بناء نظام دولي ليبرالي، إلى تسميم العلاقات بين القطب الواحد وأيّ قوة أخرى في النظام ليست ديمقراطية ليبرالية. وبالرغم من أنّ الدولة المهيمنة سوف تكون ميّالة بقوة لشنّ حرب على قوى صغرى لأجل ترويج الديمقراطية الليبرالية، ونادراً ما تهاجم قوى كبرى لأجل ذات المقصد، خصوصا إذا كانت هذه القوى تحوز على أسلحة نووية. ستكون التكاليف ضخمةً جدّا، كما أنّ إحتمالية النجاح بالأخصّ ستكون قليلة. لهذا، فإنّ صنّاع السياسة الأمريكية في حقبة ما بعد الحرب الباردة لم يفكّرو أبداً على نحوٍ جدّي في اجتياح الصين أو روسيا، حتّى مع كون الولايات المتحدة أكبر قوة من هذين القوتيْن بكثير.
على الرغم من ذلك، ألزمت الولايات المتحدة نفسها بتحويل الصين وروسيا إلى ديمقراطيات ليبرالية مستوعبةً إيّاهم في النظام العالمي الليبرالي الذّي تُهيمن عليه الولايات المتحدة. لم يجعل قادة الولايات المتحدة نواياهم واضحة وحسب، بل اعتمدوا أيضا على منظمات غير حكومية واستراتيجيات بارعة عديدة لدفع بيجين وموسكو نحو اعتناق الديمقراطية الليبرالية. في واقع الأمر، فإنّ الهدف يتمثّل في التغيير السلمي للنظام. كان من المتوقّع أن تقاوم الصين وروسيا جهود القطب الواحد لذات السبب الذّي جعل القوى الصغرى تناضل ضدّ الجهود الأمريكية لتشكيل سياساتها الداخلية وفي الحقيقة لأجل ذات السبب الذّي يجعل الأمريكيين الآن يشمئزّون من فكرة تدخّل روسيا في سياسات بلدهم. في عالم تكون فيه النزعة القومية أكثر الإيديولوجيات السياسية قوّةً، فإنّ السيادة والتقرير الذاتي للمصير تُعتبر مسائلا مهمّة بشكل هائل بالنسبة لكلّ البلدان.
قاومت الصين وروسيا أيضا عملية نشر النظام اللبيرلي لأسباب واقعية، لأنّ من شأن ذلك أن يسمح للولايات المتحدة أن تُهيمن على النظام الدولي اقتصاديا، عسكريا وسياسيا أيضا. على سبيل المثال، لا بيجين ولا موسكو تريدان قوات عسكرية أمريكية في جوارهما، ناهيك على حدودهما. لذلك، فمن غير المفاجئ أن تتكلّم الصين عن الدفع بالقوات العسكرية الأمريكية خارج الباسيفيك الغربي، أو أن تعارض روسيا بعمق منذ أمدٍ طويل توسّع الاتحاد الأوروبي والناتو باتجاه أوروبا الشرقية. في الحقيقة، فإنّ تحريك هذه المؤسّسات باتجاه روسيا قاد في نهاية المطاف إلى الأزمة الأوكرانية سنة 2014. لم يتسبّب هذا النزاع المستمر في تسميم العلاقات بين روسيا والغرب وحسب، بل حفزّ موسكو لأجل إيجاد طرق لإضعاف كلٌّ من الاتحاد الأوروبي والناتو. بإختصار، فإنّ كلاًّ من الحسابات القومية والواقعية أدّت بالقوتيْن الكبيرتيْن في نظام أحادي القطبية إلى مبارزة جهود القطب الواحد في بناء نظام دولي ليبرالي متين.
تحويل الديمقراطيات الليبرالية ضدّ النظام الليبرالي:
يتسبّب بناء نظام دولي ليبرالي متين في نهاية المطاف بمشكلات سياسية جدّية وخطيرة داخل الديمقراطيات الليبرالية ذاتها، لأنّ السياسات المُصاحبة تتصادم مع النزعة القومية. تعمل هذه المشكلات المتواجدة على الجبهة الداخلية، والتّي تأتي على شكلين، على تقويض النظام ذاته في نهاية المطاف.
بادئ ذي بدء، تؤمن الدول اللبيراية بقوة بفضيلة المؤسّسات الدولية، والتّي تقودها إلى تفويض سلطة أكثر فأكثر للمؤسّسات التّي تُشكّل النظام. لكن هذه الاستراتيجية، يُنظر إليها بشكل واسع باعتبارها دليلا على أنّ هذه الدول مستسلمة للسيادة. يمكن لأحدهم أن يُحاجج ما إذا كانت هذه البلدان الليبرالية تتخلّى فعلا عن سيادتها أم لا، لكن ليس هناك شكّ بأنّها تقوم بتفويض سلطة إتخاذ بعض القرارات المهمّة لهذه المؤسّسات، الأمر الذّي قد يسبّب مشكلة سياسية جدّية في الدولة-الأمّة المعاصرة. على كلّ حال، تعطي مزايا لمسألتيْ التقرير الذاتي للمصير والسيادة، ولذلك فإنّها على نقيض بشكلٍ جذري مع المؤسّسات الدولية التّي تصنع سياسات تُؤشّر حتما على دولها الأعضاء. يكتب كلٌّ من جيف كولغان وروبرت كيوهان (Jeff Colgan and Robert Keohane) بأنّ: “التأثير التراكمي لمثل هذه التوسِعات لسلطة المؤسّسات يأتي لأجل الحدّ من السيادة بشكلٍ مفرط، ومنح الشعوب شعورا بأنّ القوى الأجنبية متحكّمة في حياتهم”.
سوف تعتمد شدّة هذه المشكلة على مقدار القوة والتأثير الذّي تمارسه المؤسّسات المعنية على الدول الأعضاء. طبعاً، فقد صُمِّمت المؤسّسات التّي وضعت لتشكيل نظام عالمي ليبرالي ليكون لها تأثير عميق على سلوك دولها الأعضاء. يثير نفوذ المؤسّسات حتما مخاوفا بخصوص “العجز الديمقراطي”. سيصل المصوّتون إلى التفكير بأنّ البيروقراطيات البعيدة التّي تصنع القرارات المهمّة لهم بشكلٍ كبير لهي بيروقراطيات غير قابلة للوصول إليها وغير خاضعة للمساءلة.
هناك أدّلة واضحة عن هذه الظاهرة القائمة عبر أنحاء أوروبا، بالنظر إلى تصويت سنة 2016 لصالح البريكسيت. ونظرا للأثر الهائل الذّي يحظى به الاتحاد الأوروبي على سياسات أعضائه، فليس من المفاجئ أنّ أحد الأسباب الأساسية التّي جعلت أغلبية المواطنين البريطانيين يصوّتون لأجل البريكسيت مرتبط باعتقادهم أن بلدانهم كان مفوٍّضا إلى حدٍّ كبير السلطة لبروكسيل، وها قد آن الأوان لإعادة تأكيد السيادة البريطانية. على وجهٍ أخصّ، اعتقد عديد من البريطانيين بأنّ بريطانيا فقدت السيطرة على سياستها الاقتصادية والتّي قوّضت المسألة الديمقراطية. لقد تمّ النظر إلى البيروقراطيات في بروكسيل، التّي لم يتّم انتخابها من طرف البريطانيين، بأنّها المهندس الأساسي للسياسة الاقتصادية البريطانية وغيرها من السياسات أيضا. لذلك، كتب عدد من المؤلفين لدراسةٍ مهمّة عن البريكسيت التالي: “لقد كانت مسألة استعادة السيادة –أو استرجاع السيطرة عليها- الموضوع الأكبر في إستفتاء سنة 2016”.
لم تتوقّف مسألة الخوف في الغرب من التنازل عن السيادة على الاتحاد الأوروبي. أشار روبرت كوتنر (Robert Kuttner) أنّه ومع ازدهار العولمة المفرطة سنوات التسعينيات، تحوّل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى “نقيض الأدوار المتصوّرة لهما في بروتن وودز. لقد صارت المؤسّستيْن أدوات للتطبيق الإجباري للمبدأ الكلاسيكي “دعمه يعمل” باعتباره مبدءًا عالمياً للحكم”. ليس مفاجئا أن تكون المخاوف بخصوص السيادة قد لعبت دوراً مهمّاً في السياسات الأمريكية الأخيرة. بالأخصّ، ترشّح ترامب لمنصب الرئيس على منصّة أكدّت مبدأ “أمريكا أولاًّ”، وانتقاده بحدّة كلّ المؤسّسات الرئيسية التّي شكلّت النظام الدولي الليبرالي بما فيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
يتبنّى النظام الدولي الليبرالي أيضا سياسات تتصادم مع الهويّة الوطنية، التّي تحظى بأهميّة كبيرة لدى الشعوب عبر العالم كلّه، بما فيها تلك المتواجدة بالولايات المتحدة وأوروبا الغربية. تُعتبر الليبرالية في جوهرها إيديولوجية فردانية تمنح وزنا كبيرا لمصطلح الحقوق غير القابلة للمصادرة. هذا الاعتقاد، الذّي يقول بأنّ كلّ فرد على الأرض له نفس جملة الحقوق القاعدية الأساسية، هو الاعتقاد الذّي يُعزّز البُعد العالمي لليبرالية. تقف هذه النظرة العالمية أو العابرة للأمم على طرف نقيض ملحوظ مع الخصوصية العميقة للنزعة القومية، والتّي بُنيت على الإيمان بأنّ العالم مُقسّم إلى أمم متمايزة، لكلٍ منها ثقافته الخاصّة. يُخدم الحفاظ على هذه الثقافة على نحوٍ أفضل من خلال حيازة دولتك الخاصّة، هكذا تتمكّن الأمّة من البقاء في مواجهة التهديدات القادمة من “الآخر”.
بالنظر إلى تأكيد الليبرالية على الأفراد الذّين يتمتّعون بحقوق متساوية، وبالترافق مع ميلها إلى التقليل -إن لم يكن تجاهل- من أهميّة الهويّة الوطنية، فليس من المفاجئ أنّ النظام الدولي الليبرالي يؤكّد بأنّ على البُلدان أن تقبل بشكلٍ بديهي اللاجئين الذّين يبحثون عن مأوى، كما ينبغي على الأفراد أن يواجهو بعض العراقيل التّي تمنعهم من التحرّك من دولة-أمّة إلى أخرى لأجل أسباب اقتصادية أو غيرها من الأسباب. المثال النموذجي لهذه السياسة هي اتفاقية شنغين للاتحاد الأوروبي، والتّي حيّدت بشكلٍ كبير الحدود بين أغلب الدول الأعضاء بهذه المؤسّسة (أي بالاتحاد الأوروبي). الأكثر من ذلك فإنّ الاتحاد الأوروبي ملتزم بعمق بمبدأ فتح أبوابه لللاجئين الفارّين من نقاط الاضطرابات.
في عالمٍ تُعتبر فيه الهويّة القومية أمراً مهمّا جدّاً، فإنّ إختلاط شعوب مختلفة معاً، وهو الأمر الذّي يحدث حينما تكون هناك حدود مفتوحة وسياسات متسامحة مع اللاجئين بشكلٍ واسع، عادة ما يكون وصفة لمشكلة خطيرة. عل سبيل المثال، يبدو واضحا أنّ موضوع الهجرة كان السبب الرئيسي وراء دعم المصوّتين البريطانيين للبريكسيت. لم يكونوا بالأخصّ سعداء باستخدام شعوب من أوروبا الشرقية لسياسة الاتحاد الأوروبي المتعلّقة بالحدود المفتوحة للهجرة السهلة إلى بريطانيا. تعدُّ بريطانيا إستثناءً حقيقيا في هذا الصدد، كما تنتشر مشاعر معاداة الأجانب بشكلٍ واسع في أوروبا مُغذّيةً العداء تجاه الاتحاد الأوروبي. لقد بدأت أعدادٌ كبيرة من المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط الكبير تصل أوروبا سنة 2015، ومن المؤكّد عدم مقابلتها بنوع من الترحيب الذّي يتوقّعه المرء من الدول المتمركزة بقلب النظام الدولي الليبرالي. في الواقع، كانت هناك مقاومة هائلة لقبول هؤلاء اللاجئين، خصوصا في أوروبا الشرقية، ولكن في ألمانيا أيضا حيث ألحقت المستشارة ميركيل الأذى بنفسها سياسياً بسبب الترحيب المبدئي بهم. لم تستجلب هذه المشكلة المتعلّقة بالحدود المفتوحة واللاجئين مسائلةً بالتزام الاتحاد الأوروبي بالقيم الليبرالية وحسب، ولكنّها خلقت أيضا تصدّعات بين الدول الأعضاء، تشقّقات هزّت أُسس هذه المؤسّسة المُوقّرة.
الجانب السلبي للعولمة المُفرِطة:
ساعد النمو الحاد للاتصال الاقتصادي، الذّي جاء مع إرساء النظام الدولي اللبيرلي، في التسبّب بمشكلاتٍ كبيرة داخل الدول الليبرالية في النظام. في المقابل، ولّدت هذه المشكلات مقاومة سياسية جوهرية لهذا النظام. حينما يحدث هذا الأمر في ديمقراطيةً ما، فمن المرجّح أن ينقلب الجمهور على النخب الليبرالية ويختار قادة يدعمون سياسات تقف على النقيض مع المبادئ الليبرالية.
يُعدُّ النظام الاقتصادي المعاصر نظاما متكاملاً للغاية وديمانيكيا بشكلٍ ملحوظ. يحدث التغيير بسرعة منفلتة ويكون للتطوّرات الأساسية في بلدٍ ما تأثيرات كبيرة بشكلٍ ثابت على بقيّة البلدان. لهذا النظام المنفتح بشكلٍ كبير فوائد كثيرة. لقد أدّى ذلك إلى نموٍ مثيرٍ للإعجاب على المستوى العالمي، كما ساعد على إنتشال ملايين من الناس من الفقر في بلدان على غرار الصين والهند، ووفّر فوائدا اقتصاديةً ضخمةً للناس الأكثر ثراءً في العالم. في نفس الوقت، تسبّب في مشكلاتٍ كبيرة لا تزال الحكومات غير مُؤهّلة لإصلاحها، على الأقل إذا ما لعبت وفقا لقواعد النظام العالمي الليبرالي. الطريقة الأفضل لفهم هذه الظاهرة هي مقارنة العولمة المفرطة القائمة اليون بالعولمة المعتدلة التّي تمّ تحصيلها تحت اتفاق بريتون وودز من سنة 1945 إلى نهاية الثمانينيات.
تمّ تصميم اتفاق بريتون وودز لتسهيل اقتصاد دولي منفتح لكن إلى حدود معيّنة وحسب. على سبيل المثال، هناك حدود كبيرة لتدفّقات رؤوس الأموال عبر حدود الدولة. وبالرغم من أنّ الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT) تمّ تصميمها لتسريع وتيرة التجارة الدولية، فقد كان للحكومات مجالا كبيرا للمناورة لأجل تبنّي سياسات حمائية حينما كانت تصبّ في مصالحها. في واقع الأمر، كانت الحكومات قادرة على متابعة سياسات لا تُسهل الازدهار وحسب، ولكن أيضا لحماية مواطنيها من تقلّبات السوق. يشير جون روجيه (John Ruggie) بشكلٍ شهير إلى هذه العلاقة بين الأسواق والحكومات باعتبارها “ليبرالية مدمجة أو متضمّنة بشكل راسخ” (Embedded Liberalism). لقد عمل اتفاق بريتون وودز على نحوٍ جيّد لأكثر من أربعة عقود، بالرغم من أنّ أيّامه صارت معدودة مع نهاية الثمانينيات.
إنقلبت العولمة المفرطة، التّي بدأت تكتسب قوةً في الثمانينيات لتتسارع بعد الحرب الباردة، بشكلٍ فعّال على اتفاق بريتون وودز. تمّ تصميم النظام الجديد، الذّي أُنشأ بشكل كبير من طرف صنّاع السياسة الغربيين، ليُقلّص على نحو كبير اللوائح التنظيمية للأسواق العالمية وذلك من خلال نزع السيطرة عن تدفّق رؤوس الأموال واستبدال الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT) بمنظمة التجارة العالمية (WTO). كان المقصود من هذه المنظمة التجارية الجديدة، التّي دخلت حيّز العمل سنة 1995، فتح الأسواق عبر جميع أنحاء العالم، وجعل الأمر صعبا على الحكومان خصوصا لمتابعة سياسات حمائية. تمّ النظر إلى “أيّ حاجز أمام التجارة الحرّة” كما يذكر داني رودريك (Dani Rodrik): “باعتباره رجساً يجب أن يُزال، ومحاذيراً يجب أن تُلعن”. جوهر القول، فقد تمّ اعتبار أيّ شكلٍ من أشكال تدخّل الحكومة في عمل الاقتصاد العالمي تقريبا باعتباره أمرا مؤذيا للنظام الدولي الليبرالي. إقتباسا مرّة أخرى عن رودريك: “فقد انتقلت الدولة من كونها الطرف الخادم للنمو الاقتصادي إلى العقبة الأساسية المعيقة له”.
العولمة المفرطة وتذمّراتها:
تسبّبت العولمة المفرطة في عددٍ كبير من المشكلات الاقتصادية التّي عملت على تقويض شرعية النظام العالمي الليبرالي في الدول التّي شكلّت مركز هذا النظام. بادئ ذي بدء، فإن العديد من الوظائف في قطاعات بعينها باقتصاد الدولة تختفي بسرعة كنتيجة للإستعانة بالمصادر الخارجية لليد العاملة، ورمي عدد كبير من الناس خارج العمل. في بعض الأحيان، فإنّ أقاليما كاملة تُشاهد قواعدها الاقتصادية التقليدية وهي تتدمّر. غالبا ما يكون صعبا على العاطلين عن العمل، خاصّة وأنّ العديد منهم عمّال لا يتمتّعون بالمهارة وذوي قدرات محدودة على التحرّك، إيجاد وظائف ذات أجر جيّد أو أيّ وظيفة أخرى على الإطلاق. حتّى وإن عثروا على وظائف جيّدة، فإنّ هناك إمكانية دائمة لفقدانهم إيّاها مرّة أخرى نظراً “للتدمير الخلاّق” القادم من العولمة المفرطة. حتّى بالنسبة للناس الذّين لم يفقدوا وظائفهم، فإنّهم قلقون أن يحدث ذلك يوما ما. بإختصار، فإنّ الديناميكية الكامنة في الاقتصاد العالمي لا تُهدّد الوظائف وحسب، بل أيضا تُعزّز شعورا حادّاً باللايقين بين الناس بخصوص المستقبل في كلّ مكان.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أدّت العولمة المفرطة جهودا قليلة لرفع مستوى الدخل الحقيقي للطبقات الدنيا والمتوسّطة في الغرب الليبرالي. في نفس الوقت، فقد زاد بشكلٍ كبير من أجور وثروة الطبقات العليا. النتيجة هي ترنّح مذهل لللاعدالة الاقتصادية تقريبا في كلّ مكان، والتّي تُظهر علامات قليلة من الإنحسار. في الواقع، يبدو من المرجّح أن يأخذ المشكل مساراً أسوء، ففي ظلّ اتفاق بريتون وودز كانت الحكومات في موضعٍ جيّد للتعامل مع مشكلات من هذا النوع من خلال إبتكار سياسة إعادة التوزيع الضريبي، برامج تدريب للعمال، وفوائد الرعاية الاجتماعية السخيّة. لكن في النظام الدولي الليبرالي، فإنّ الحلّ المعطى لكلّ مشكلة تقريبا هو السماح للأسواق بالتعامل معها، وليس الحكومات، والتّي تمّ اعتبارها (أي الأسواق) أكثر مسؤولية في جعل الاقتصاد العالمي يعملُ بسلاسة. بقدر ما تكون هذه القواعد في حاجة إلى تسهيل العمل السلس للاقتصاد العالمي، بقدر ما كان الاعتماد على المؤسّسات الدولية أفضل من الاعتماد على الحكومات.
طبعاً، لا يمكن للأسواق أن تُصلح هذه المشكلات، في الحقيقة فقد ساعدت في التسبّب فيها بالدرجة الأولى، وفي جعلها على الأرجح أكثر سوءً في غياب سياسات تُصمّنها الدول لحماية مواطنيها. كما يمكن للمرء أن يتوقّع، أنّ هذه المشكلات المستشرية قادت لعدم رضا واسع النطاق تجاه النظام الدولي الليبرالي وإلى مشاعر متنامية لدى الحكومات لتبنّي سياسات اقتصادية حمائية، والتّي سوف تُقيّض النظام الحاضر. لقد استفاد ترامب من هذا العداء تجاه النظام القائم في حملته الرئاسية سنة 2016، ليس من خلال الإحتجاج ضدّ المؤسّسات الدولية وحسب، بل أيضا من خلال الاستفادة من القضية لأجل متابعة سياسات اقتصادية حمائية. لقد أكدّ على أهمية حماية العمال الأمريكيين قبل كلّ شيء. في كلٍّ من الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، والانتخابات العامة هزَم ترامب الخصوم الذّين دافعوا عن النظام الدولي الليبرالي وحاججوا ضدّ النزعة الحمائية. ومنذ أن صار رئيسا، انتقل ترامب إلى متابعة اتجاه حمائي بشكلٍ حاسم. في نهاية المطاف، حينا تتصادم الأسواق مع المصالح العميقة المتأصّلة لأكبر عددٍ من مواطني البلد، سوف تتطوّر سياسته بطرقٍ تُقوّض النظام الدولي الليبرالي.
هناك مشكلة كبيرة أخرى ترافق العولمة المفرطة. تترافق سهولة وسرعة تدفّق رؤوس الأموال عبر الحدود مع التأكيد بأنّ النظام العالمي الليبرالي يفرض على الحكومة رفع القيود، جاعلا من هذا النظام عرضة للأزمات الاقتصادية واسعة النطاق في بلدان أو أقاليمٍ بعينها أو حتّى في العالم بأكمله. يكتبُ كلٌّ من كارمين رينهارت وكنيث روغوف (Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff): “تُنتج فترات الحركة العالية لرؤوس الأموال الدولية بشكلٍ متكرّر أزماتٍ مصرفية دولية”. في الحقيقة، فقد كانت هناك عدد من الأزمات منذ بدأت العولمة المفرطة تتجذّر نهاية الثمانينيات. أكثر الأزمات ذات الصلة كانت الأزمة المالية الآسيوية سنة 1997-1998، والتّي كادت أن تنتشر بشكلٍ خطير عبر العالم بأكمله، أيضا الأزمة العالمية سنة 2007_2008، والتّي كانت بمثابة الانهيار الاقتصادي الأكثر حدّةً منذ الكساد الأعظم لسنوات الثلاثينيات، وقد تسبّبت كثيرا في نزع الشرعية عن النظام الدولي الليبرالي في الغرب. ونظرا لاستمرارية حركة رؤوس الأموال، فمن المرجّح أن يحدث مستقبلا هذا النوع من المشكلات مُضعفةً النظام الحالي أكثر، أو ربّما حتّى متسبّبةً في انهياره.
هناك بعض الكلمات التّي يتّم ترتيبها بخصوص اليورو، الذّي يُعدُّ الملمح الأساسي للنظام الدولي، بغضّ النظر عو كونه جزءً من مؤسّسة أوروبية بشكلٍ صارم. فحينما تمّ إرساء هذه العملية سنة 1999، فقد مثلّت خطوةً عملاقة تجاه تعزيز الوحدة المالية بين الدول الأعضاء، بالرغم من عدم وجود وحدة نقدية أو سياسية من شأنها أن تُساعد على دعم اليورو. توقعّت الانتقادات آنذاك بأنّه من دون وحدة مالية أو سياسية فسوف يعاني اليورو من مشكلات كبيرة في نهاية المطاف. إعترف العديد من المؤيّدين بهذه المشكلة، لكنّهم ظنّوا بأنّ الوحدة النقدية ستُؤدّي في النهاية إلى الوحدة في كلّ الجبهات الثلاث، هذا ما سيؤدّي إلى القضاء على المشكلة. لكنّ هذا الأمر لم يحدث، ليُواجه اليورو أول أزمة كبيرة له سنة 2009، والتّي لم تنتج مشكلات اقتصادية وحسب، بل مشكلات سياسية أيضا. جلبت الأزمة والمحاولات التّي أعقبتها بهدف حلّها ظهوراً للمشاعر القومية المتأجّجة إلى السطح في أوروبا.
وجد الاتحاد الأوروبي صعوبة كبرى في التعامل مع أزمة منطقة اليورو، إلاّ أنّ المشكلات تمّ حلّها من خلال عمليات إنقاذ شاملة باشترتها مؤسّسات على غرار البنك المركزي الأوروبي ومن الحكومة الأمريكية أيضا، وإن لم يكن ذلك قبل الدمار السياسي الكبير الذّي لحق بالاتحاد الأوروبي. إلاّ أنّ الأمر الأكثر أهمية يتمثّل في عدم قيام الاتحاد الأوروبي بحركةٍ كبيرة تجاه الوحدة النقدية والسياسية، ممّا يعني أنّ الإصلاح كان إصلاحاً مؤقّتا وأنّه من المرجّح أنّ أزمات أكثر مُقبلةٌ عليه في السنوات القادمة، الأمر الذّي ليس من شأنه أن يُقوّض الاتحاد الأوروبي أكثر وحسب، بل النظام الدولي الليبرالي بشكلٍ عام أكثر.
صعود الصين:
هناك مشكلة إضافية ارتبطت بالعولمة المفرطة، ليس لديها الكثير لتفعله مع المعارضة السياسية المتنامية للنظام الدولي في البلدان الليبرالية، ومع أيّ شيء له علاقة بتوازن القوة العالمي. إلى الوقت الذّي وصل فيه ترامب إلى السلطة سنة 2017، كانت النخب الغربية –تماشيا مع سياسة الانخراط التّي اتبعتها ما بعد الحرب الباردة تجاه الصين، لا الاحتواء- ملتزمة بشكلٍ عميق بإدماج الصين في الاقتصاد العالمي، بما فيه كلّ مؤسّساته الاقتصادية الأساسية. افترض هؤلاء أنّ صيناً مزدهرة وثريّةً بشكل متزايد سوف تصير في نهاية المطاف ديمقراطية ليبرالية وعضوا بارزا (ونزيها) في النظام الدولي الليبرالي.
لكنّ الأمر الذّي لم يكن يُدركه مهندسو هذه السياسة، أنّه ومن خلال المساعدة في تسريع النمو الصيني، فإنّهم يكونون قد ساعدوا في الحقيقة على تقويض النظام الليبرالي، حيث عرفت الصين نموا سريعا لتصير قوة اقتصادية نشطة ذات قدرات عسكرية كبيرة. في واقع الأمر، لقد ساعدوا الصين لتصير قوة عظمى، هذا ما أدّى إلى تحجيم الأحادية القطبية، التّي تُعدُّ أمراً ضروريا للحفاظ على نظام عالمي ليبرالي. لقد تفاقمت هذه المشكلة من خلال انبعاث روسيا، التّي أصبحت مرّة أخرى قوة عظمى رغم ضعفها الواضح. ومع صعود الصين وعودة روسيا، صار النظام الدولي نظاما متعدّد الأقطاب، الأمر الذّي يُعدُّ ناقوس خطرٍ (أو علامة وفاةٍ) بالنسبة للنظام الدولي الليبرالي. وليكون الأمر أسوء، فلم تصر الصين ولا روسيا ديمقراطيةً ليبرالية.
حتّى وإن لم تصر الصين وروسيا قوى عظمى وبقي العالم أحاديّ القطبية، فسوف يستمر النظام الليبرالي في التهاوي اليوم بسبب عيوبه الجوهرية. إنّ انتخاب دونالد ترامب، الذّي إنتقد بحدّة وعلى نحوٍ مستمر كلّ العناصر الأساسية لنظام ما بعد الحرب الباردة أثناء حملته الانتخابية الرئاسية، لهو دليل على مقدار الورطة التّي آل إليها النظام الليبرالي بحلول سنة 2016. لذلك، إذا ما بقي النظام الدولي الليبرالي نظاما أحادي القطبية، فإنّ النظام العالمي الليبرالي سوف يؤول إلى نظام مُلحد (لا يُؤمن ولا يلتزم بأيّ قيم Agnostic Order) تحت حكم الرئيس ترامب، حيث لا تحظى الأنظمة الواقعية (Realist Orders) بمكان في الأحادية القطبية. بالتأكيد ليس هناك دليل بأنّ ترامب ملتزمٌ بإعادة تشكيل النظام الليبرالي القائم. في الحقيقة، يبدو بأنّه عازم على تحطيمه. فمع الصين أو من دونها، فإنّ النظام الدولي الليبرالي مُقدّرٌ له السقوط، لأنّ ولادته كانت مَعيبةً ومُشوَّهَةً على نحوٍ مميت.
خلاصة:
تلعب المسارات السببية الموصوفة المتعدّدة أعلاه كلّها دوراً مهمّا في تخريب النظام الدولي الليبرالي. ورغم أنّ لكلٍّ منها منطقٌ متمايز، فإنّها تشتغل عادةً على نحوٍ متظافر. على سبيل المثال، فإنّ الآثار السلبية للعولمة على الطبقات الاجتماعية الدنيا والمتوسّطة ترافقت مع الإستياء القومي ضدّ الهجرة والشعور بفقدان السيطرة على السيادة لتغذية ردود الفعل الشعبوية العنيفة ضدّ مبادئ وممارسات النظام الليبرالي. في الحقيقة، عادة ما يتّم توجيه هذا الغضب للنخب الليبرالية التّي استفادت من النظام والتّي تُدافع عنه بشدّة. بالطبع، كان لهذا الإستياء نتائج سياسية كبيرة. لقد تسبّب في حدوث إنقسامات سياسية عميقة في الولايات المتحدة وبقيّة الديمقراطيات الغربية، أدّى إلى البريكسيت، ساعد على إيصال ترامب إلى البيت الأبيض، كما دعم تغذية القادة القوميين عبر العالم.
إلى أين نتجّه؟
يمكن للمرء الإقرار بأنّ النظام الدولي الليبرالي قد بلغ تراجعه النهائي، لكن بإمكانه المحاججة أيضا بأنّ هناك إمكانية لتعويضه بنسخة أكثر براغماتية، نسخة تتجنّب تجاوزات نظام ما بعد الحرب الباردة. سوف يتابع هذا النظام الليبرالي الأكثر اعتدالاً مقاربةً أكثر دقّة وأقلّ عدوانية لأجل نشر الديمقراطية الليبرالية وكبح جماح العولمة المفرطة، ووضع بعضٍ من الحدود المهمّة على سلطة المؤسّسات الدولية. سوف يبحث النظام الجديد، وفقا لهذه الرؤية، عن شيءٍ مشابه للنظام الغربي أثناء الحرب الباردة، بالغم من أنّه سيكون عالميا وليبراليا، لا نظاما محدوداً أو واقعياً (Not Bounded or Realist Order).
إلاّ أنّ هذا الحلّ لا يُعتبر قابلا للتحقيق، لأنّ لحظة الأحادية القطبية قد انتهت، الأمر الذّي يعني أنّه لا يوجد فرصة للمحافظة على أيّ شكلٍ من أشكال النظام الدولي الليبرالي في المستقبل المنظور. الأكثر من ذلك، فليس للرئيس ترامب أيّة نيّة لمتابعة “نظام عاملي ليبرالي مُخفَّف (لايت)، فمن دون دعمه فإن خياراً كهذا لهو خيار محكوم عليه بالفشل. لكن حتّى ولو لم يكن ترامب عائقا ويظلّ النظام الدولي نظاما أحاديَّ القطبية، فسوف تفشل الولايات المتحدة إذا ما خفضّت من بصمتها وحاولت بناء نظام ليبرالي أقلّ طموحا. في الحقيقة، فسوف تنتهي بدلا من ذلك إلى بناء نظام دولي مُلحدٍ لا يُؤمن بأيّ قيم أو إلزامات (Agnostic Order).
إنّه لمن المستحيل بناء نظام عالمي ليبرالي ذي معنى مع تبنّي سياسات محتشمة أو أكثر مُسالمةً. يتطلّب المشروع هندسةً اجتماعية كبيرة جدّاً في العديد من الأماكن. لو كان له أيّ فرصةِ نجاحٍ (اعتقد أنّه لا يملك)، فإنّ على القطب الواحد الليبرالي وحلفاءه متابعة سياسات عالمية عالية الطموح وبلا هوادة، لهذا السبب تصرّفت الولايات المتحدة وشركاؤها الليبراليون بتلك الطريقة في أعقاب الحرب الباردة. إلاّ أنّ هذه المقاربة غير ممكنة الآن من الناحية السياسية بسبب الخيبات السابقة. كنتيجة لذلك، فليس للديمقراطيات الليبرالية خيارٌ إلاّ أن تتخّذ خطوات صغيرة هنا وأخرى هناك لأجل إعادة تشكيل العالم على صورتها الخاصّة مع تبنّي مقاربة “عِشْ ودع غيرك يعيش” تجاه أغلب بلدان العالم. سوف تنتج هذه المقاربة المتواضعة بشكلّ فعّال نظاماً مُلحداً لا يؤمن بأيّ قيم أو التزامات. إلاّ أنّ أمراً كهذا ليس بصدد الحدوث، لأنّ النظام نظامٌ متعدّد الأقطاب كما أنّ سياسة القوى الكبرى تلعب مرّة أخرى، لذلك فإنّ السؤال الأساسي هو: أيّ شكلٍ من أشكال الأنظمة الواقعية سوف يُهيمن على المشهد في العالم الجديد متعدّد الأقطاب؟
الأنظمة الواقعية الجديدة:
من المرجّح أن تكون هناك ثلاثة أنظمة واقعية مختلفة في المستقبل المنظور. نظام دولي هزيل ونظامين محدودين متينين (A Thin International Order and Two Thick Bounded Orders)، أحدهما يُقاد من طرف الصين، والآخر يُقاد من طرف الولايات المتحدة. سوف يكون النظام الدولي الهزيل الصاعد مهتّما أساساً بالإشراف على اتفاقيات الحدّ من التسلّح وجعل الاقتصاد العالمي يعمل بفعالية. من المرجّح أيضا أن يمنح اهتماما جدّيا أكثر من الماضي بمشكلات متعلّقة بالتغيّر المناخي. في الجوهر، سوف تركّز المؤسّسات التّي تشكّل النظام الدولي بتسهيل التعاون البيني بين الدول. في المقابل، فإنّ النظامين المحدودين سوف يهتمّان بشكلٍ رئيسي بشنّ منافسة أمنية ضدّ بعضهما البعض، بالرغم من أنّهما سيدعوان إلى تعزيز التعاون بين أعضاء كلّ من النظامين. سوف تكون هناك منافسة اقتصادية وعسكرية كبيرة بين هذين النظامين تحتاج إلى أن تُدار، لهذا السبب سوف يكونان نظامين متينين.
سوف يكون هناك ملمحان أساسيان للعالم الجديد متعدّد الأقطاب يشكلان على نحوٍ عميق الأنظمة الصاعدة. أولاًّ، بافتراض استمرار الصين في صعودها المثير للإعجاب، فإنّها سوف تنخرط في منافسة أمنية شديدة مع الولايات المتحدة، سوف يكون ذلك بمثابة السِّمة المركزية للسياسة الدولية على مدار القرن الحادي والعشرين. سوف يقود هذا يقود هذا التنافس إلى خلق أنظمة محدودة يُهيمن عليها من طرف الصين والولايات المتحدة. سوف تكون التحالفات العسكرية المركّب المركزي لهذين النظامين، وهما الآن بصدد التشكّل وسوف يشبه ذلك النظامين اللذين قادهما الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة في الحرب الباردة.
إلاّ أنّ بيجين وواشنطن سوف يكون لهما في بعض الأحيان أسباب تدفعهما للتعاون في مسائل عسكرية بعينها، وهو مسعى سوف يقع في نطاق إختصاص النظام الدولي، كما كان من قبل أثناء الحرب الباردة. مرّة أخرى، سوف يكون التركيز بالدرجة الأولى على اتفاقيات الحدّ من الأسلحة وسوف تنخرط روسيا في هذا المسعى كما ستفعل الصين والولايات المتحدة. من المرجّح أن تظلّ المعاهدات والاتفاقيات الموجودة التّي تتعامل مع مسالة الانتشار النووي في مكانها، نظرا لأنّ كلّ القوى العظمى الثلاث تريد الحدّ من انتشار الأسلحة النووية. لكن سوف يكون على كلّ من بيجين وموسكو وواشنطن التفاوض على معاهدات جديدة تحدّ من ترسانتهما العسكرية، مثلما فعلت القوتيْن العظميين أثناء الحرب الباردة. رعم ذلك، سوف تكون الأنظمة الأمريكية والصينية المحدودة مسؤولة بشكل كبير عن التعامل مع المسائل الأمنية المركزية.
في المسائل العسكرية، ينبغي على الأنظمة الصاعدة الثلاث المبنية حول التنافس الأمريكي-الصيني أن تحمل تشابها ملحوظا بأنظمة الحرب الباردة الثلاث، وإن كانت الصين تحلّ محلّ الاتحاد السوفياتي.
إلاّ أنّ تشابها كهذا لا يوجد في المجال الاقتصادي، فقد كان هناك تواصلٌ اقتصادي ضئيل بين القوتين العظميين أو في النظامين المعنيين أغلب فترة الحرب الباردة. لذلك، لم يكن النظام الدولي القائم مهتّما بأيّ وسيلة ذات مغزى تتعلّق بتسهيل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. لقد كانت التعاملات الاقتصادية محصورة إلى حدٍّ كبير في الأنظمة المحدودة، وقد كان الهدف الأساسي هناك هو متابعة سياسات من شأنها أن تُساعد على ربح مكاسب على حساب الطرف الآخر. ولأنّ القوة الاقتصادية تُعزّز القوة العسكرية، فقد جرى شنّ منافسة أمنية في كلّ من المجالين الاقتصادي والعسكري على حدٍّ سواء.
التعاون الاقتصادي والتنافس:
يُعتبر الوضع على الجبهة الاقتصادية أكثر صعوبة اليوم منه إلى الأمس أيّام الحرب الباردة، هذا ما يقودنا للحديث عن السمّة المهمّة الثانية للتعدّدية القطبية الجديدة التّي سوف تُشكّل الأنظمة الناشئة. هناك قدرٌ ضخمٌ من التواصل الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة وبين الصين وحلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا، كما أنّ الصين والولايات المتحدة أيضا تُتاجران وتستثمران عبر كلّ أنحاء العالم. ليس من المرجّح أن تُقلّص المنافسة الأمنية بين النظامين المحدودين بشكلٍ ملحوظ هذه التدفّقات الاقتصادية، فالمكاسب المتأتيّة من التجارة المستمرة لهي مكاسبٌ عظيمةٌ جدّا. حتّى ولو تحاول الولايات المتحدة الحدّ من تجارتها مع الصين، فبإمكان بيجين أن تُعوّض ذلك من خلال تجارتها مع الشركاء الآخرين، على غرار أوروبا. بعبارة أخرى، فمن المرجّح أن يشبه المستقبل الوضع في أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى، حيث كان هناك تنافس أمني شديد بين الحلف الثلاثي (النمسا-المجر، ألمانيا وإيطاليا) والوفاق الثلاثي (بريطانيا العظمى، فرنسا وروسيا)، لكن كان هناك قدرٌ هائل من التفاعل الاقتصادي بين هذه البلدان الستّ وداخل أوروبا بشكلٍ عام أيضا.
ولأنّ الاقتصاد العالمي سوف يظلّ مستقلا بدرجة عالية، فإنّ النظام الدولي الصاعد سوف يلعب دورا محوريا في إدارة العلاقات الاقتصادية بين البلدان عبر العالم. بالرغم من أنّ للصين مصلحة عميقة راسخة في مساعدة النظام على تسهيل التعاون الاقتصادي، فإنّها ستمارس قوتّها المتنامية لإعادة تشكيل النظام الدولي الجديد وفقا لمصالحها. سوف تسعى لإعادة كتابة القواعد في المؤسّسات الاقتصادية الراهنة للنظام لإعطائها نفوذا أكبر، كما أنّها ستخلق مؤسّسات جديدة تعكس قوتّها المتنامية. إحدى أبرز الأمثلة لهذه المقاربة الأخيرة هو إرساء بيجين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سنة 2015، الذّي يراه بعض المراقبين باعتباره المنافس المحتمل لكلٍّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. بالطبع، يُعتبر هذا الوضع مختلفا بشكلٍ جذريٍ عن الكيفية التّي تصرّف بها الاتحاد السوفياتي أثناء الحرب الباردة.
لكن لا يعدُّ هذا الأمر نهايةً للقصّة الاقتصادية، فمن المؤكّد وجود تنافس اقتصادي شديد بيم النظامين المحدودين الذّي يحدث في سياق أوسع للتعاون الاقتصادي المستمر على المستوى العالمي. سوف يُقاد هذا التنافس في جانبه الجيّد من خلال المخاوف الأمنية. على كلّ حال، تُعدّ القوة الاقتصادية أساسا للقوة العسكرية، الأمر الذذي يعني بأنّ للصين حافزا استراتيجيا قويّا لأن تحظى بالهيمنة الاقتصادية في العالم، وهو ما يُعتبر هدفا لها. على سبيل المثال، تُعتبر مبادرة “صُنع في الصين 2025” بمثابة خطّة بيجين للهيمنة على الأسواق العالمية في مجموعة واسعة من منتجات التكنولوجيا الفائقة. تقوم الاستراتيجية الصينية على إعانات حكومية واسعة للشركات المملوكة للدولة وإستكمال بحثوهم بتكنولوجيات مسروقة من الشركات الأمريكية وبقيّة الشركات الغربية. تستخدم الصين أيضا قوتّها الاقتصادية المتنامية لإكراه جيرانها في شرق آسيا حتّى يقفوا إلى جانب بيجين على حساب واشنطن.
طبعاً، سوف تُدافع الولايات المتحدة عن نفسها في مواجهة الصين، لا لأسباب متعلّقة بالأمن وحسب، ولكن لأنّ مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لا يريد أن يتكبّد خسارة أمام الصين. تُعتبر السياسات الاقتصادية الحادّة لإدارة ترامب تجاه الصين مجرّد بداية وحسب لما يعد بأن يكون تنافسا شديدا وطويل الأمد بين النظامين الذّي تقودهما الولايات المتحدة والصين. على سبيل المثال، من المؤكّد أن تحاول الولايات المتحدة تقييد عملية تحويل التكنولوجيات ثنائية الاستخدام إلى الصين، وهي تكنولوجيات مدنية معقدّة يمكن أن تُستخدم لأغراض عسكرية. سوف تحاول أيضا إدارة تجارتها واستثماراتها مع الصين، وكذلك تفعل مع حلفاءها، بطرق لا يُؤدّي إلى تآكل مكانتهم في ميزان القوى، آملة في تحسينها في المقابل.
سوف يتضمّن النظامان المحدودان، اللذان بصدد التشكّل مؤسّسات تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائها، في الوقت الذّي تسعى فيه إلى ربح ميزات اقتصادية على حساب النظام المنافس. على سبيل المثال، صُمّمت إدارة أوباما بشكل صريح الشراكة العابرة للباسيفيك لهذا الغرض، رغم أن ترامب انسحب منها بعدما صار رئيسا. أمّا مبادرة الصين عالية الطموح “حزام واحد، طريق واحد”، التّي تمّ إطلاقها سنة 2013، فلم يتّم تصميمها لمساعدة الصين في استمرار نمّوها الاقتصادي المثير للإعجاب وحسب، بل أيضا لأجل تصدير القوة الصينية العسكرية والسياسية عبر أنحاء العالم. ونظرا لرفض الولايات المتحدة الانضمام إلى البنك الآسيوي لتطوير البنية التحتية، فمن المرجّح أن تصير هذه المؤسّسة المثيرة للإعجاب جزءًا مركزيا من النظام الدولي المحدود الذّي تقوده الصين.
بإختصار، فإنّ التنافس بين النظامين المحدودين اللذين تقودهما الصين والولايات المتحدة سوف يُورّط كلاهما في منافسة اقتصادية وعسكرية تامّة، مثلما كان الحال مع النظامين المحدودين اللذيْن هيمنت عليهما موسكو وواشنطن أثناء الحرب الباردة. يكمن الاختلاف الكبير هذه المرّة في أنّ النظام الدولي سوف يكون منخرطا بعمق في إدارة جوانب التنافس في الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذّي لم يكن موجوداً أثناء الحرب الباردة.
روسيا وأوروبا:
ماذا بخصوص روسيا؟ من المؤكّد أنّها قوة عظمى، لهذا السبب فإنّ العالم الناشئ عالمٌ متعدّد الأقطاب، لا ثنائية القطبية، إلاّ أنّها ستكون إلى حدّ بعيد الطرف الأضعف بين القوى العظمى الثلاث في المستقبل المنظور، إذا ام يُواجِه أيٌّ من الاقتصاد الأمريكي أو الصيني مشكلات أساسية طويلة المدى. إنّ السؤال الأساسي المتعلّق بروسيا هو: أيّ جانبٍ سوف تصطف مع روسيا –إن وُجد- في التنافس الأمريكي-الصيني؟ بالرغم من أنّ روسيا منحازة الآن إلى الصين، فمن المحتمل أن تُحوّل جانب الإنحياز مع الوقت وتتحالف مع الولايات المتحدة، والسبب راجع ببساطة إلى قوة الصين المتزايدة والتّي تُعتبر أعظم تهديد لروسيا نظرا لتقاربهما الجغرافي. إذا ما ذهبت موسكو وواشنطن إلى صياغة علاقات مقرّبة بسبب خوفهما المتبادل من الصين، فسيتّم إدماج روسيا على نحوٍ سهل في النظام المحدود الذّي تقوده الولايات المتحدة. أمّا إذا ما استمرت موسكو في الحفاظ على علاقات وديّة مع بيجين بسبب خوفها من الولايات المتحدة أكثر من خوفها من الصين، فسوف يتّم إدماج روسيا على نحوٍ سهل في النظام المحدود الذّي تقوده الصين. من الممكن أنّ روسيا لن تحاول جعل نفسها تصطّف إلى أحد الطرفين، وستبقى على الهامش.
أخيرا، ماذا عن أوروبا؟ من المرجّح أن تصير أغلب البلدان في أوروبا، لاسيما القوى الأساسية جزءً من النظام المحدود بقيادة الولايات المتحدة، رغم أنّه من غير المرجّح أن تلعب دورا عسكريا جدّيا في احتواء الصين. فليس لها القدرة على تصدير قوة عسكرية جوهرية تجاه شرق آسيا، كما أنّ لها سببا ضئيلا لتحصيل ذلك نظراً لأنّ الصين لا تُمثّل تهديدا مباشرا لأوروبا، ولأنّ الأمر يبدو أكثر منطقية بالنسبة لأوروبا في ترحيل المسؤولية إلى الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين. إلاّ أنّ صنّاع السياسة الأمريكية سوف يريدون الأوروبيين داخل نظامهم المحدود لأسباب اقتصادية مرتبطة على نحوٍ استراتيجي. بالأخصّ، سوف تريد الولايات المتحدة منع البلدان الأوروبية من بيع التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج للصين والمساعدة في فرض ضغوط اقتصادية على بيجين حينما يتطلّب الأمر ذلك. في المقابل، سوف تبقى القوات العسكرية الأمريكية في أوروبا، محافظةً على الناتو حيّاً ومستمرةً في العمل باعتبارها صانع السلام في المنطقة. ونظراً لأنّ كلّ قائد أوروبي تقريبا يريد أن يرى هذا الأمر يحدث فعلاً، فإنّ تهديد المغادرة ينبغي أن يمنح الولايات المتحدة نفوذا كبيرا في دفع الأوروبيين إلى التعاون على الجبهة الاقتصادية في مواجهة الصين.
خاتمة:
لقد بنت الولايات المتحدة وحلفاءها نظاماً هائلا أثناء الحرب الباردة، إلاّ أنّه لم يكن دوليا ولا ليبيراليا. لقد كان نظاما محدوداً غايته الأساسية كانت شنُّ منافسة أمنية ضدّ نظام محدودٍ منافس مهيمَنٌ عليه من طرف الاتحاد السوفياتي. كان كلٌّ من النظامين نظاما واقعياً في جوهره، لا نظاما ليبراليا أو شيوعيا. أتاح ظهور الأحادية القطبية في أعقاب الحرب الباردة للغرب المنتصر مع الولايات المتحدة أخْذَ زمام القيادة لبداية بناء نظام دولي ليبرالي حقيقي. كان الأمل في أن يتصرّف باعتباره خادما من أجل عالمٍ يسوده السلام والازدهار.
خلال التسعينيات والسنوات الأولى القليلة من الألفية الجديدة، بدا بأنّ النظام الليبرالي يسير في العمل على نحوٍ منشود وأنّه سيُعمّر طويلا. يمكن لدُعاته ومهندسيه تسجيل العديد من النجاحات في الوقت الذّي يدركون فيه وجود بعض الإخفاقات. لكن ابتداء من سنة 2005 تقريبا، بدأ النظام يُواجه مشكلاتٍ جدّية خطيرة، والتّي تضاعفت مع الوقت إلى الحدّ الذّي بدأ معه الانهيار. ينبغي أن تكون هذه النتيجة متوقّعة بما أنّ النظام يحمل بذور دماره في ذاته، ولهذا السبب فهو مُقدّرٌ له الفشل والسقوط عاجلاً أم آجلاً.
لقد واجهت محاولة الولايات المتحدة وحلفاءها خلق نظام دولي ليبرالي ثلاث مشكلات أساسية. أولاًّ، تطلّبت -هذه المحاولة- من الدول الليبرالية في النظام لاسيما الولايات المتحدة متابعةَ سياسة تعديلية طموحة عالية المستوى وواسعة النطاق متعلّقة بتغيير النظام (أي النظام السياسي للدول المستهدفة) والتّي كان مآلها الفشل المؤكّد في أغلب الأحيان، في حقبةٍ تبقى فيها النزعة القومية التّي تُؤكّد على السيادة والتقرير الذاتي للمصير عنصراً قويّا بشكلٍ ملحوظ. وُضعت هذه السياسة في حرجٍ أيضاً بسبب سياسة توازن القوة على المستويين العالمي والإقليمي على حدٍّ سواء.
ثانيا، من خلال الدفع نحو الحركة الحرّة للناس عبر الحدود والتنازل عن سلطة صنع قرار جوهرية للمؤسّسات الدولية، فقد سبّب النظام الليبرالي المتوسّع مشكلات سياسية كبيرة داخل الدول الليبرالية ذاتها. إصطدمت النتائج في أغلب الأحيان مع اعتقادات الهويّة الوطنية والسيادة التّي تحظة بأهميّة كبيرة جدّا بالنسبة لأغلب مواطني الدول-الأمم الحديثة.
ثالثا، بالرغم من أنّ بعض الشعوب والبلدان استفادت من العولمة المفرطة، فقد تسبّبت الأخيرة في نهاية المطاف في مشكلات اقتصادية وسياسية كبيرة داخل الديمقراطيات الليبرالية، والتّي أدّت في نهاية المطاف إلى تآكل جدّي خطير في دعم النظام الدولي الليبرالي. في نفس الوقت، فقد ساعدت الديناميكية الاقتصادية التذي جاءت مع العولمة المفرطة الصين في تحويل نفسها بشكلٍ سريع إلى قوة عظمى، في نفس الوقت أعادت ترتيب نفسها كقوة عظمى على نحو متقارب. وضع هذا التحوّل في ميزان القوى العالمي حدّاً للأحادية القطبية والتّي تعتبر شرطا مسبقا لنظام عالمي ليبرالي.
في العالم متعدّد الأقطاب الناشئ، فإنّه من المرجّح أن يكون نظاما دوليا واقعيا والذّي سيكون مهتّماً بإدارة الاقتصاد العالمي وأيضا التعزيز والمحافظة على اتفاقيات الحدّ من التسلّح. سيكون التركيز في هذا النظام على عملية تسهيل التعاون البيني بين الدول. بالإضافة إلى ذلك، فمن المرجّح أن يكون هناك نظامين محدوديين بقيادة كلّ من الولايات المتحدة والصين، يساعد ذلك على متابعة المنافسة الأمنية التّي من المؤكّد غالبا أن تتصاعد بين الصين وحلفاءها من جهة وبين الولايات المتحدة وحلفاءها من جهة أخرى. سيكون لهذا التنافس أبعادا اقتصادية وعسكرية على حدٍّ سواء.
كيف ينبغي على الولايات المتحدة أن تتصرّف حينما تترك وراءها النظام الدولي الليبرالي التّي عملت جاهدةً على بنائه؟ أولاًّ، عليها أن تُقاوم أيّ إغراء يدفعها للاستمرار في محاولة نشر الديمقراطية بالإكراه عبر العالم من خلال تغيير النظام. نظراً لأنّ الولايات المتحدة سوف تكون مجبرةً على الانخراط في سياسة توازن القوة مع الصين وروسيا، فستكون قدرتها على الانخراط في الهندسة الاجتماعية خارجيا أمرا محدوداً بشكلٍ كبير. إلاّ أنّ إغراء إعادة تشكيل العالم سوف يكون دوما متواجدا نظراً لإيمان الولايات المتحدة بحماسٍ مفرط بفضائل الديمقراطية الليبرالية. لكن، يجب أن تقاوم الإغراء لأنّ المُضيّ إلى الحملات التبشيرية الليبرالية يقود بشكلٍ مؤكّد إلى ورطة جديّة وخطيرة.
ثانيا، ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى لتعظيم نفوذها في المؤسّسات الاقتصادية التّي شوف تُشكّل النظام الدولي الناشئ. يُعدُّ القيام بذلك أمراً مهمّاً جدّاً لأجل الحفاظ على وضعية أفضلية قدر الإمكان في التوزيع العالمي المتطوّر للقوة. على كلّ حال، تُعتبر القوة الاقتصادية أساساً للقوة العسكرية. إنّه لمن المثير للإعجاب ألاّ تسمح واشنطن للصين بالهيمنة على هذه المؤسّسات واستخدام النفوذ الناتج عن ذلك لكسب القوة على حساب الولايات المتحدة.
ثالثا، على صنّاع السياسة الأمريكية ضمان خلق نظام محدود هائل بإمكانه احتواء التمدّد الصيني. تتطلّب هذه المهمّة إيجاد مؤسّسات اقتصادية على غرار الشراكة العابرة للباسفيك وتحالفا عسكريا في آسيا مشابهٌ للناتو أثناء الحرب الباردة. في خضّم هذه العملية ينبغي على الولايات المتحدة أن تذهب إلى أبعد الحدود لسحب روسيا من فلك الصين وإدماجها في النظام الذّي تقوده الولايات المتحدة.
كمحصّلة، فقد آن الأوان لمؤسّسة السياسة الخارجية الأمريكية أن تُدرك بأنّ النظام الدولي الليبرالي صار مشروعا فاشلاً لا مستقبل له. إنّ الأنظمة التّي ستكون مهمّة في المستقبل المنظور هي الأنظمة الواقعية والتّي يجب صياغتها لخدمة المصالح الأمريكية.
جون ميرشايمر:
أستاذ علم السياسة بجامعة شيكاغو، حيث درّس هناك منذ سنة 1982. يُعتبر البروفيسور ميرشايمر أكثر المنظرّين المعاصرين في حقل الدراسات الدولية شهرةً وتأثيراً على الإطلاق، كما يُعدّ بمثابة الجسر المتين المعاصر للتقليد الواقعي في الحقل منذ ثيوسيديدس، ميكيافيلي، مورغانثو وكينيث والتز. يقود البروفيسور ميرشايمر تيار الواقعية الكلاسيكية الجديدة في شقّها الهجومي، وترتكز كتاباته على القضايا الأمنية الدولية وسياسات القوى الكبرى، كما يولي أهميّة خاصّة لمسألة الصعود الصيني والاستراتيجية الأمريكية الكبرى. تحظى كتابات ميرشايمر بانتشار واسع وتُترجم إلى أكثر من 20 لغة، من أبرز كتبه “مأساة سياسات القوى الكبرى” (2001)، “اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية” بالإشتراك مع زميله البروفيسور ستيفن والت (2007)، وكتابه الأخير “الوهم الأعظم: الأحلام الليبرالية والحقائق الدولية” (2018)
[1] John J. Mearsheimer, Bound To Fail: The Rise, and Fall of the Liberal International Order, International Security, Vol. 43, No. 4 (Spring 2019), pp. 7–50.