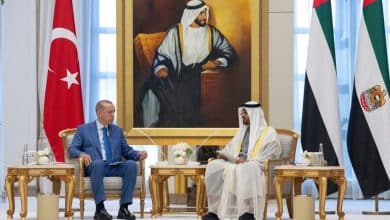فورين أفيرز: كيف يمكن إنقاذ العلاقة الأمريكية – السعودية
نشرت مجلة فورين أفيرز في عدد يناير / فبراير 2023 مقالاً لـ إف. جريجوري جوز الثالث، أستاذ الشؤون الدولية في كلية بوش للحكومة والخدمة العامة بجامعة تكساس إيه أند إم، بعنوان: “المملكة والقوة – كيف يمكن إنقاذ العلاقة الأمريكية-السعودية”، خلُص فيه الكاتب إلى أنه لا تزال عناصر التعاون المستمر بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة؛ وأن على كلا البلدين أن يستبعدا أي أحلام غير واقعية بإمكانية تغيير السياسات الداخلية للطرف الآخر أو حتى التأثير عليها؛ وأن يحرصا على أن يتعامل كل منهما مع الآخر كما هو – وليس كما يرغب أن يكون. ومن أهم المضامين التي تضمنها المقال:
أعلنت السعودية في شهر أكتوبر 2022 أن منظمة (أوبك +) وهي منظمة حكومية دولية من الدول المصدرة للنفط، ستخفض مستهدفاتها من إنتاج النفط بشكل كبير (بمعدل مليوني برميل يومياً) وبصفتها أكبر مصدر لإنتاج النفط في العالم، فقد دأبت المملكة على أخذ زمام المبادرة في جهود المجموعة لإدارة سوق النفط العالمية. وكان لهذه الخطوة تأثير فوري، وإن كان متواضعاً نسبياً، على أسعار النفط، التي ارتفعت من مستوى منخفض خلال العام عند حوالي 76 دولاراً للبرميل قبل هذا الإعلان إلى نطاق يتراوح بين 82 دولاراً و 91 دولاراً للبرميل مع منتصف نوفمبر 2022. وإن كانت الصدمة التي شعر بها الأمريكيون كانت جيوسياسية أكثر منها اقتصادية، حيث كانت إدارة بايدن قد طلبت من السعودية تأجيل قرار الخفض؛ لكن الرياض مضت قُدماً في قرارها رغم ذلك، متجاهلة واشنطن.
وقد أثارت الاتهامات المتبادلة بين واشنطن والرياض تساؤلات حول مستقبل العلاقات الثنائية بينهما؟ ورداً على قرار أوبك +، أعلنت إدارة بايدن أنها ستعيد تقييم علاقتها مع السعودية وقالت إن تلك التخفيضات “ستؤدي إلى زيادة الإيرادات الروسية وإلى التقليل من فعالية العقوبات” على موسكو التي تم فرضها رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا. وتعهد السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، روبرت مينينديز، بالحيلولة دون بيع الأسلحة للسعودية. وقدَّم العديد من أعضاء الكونجرس مشروع قانون يفرض سحب القوات الأمريكية من المملكة. ولكن الرياض رفضت التراجع، قائلة إن قرار أوبك + كان بالإجماع وكان مبنياً على “أسباب اقتصادية بحتة”.
وتراجعت حدة التوتر لدى الجانبين بعد ذلك، ويبدو أنه من غير المرجح أن تؤدي إعادة تقييم العلاقات مع السعودية التي وعدت بها إدارة بايدن إلى تغيير كبير في هذا الشأن. حيث كانت العلاقات الأمريكية-السعودية قد نجت من أزمات أسوأ من ذلك. وفي شهر نوفمبر 2022، منحت إدارة بايدن حصانة سيادية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والمعروف اختصاراً بـ “مبس”، على أساس تبوئه منصب رئيس وزراء المملكة، في قضية مدنية أمريكية رفعتها عليه خطيبة جمال خاشقجي، الصحفي السعودي الذي قُتل على يد عملاء سعوديين (في القنصلية السعودية بإسطنبول). وهذه الحصانة هي علامة واحدة، من بين العديد من العلامات الأخرى، على أن العلاقات الأمريكية-السعودية ليست في طريقها إلى التمزق. لكن أزمة أوبك + وتداعياتها تشير إلى الوصول إلى مرحلة جديدة في هذه العلاقات. فلأول مرة منذ منتصف القرن العشرين، عندما بدأت العلاقة، لم تعد الرياض تتماشى مع استراتيجية واشنطن الكبرى.
ويميل محللون ومراقبون للشؤون الأمريكية-السعودية إلى التركيز على طبائع الأفراد وأجنداتهم. فمحمد بن سلمان يتصف بالعناد والسلطوية، ويسعى إلى إعادة تشكيل اقتصاد المملكة وترقية دور بلاده كلاعب عالمي مستقل. وعلى النقيض من ذلك، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه أسلوب أكثر حذراً ويريد جعل الديمقراطية محور سياسته الخارجية، وحشد العالم ضد روسيا والصين. وهذه الفجوة بين طبيعة شخصيات وأهداف الرجلين مهمة بلا شك في تشكيل العلاقات بين البلدين. لكن حسبما قال كارل ماركس في واحدة من أكثر لحظاته وضوحاً، ما مؤداه، أن الأفراد يصنعون التاريخ، ولكن ليس بالضرورة بالطريقة التي يختارونها. حيث يشير الجدل حول قرار أوبك + إلى ثلاثة تغييرات مهمة في العلاقة الثنائية بين البلدين تتجاوز شخصيات الزعماء وستكون لها عواقب أكثر ديمومة من تصرفات وردود فعل أي من صناع القرار.
أولاً، تغير ميزان القوى العالمي: حيث يتضاءل نفوذ واشنطن نسبياً، مع تحول النظام الدولي إلى نظام متعدد الأقطاب، مما يجعل الدول ذات القوة المعتدلة مثل السعودية أكثر عرضة للتحوط في رهاناتها وأقل احتمالية أن تربط كل مصيرها بقوة عظمى واحدة فقط.
ثانياً، بينما يدفع تغير المناخ العالم بعيداً عن استخدام الوقود الأحفوري، تتعرض السعودية لضغوطات للاستفادة من احتياطياتها النفطية بينما لا تزال تستطيع ذلك – وهو شعور بالإلحاح يصبغ نهجها في إنتاج وتسعير النفط.
ثالثاً، مثل كل القضايا المهمة تقريباً في السياسة الأمريكية، شهدت قضية العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية استقطاباً كثيفاً على طول الخطوط الحزبية في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن السعوديين أنفسهم أوضحوا تفضيلهم لوجود الجمهوريين في سدة الحكم. ولم يعد هناك التداخل الاستراتيجي الكبير الذي طالما حدّد العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية على مدى عقود. ولكن استمرار آفاق التعاون بين البلدين في مجموعة ضيقة نسبياً من القضايا الإقليمية والاقتصادية يظل أمراً جيداً، في حالة إدراك كلا الجانبين لهذه التحولات، حتى يتمكنوا من التوصل إلى مجموعة أكثر واقعية من التوقعات المشتركة بينهما.
على طرفي نقيض
كانت السعودية قد برزت أهميتها للولايات المتحدة بعد أحداث الحرب العالمية الثانية، وهو الصراع الذي سلط الضوء على الدور المركزي الذي سيلعبه النفط في الإستراتيجية العسكرية الحديثة والتنمية الاقتصادية. وشهد العالم منذ ذلك الحين ثلاث فترات توزعت فيها القوة العالمية:
الفترة الأولى: إبان الحرب الباردة، حيث لم يكن أمام السعودية حينها خيار سوى دعم الأهداف الجيوسياسية للولايات المتحدة. وفي نهاية الأمر، لم يكن بإمكانها الاعتماد على المساعدة الأمنية والاقتصادية من الاتحاد السوفيتي، الذي كان يدعم العديد من خصوم الرياض الإقليميين وكان يعتنق أيديولوجية شيوعية ثورية تتعارض مع الأسس الإسلامية المحافظة للحكم السعودي. ولذلك ظلت القرارات المتعلقة بإنتاج النفط السعودي في ذلك الوقت في أيدي شركات النفط الأمريكية التي عملت على تطوير صناعة النفط السعودية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. ولم يكن لدى الرياض القوة للتعامل مع موسكو في مسائل النفط، حتى لو أرادت ذلك.
وكانت الولايات المتحدة والسعودية أيضاً شريكين على طرفي نقيض من الناحية الأيديولوجية. لكن الأعداء المشتركين والاحتياجات الاقتصادية المكملة جعلتهما شركاء بشكل افتراضي؛ حيث تم حلت “المصالح المشتركة” محل “القيم المشتركة”. وكان الاستثناء الوحيد في هذه الشراكة هو الصراع العربي- الإسرائيلي. فقد أدى اختلافهم حول هذه القضية إلى أكبر أزمة في تاريخ العلاقات الثنائية: وهو حظر تصدير النفط في العام (1973-1974)، كرد فعل للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل في حرب أكتوبر (المعروفة في إسرائيل بحرب يوم الغفران)، حيث خفّضت المملكة العربية السعودية وخمس دول عربية أخرى إنتاجها من النفط لفترة وجيزة وأوقفوا شحنه إلى الولايات المتحدة. وأدى هذا الاضطراب إلى تزايد عمليات شراء مدفوعة بالذعر، وبالتالي تضاعفت أسعار النفط أربع مرات، وقاد ذلك إلى تحول عميق في علاقات القوة داخل سوق النفط. فالدول المنتجة للنفط مثل السعودية أصبحت هي صاحبة القرار حينها؛ وأصبحت الشركات الأمريكية التي كانت تدير صناعة النفط السعودية هي الشريك الأدنى مرتبة ومقدمي الخدمات للحكومة السعودية.
لقد أضرّت السياسة السعودية حينها بالاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر، وهدّدت واشنطن بالتدخل العسكري. ولكن تم تخطي الأزمة بسرعة بعد أن أنهت الدبلوماسية الأمريكية الحرب وقادت مفاوضات تم تتويجها بمعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية في عام 1979. وقد ساعدت الأهداف الاستراتيجية المشتركة لواشنطن والرياض إبّان الحرب الباردة، بما في ذلك الحد من النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط، على رتق الخرق بين العاصمتين. وعندما برزت أهمية مسألة النفط خلال السنوات التي تلت ذلك بالنسبة لصانعي السياسة في الولايات المتحدة، بشكل أكثر من أي وقت مضى، أصبح الحفاظ على علاقات جيدة مع السعوديين هدفاً متزايد الأهمية من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري). وتنامى التعاون بين البلدين خلال الثمانينيات، حيث ساعدت كل من الولايات المتحدة والسعودية بشكل مشترك الأفغان والمقاتلين الأجانب في مقاومة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان، ووصل التعاون إلى ذروته خلال حرب الخليج (الثانية) – أو حرب تحرير الكويت (1990-1991)، والتي تزامنت مع نهاية الحرب الباردة وأبرزت أهمية العلاقات الثنائية بين الجانبين.
الفترة الثانية: كانت الفترة الثانية هي فترة القطبية الأحادية للولايات المتحدة، والتي امتدت منذ انهيار الاتحاد السوفيتي إلى وقت ما في عام 2010. وكانت الولايات المتحدة خلال هذه الحقبة هي الخيار الوحيد لدول مثل المملكة العربية السعودية التي سعت إلى الشراكة مع قوة عظمى. وحدثت خلال هذه الفترة أزمة كبيرة أخرى، وهي: هجمات 11 سبتمبر، التي خطط لها أسامة بن لادن، سليل إحدى أغنى العائلات السعودية، ونفذها 15 سعودياً (من إجمالي 19 مختطِفاً). ولأن تنظيم القاعدة استهدف كلاً من الأسرة السعودية الحاكمة والولايات المتحدة، فقد وجدت الدولتان مرة أخرى أن هناك عدو مشترك يمكن أن يجمعهما معاً. وخلال “الحرب على الإرهاب” التي أعقبت ذلك، قام كل من الرئيسين الأمريكيين جورج دبليو بوش وباراك أوباما بتنمية علاقات استخباراتية وثيقة مع السعودية. وكانت واشنطن هي اللاعب الوحيد على الساحة، ومن جانبها دعمت الرياض المبادرات الأمريكية، حتى عندما كانت تشكك علناً في حكمتها، وعلى الأخص أثناء غزو العراق عام 2003.
وكانت نهاية الحرب الباردة وفجر السلام الأمريكي (باكس أمريكانا) مفاجئة نسبياً وانطوت على سلسلة من الأحداث الدرامية. وعلى النقيض من ذلك، جاءت نهاية فترة الأحادية القطبية تدريجياً. ومع ذلك، فبحلول عام 2020، أدت عوامل تبديد الأصول الأمريكية ومصداقيتها في العراق وأفغانستان، وتزايد مظاهر الخلل الوظيفي والاستقطاب في السياسة الداخلية الأمريكية، وصعود الصين، ومحاولة روسيا العودة من جديد كقوة عظمى، أدت مجتمعة إلى خلق توازن دولي جديد للقوى.
الفترة الثالثة: وعلى عكس الفترتين السابقتين، ففي الفترة الثالثة، لا يوجد عدو مشترك يدعم العلاقات الأمريكية-السعودية. فبينما تسعى إدارة بايدن إلى حشد التحالفات الدولية ضد روسيا والصين، لا تنظر المملكة العربية السعودية إلى أي من هاتين القوتين العظميين (روسيا والصين) على أنهما أعداء لها. فالصين تُعد الآن أكبر عميل وشريك تجاري لها في مجال النفط. حيث ارتفعت التجارة بين السعودية والصين من أقل من 500 مليون دولار في عام 1990 إلى 87 مليار دولار في عام 2021. وفي نفس العام، كانت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين، ومعظمها من النفط والمنتجات البترولية، أكبر بثلاث مرات من الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة. وما يقرب من ضعف صادرات السعودية إلى الهند واليابان، ثاني وثالث أكبر أهداف الصادرات السعودية. وتُعتبر روسيا الشريك الضروري للسعودية (على الرغم من الصعوبة التي قد تعتري ذلك في بعض الأحيان) في إدارة سوق النفط العالمية. حيث تنتج دول أوبك + ما يقرب من 40 مليون برميل من النفط يومياً ؛ وتشكّل السعودية وروسيا مجتمعتين أكثر من نصف هذا الرقم. وفي حالة وقوف موسكو والرياض معاً في نفس الجهة، حينئذٍ فقط يمكن أن يكون لقرارات أوبك + تأثير على السوق.
ولكل هذه الأسباب، فعندما يستعرض القادة السعوديون المشهد الجيوسياسي، فإن الصورة التي يرونها تختلف بشكل ملحوظ عن الصورة التي يراها نظرائهم الأمريكيون. وقد أصبح هذا الواقع الجديد يمثل صدمة بالنسبة للنخب في واشنطن والتي أصبحت معتادة على الدعم السعودي شبه المؤكد للولايات المتحدة، ولهذا السبب جاء رد الفعل الهستيري من بعض السياسيين الأمريكيين على القرار التي اتخذته أوبك + مؤخراً بتخفيض الإنتاج. إذ لا تتعلق ردود الفعل تلك فقط بأسعار النفط في الفترة التي سبقت انتخابات التجديد النصفي. فقد اختلفت السعودية والولايات المتحدة كثيراً في الماضي حول أسعار النفط. ولكن الاختلاف هذه المرة جاء في السياق الجيوسياسي – وخاصة الحرب في أوكرانيا، التي حدّدتها إدارة بايدن كنقطة انعطاف تاريخية ستحدد مستقبل النظام العالمي. أما بالنسبة للسعودية، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الهند وإسرائيل، فهي مجرد حرب إقليمية.
وفي نفس الوقت، فإن لدى السعوديين شكواهم الخاصة حول هذا الأمر. فقد شنِّ الرؤساء الأمريكيون الثلاثة السابقون حملاتهم الانتخابية على أساس أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تقليل والحد من الوقت والجهد الذي تبذله في منطقة الشرق الأوسط. وهذا ما لا يبعث على الارتياح للنظام السعودي الذي يرى في إيران، التي وسعت نفوذها في العراق ولبنان وسوريا واليمن، تهديداً إقليمياً خطيراً له. وكان الهدف المعلن لتركيز الولايات المتحدة على منطقة الخليج العربي على مدار السبعين عاماً الماضية هو حماية حرية تدفق النفط. ولكن عندما شنت إيران هجوماً صاروخياً ومن خلال مُسيَّرات على منشآت النفط السعودية في سبتمبر 2019 – وهو أخطر هجوم على حرية تدفق النفط منذ أن أشعل الديكتاتور العراقي صدام حسين النار في حقول النفط الكويتية في عام 1991 – لم تفعل إدارة ترامب شيئاً يُذكر، على الرغم من العلاقات الوثيقة التي عزّزتها مع الرياض.
وبالتالي لم تعد المملكة شريكاً تلقائياً للولايات المتحدة. ولن تعود العلاقة الاستراتيجية الحميمة التي كانت سائدة في العصور السابقة. لكن هناك إمكانية لاستمرار التعاون المحدود بينهما، حتى لو استمرت السياسات الداخلية على كلا الجانبين في خلق الصعوبات.
على غرار الزيت والماء
وعلى الرغم من أن السعودية تفضل دائماً الحفاظ على أسعار النفط في مستوى أعلى مما يرغب به رؤساء الولايات المتحدة، فقد اعتادت المملكة في بعض الأحيان الاستجابة لطلبات واشنطن لزيادة المعروض وتوفير المزيد من النفط في السوق، وعادةً ما كان يحدث ذلك في الفترات التي تسبق الانتخابات الأمريكية. لكن في أكتوبر 2022، ذهبت نداءات واشنطن في ذلك أدراج الرياح.
حيث ترى الرياض ضرورة أن تستغل فرصتها الأخيرة للاستفادة من صادراتها النفطية قبل انتهاء عصر النفط. وهذا هو الافتراض الذي كان وراء خطة إعادة الهيكلة الاقتصادية الطموحة في إطار رؤية 2030 لولي العهد السعودي – لخلق اقتصاد سعودي أكثر تنوعاً قبل أن تنهار السوق العالمية للنفط تحت ضغط تغير المناخ، والانتقال إلى أنواع الوقود البديلة، والتغيرات التكنولوجية الأخرى. وهذا لن يحدث بالطبع قبل سنوات. لكن ولي العهد يحتاج إلى استخدام كل النفوذ الذي يمكنه الحصول عليه للاستثمار في القطاعات غير النفطية للاقتصاد السعودي ولحماية شعبه من العواقب المؤلمة للإصلاحات الضرورية، مثل خفض الإعانات الكبيرة للمرافق العامة، بما في ذلك المياه والكهرباء، و إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة على مشتريات المستهلكين.
وهذا يفسر سبب استهداف سياسة النفط السعودية الحفاظ على الأسعار عند مستوى يمكن أن يمول خطط محمد بن سلمان الطموحة وتستمر في الحفاظ على مستوى ثابت من الطلب العالمي على النفط. وبالتأكيد لن تتوافق هذه الضرورات دائماً مع التقويم الانتخابي للولايات المتحدة. ومع وجود تداخل بدرجة أقل بين استراتيجية واشنطن الكبرى ومخاوف السياسة الخارجية للرياض، فإن القيادة السعودية أقل احتمالا لتقديم أي مزايا انتخابية لرؤساء الولايات المتحدة مقارنة بما كان عليه الحال في الماضي عندما يتعلق الأمر بالنفط.
وإذا كانت التغييرات المهمة التي تؤثر على العلاقات الثنائية من الجانب السعودي تتعلق بالاقتصاد السياسي، فإن التغييرات الأمريكية الداخلية تتعلق بالسياسات الحزبية. فقد انجرفت العلاقات الأمريكية-السعودية، مثل العديد من القضايا الأخرى، إلى دوامة الاستقطاب الحزبي في السياسة الأمريكية. وبالرغم من أن العلاقات مع السعودية في الماضي لم تحظ بدعم كبير بين عامة الأمريكيين، إلا أن ساكني البيت الأبيض كانوا يرغبون في أن تكون لهم علاقات جيدة مع أكبر مصدر للنفط في العالم. ولكن ذلك بدأ يتغير خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ولم يُخفِ ترامب مودته تجاه السعوديين، وعلى وجه الخصوص محمد بن سلمان. وفي خطوة غير مسبوقة، جعل ترامب أول عاصمة أجنبية يزورها بعد انتخابه هي الرياض. ولطالما تفاخر، وبالغ، في مبيعات الأسلحة التي تفاوض عليها مع المملكة في حينه. وفي خطوة محفوفة بالمخاطر، ألمح ترامب علناً إلى دعمه لمحمد بن سلمان حيث تغلب الأمير الشاب على ابن عمه محمد بن نايف، المحاور الرئيسي للإدارات الأمريكية السابقة، وأطاح بابن نايف من السلطة في عام 2017. وتاريخياً، لم يقحم الرؤساء الأمريكيون أنفسهم علناً، أو حتى بشكل غير مباشر، في سياسة القصر هناك. وراوغ ترامب بشأن تواطؤ محمد بن سلمان في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حتى في مواجهة أدلة قوية متداولة بأن الجريمة نُفِّذت بتوجيه من ولي العهد. (حيث قال ترامب: “من المحتمل جداً أن ولي العهد كان على علم بهذا الحدث المأساوي – ربما يكون قد فعل وربما لم يفعل!”). وطوّر جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه، علاقة مباشرة مع ولي العهد خارج القنوات الدبلوماسية العادية. وبعد تركه المنصب، تلقى كل من كوشنر وستيفن منوتشين، الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد ترامب، استثمارات كبيرة من الصندوق السيادي السعودي لمشاريعهما الاستثمارية الخاصة. وفي نوفمبر الماضي، وافقت شركة ترامب بالسماح لوضع اسم ترامب على مجمع سكني فاخر ومجمع جولف بمليارات الدولارات يتم تطويره في عُمان من قِبل شركة عقارية سعودية كبرى.
وبالنسبة لمؤسسة السياسة الخارجية الديمقراطية، فقد بدا الأمر كما لو أن السعوديين قد اختاروا جانباً، وتم تتبع موقفها وفقاً لذلك. حيث تعرض مقتل خاشقجي وتورط السعودية في الحرب الأهلية اليمنية لانتقادات مستمرة من جانب الديمقراطيين. وخلال الحملة الانتخابية لترشيحات الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2020، وصف بايدن السعودية بأنها “منبوذة”. وكانت هذه لغة قاسية بشكل صادم من نائب رئيس أمريكي سابق وعضو مجلس الشيوخ آنذاك، والذي تعامل مع السعوديين لعقود وكان دائماً مؤشراً موثوقاً للحكمة التقليدية بشأن السياسة الخارجية داخل الحزب الديمقراطي.
وعندما تولت إدارة بايدن السلطة، قامت بتطبيق وضعية الازدراء للسعودية التي عبر عنها الرئيس خلال الحملة الانتخابية. فرفض بايدن التحدث مع ولي العهد وأذن بنشر تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية يحمّله مسؤولية وفاة خاشقجي. وقلّصت واشنطن دعمها للجهود الحربية السعودية في اليمن وسحبت صواريخ باتريوت المضادة للطائرات من المملكة، حتى في الوقت الذي كانت تواجه فيه السعودية هجمات صاروخية من الحوثيين في اليمن.
وتسببت الحرب في أوكرانيا والارتفاع اللاحق في أسعار النفط في دفع الإدارة لإعادة النظر في الأمر. لقد كان عزل السعوديين ممكناً أثناء انخفاض الطلب العالمي على النفط إبّان جائحة كوفيد -19. لكن عندما حاولت الولايات المتحدة قطع صادرات النفط الروسية مع تعافي الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب على النفط، كانت واشنطن في حاجة إلى السعودية. حيث كانت الرياض واحدة من الجهات الفاعلة القليلة التي يمكنها ضخ المزيد من النفط على الفور. ومع ذلك، فإن رحلة بايدن إلى السعودية لم تحقق الكثير، بل إنها ولّدت المزيد من المشاعر السيئة. فقد استاء السعوديون من ادعاء الولايات المتحدة بأن بايدن لم يأت للقاء ولي العهد بل لحضور اجتماع متعدد الأطراف مع دول مجلس التعاون الخليجي. وتشاحن الطرفان علناً حول ما إذا كان بايدن قد أثار قضية خاشقجي خلال محادثة خاصة له مع محمد بن سلمان. حيث قال بايدن إنه قام بذلك، بينما قال السعوديون إنه لم يفعل ذلك. كان الهدف من الاجتماع أن يهدئ العلاقات ولكنه فقط زاد من توترها.
لقد تعامل بايدن مع العلاقة مع السعودية بطريقة خرقاء، ولكن السعوديين أيضاً ليسوا بلا أخطاء. حيث كان مقتل خاشقجي بالطبع جريمة لا تغتفر. وكان السعوديون واضحين للغاية في احتضانهم لترامب علناً، بدءاً من احتفائهم وترحيبهم السخي به في بداية رئاسته إلى مساهمتهم في مشاريعه التجارية ومشاريع عائلته منذ هزيمته في الانتخابات عام 2020. وفي نهاية الأمر، لم يتحرك ترامب أبداً للدفاع عن المملكة حتى عندما هاجمت إيران منشآت النفط السعودية في عام 2019. ومع ذلك، يبدو أن القيادة السعودية قد خلصت إلى أنها لا تستطيع الحصول على استماع منصف لها من قِبل الديمقراطيين وأنه يمكنها فقط أن تأمل في عودة الجمهوريين إلى السلطة بالولايات المتحدة. وعندما رفض السعوديون طلب إدارة بايدن بتأجيل خفض إنتاج أوبك + من النفط إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، عزّز ذلك الشعور بأن الرياض لا تريد أن تقدم للديمقراطيين أي معروف. لا يمكن أن تستمر علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأجنبية من قبل حزب واحد فقط. لذا فإن هذا الاستقطاب الحزبي هو ما يشكل أكبر تهديد للعلاقة الأمريكية-السعودية.
إصلاح الأسوار
في الحقيقة، لا تمثل العلاقات الأمريكية-السعودية المتوترة أي مشكلة لأولئك الذين يعتقدون أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة يجب أن تولي اهتماماً أكثر لحقوق الإنسان وأن تبتعد في نفس الوقت عن الوقود الأحفوري. لكن حتى إدارة بايدن نفسها، التي تولت السلطة وهي عازمة على النأي بنفسها عن الرياض، سرعان ما أدركت الحاجة إلى ضرورة وجود علاقة عمل مع أكبر مصدر للنفط في العالم. وبغض النظر عن مدى التزام الولايات المتحدة بتبني الطاقة النظيفة، فستكون هناك حاجة إلى النفط كذلك خلال الفترة الانتقالية. وبغض النظر عن مدى رغبة الأمريكيين في الابتعاد عن منطقة الشرق الأوسط، فإن لدى واشنطن التزامات جيوسياسية في المنطقة تشد الولايات المتحدة مرة أخرى للمنطقة: مثل منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، والحيلولة دون بعث الجهادية من جديد، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي لتقليل ضغوط اللاجئين على أوروبا، وإدامة العلاقة مع إسرائيل. ولذلك، فسيظل استمرار علاقة العمل مع السعودية ضرورياً طالما ظل عامل النفط ومسألة الشرق الأوسط يحظيان بأهمية، ولو كانت هامشية، لمصالح الولايات المتحدة.
تتمثل الخطوة الأولى في الحفاظ على مثل هذه العلاقة في إدراك إلى أي مدى قد تغيرت. لقد ولت الأيام التي كانت فيها السعودية تقف بشكل تلقائي إلى جانب الولايات المتحدة في القضايا الاستراتيجية الكبرى. حيث تلوح الآن الصين وروسيا في الأفق للسعوديين أكثر من أي وقت مضى. وهذا لا يعني أن الرياض ستعمل ضد الولايات المتحدة على المستوى العالمي. إنما يعني فقط أن السعوديين سينظرون إلى القضايا كل على حدة. وسيتطلب ذلك من الولايات المتحدة اتباع نهج منفتح واستشاري، والحفاظ على قنوات الاتصال لإقناع السعوديين بالمصالح المشتركة حول القضايا العالمية. إن إبقاء الرياض على بُعد ولو ذراع ليس هو السبيل لإبقائها في جانب واشنطن.
ومع ذلك، فلا تقف واشنطن والرياض بعيداً عن بعضهما البعض فيما يتعلق بالقضايا الكبرى في الشرق الأوسط. ولم تعد العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، العائق التقليدي، عقبة أمامهما، بفضل دفء العلاقات السعودية-الإسرائيلية. حيث يتصاعد استعداد السعوديين للعمل مع إسرائيل، حتى لو لم يكن هناك استعداد لديهما لاتباع نموذج البحرين والمغرب والسودان والإمارات في ما يسمى باتفاقات أبراهام، والتي من خلالها قامت تلك الدول بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وهناك نقطة توتر أخرى مع الرياض قد تبدو لأول وهلة أقل أهمية وهي جهود واشنطن لتقليص أنشطة إيران النووية من خلال الدبلوماسية، والتي كان السعوديون يشعرون بالقلق من أنها قد تنطوي على تقديم تنازلات لإيران من شأنها أن تعزز نفوذ طهران الإقليمي. ويبدو من المرجح أن جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحب ترامب منه في 2018، سيكون مآلها الفشل. وسيتعين على واشنطن حتماً أن تجد سياسة جديدة لردع إيران أو منعها من الحصول على أسلحة نووية مع الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة أو تقليصه. ولدى المملكة العربية السعودية نفس المصلحة في ذلك.
وعلى الرغم من أن قضية الإرهاب ليست على رأس جدول أعمال الولايات المتحدة اليوم، إلا أن واشنطن لا تزال مهتمة بالحيلولة دون بعث السلفية الجهادية من جديد، وكذلك التطرف الذي يغذيه التفسير الثوري والعنيف للإسلام، على غرار تنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضاً باسم داعش)، وجماعات أخرى من هذا القبيل. وفي عهد محمد بن سلمان، لم تعارض السعودية تلك الجماعات في المنطقة فحسب، بل قللت أيضاً من تأثير المؤسسة الدينية السلفية في المملكة نفسها. وعندما تشجع السعودية تقديم تفسير أكثر تسامحاً وانفتاحاً للإسلام، فإنها بالتالي تقوض الإقبال على السلفية الجهادية.
لا تزال المصالح الاقتصادية للبلدين متداخلة بشكل بارز على الرغم من وجود خلافات بينهما حول أسعار النفط. فكلاهما تشتركان في مصلحة الحفاظ على هيمنة الدولار الأمريكي. وتقوم الرياض بتسعير نفطها بالدولار، وهو ما يدعم دور الدولار كعملة تمثل احتياطي العالم، لأن مستهلكي النفط يجب أن يكون لديهم الدولارات في متناول أيديهم لتمويل احتياجاتهم من الطاقة. وتدفع الدول غير الصديقة المنتجة للنفط مثل إيران وفنزويلا وروسيا أحياناً في اتجاه إجراء معاملاتهم باستخدام عملات بديلة. ولطالما قاومت السعودية مثل هذه المبادرات، لأن أي شيء يضر بمركزية وهيمنة الدولار من شأنه أن يقلل من قيمة الأصول المقومة بالدولار في المملكة العربية السعودية، وهو أمر مهم بالنظر إلى حجم الأصول المالية السعودية في الأسواق الأمريكية، بما في ذلك الحيازات الكبيرة من ديون الحكومة الأمريكية، والاستثمارات في الشركات الأمريكية.
وأخيراً، من مصلحة كل من الولايات المتحدة والسعودية مواصلة التعاون في القضايا العسكرية والاستخباراتية. فبالنسبة للسعودية، لا يمكن للصين ولا روسيا أن توفر مستوى التعاون الأمني الذي تستطيع الولايات المتحدة القيام به. إذ تستطيع واشنطن وحدها إبراز قوة عسكرية كبيرة في منطقة الخليج العربي، كما ظهر خلال حرب الخليج الثانية (1990-1991). وتستفيد الولايات المتحدة من هذا التعاون أيضاً. تقلل مشتريات الأسلحة السعودية من تكاليف إنتاج الأسلحة الأمريكية وتربط بين جيشي الدولتين، مما يعزز آفاق شراكة طويلة الأمد. ومع الفشل المحتمل للمحادثات النووية مع طهران، ستزداد فرصة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. ويزيد التعاون مع السعودية في حالات الطوارئ العسكرية من الكفاءة العسكرية للولايات المتحدة في المنطقة، وبالتالي يؤدي إلى ردع إيران.
ومع أنه لا يتأتى فعل الكثير لعكس التحول في ميزان القوى العالمي أو لتخفيف الضغط الذي تشعر به الرياض للاستفادة من النفط، إلا أن كلاً من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تستطيعان تعزيز العلاقات الثنائية بينهما إذا أعاد كل جانب منهما النظر في رؤيته للسياسة الداخلية للطرف الآخر. فعلى السعوديين أن يتخلوا عن الاعتقاد المدمر للذات بأن أحد الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة ضدهم والآخر لصالحهم. إذ من المحتم أن تفشل الجهود المبذولة للتأثير على السياسة الأمريكية لصالح حزب واحد على المدى الطويل لأنه في نظام الحزبين، يصبح الحزب الخارج من السلطة دائماً هو الحزب الحاكم فيما بعد في نهاية الأمر. ولذلك تحتاج الرياض إلى بذل جهد كبير لإقناع المؤسسة الديمقراطية في واشنطن بأنها تسعى إلى علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وليس فقط مع الجمهوريين. وهذا يعني أن تبدأ على الفور بمقاومة نداءات الإنذار القادمة من عالم ترامب للمساعدة في استعادة السلطة عام 2024، إما من خلال الدعم المالي غير المباشر أو التحركات السياسية التي تهدف إلى إضعاف إدارة بايدن. ويعني ذلك أيضاً أنه على السعودية تقديم مبادرات لمنتقدي المملكة من الديمقراطيين في واشنطن. ومع أن ذلك قد لا يغير من قناعاتهم، لكنه قد يؤدي إلى تهدئة مخاوفهم بشأن التدخل السعودي في السياسة الداخلية للولايات المتحدة.
وفي الجانب الأمريكي، على الديمقراطيين قبول حقيقة أن محمد بن سلمان سيكون على الأرجح الملك القادم للمملكة العربية السعودية وسيحكم البلاد لفترة طويلة. ولا معنى لمحاولة عزله أو الالتفاف حوله. وقد يكون هذا أمراً مَقيتاً للمدافعين عن حقوق الإنسان، ولكن إذا كان الدبلوماسيون والمسؤولون الأمريكيون قد تمكنوا من التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، وممثلي جمهورية إيران الإسلامية والعديد من الحكومات الأخرى التي تنتهك حقوق الإنسان لمواطنيها وغيرهم، فإنه يمكنهم أيضاً بالتأكيد الاجتماع بمحمد بن سلمان.
وسيتعين على واشنطن في واقع الأمر أن تجتمع مع الرياض في كثير من الأحيان في إطار الترتيب العالمي الجديد، لإقناع المملكة برؤية الأمور على طريقتها هي. زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين السعودية مرة واحدة فقط، خلال زيارة بايدن للمملكة في يوليو 2022. وكذلك لم ينعقد الحوار الاستراتيجي السعودي-الأمريكي منذ عامين. وبالتأكيد يلاحظ السعوديون هذه الأشياء.
لا تزال عناصر استمرار التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة. لكن ما يتعين على كلا البلدين هو أن ينحيا جانباً أحلامهما التي لا تمتّ للواقع في تغيير أو التأثير على السياسات الداخلية للطرف الآخر. يجب أن يتعلم كلا الجانبين كيف يمكن أن يتعامل مع الجانب الآخر كما هو – وليس كما يرغب أن يكون.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.