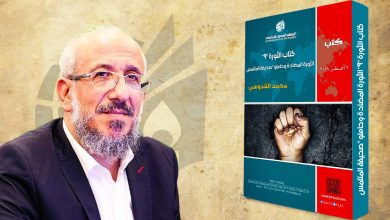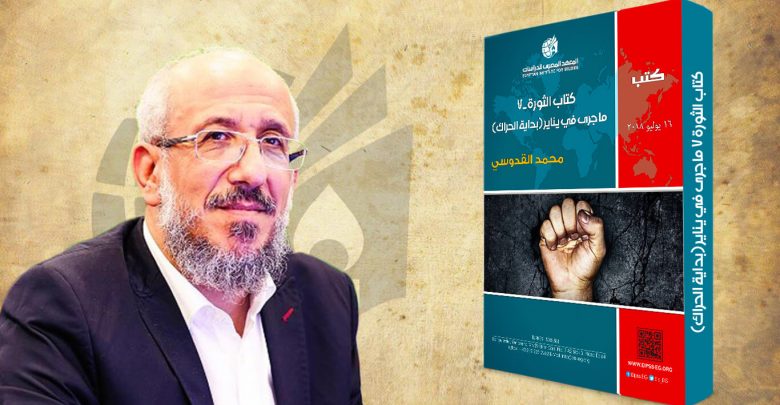
كتاب الثورة ـ 7: ما جرى في يناير (بداية الحراك)
الذين يسألون، وقد تملكتهم الصدمة، عن “أسباب فشل الربيع العربي” هم أنفسهم الذين توهموا من قبل أن ثورة يمكن أن تُنجَز في أيام معدودات، وتوهموا أن “إسقاط الرئيس” هو الثورة، ولو كان ذلك كذلك لكان “الموت” هو أكبر “ناشط” ثوري على الإطلاق، لأنه يسقط كل الرؤساء عبر الزمان والمكان. وهم أنفسهم الذين لم تعنِ الثورة بالنسبة لهم أكثر من سلطة، توهموا أنها دانت لهم أو دنت منهم. وفي “مستنقع الأوهام” هذا لن تجد حقيقة واحدة.
وقبل هذا فإنه من المبكر جدا الحديث عن فشل، أو نجاح، الربيع العربي، ذلك أن الثورة بوصفها “تغيير واع جذري ينتظم بنية المجتمع” تحتاج إلى زمن لتكوين الوعي، ثم لامتداد التغيير أفقيا ورأسيا، وتمر عبر مراحل متعددة:
المرحلة الأولى: الحراك الثوري، ينطلق باكتمال عوامله الأربعة التي أشرنا إليها في الفصل السابق، وآخرها ـ وهو العامل الفارق فيها ـ أن تتساوى تكلفة الثورة مع تكلفة الخضوع. ويكون انتفاضة عفوية.
وطبقا لقاعدة أن “وعي الناس ليس هو الذي يحدد وجودهم الاجتماعي، بل إن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم” فإنه ليس من المتصور ـ طبعا ـ أن يولد الوعي الثوري مكتملا، ولا أن يشمل التفاصيل كلها، ولا أن يعم الجميع، ولا أن يكون الثوار على درجة واحدة منه. الوعي هو مسؤولية ـ ومهمة ـ الطليعة الثورية في المقام الأول. والتفاعل بين هذه الطليعة والجماهير من جهة، ثم المواجهة بينهما معا وبين الطغمة الحاكمة من جهة أخرى، هو ما يطور الوعي، على طريقة “الدوامة” التي تبدأ من نقطة مركزية، ثم تتسع شيئا فشيئا في دوائر تظل مترابطة.
وطبقا لصورة “الدوامة” هذه فإن الثورة لا تنطلق إلا بالوعي، والوعي لا يكتمل إلا بالثورة، بمعنى أن “شرارة” الوعي التي تطلق الثورة ليست هي كل “النار” التي تضطرم بها. يكفي ـ في البداية ـ أن يوجد هذا القدر من الوعي الدافع لحراكٍ تؤدي تفاعلاته لمزيد من الوعي، الذي يؤدي لمزيد من الحراك، ثم مزيد من الوعي، وهكذا في دوامة متصاعدة، تنطلق من نقطة متناهية الصغر، وتصل إلى أقصى طاقتها.
المرحلة الثانية: الثورة المضادة، وفيها تعود أشباح الدولة التي لم يكتمل هدمها لتحول دون نشوء الدولة التي لم يبدأ بناؤها، وسنفصل الحديث عن هذه المرحلة لاحقا.
المرحلة الثالثة: الحسم، وهي مرحلة تنتج “حالة مختلفة” عما كان قائما قبل بدء الحراك الثوري، لكن هذه الحالة ليست بالضرورة (أو قل: ليست على الأرجح وفي الأغلب الأعم) ما كانت الثورة تسعى إليه، وهو ما يستحضر موجات ثورية تالية. وقد يحسم الأمر بنهاية الحالة الثورية، ليبدأ تراكم جديد لدورة ثورية أخرى.
وفي سياق الربيع العربي، لم يكن ما شهدته مصر في 25 من يناير/كانون الثاني 2011 ثورة مكتملة (من المستحيل أن تكتمل ثورة في 18 يوما) ولا كان مجرد انتفاضة مبتورة، لكنه كان حراكا بدأته كتلته الأولى، فقط، لتعديل التوازن النسبي بين مكونات “الأقليات المتساندة” في دولة “الجنرال” التي كانت، حتى 25 من يناير/كانون الثاني 2011 تعمل وفق نسخة تجاوزها التاريخ، وظلت موجودة من دون سند(1 ) منذ الستينيات، هي النسخة التي سماها جمال عبد الناصر “تحالف قوى الشعب العامل”، وفيها كان اليسار في صدارة المشهد (بحكم وجود الاتحاد السوفيتي والعلاقة القوية معه) وكان الأزهر يقود المؤسسة الدينية الرسمية وتتلوه الكنيسة. ولم يكن لليبرالية من وجود إلا عبر المدخل الاقتصادي “الرأسمالية الوطنية”. وهو ترتيب فقد مبرراته، ولم يعد من الممكن استمراره. فالطفيليون ـ المحجوبون تقريبا عن الشرعية ـ أصبحوا يهيمنون على الإعلام وعلى الاقتصاد، وأموالهم ـ سواء دفعوها مباشرة أو عبر بعض العاملين لديهم ـ هي التي تتيح دفع الرشوة اللازمة للالتحاق بالكليات العسكرية وكلية الشرطة والنيابة العامة، وهي التي تمول الحملات الانتخابية للنواب، وهي التي توفر “نثريات” الوزراء والمحافظين، فما الذي يبقيهم محجوبين؟ وبأية ذريعة يتصدر اليسار الرسمي، المفلس جماهيريا وماديا، قطار الأقليات المتساندة؟
وفي السياق نفسه: ما الذي يبقي الأزهر في صدارة المؤسسة الدينية، على حساب الكنيسة الأرثوذكسية ذات العلاقة المتميزة والمباشرة مع الولايات المتحدة (مالكة 99% من أوراق اللعبة حسبما يؤمن الجنرال) والتي يشكل أتباعها سفارة أكبر وأكثر أهمية من السفارة المصرية في أمريكا؟ هل تقنع الكنيسة، بعد أن أصبح رأسها برأس الجنرال نفسه، وربما أعلى في بعض الملفات، بالمرتبة الثانية داخل إحدى أقلياته؟ بالتأكيد لا.
وهكذا فإن الطفيلية ـ بقناع ليبرالي ـ كانت تسعى لصدارة “دولة الأقليات المتساندة وفي القلب جنرال” وكان “السيد البدوي” هو التعبير الأفضل عن هذا المزيح، فهو “طفيلي” بحكم المهنة والصعود الاقتصادي، وهو “قيادة ليبرالية” فقط بحكم أنه “اختلس الصعود” إلى رأس حزب يسمى ليبراليا برغم أنه محافظ في ممارساته ورؤاه! بينما كان اليسار يسعى إلى تقليل خسائره أمام الطفيليين، وهم يواصلون زحفهم يسارا، ويمينا أيضا على حساب المؤسسة الدينية الرسمية، التي كانت تشهد محاولات الكنيسة لحمل الأزهر على أن يعود خطوة للخلف متخليا لها عن صدارتها.
في 25 من يناير/كانون الثاني 2011 كنا بصدد حراك سياسي، بغطاء شعبي ومظهر ثوري، لا يستهدف أكثر من إجراء تعديل يأتي في جانب منه تعبيرا عن “إقرار واقع” مع بقاء البنية الأساسية لحكم العسكر كما هي، وهو التعديل الذي تحقق فعلا بعد أن أسفر الانقلاب العسكري عن وجهه في 3 من يوليو/تموز 2013، تحت مظلة حراك ظاهر التلفيق، هو حراك 30 من يونيو/حزيران، تصدر مشهده الافتتاحي الطفيليون بقناع ليبرالي، والمؤسسة الدينية بقيادة كنسية (لاحظ حرص الكنيسة على إلغاء المرجعية التشريعية للأزهر الذي لم يبد اعتراضا لا هو ولا حزب النور صاحب اقتراح وضع المرجعية في الدستور، لأن كلا منهم كان يعرف دوره وموقعه).
في 25 من يناير/ كانون الثاني 2011، كان هناك غضب شعبي كبير، خرج ليعبر عن نفسه في تظاهرة بدت في أول أمرها حركة احتجاجية بارزة، من دون أفق ثوري، في سياق الاحتجاجات المتتالية التي شهدتها مصر منذ العام 2004، وبرغم نجاح تونس في إسقاط “بن علي” فقد كان بوسع “مبارك” أن يظل في مكانه لو أقال الحكومة، واستبعد وزير الداخلية، وحدد موعد إجراء انتخابات برلمانية من دون تزوير، ولو فعل “مبارك” هذا بعد أن غادر المتظاهرون ميدان التحرير في يوم الاحتجاجات الأول، لكانت الجماهير ـ على الأرجح ـ خرجت في اليوم التالي هاتفة باسمه، لكنه بدلا من هذا سكب وقودا على بصيص النار باعتقال بعض المشاركين في التظاهرة.
لم يكن ما فعله “مبارك” مجرد عناد، لكنه تصرف في حدود المعلومات (المبتورة والناقصة وغير الدقيقة) التي أتيحت له، وفي حدودها وعلى ضوئها أراد “الجنرال” أن يؤدب “أقلياته” التي رآها تحاول “لي ذراعه” بمطلب إعادة ترتيب أوضاعها، وكانت الاعتقالات رسالة منه إلى هذه الأقليات، فضلا عن عبارة “خليهم يتسلوا” التي كانت أول رد فعل يصدر عنه تعليقا على التظاهرات، وتقديري أنها كانت خطابا للأقليات المتساندة، التي لا يرى الجنرال غيرها، بما إن الأغلبية ـ على الأصل ـ مستبعدة من نظامه. وكانت هناك أيضا تأثيرات جانبية منها إصرار “مجموعة توريث الحكم” على استكمال خطوات مشروعها ورفضها التراجع، فضلا عن الاضطراب الناتج عن الصراع المحتدم بين هذه المجموعة (المرتبطة أكثر بمباحث أمن الدولة/وزارة الداخلية) وبين مجموعة الحرس القديم (المرتبطة أكثر بالمخابرات/المؤسسة العسكرية). وحرص المرشحين للاستبعاد على الدفاع عن مواقعهم وأنفسهم حتى النهاية.
كل هذا دفع مبارك إلى التصرف على نحو بدا بالغ الغباء، وبالرغم من هذا ظل يتمتع بمساندة أمريكية غير محدودة (من واشنطن ومن أتباعها الإقليميين أيضا) طالما ظلت الاحتجاجات في إطارها المحدود. بقي “أوباما” يرى مبارك “رجلا حكيما” كما وصفه في زيارته للقاهره 2009، واهتم البيت الأبيض بعقد اجتماعات يومية لمتابعة “تطورات الأزمة في مصر” كما سماها، وهي تسمية تتبنى وجهة نظر الجنرال، معتمدة وصف “الأزمة” وليس “الثورة” ولا “الانتفاضة” ولا “الاحتجاج” وما إلى ذلك. وصرحت “هيلاري كلينتون” وزيرة الخارجية آنذاك بأن “الحكومة المصرية مستقرة وتبحث عن طرق للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة”. مؤكدة أن الفرصة متاحة أمام الحكومة لإجراء الإصلاحات، التي قال “أوباما” إنه حث مبارك في اتصال هاتفي على القيام بها.
لكن هذا الموقف اضطر للانحناء، بعد ثلاثة أيام من العجرفة، مع البداية الحقيقية للحراك الثوري في 28 من يناير/كانون الثاني، عندما أطلت مطالب “الأغلبية المستبعدة” على الميدان، وهي المطالب التي أجلت الأغلبية رفعها، برغم مشاركتها في الحراك الثوري منذ لحظته الأولى، لكنها كانت تكتفي بدور “الحشود” متخلية لأقليات الجنرال عن “الصدارة” لدوافع يمتزج فيها الحذر بالرغبة في سلوك السبيل المعتاد (حيث الأقليات في جانب من دورها تلعب ـ عند الحاجة ـ دور الوسيط بين الجنرال وبين الأغلبية المستبعدة). وهي دوافع انهارت مع احتدام الصراع، ليتبدي المشهد الرائع في “جمعة الغضب” 28 من يناير/كانون الثاني 2011: مواجهة مباشرة بين أغلبية هادرة تكسر الجدار منتقلة من الغياب إلى الحضور، وجنرال مرتبك كان يظن نفسه في “جولة تأديب” للأقليات المطالبة بـ”إعادة الترتيب” فإذا به وحيدا أمام الطوفان. ولم تكن الأقليات أقل ارتباكا من جنرالها، الذي لم يكن قد تدارك الأمر معيدا استدعاءها، ولا هي تداركته معيدة الالتفاف حوله.
كان حضور الأغلبية يعني اختلال الركن الثالث من أركان دولة الجنرال والأقليات المتساندة، ركن استبعاد الأغلبية، وهو تحول في المشهد فرض نفسه على الخطاب الأمريكي، الذي تغير متحدثا للمرة الأولى عن التغيير وعن رحيل مبارك، عبر تصريحات لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، قالت فيها إن الولايات المتحدة تسعى إلى فترة انتقالية منظمة في مصر، ينتج عنها إصلاحات ديمقراطية، مع الإشارة إلى أن “رحيل مبارك يحدده الشعب وحده”. كان خطابا لا يخلو من تحفظ، بإشارته الواضحة إلى “عدم زعزعة استقرار البلاد” وإبقاء الباب مواربا أمام رحيل مبارك، لكنها كانت المرة الأولى التي تضع فيها واشنطن مصير مبارك على محك الشعب، والتي تتحدث فيها عن “انتقال” سمته “ديمقراطيا” وكان واضحا أنها تضحى برجلها لإنقاذ نظامها، عبر إعادة تثبيت ركنه الثالث المختل، ساعية إلى إعادة استبعاد الأغلبية، في إطار مناورة من الوعود والعبارات الغامضة، التي تنذر مبارك وفي الوقت نفسه تبقي المجال مفتوحا أمامه لمحاولة أخيرة، قام بها فعلا في “أربعاء الجمل” 2 من فبراير/شباط 2011.
ولما كانت الشرطة وقوات الأمن “مرفوعة من الخدمة” والجيش يكتفي بالمناورة عن بعد، فإن مبارك لم يجد أمامه من يتورط في الاشتباك المباشر مع المتظاهرين إلا “الطفيليين” بأموالهم وبلطجيتهم وحيواناتهم، ومر الجميع في حماية قوات “الحرس الجمهوري” وآليات عسكرية تابعة لأسلحة أخرى، عدة كيلومترات، من “الهرم” إلى “ميدان التحرير” للقيام بهجوم هو أول اختبار للأغلبية التي أصبحت في صدارة المشهد الثوري، وقد أدى فشل هذا الهجوم إلى صدور الحكم أمريكيا على مبارك بالإقصاء، وإن انقسمت الإدارة بين من يرى التنحي تماما، ومن يكتفي بنقل صلاحيات الرئيس للنائب “عمر سليمان” لحين إجراء انتخابات رئاسية. وحين تلكأ مبارك في إعلان حسم أمره خرج أوباما بعد يومين بتصريحه الحاسم الذي قال فيه لمبارك “الآن يعني الآن” وبدا واضحا أنه يحزم حقائبه، وأن الأقليات حسمت أمرها بالدفاع عن “دولة الجنرال” والحفاظ عليها من السقوط في يد “الأغلبية” بعد إقصاء مبارك، كما بدا الخلل واضحا في مركز قيادة الجنرال، متمثلا في “حرب نجوم” أسفرت عن حرق أبرز قيادتين عسكريتين، تمهيدا للمجهول القادم.
القيادة الأولى: أحمد شفيق، وقد تحول من الوريث المحتمل، الذي يحل ثانيا بعد “جمال مبارك”، إلى رئيس وزراء أيام السقوط، والرجل الذي اعتبر رمزا لعهد بائد، مع أنه لم يشهد منه إلا إبادته.
القيادة الثانية: عمر سليمان، الذي “طيره” منصبه إلى أعلى، ليصبح “النائب الذي فقد ظله” إذ فقد مصدر قوته بمغادرة الموقع العسكري. وهو نفسه “عمر سليمان” الذي خاض مع ممثلي “الأقليات المتساندة” في 6 من فبراير/شباط 2011 مفاوضات لصالح بقاء مبارك ولو بعض الوقت، أدى تسريب العسكر لها إلى شيطنته (وهو الهدف الأول للتسريب) وفضحهم (وهو مكسب لا بأس به). كما أنه أصبح “اللحاد” الذي أعلن خبر تنحي مبارك لصالح المجلس العسكري في 11 من فبراير/شباط 2011، ليلقي بنفسه خارج التاريخ، من جهة لأن “اللحاد” لا يحبه أحد، فضلا عن أن إعلان التنحي كان إعلانا عن فشل جهوده في إبقاء مبارك. ومن جهة أخرى لأنه ـ بنفسه ـ من وضع “المجلس العسكري” في واجهة الثورة، بإعلان تسليمه السلطة، وكان المجلس مجمعا على استبعاده، الذي بدأ فعلا بمغادرته منصب نائب الرئيس، مع الرئيس الذي “تخلى” عن منصبه. كان عمر سليمان يغادر منصب نائب الرئيس في اللحظة نفسها التي شوهد فيها على شاشة التلفزيون وهو يلقي بيانه: “بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون: في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. والله الموفق والمستعان” (2 ).
1 “العالم الثالث هو أكبر متحف عالمي للحفريات السياسية ومخلفات الطغيان والاستبداد الشرقي القديم والرجعيات البدوية البدائية العتيقة المتحجرة، فضلا عن أنه غدا أبشع معقل للديكتاتوريات العسكرية والفاشية اللاشرعية الاغتصابية الفاسدة نصف المتعلمة أو نصف الجاهلة. وكأنما قد حكم عليه بأن يستبدل بالاحتلال العسكري الأجنبي القديم أيام الاستعمار، الاحتلال العسكري الداخلي الجديد تحت الاستقلال، هذا استعمار خارجي وهذا “استعمار داخلي”، أنظر: د. جمال حمدان ـ استراتيجية الاستعمار والتحرير ـ دار الشروق ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى 1983م.
2 الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات