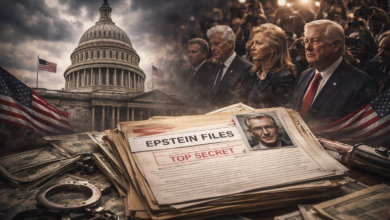نحن والعالم عدد 30 سبتمبر 2025

يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 19 سبتمبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2025.
تشهد الساحات الدولية والإقليمية تداخل أزمات عميقة. في الملف السوري يبرز خطاب الرئيس أحمد الشرع في الأمم المتحدة ودعوته لرفع العقوبات وإعادة تقديم بلاده كفرصة استقرار إقليمي، بالتوازي مع لقاءات رفيعة شملت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين يهود. وفي الجنوب السوري، برز اتفاق “خريطة الطريق” في السويداء وسط اتهامات لجهات إسرائيلية بتمويل وتسليح فصائل محلية.
على الجانب الأميركي، تكشف وثائق البنتاغون عن تخصيص مليارات لتعويض الأسلحة المستخدمة في العمليات المرتبطة بإسرائيل، فيما يواجه الاقتصاد عجزاً يقترب من تريليوني دولار، ويتنامى دور الملياردير ذي التوجه الصهيوني لاري إليسون في الاستحواذ والسيطرة على أهم وسائل الإعلام الأمريكية.
إيران بدورها عادت تحت العقوبات الأممية بعد تفعيل “آلية الزناد”، ما ضاعف عزلتها الاقتصادية في ظل استعدادات إقليمية لمواجهة عسكرية محتملة مع إسرائيل.
أما إقليمياً ودولياً، فقد انعكست التوترات على الخليج عبر تحالفات جديدة بين السعودية وباكستان، وعلى أوروبا التي تجد نفسها بين ضغوط واشنطن وطموحات موسكو، فيما تشهد المغرب احتجاجات شبابية عارمة، وتسجل أفريقيا احتجاجات ومشاريع تسلّح، والمزيد من التباعد عن فرنسا والتقارب مع روسيا، في مشهد يعكس اتساع رقعة الاضطراب العالمي.
سوريا
تشير التطورات الأخيرة حول سوريا إلى دخولها مرحلة مفصلية: ففي الأمم المتحدة قدّم الرئيس أحمد الشرع بلاده كفرصة جديدة للاستقرار بعد عقود من الأزمات، مطالباً برفع العقوبات ومؤكداً دعم غزة. اللقاءات الجانبية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، إضافةً إلى التواصل مع المؤتمر اليهودي العالمي، عكست انفتاح دمشق على مسارات غير مسبوقة تشمل حتى ملفات أمنية مع إسرائيل.
وفي موازاة ذلك استعادت سوريا علاقاتها مع أوكرانيا، فيما شهد الجنوب اتفاق “خريطة الطريق” في السويداء وسط اتهامات لإسرائيل بتمويل وتسليح ميليشيات درزية لإدامة الفوضى.
داخلياً، سعى الإخوان المسلمون لتثبيت حضورهم بدعم السلطة الجديدة، بينما طالت اتهامات التضليل الإعلامي زيارة الوفد السوري إلى نيويورك. وعلى الصعيد الدولي، داهمت الشرطة الفرنسية منظمة “إس أو إس – مسيحيو الشرق” بتهم التواطؤ مع جرائم حرب في سوريا. هذه اللوحة المتشابكة توضح أن سوريا تحاول الانتقال من كونها مصدر أزمات إلى ساحة صفقات إقليمية ودولية دقيقة.
الشرع: سوريا انتقلت من تصدير الأزمات إلى فرصة لإحلال الاستقرار
في أول كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قدّم الرئيس السوري أحمد الشرع رؤية بلاده للمرحلة الجديدة بعد سقوط النظام السابق، مؤكداً أن سوريا اليوم تعيد بناء نفسها كـ”دولة قانون تكفل حقوق الجميع وتصون الحريات”.
إدانة النظام السابق
الشرع وصف النظام الذي حكم سوريا لعقود بأنه مسؤول عن “قتل نحو مليون إنسان وتهجير 14 مليون وتدمير مليوني منزل”، إضافة إلى “أكثر من مئتي هجوم كيميائي موثق”. وأكد أن إسقاط هذا النظام كان “معركة انتصر فيها الشعب للمظلومين والمعذبين”، وأنها مهدت لعودة اللاجئين ولإنهاء تجارة المخدرات التي كانت تعبر من سوريا إلى دول أخرى.
مواجهة مشاريع التقسيم
الرئيس السوري شدد على أن التكاتف الشعبي بعد إسقاط النظام أفشل محاولات إثارة النعرات الطائفية وإعادة البلاد إلى مربع الحرب الأهلية، متعهداً بتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة.
الموقف من إسرائيل
في كلمته، حذر الشرع من “التهديدات الإسرائيلية ومحاولاتها استغلال المرحلة الانتقالية”، داعياً المجتمع الدولي إلى احترام سيادة سوريا والوقوف إلى جانبها، مؤكداً التزام دمشق باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
إعادة بناء الدولة
أوضح الشرع أن سوريا وضعت منذ سقوط النظام السابق سياسة جديدة ترتكز على:
- الدبلوماسية المتوازنة.
- الاستقرار الأمني مع حصر السلاح بيد الدولة.
- التنمية الاقتصادية وإطلاق الانتخابات التشريعية.
كما أشار إلى استعادة العلاقات الدولية وتوسيع الشراكات، مطالباً برفع العقوبات بشكل كامل لأنها “تُكبّل الشعب السوري وتصادر حريته”.
التضامن مع غزة
الشرع خصص جزءاً من خطابه للتعبير عن دعم سوريا لأهالي غزة، قائلاً: “نحن من أكثر الشعوب التي تشعر بحجم المعاناة، ولا نتمنى الألم الذي عايشناه لأي شعب آخر”. وطالب بوقف الحرب فوراً.
الرسالة الختامية
أكد الرئيس السوري أن “الحكاية السورية لم تنته بعد”، بل بدأت كتابة فصل جديد عنوانه السلام، الازدهار، والتنمية، محاولاً تقديم بلاده كفرصة للاستقرار الإقليمي بعد أن كانت لعقود عنواناً للأزمات.
ماذا تضمن اللقاء “الودي” بين الشرع وترامب؟
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على هامش زيارة أجراها الشرع، إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80.
وجرى لقاء الشرع وترامب، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس الأمريكي على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور عقيلته ميلانيا ترامب، وفقاً لما نقلته الرئاسة السورية، الخميس 25 من أيلول/سبتمبر.
ونشرت الرئاسة صوراً للشرع وهو يصافح ترامب، بحضور ميلانيا ترامب، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.
وهذا الاجتماع الثاني بين الشرع وترامب، بعد لقائهما في العاصمة السعودية الرياض في أيار الماضي.
مدير الشؤون الأمريكية، في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، قال في تصريحات لـ“التلفزيون العربي”، إن اللقاء بين الشرع وترامب كان ودياً وبحث العلاقة بين البلدين، ورفع العقوبات.
وأشار إدلبي، إلى أن الشرع وترامب، اتفقا على عقد لقاء قريب آخر في واشنطن.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال خلال اجتماع مع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية مساء الأربعاء 24 من أيلول، إن “الرئيس السوري أحمد الشرع تعهد بالتزامه بالعمل مع الشركاء الدوليين”.
وأضاف روبيو: إن “هناك فرصاً فريدة ومثيرة نعمل عليها معاً، إحداها مستقبل سوريا، وهي فرصة ربما قبل عامين أو عام ونصف كانت غير قابلة للتصور”.
ولا يزال الرئيس دونالد ترامب ملتزماً، ليس فقط من منظور أحادي للولايات المتحدة، بل بالشراكة مع العديد من الدول، بمنح سوريا كل فرصة ممكنة لبناء دولة قوية وموحدة تُحترم فيها تنوعات المجتمع السوري، وتكون أيضاً مكاناً مستقراً، وفق وزير الخارجية الأمريكي.
وأشار روبيو، إلى أن سوريا لم تعد قاعدة لعمليات المتطرفين أو الجهات الأجنبية التي تستخدمها لشن هجمات وممارسة أنشطة مزعزعة للاستقرار ضد جيرانها”.
واعتبر روبيو أن استقرار سوريا يحدد، بطرق عديدة، استقرار المنطقة بأسرها، مضيفاً أن “الرئيس ترامب اتخذ خطوة جريئة جداً في أيار الماضي، ونحن نواصل متابعة ذلك والعمل عليه”.
رفع العقوبات
تصدر موضوع رفع العقوبات المفروضة على سوريا، محاور اللقاءات التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال زيارتهما إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ 80.
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع قد طالب برفع العقوبات، خلال خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
والتقى الشرع، وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، حيث جرى بحث “الجهود المتواصلة” لتحقيق الأمن والازدهار لجميع السوريين.
وقال روبيو في تغريدة على منصة، “إكس” في 22 أيلول/سبتمبر، إنه ناقش مع الرئيس السوري، ”أهدافنا المشتركة في سوريا مستقرة وذات سيادة”.
كما ناقش الشرع وروبيو، تنفيذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه روبيو بـ “التاريخي” بشأن “تخفيف العقوبات”، وكذلك “أهمية العلاقات الإسرائيلية السورية”، على حد تعبيره.
الخارجية الأمريكية، قالت في بيان، نشرته على منصة “إكس” ، أنه خلال الاجتماع أكد وزير الخارجية الأمريكية، على فرصة “بناء دولة مستقرة وذات سيادة” في سوريا بعد إعلان ترامب عن تخفيف العقوبات، لكنه لم يتطرق إلى العقوبات المتبقية.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، في البيان “ناقش (الشرع وروبيو) جهود مكافحة الإرهاب الجارية، والجهود المبذولة للعثور على الأمريكيين المفقودين، ومدى أهمية العلاقات الإسرائيلية السورية في تحقيق قدر أكبر من الأمن الإقليمي”.
الرئيس السوري الشرع يلتقي رئيس المؤتمر اليهودي العالمي في نيويورك
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، برونالد لاودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ولاودر من أصول سورية، وقد لعب أدواراً في مسارات التفاوض السورية – الإسرائيلية منذ تسعينيات القرن الماضي. وأوضح التقرير أن اللقاء تطرق إلى مساعي دبلوماسية حديثة بين دمشق وتل أبيب، في ظل محادثات أمنية متواصلة بين الجانبين.
لا صحة لرفع العقوبات الأمريكية عن رامي مخلوف وشخصيات من النظام السوري
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات تزعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قراراً يقضي برفع العقوبات عن شخصيات بارزة من النظام السوري السابق، من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف وعدد من أقربائه، إضافة إلى بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية. وقد أرفقت تلك المزاعم بصور قوائم تحمل أسماء بالعربية والإنكليزية، قيل إنها توثّق قرار رفع العقوبات.
لكن التحقق الذي أجراه فريق منصة “تأكد” أظهر أن هذه المعلومات مضللة. فبالعودة إلى موقع وزارة الخزانة الأمريكية، تبيّن أن جميع الأسماء المذكورة، وفي مقدمتها رامي مخلوف، ما زالت مدرجة على قائمة العقوبات الخاصة SDN List الأشخاص المحددين بشكل خاص والمحظورين.
أما بشأن القرار التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 حزيران/يونيو 2025، فقد تبيّن أنه لم يتضمن أي رفع للعقوبات عن شخصيات أو كيانات مرتبطة بالنظام السوري. بل اقتصر على إلغاء بعض الأوامر التنفيذية العامة التي شكّلت أساس برنامج العقوبات الشامل، مع الإبقاء على الإجراءات المستهدفة ضد بشار الأسد ودائرته المقربة، بمن فيهم مخلوف، والأجهزة الأمنية، والمتورطون في انتهاكات حقوق الإنسان أو دعم الإرهاب، وفق ما ورد في الموقع الرسمي للبيت الأبيض ووزارة الخزانة.
أوكرانيا تعلن استعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده استعادت رسمياً علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، وذلك عقب لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
زيلينسكي وصف الخطوة بأنها “مهمة” مؤكداً في منشور على تطبيق تليغرام استعداد أوكرانيا لدعم الشعب السوري في مسيرته نحو الاستقرار، مضيفاً في خطابه أمام الجمعية العامة أن سوريا “تستحق دعماً دولياً أقوى”.
يأتي هذا الإعلان بعد جهود دبلوماسية بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أرسل زيلينسكي وزير خارجيته أندريه سيبيغا إلى دمشق للقاء القيادة الجديدة، حيث طالب بإنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا، وتعهد في المقابل بتقديم شحنات من المساعدات الغذائية. وقد عبّرت دمشق في حينه عن رغبتها في بناء علاقات وثيقة مع كييف.
وكانت العلاقات بين الجانبين قد قُطعت عام 2022 بعدما اعترفت حكومة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بالمناطق الأوكرانية التي احتلتها روسيا بوصفها “مستقلة”، وهو ما دفع كييف إلى تجميد العلاقات. لكن مع الإطاحة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأت أوكرانيا بإعادة فتح قنوات التواصل مع السلطات السورية الجديدة.
وفي المقابل، تحاول روسيا الحفاظ على نفوذها في سوريا بعد سقوط الأسد، إذ منحت الرئيس المخلوع حق اللجوء على أراضيها، وأرسلت في وقت سابق من الشهر الجاري وفداً رفيع المستوى برئاسة مسؤول بارز في قطاع الطاقة إلى دمشق في مسعى لتعزيز العلاقات مع الحكومة الجديدة.
اتفاق “خريطة الطريق” في السويداء: تسوية داخلية بإشراف خارجي
في تطور لافت يعكس حجم التعقيدات التي تشهدها محافظة السويداء جنوب سوريا، أعلنت دمشق في 17 أيلول/سبتمبر 2025 التوصل إلى اتفاق سياسي – أمني برعاية أميركية وأردنية، أُطلق عليه اسم “خريطة طريق لحلّ أزمة السويداء”. ويأتي هذا الاتفاق استكمالاً لاجتماعات عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهري تموز وآب الماضيين، بعد أسابيع من التصعيد الدامي الذي شهدته المحافظة ذات الغالبية الدرزية، والذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتهجير آلاف السكان من العشائر البدوية، في ظل فراغ أمني وتدخل إسرائيلي مباشر.
أحداث العنف التي اندلعت في الفترة ما بين 13 و18 تموز، على خلفية اشتباكات طائفية وعمليات انتقام متبادلة بين ميليشيات محلية وقوات أمنية وعشائرية، فتحت الباب أمام تدخلات إقليمية غير مسبوقة، أبرزها من إسرائيل التي نفّذت غارات جوية على مواقع حكومية سورية في دمشق والسويداء بذريعة “حماية المدنيين الدروز”، وهو ما أدى إلى انسحاب الجيش السوري من بعض النقاط، ودخول المحافظة في حالة من شبه الانفصال عن سلطة الدولة المركزية.
الاتفاق الجديد ينصّ على إعادة إدماج السويداء ضمن الإطار الوطني السوري، دون المساس بوحدة الأراضي أو السماح بأي نزعات انفصالية. ووفق ما أعلنته وزارة الخارجية السورية، فإن خريطة الطريق تشمل انسحاب القوات العسكرية من داخل المحافظة، مع الإبقاء على حضور رمزي للدولة من خلال وزارة الداخلية، وتشكيل شرطة محلية بقيادة شخصيات من أبناء المنطقة، إلى جانب نشر قوات لحماية الطريق الحيوي بين دمشق والسويداء. وقد تم تعيين سليمان عبد الباقي، القائد السابق لتجمع “أحرار جبل العرب”، مديراً عاماً لأمن السويداء، بينما يجري التفاوض على بقية التعيينات ضمن هيكلية أمنية جديدة.
سياسياً وإدارياً، تنص الاتفاقية على تشكيل مجلس محلي يضم جميع مكونات المجتمع، ويُمنح صلاحيات خدمية ومدنية موسعة، بينما تبقى الملفات السيادية، كالأمن والقضاء والسياسة، بيد الحكومة المركزية في دمشق. ويُعد هذا الشكل أقرب إلى نموذج اللامركزية الإدارية الموسعة، مع رفض صريح لأي صيغة حكم ذاتي. ومع ذلك، أثار الاتفاق جدلاً داخل السويداء، إذ أطلقت مجموعات محلية حملة توقيعات للمطالبة بحق تقرير المصير، ونُظمت مظاهرات تطالب باستقلالية أكبر عن الحكومة السورية.
في الشق الإنساني، تتضمن الاتفاقية التزاماً من الحكومة السورية، بالتعاون مع الأردن والولايات المتحدة، بإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المناطق المتضررة، وإعادة إعمار القرى، وضمان عودة النازحين بعد ضبط الأوضاع الأمنية. كما أكدت على إطلاق سراح المحتجزين، وتسريع عمليات تبادل الأسرى، بإشراف الصليب الأحمر، مع إنشاء لجنة ثلاثية لمراقبة تنفيذ الاتفاق، وغرفة عمليات مشتركة لتنسيق الخطوات التنفيذية.
وعلى الرغم من تأكيد الاتفاق على احترام السيادة السورية، فإن بنوداً عديدة منه منحت دوراً مؤثراً للأطراف الخارجية، لا سيما الأردن الذي سيتولى دعوة ممثلين محليين من الطوائف المختلفة لعقد لقاءات مصالحة، والولايات المتحدة التي ستجري مباحثات أمنية مع إسرائيل حول مستقبل الجنوب السوري، بمشاورة دمشق. هذا البند تحديداً أثار تساؤلات حول مدى فعالية الدولة السورية في فرض رؤيتها الأمنية، ومدى تحوّل الولايات المتحدة إلى الوصي الفعلي على الملف السوري الجنوبي، بعد انسحاب روسيا من المشهد.
الاتفاق تضمن كذلك بنداً غير مسبوق يقضي بدعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا لإجراء تحقيق في الأحداث، وهو مطلب لطالما رفعته قوى محلية، ويُعتقد أن دمشق قبلت به تحت الضغط، خصوصاً في ظل توثيق انتهاكات ارتكبتها القوات النظامية وميليشيات حليفة.
في خلفية هذا المشهد، تسعى كل من دمشق، وعمّان، وواشنطن لتحقيق أهداف خاصة بها. فالحكومة السورية تأمل أن يكون الاتفاق نموذجاً يمكن تعميمه في مناطق أخرى كشرق الفرات، وتحاول من خلاله استعادة الشرعية والحد من الدعوات الانفصالية.
أما الأردن، فيسعى لاحتواء تداعيات الأزمة على أمنه الداخلي، ومنع تمدد الجماعات المتطرفة أو تصاعد تهريب المخدرات على حدوده. في المقابل، ترغب الولايات المتحدة في تحقيق استقرار منخفض التكلفة جنوب سوريا، يضمن أمن إسرائيل ويمنع خصومها، كإيران وتنظيم داعش، من استغلال الفوضى.
رغم أن إسرائيل ليست طرفاً موقّعاً على الاتفاق، فإنها كانت حاضرة في خلفية كل ما جرى. فمنذ وقف إطلاق النار الذي تم في 19 تموز بوساطة أميركية، شاركت تل أبيب في لقاءات غير معلنة، شملت جولات في باريس بين ممثلين إسرائيليين وسوريين بإشراف أميركي، ناقشت ترتيبات أمنية مستقبلية للجنوب السوري. ومع ذلك، أبدت إسرائيل تحفظها على بنود إعادة تموضع الحكومة السورية في السويداء، وهو ما يتعارض مع استراتيجيتها القائمة على إبقاء الجنوب هشاً وضعيف السيطرة.
الاتفاقية لا تزال تواجه تحديات كبيرة على الأرض؛ منها رفض بعض القوى المحلية لها، وغموض بعض بنودها التي تجمع بين دمج المحافظة في الدولة وبين منحها صلاحيات واسعة، فضلاً عن نشاط شبكات تهريب السلاح والمخدرات التي تخشى من انضباط الأوضاع، واستمرار الانقسام السياسي داخل السويداء حول من يملك شرعية التمثيل، خصوصاً في ظل تصاعد نفوذ تيار الشيخ حكمت الهجري، وتراجع دور شيخي العقل الآخرين.
في المجمل، تمثل خريطة الطريق خطوة أولى نحو تهدئة الجنوب السوري، لكنها لا تخلو من الألغام السياسية والميدانية. وهي في جوهرها تعبير عن مقاربة “الإدارة المشتركة” بين أطراف دولية فاعلة، أكثر منها حلاً وطنياً خالصاً لأزمة داخلية. وبذلك، يبقى مصير السويداء مرهوناً بتوازنات إقليمية هشّة، ومشروطاً بإرادة دولية، أكثر من كونه نتيجة توافق داخلي سوري شامل. (المركز العربي للأبحاث والدراسات) (انظر أيضاً إلى نص خارطة الطريق)
إسرائيل تسلّح وتموّل ميليشيات درزية في السويداء.. ودمشق تتهمها بصناعة الفوضى
كشفت وكالة رويترز، نقلاً عن قادة دروز بارزين ومصدر استخباراتي غربي، أن إسرائيل تقوم بتزويد ميليشيات درزية في محافظة السويداء السورية بالأسلحة والذخيرة، بل وتدفع رواتب آلاف المقاتلين منهم، في خطوة اعتبرتها دمشق محاولة ممنهجة لجرّ الجنوب السوري إلى حالة من الفوضى الدائمة.
ووفق التقرير، فإن قائدي ميليشيات درزية ــ طلبا عدم الكشف عن هويتهما ــ أكدا أن إسرائيل زوّدت الفصائل المتفرقة بإمدادات عسكرية ساعدت على توحيدها. كما أفاد المصدر الاستخباراتي الغربي بأن تل أبيب تدفع رواتب لعدد كبير من المقاتلين، يُقدَّر بحوالي 3 آلاف عنصر. غير أن رويترز أوضحت أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات، بينما امتنعت مكاتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر عن التعليق.
استغلال هشاشة الوضع السوري
تزامنت هذه الاتهامات مع مرحلة حرجة تعيشها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وصعود إدارة الرئيس أحمد الشرع، التي تسعى إلى تثبيت الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة. إلا أن دمشق تتهم إسرائيل باستغلال توترات السويداء لتعطيل جهود المصالحة، لاسيما مع تكثيفها الغارات الجوية على المحافظة خلال الأشهر الماضية.
ففي يوليو/تموز، استهدفت المقاتلات الإسرائيلية مواقع جنوب سوريا بينها مناطق قريبة من القصر الرئاسي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات. وبينما تبرر تل أبيب تدخلها بأنه لحماية الطائفة الدرزية ــ المنتشرة أيضاً داخل إسرائيل ــ فإن الحكومة السورية وصفت هذه الضربات بأنها “عدوان غادر” وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
الانقسام داخل الطائفة الدرزية
داخل السويداء نفسها، تعقّد المشهد أكثر؛ فزعماء روحيون دروز دعوا الفصائل المسلحة إلى تسليم السلاح والتعاون مع قوات الأمن الحكومية، بينما حذّر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط من محاولات إسرائيل “التلاعب بالطائفة تحت ستار الحماية”.
وكان وقف إطلاق النار الذي أُبرم في يوليو/تموز بين الميليشيات الدرزية ومجموعات قبلية بدوية قد شكّل لحظة نادرة تخلّت فيها دمشق عن مسؤولية الأمن لصالح الفاعلين المحليين. لكن بعد ساعات فقط، جاءت الغارات الإسرائيلية لتقوض الهدنة وتعمّق الشكوك بشأن نواياها.
توسع ميداني إسرائيلي
التقرير أشار أيضاً إلى أن إسرائيل لم تكتف بالغارات الجوية، بل وسّعت وجودها البري في الجنوب السوري، حيث أنشأت ما لا يقل عن عشر قواعد عسكرية جديدة في محافظتي القنيطرة ودرعا، في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974. معظم هذه القواعد تقع على تلال استراتيجية ومفترقات طرق رئيسية، ما تسبب بتهجير جماعي للمدنيين.
دمشق: مشروع “فوضى لا تنتهي”
في ضوء هذه التطورات، ترى الحكومة السورية أن الهدف الإسرائيلي بات مكشوفاً: تحويل جنوب سوريا إلى “ساحة فوضى لا تنتهي”، وفق تعبير الرئيس أحمد الشرع، بهدف إضعاف الدولة ومنعها من استعادة استقرارها.
الشيباني: سوريا لا تمثل تهديدا لأحد بما في ذلك إسرائيل
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية “تجعل أي مسار للتطبيع صعبا”، وذلك في ظل محادثات جارية منذ أسابيع للتوصل لاتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب.
وأضاف الشيباني لشبكة سي إن إن الأميركية أن” إسرائيل تقابل سعينا للسلام بالغارات والتهديدات”.
وأشار وزير الخارجية السوري أن “إسرائيل تعرقل بناء الدولة السورية وتؤجج العنف الطائفي”، مؤكدا أن “سوريا لا تمثل تهديدا لأحد في المنطقة بما في ذلك إسرائيل”.
وقال الشيباني إن “إسرائيل دعمت خارجين على القانون” في سوريا، و”هذا منعنا من حل المشكلة بين البدو والدروز” في إشارة إلى الاشتباكات التي وقعت قبل أشهر في محافظة السويداء وتدخلت تل أبيب لدعم الدروز.
وأضاف أن ما فعلته إسرائيل “لم يزد الأمور إلا تعقيدا وجعل الدروز في وضع صعب ومحرج للغاية”، مشيرا إلى أن إسرائيل “عرقلت جهودنا عندما واجهنا تصاعدا في العنف الطائفي جنوبي البلاد”.
وقال الشيباني إن الضربات الإسرائيلية على سوريا بعد سقوط نظام الأسد “كانت صادمة بالنسبة لنا”، مؤكدا أن “سوريا قوية وموحدة ستكون مفيدة للأمن الإقليمي وهذا سيفيد إسرائيل”.
وأشاد وزير الخارجية السوري “بموقف واشنطن إزاء دمشق منذ يوم التحرير”، واعتبره “إيجابيا للغاية ونال رضى واسعا من السوريين”.
ونقلت رويترز قبل يومين عن 4 مصادر لم تسمّها، أن جهود التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل تعثرت في اللحظات الأخيرة، بسبب مطلب إسرائيل السماح لها بفتح “ممر إنساني” إلى محافظة السويداء بجنوب سوريا، وهو ما رفضته دمشق لكونها تعتبره انتهاكا لسيادتها. (الجزيرة نت)
زيارة الوفد السوري إلى نيويورك.. 3 ادعاءات خاطئة أثارت الجدل
تحولت مشاركة الوفد السوري برئاسة الرئيس أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إلى مادة للجدل الرقمي، بعدما رافقتها موجة من الصور والمقاطع المضللة التي انتشرت على نطاق واسع عبر المنصات الاجتماعية.
1. حضور خطاب نتنياهو
أكثر الادعاءات انتشاراً كانت صورة قيل إنها توثق وجود الوفد السوري خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعة الأمم المتحدة.
لكن التدقيق أظهر أن الصورة تعود لمشاركة الوفد في مؤتمر “حل الدولتين” بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول، وقد نُشرت حينها عبر الحساب الرسمي للرئاسة السورية، بينما أُلقي خطاب نتنياهو بعد مغادرة الوفد نيويورك. (انظر)
2. مواجهة مع سيدة أميركية
ادعاء آخر تداول مقطع فيديو زُعم أنه يوثق مواجهة مباشرة بين سيدة أميركية والرئيس السوري داخل قاعة الأمم المتحدة.
غير أن المقطع يعود فعلياً إلى فعالية للمجلس الأطلسي في واشنطن عام 2024، ويظهر فيه احتجاج الأميركية إيما تسوركوف على خطاب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن شقيقتها المختطفة، لا علاقة له بالوفد السوري.
3. صورة “الرأسيْن المقطوعيْن”
أما الادعاء الأخطر فجاء عبر المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية تكساس ألكسندر دنكان، الذي نشر صورة مركبة تربط بين الرئيس الشرع ومقاتل يحمل رأسين مقطوعين.
التحقق بالبحث العكسي أكد أن الصورة تعود لمقاتل أسترالي في صفوف تنظيم الدولة عام 2014، ولا علاقة لها بالشرع.
الزيارة التي تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ عقود إلى الجمعية العامة، لم تخلُ من الضجة، لكنّ أبرز ما طبعها هو حملة تضليلية مكثفة استُخدمت فيها صور ومقاطع قديمة أو مركبة لإثارة الجدل السياسي والإعلامي حول الوفد السوري في نيويورك.
مراقب “إخوان سوريا”: لا ضغوط رسمية لحل الجماعة.. ونقف إلى جانب السلطة الجديدة
في ظل النقاشات الدائرة حول مستقبل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا بعد التغيير السياسي الأخير، علّق الدكتور عامر البو سلامة، المراقب العام للجماعة، على الدعوات التي طُرحت بشأن حل التنظيم، مؤكداً أن ما جرى تداوله “لا يمثل موقفاً رسمياً للسلطة السورية الجديدة”، وإنما مجرد اجتهادات إعلامية وشخصية، في إشارة إلى تصريحات أحمد موفق زيدان، المستشار الإعلامي للرئيس أحمد الشرع.
لا ضغوط رسمية وحضور وطني
وقال البو سلامة، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إن الجماعة لم تتلق أي اتصالات أو ضغوط من جانب الحكومة الانتقالية بخصوص حل نفسها، موضحاً أن أي قرار من هذا النوع لو كان في مصلحة سوريا “لاتخذته الجماعة فوراً”. لكنه شدد على أن وجود الإخوان ما زال “ضرورة وطنية”، وأنهم يشكّلون إضافة للحالة السورية الجديدة بعد عقود من الصراع مع نظام الأسد الأب والابن.
وأشار إلى أن الجماعة حاضرة في المشهد السوري منذ ستينيات القرن الماضي، وقدمت تضحيات كبيرة في السجون والمنفى، ما يجعلها مكوناً لا يمكن تجاوزه في مرحلة الانتقال السياسي.
المرونة والقدرة على التطوير
ورداً على الانتقادات التي تصف الجماعة بأنها عبء على سوريا الجديدة، قال البو سلامة إن الإخوان يملكون من المرونة والديناميكية ما يمكنهم من التطور مع المرحلة، معتبراً أن الحديث عن شيخوخة قياداتهم “مضلل”، مستشهداً بفاعلية رموز تاريخية ما زالت حاضرة رغم تقدمها في العمر. وأكد انفتاح الجماعة على إعادة النظر في هياكلها وأسمائها إذا اقتضت الضرورة، لكنه رفض فكرة الحل الكامل، مشيراً إلى أن ما جرى في تونس والسودان “لم يكن حلاً حقيقياً، بل إعادة تموضع تحت مسميات جديدة”.
العلاقة مع السلطة الجديدة
وحول موقعهم من السلطة الحالية، أوضح المراقب العام أن الجماعة “مؤيدة وساندة للرئيس الشرع والإدارة الانتقالية”، وأنها لا تسعى إلى المعارضة أو التعطيل، بل لوضع خبراتها في خدمة الدولة. وأضاف: “نحن في خندق واحد مع القيادة الجديدة، نؤيدها وننصحها، وإذا وجدنا خللاً سنشير إليه بلغة النصح والود، لا بهدف الإضعاف”.
الموقف من السلاح والعمل المدني
وأكد البو سلامة أن الجماعة ترفض حمل السلاح خارج إطار الدولة، داعياً الكتائب السابقة إلى الاندماج في مؤسسات الجيش ووزارة الدفاع، بما يضمن وحدة القرار العسكري والأمني. كما شدد على أن عمل الإخوان لا يقتصر على السياسة، بل يمتد إلى التربية والتعليم والدعوة والخدمات الاجتماعية، وهي مجالات يرى أنها ستبقى رافداً للمجتمع السوري في المرحلة المقبلة.
واختتم البو سلامة تصريحاته بالتأكيد أن الإخوان المسلمين في سوريا جزء من النسيج الوطني، وسيواصلون عملهم في مختلف المجالات بالتوازي مع دعم السلطة الجديدة، مشدداً على أن وجودهم لا يتناقض مع بناء دولة وطنية جامعة، بل يعززها في مسيرتها نحو الاستقرار والانتقال السياسي.
الشرطة الفرنسية تداهم مقر منظمة بشبهة التواطؤ بجرائم في سوريا
داهمت الشرطة الفرنسية مقر منظمة “إس أو إس – مسيحيو الشرق”، في إطار تحقيقات تجري منذ نهاية العام 2020 بشأن التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت في سوريا.
وقالت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب اليوم السبت: “جرت عمليات دهم عديدة لمنظمات، من بينها منظمة “إس أو إس – مسيحيو الشرق”، ولشركات ومنازل أفراد، فضلا عن جلسات استماع متعددة لشهود أو متهمين”، مؤكدة معلومات كانت ذكرتها إذاعة “فرانس إنفو” العامة.
ويُجري التحقيق المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب “أو سي إل سي إتش” (OCLCH).
وأكد رئيس المنظمة التي أُنشئت عام 2013، شارل دو ميير، تنفيذ عمليات التفتيش التي طالت خصوصا جهاز الكومبيوتر الخاص به، مشيرا إلى أنّه تم استجوابه خلال جلسة استماع.
ووفق “فرانس إنفو”، فتش عناصر مكتب “أو سي إل سي إتش” مكاتب الجمعية في بولون بيانكور بالقرب من باريس على مدى 3 أيام.
وأشارت الإذاعة إلى أنّهم دهموا مكاتب المنظمة في باريس وفي “كوربفوا” إحدى ضواحيها، إضافة إلى شركتين تقعان في “إيل إي فيلان” في شمال غرب فرنسا ومقر في “إيسون” قرب باريس.
نهب وقصف
وذكر موقع “ميديابار” وإذاعة “فرانس إنفو” أنّ التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت المنظمة غير الحكومية دفعت جزءا من الأموال التي تجمعها لقوات الدفاع الوطني، وهي فصائل موالية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تتهمها منظمات غير حكومية سورية بنهب قرى وقصف مدنيين وتدريب أطفال للقتال في سوريا خلال سنوات الصراع.
ومع نشر “ميديابار” تحقيقه بداية العام 2022، نفت المنظمة “تورّطها في أي جريمة على الإطلاق”.
وتقول هذه المنظمة إنّها تساعد المسيحيين الذين وقعوا ضحايا الاضطهاد العنيف في المنطقة، وخصوصا على أيدي عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.
ولكن بعض المسؤولين فيها اتُهموا أحيانا بالتساهل حيال النظام السوري السابق.
أمريكا
تتصاعد التوترات من واشنطن إلى الشرق الأوسط وسط سباق على النفوذ والمال، حيث يكشف تخصيص البنتاغون 3.5 مليار دولار لتعويض أسلحته بعد العمليات الإسرائيلية عن ثمن باهظ للوجود الأميركي.
وفي الداخل، يتعمق الشرخ السياسي مع اغتيال تشارلي كيرك وما سبقه من ضغوط إسرائيلية على التيار المحافظ، بينما يواصل الملياردير لاري إيلسون بناء إمبراطورية إعلامية قد تعيد تشكيل السردية الأميركية بعد استحواذه على تيك توك.
على خط غزة، يقود توني بلير خطة مدعومة من ترامب لتأسيس سلطة انتقالية دولية تعيد رسم مستقبل القطاع. أما الرئيس الأميركي، فبينما يبالغ في إنجازاته على منبر الأمم المتحدة، يواجه اقتصاداً مثقلاً بعجز يقترب من تريليوني دولار وقرارات مثيرة للجدل تمتد من بورتلاند إلى قاعدة باغرام. أوروبا من جانبها تترقب، وقد وجدت نفسها بين فكي كماشة ترامب وبوتين في لعبة جيوسياسية جديدة.
البنتاغون يخصص أكثر من 3.5 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة بعد العمليات الإسرائيلية
في خطوة تكشف حجم التكلفة الاستراتيجية للحفاظ على وجود عسكري نشط في الشرق الأوسط، تخطط وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لإنفاق ما يزيد عن 3.5 مليار دولار لتعويض النقص في مخزون الأسلحة والأنظمة العسكرية، نتيجة العمليات المتكررة المرتبطة بإسرائيل، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ.
تفاصيل التمويل: صواريخ ورادارات وصيانة لوجستية
تُظهر وثائق الميزانية الأميركية التي جرى إعدادها حتى منتصف مايو أن هذه الأموال ستُستخدم لعدة أغراض، من بينها:
- إعادة تزويد الترسانة الأميركية بالصواريخ التي استُخدمت في التصدي لهجمات إيرانية.
- تخصيص أكثر من مليار دولار لصالح شركة “RTX Corp.” لإنتاج صواريخ اعتراضية.
- مهام دعم لوجستي تتضمن صيانة الرادارات، إعادة تأهيل السفن، ونقل الذخائر.
اللافت أن كل فقرة تقريباً في هذه الوثائق الموسومة بـ”طلبات طارئة” تُدرج تحت بند “تمويل طارئ”، ما يعكس الطابع الاستثنائي والمُلِح لهذه النفقات.
تشريع داعم: قانون المخصصات الإسرائيلية للعام 2024
تستند هذه التخصيصات إلى ما يُعرف باسم “قانون المخصصات التكميلية لأمن إسرائيل 2024″، والذي يشمل 14 مليار دولار، جزء منها مخصص لإعادة بناء مخزونات الأسلحة الأميركية، وتمويل المزيد من صواريخ الدفاع الإسرائيلي.
تربط الوثائق بين هذه النفقات وما يتكبده الجيش الأميركي من تكاليف ضمن قيادة “القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)” بسبب:
- التطورات “الطارئة” في إسرائيل.
- العمليات العسكرية الأميركية المنسقة مع إسرائيل، خصوصاً أثناء صدّ هجمات إيرانية أو من قبل وكلائها.
الرد على هجوم إيران في إبريل 2024
تشير الوثائق إلى الهجوم الإيراني في إبريل 2024، تضمن أكثر من:
- 110 صواريخ باليستية متوسطة المدى،
- 30 صاروخ كروز أرض-أرض،
- وأكثر من 150 طائرة مسيرة.
وقد استُخدمت العديد من الصواريخ الاعتراضية الأميركية لصد هذا الهجوم، مما أدى إلى نقص في المخزون يستوجب التعويض العاجل.
أبرز بنود الإنفاق: صواريخ SM-3 وTHAAD
أكبر بند منفرد في الطلبات كان تخصيص مليار دولار لإعادة شراء نماذج متعددة من صواريخ “ستاندارد SM-3” التي تنتجها شركة RTX، وتحديداً النسخة المطوّرة “SM-3 IB Threat Upgrade” المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية، والتي يتراوح سعر الصاروخ الواحد منها بين 9 و12 مليون دولار. وقد أُطلقت هذه الصواريخ من سفن تابعة للبحرية الأميركية خلال التصدي لهجمات إيران في إبريل.
كما طلب البنتاغون إنفاق 1.4 مليون دولار لتغطية تكاليف “رحلة تكليف خاصة” نُفذت لنقل هذه الصواريخ المنتجة حديثاً إلى وجهة لم يُفصح عنها.
الوجود العسكري في المتوسط: عمليات جوية وبرية مشتركة
في يونيو الماضي، شاركت مدمرتان أميركيتان مزودتان بنظام الدفاع الصاروخي “إيجيس” — وهما USS Arleigh Burke وUSS The Sullivans — في إطلاق صواريخ SM-3 دفاعاً عن إسرائيل. وقد انضمت إليهما وحدة برية من الجيش الأميركي كانت تطلق صواريخ THAAD لاعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية.
ثاني أكبر بند إنفاق كان مخصصاً لشراء المزيد من صواريخ THAAD الاعتراضية من شركة “لوكهيد مارتن”، بقيمة 204 مليون دولار، علماً أن تكلفة إنتاج كل صاروخ تقارب 12.7 مليون دولار.
صيانة غير مخططة لرادارات الدفاع
كذلك تضمنت الطلبات تخصيص 9.2 مليون دولار لصيانة مؤجلة لنظام الرادار القوي TPY-2 المستخدم في منظومة THAAD، وذلك بعد الحاجة غير المتوقعة لاستبدال ثماني محركات ومولدات كهربائية.
وقد سبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في أكتوبر الماضي نشر بطارية THAAD في إسرائيل، إلا أن الوثائق الجديدة تشير إلى “نشر غير مخطط له” للمنظومة في موقع جديد لم يُكشف عنه.
اجتماع غامض في هامبتونز سبق اغتيال تشارلي كيرك: تدخل من أكمان وضغوط إسرائيلية مكثفة
كشفت مصادر لموقع The Grayzone أن الملياردير الأمريكي المؤيد لإسرائيل، بيل أكمان، نظم في أغسطس 2025 اجتماعاً مغلقاً في هامبتونز مع مجموعة من المؤثرين المحافظين، على رأسهم تشارلي كيرك، مؤسس منظمة Turning Point USA.
الاجتماع، الذي وُصف بأنه أشبه بـ”تدخل عنيف”، شهد مواجهات حادة بين كيرك وأكمان بسبب انتقادات كيرك المتزايدة للنفوذ الإسرائيلي في السياسة الأمريكية. ووفقاً للمصادر، غادر كيرك الاجتماع وهو يشعر بأنه تعرض لـ “ابتزاز معنوي”، وبدأ بعدها حضور القداس الكاثوليكي بشكل منتظم في تحول ديني لافت.
مطالب وضغوط وتهديدات ضمنية
خلال اللقاء، قُدمت لكيرك قائمة مفصلة بـ “تجاوزاته” ضد إسرائيل، وطُلب منه سحب دعوة وجهها للمذيع تاكر كارلسون لحضور مؤتمر TPUSA. كما زُعم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض ضخ أموال هائلة في منظمته مقابل تغيير موقفه، لكن كيرك رفض العرض، وكذلك رفض دعوة لزيارة القدس قبل اغتياله بأسابيع.
أكمان نفى لاحقاً هذه المزاعم، وأكد في بيان أنه “لم يهدد أو يبتز أحداً”، لكنه امتنع عن تقديم توضيحات تفصيلية أو أدلة مباشرة تدحض ما ورد في التقرير.
بعد الاغتيال… إشادة علنية ومكافأة ضخمة
عقب مقتل كيرك في 10 سبتمبر، نشر أكمان تغريدة أشاد فيها بالراحل ووصفه بأنه “رجل عظيم”، ثم أعلن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على القاتل. وبحسب تقارير، قد تذهب الجائزة لوالد المشتبه به تايلر روبنسون الذي سلّمه للسلطات.
لقاء هامبتونز.. رموز مؤثرة ودعم حكومي إسرائيلي
ضم الاجتماع شخصيات بارزة في التيار المحافظ، بينها سيث ديلون (Babylon Bee)، وإميلي ويلسون (Emily Saves America)، وزافير دوروسو (PragerU)، بالإضافة إلى شخصيات مقربة من الحكومة الإسرائيلية. بعض المشاركين حصلوا لاحقاً على رحلات ممولة بالكامل إلى إسرائيل، حيث شاركوا في حملات دعائية على حدود غزة تنفي وقوع مجاعة، وهو ما أثار استنكاراً واسعاً.
انقسام داخل التيار المحافظ وتراجع في المسيحية الصهيونية
تشير تقارير The Grayzone إلى أن تصاعد التدخل الإسرائيلي في قرارات TPUSA أثار غضباً داخل القاعدة المسيحية المحافظة، ودفع كيرك نحو إعادة النظر في مواقفه العقائدية والسياسية، خاصة في ظل تحوّله الديني وتقربه من شخصيات محافظة مناوئة للتوجه الصهيوني.
لاري إليسون.. قطب إعلامي جديد يهيمن على تيك توك وCBS وCNN
في تحول لافت بمسيرته، لم يكتف مؤسس أوراكل الملياردير الشهير لاري إليسون بالشهرة كأحد أقدم رجال التكنولوجيا في وادي السيليكون، بل بات اليوم في طريقه ليصبح أحد أكبر أقطاب الإعلام في العالم.، طبقاً لتحقيق مطول نشرته صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية.
تحالف إعلامي ضخم على خطى روبرت مردوخ
إليسون، البالغ من العمر 81 عاماً، اليهودي المعروف عنه الدعم غير المحدود لإسرائيل، بدأ يعيد تشكيل المشهد الإعلامي الأميركي من خلال استثمارات ضخمة تشمل:
- تيك توك (النسخة الأميركية الجديدة)، بعد أن أُجبرت شركة ByteDance الصينية على بيع التطبيق لأسباب أمنية.
- صفقة ابنه ديفيد إليسون التي استحوذ بها على باراماونت وCBS مقابل 8 مليارات دولار.
- تحركات لشراء Warner، التي تشمل شبكة CNN.
- علاقات وثيقة مع الرئيس ترامب، الذي يدعم وجود إليسون ومردوخ في هذه الاستثمارات.
إمبراطورية إعلامية متشابكة
هذه الصفقات، غير المسبوقة من حيث الحجم والتأثير، تُظهر طموح إليسون لتوحيد النفوذ الإعلامي عبر منصات مختلفة – من شبكات الأخبار التقليدية إلى المنصات الشبابية مثل تيك توك. ويقول مراقبون إن هذه السيطرة المزدوجة على المحتوى الإخباري والترفيهي قد تعيد تشكيل السرد الإعلامي الأميركي بالكامل.
ثروة بلا حدود ونفوذ سياسي مباشر
ثروة إليسون تجاوزت 367 مليار دولار، بما يجعله رقم 2 على قائمة أغنياء العالم بعد إيلون ماسك، ويملك أكثر من 40% من أسهم أوراكل. وقد أتاح له تداخل أوراكل من الكثير من الشركات والمؤسسات الكبرى نفوذا وتأثيراً هائلاً حول العالم. علاقته الوطيدة مع ترامب تمنحه حرية حركة تنظيمية وسياسية، في وقتٍ كان فيه امتلاك CBS وCNN وتيك توك معاً أمراً مستحيلاً سابقاً.
طموحات خيرية متعثّرة
رغم وعوده ببناء إرث خيري من خلال معهد إليسون للتكنولوجيا في جامعة أوكسفورد، شهد المشروع خلافات داخلية واستقالات، كان آخرها العالم البارز جون بيل، الذي وصف المشروع بأنه “تحدٍ صعب”. وتُطرح تساؤلات حول مدى التزام إليسون بتمويل المؤسسة على المدى البعيد.
ملياردير واحد، عدة جبهات
ما بين السيطرة على الإعلام الأميركي التقليدي، والتمدد في منصات الجيل الجديد، ومشاريع البحث العلمي، يبدو أن إليسون لا يسعى فقط إلى المجد التكنولوجي، بل إلى ترك بصمة ثقافية وسياسية تتجاوز حدود وادي السيليكون.
تمويل لاري إيلسون يحوّل معهد توني بلير إلى ذراع تسويق وضغط لصالح “أوراكل”
كشفت تقارير صحفية استقصائية أن التمويل الضخم الذي قدمه الملياردير الأميركي لاري إيلسون، مؤسس شركة أوراكل، حوّل معهد توني بلير للتغيير العالمي (TBI) إلى منصة دولية تركّز على التكنولوجيا وتعمل، في جزء كبير منها، كقوة ضغط وترويج لحلول أوراكل حول العالم.
توسع المعهد بدعم مالي ضخم
منذ 2021 ضخ إيلسون نحو 130 مليون دولار في TBI، متبوعاً بتعهدات إضافية بقيمة 218 مليون دولار. هذا الدعم رفع عدد موظفي المعهد من نحو 200 إلى قرابة الألف، واستقطب أسماء بارزة من شركات استشارية مثل ماكينزي ومن عمالقة وادي السيليكون كـ ميتا. وبالمقابل ارتفعت رواتب كبار موظفيه إلى أكثر من مليون دولار سنوياً.
نفوذ مباشر على السياسات البريطانية
أصبح المعهد لاعباً مؤثراً في صياغة سياسات الحكومة البريطانية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فقد أظهرت وثائق رسمية أن مسؤولين من TBI شاركوا في اجتماعات دورية مع وزراء بريطانيين وجرى استدعاؤهم إلى مجموعات عمل حكومية، خصوصاً فيما يتعلق بخطط إصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).
ويدور الجدل الأكبر حول فكرة المكتبة الوطنية للبيانات (NDL)، التي تتضمن دمج بيانات الصحة البريطانية – وهي الأكثر شمولاً عالمياً منذ 1948 – بما يقدّر خبراء قيمته التجارية بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني سنوياً.
ترويج لأوراكل في الدول النامية
تحقيقات أجريت مع أكثر من 29 موظفاً حالياً وسابقاً في TBI أظهرت أن المعهد لا يكتفي بالعمل كمركز أبحاث، بل يقوم بدور مباشر في تسويق تقنيات أوراكل داخل دول في إفريقيا وآسيا. بعض الموظفين وصفوا العلاقة بين الجهتين بأنها “لا تنفصل”، حيث عُقدت لقاءات ومخيمات عمل مشتركة بين مسؤولي أوراكل والمعهد في لندن وتكساس وحتى في ممتلكات إيلسون الخاصة.
وقال موظفون سابقون إنهم اضطروا أحياناً للتوصية بحلول تقنية من أوراكل رغم معرفتهم بأنها غير مناسبة للواقع المحلي أو قد تسبب أضراراً مستقبلية، خاصة مع خطر “احتكار المورد” الذي يربط الحكومات بأنظمة مغلقة ومكلفة.
انتقادات داخلية وخارجية
خبراء التقنية حذروا من أن دور TBI يمهّد الطريق لخصخصة حساسة لبيانات الصحة البريطانية، ويجعل السياسات الوطنية أسيرة لرؤية شركات كبرى. واعتبر بعضهم أن المعهد لم يعد يطور حلولاً من داخل المؤسسات الوطنية، بل يدفع باتجاه الاعتماد على الشركات الحليفة.
وفي المقابل، يرى مؤيدو بلير أن إدخال الذكاء الاصطناعي والبيانات الموحدة يمكن أن يساهم في حل أزمة الإنتاجية في بريطانيا وتحقيق قفزة في الخدمات العامة، وهو خطاب تبنّته حكومة العمال بقيادة كير ستارمر بعد وصولها إلى السلطة.
خلاصة
تؤكد هذه المعلومات أن معهد توني بلير لم يعد مجرد مؤسسة فكرية بريطانية، بل أصبح شبكة دولية ذات نفوذ سياسي وتقني متنامٍ، مدفوعة بتمويل ملياردير أميركي يرى في بيانات الصحة البريطانية وقطاع التكنولوجيا العالمية فرصة استراتيجية هائلة.
تعليق المعهد المصري:
تؤشر المعلومات التي نشرتها المصادر الصحفية الاستقصائية المختلفة، إلى النفوذ الهائل لمجموعة من الشبكات المترابطة تشمل شركات كبرى ومليارديرات ذوي علاقات سياسية، تعمل جميعاً في خدمة الكيان الصهيوني، وتستخدم المال والعلاقات للسيطرة على عوالم السياسة والإعلام، وتستطيع توظيف كم هائل من المعلومات التي تمتلكها نظراً لطبيعة عملها (شركة أوراكل مثالاً).
في الحالة قيد الدراسة ظهرت العلاقة مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي يقوم مؤخراً بهندسة التصور الخاص بغزة ما بعد الحرب، بل إن المعلومات رشحت أن يكون هو شخصياً قائداً للمنظومة الدولية التي سيكون لها الوصاية على قطاع غزة طبقاً للمقترح المطروح، لفترة انتقالية قد تصل إلى خمس سنوات. من هنا يظهر كيف يوجه الكيان الصهيوني أدواته المتاحة لتحقيق أهدافه الإستراتيجية، ما يستلزم الانتباه ومن ثمّ التعامل الصحيح والسليم مع ما يفرضه ذلك من تحديات.
كشف النقاب عن مقترح توني بلير المدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
قالت أربعة مصادر مطلعة لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فوّض توني بلير بحشد الأطراف الإقليمية والدولية حول مقترحه لتأسيس هيئة انتقالية تتولى حكم قطاع غزة بعد الحرب، إلى أن يتم تسليمه للسلطة الفلسطينية.
بلير بدأ صياغة هذا المقترح في الأشهر الأولى من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، ورآه حينها خطة لمرحلة “اليوم التالي”. لكن خلال الأشهر الأخيرة تطورت الخطة لتصبح أيضاً أداة لإنهاء الحرب فعلياً، بعدما خلصت إدارة ترامب إلى أن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الأساسية حول الجهة التي ستخلف حماس في غزة أمر ضروري لضمان وقف دائم لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، بحسب مسؤول أميركي ومصدر ثانٍ مطلع.
ورغم أن انخراط بلير في التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة قد كُشف سابقاً، وكذلك مشاركته في جلسة سياسات بالبيت الأبيض يوم 27 أغسطس، فإن تفاصيل مقترحه لم تكن قد نُشرت قبل الآن.
ليس خطة للترحيل
المقترح – الذي حصلت تايمز أوف إسرائيل على مسودته المتقدمة والمصادق عليها – يتضمن تأسيس “السلطة الانتقالية الدولية لغزة” (GITA) مع سلسلة من الهياكل التابعة.
كانت تقارير سابقة قد ربطت بلير بمحاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة أو إنشاء ما يسمى “منتجع ترامب” في القطاع، لكن مقترحه الفعلي لا يذكر أياً من هذه الأفكار، بل يتضمن تأسيس وحدة لـ”حماية حقوق الملكية”، تهدف إلى ضمان أن أي مغادرة طوعية من سكان غزة لا تؤدي إلى فقدان حقهم في العودة أو ملكية ممتلكاتهم.
وقال مصدر مشارك في المناقشات حول خطة بلير:
“ليس لدينا خطة لنقل سكان غزة إلى خارجها. غزة هي لأهل غزة”.
خطط بديلة رفضها ترامب
قدمت أطراف مرتبطة بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وأفراد مشاركين في تأسيس “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF) فضلاً عن بعض أعضاء مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، خططاً للإدارة الأميركية تتضمن تشجيع أو تسهيل “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من غزة.
لكن ترامب – الذي منح في فبراير الماضي شرعية لفكرة “الهجرة الطوعية” حين أعلن خطته للسيطرة على غزة وترحيل سكانها بشكل دائم – ابتعد لاحقاً عن هذه الفكرة. وخلال جلسة 27 أغسطس بالبيت الأبيض، أكد أنه ماضٍ مع خطة بلير بدلاً منها، وفق ما قاله المسؤول الأميركي.
دور كوشنر
نُظمت جلسة 27 أغسطس بواسطة صهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي شغل منصب مستشار رفيع في ولايته الأولى ولا يزال منخرطاً في قضايا الشرق الأوسط في ولايته الثانية، حيث يقدم المشورة بشكل منتظم للمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.
هذا الربيع، كلّف كوشنر “معهد توني بلير للتغيير العالمي” (TBI) بإعداد خطة لمرحلة ما بعد الحرب، مستفيداً من علاقات بلير الوثيقة مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب.
السلطة الفلسطينية بين الرفض والتحفظ
التقى بلير الرئيس الفلسطيني محمود عباس في يوليو بضغط خليجي، وفق ما قال دبلوماسي عربي.
ورغم أن السلطة الفلسطينية ترغب في الإشراف المباشر على هيئة الحكم بعد الحرب، وهو ما لا يحققه مقترح بلير، فإن رام الله “تفاعلت بشكل بنّاء”، بحسب مصدر مطلع.
الخطة تتوقع إصلاحات كبيرة داخل السلطة الفلسطينية، وتحد من دورها في GITA إلى التنسيق فقط، لكنها تشير صراحة إلى أن الهدف النهائي هو “توحيد كل الأراضي الفلسطينية تحت مظلة السلطة الفلسطينية”.
الدور السعودي
خلال اجتماع البيت الأبيض، أبدى ترامب إعجابه بمبادرة بلير، وطلب منه إقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان – الذي يسميه ترامب “جوني” – بالانضمام. فواشنطن ترى السعودية لاعباً أساسياً في إعادة إعمار غزة.
غير أن جهود بلير تعثرت بسبب فرض الولايات المتحدة حظر تأشيرات على مسؤولين فلسطينيين كبار، وأيضاً بسبب الضربة الإسرائيلية في 9 سبتمبر ضد قادة من حماس في الدوحة، التي عطلت مساعيه مع قطر ومصر.
جوهر الخطة
المسودة المتقدمة للخطة تنص على:
- إنشاء GITA بقرار من مجلس الأمن الدولي.
- تكون GITA “السلطة السياسية والقانونية العليا لغزة خلال المرحلة الانتقالية”.
- يتألف مجلسها من 7–10 أعضاء، بينهم ممثل فلسطيني واحد على الأقل، مسؤول أممي رفيع، شخصيات دولية، وتمثيل قوي لأعضاء مسلمين لتعزيز الشرعية الإقليمية.
- يرأس المجلس شخصية يتم تعيينها بتوافق دولي وتأييد من مجلس الأمن.
- إنشاء “أمانة استراتيجية” تضم 25 موظفاً، ووحدة حماية خاصة من عناصر عربية ودولية لحماية القيادة.
- تحت GITA، تُنشأ “السلطة التنفيذية الفلسطينية” (PEA)، وهي لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين المستقلين تدير الوزارات (الصحة، التعليم، المالية، البنية التحتية، القضاء، الشؤون الاجتماعية).
كما تتضمن الخطة:
- قوة شرطة مدنية فلسطينية غير حزبية.
- قوة “الاستقرار الدولي” (ISF) متعددة الجنسيات لمنع عودة الجماعات المسلحة وضمان الأمن.
- هيئة لتنمية الاستثمار وإعادة الإعمار.
- وحدة لحماية حقوق الملكية.
إنهاء الحرب
تؤكد الخطة أن السبيل لإنهاء الحرب هو التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الإقليمية على مبادئ حكم غزة بعد الحرب، بحيث تُستبعد حماس ولا يُسمح لها بالعودة.
المصدر المطلع قال:
“لا يمكن أن تدير السلطة الفلسطينية غزة منذ اليوم الأول. ستكون شريكاً في التنسيق، لكن الإدارة الفعلية ستبدأ لاحقاً بعد إصلاحها”.
مكتب بلير رفض التعليق رسمياً على التقرير.
تدقيق حقائق: خطاب ترامب في الأمم المتحدة مليء بالمبالغات والمغالطات
في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر 2025، قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مزيجاً من التصريحات الحادة والمثيرة للجدل، تراوحت بين الاقتصاد والطاقة والمهاجرين والحروب. غير أن التدقيق في الحقائق كشف عن العديد من المبالغات أو المعلومات المضللة التي لا تدعمها البيانات المتاحة.
الحروب والسلام
ترامب قال إنه أنهى سبع حروب غير قابلة للانتهاء خلال سبعة أشهر. لكن الواقع مختلف: فقد ساهمت واشنطن في بعض اتفاقات تهدئة، مثل إعلان السلام بين أرمينيا وأذربيجان في أغسطس الماضي، وتفاهمات بين دول أخرى (كمبوديا – تايلاند، والهند – باكستان). غير أن هذه الخطوات ليست اتفاقيات سلام نهائية، وبعضها ما زال هشاً أو موضع خلاف.
كما ادعى ترامب أن القصف الأميركي دمّر بالكامل منشآت إيران النووية، لكن تقييمات مستقلة (بينها تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز) تقول إنه من المبكر الجزم بحجم الأضرار، وأنه من غير المرجح أن تكون المواقع قد “أُبيدت كلياً” كما وصف.
حرب أوكرانيا – روسيا
ترامب بالغ أيضاً في أرقام الضحايا، إذ قال إن الحرب تحصد ما بين 5 و7 آلاف قتيل أسبوعياً. الأرقام الموثوقة من مراكز أبحاث ودراسات CSIS والأمم المتحدة تشير إلى معدل أقل بكثير: نحو 1,800 وفاة أسبوعياً، بينما يصل الرقم إلى ما يزيد عن 8,000 فقط إذا احتُسبت الإصابات والجرحى أيضاً، وليس الوفيات وحدها.
الاقتصاد الأميركي
صوّر ترامب الاقتصاد على أنه الأقوى في العالم، قائلاً إنه استقطب استثمارات بقيمة 17 تريليون دولار منذ توليه الحكم. لكن خبراء الاقتصاد يرون أن الرقم مبالغ فيه، وأن كثيراً من هذه “التعهدات الاستثمارية” لم تتحول بعد إلى أموال فعلية. كما أن نمو الوظائف تباطأ مقارنة بعهد بايدن، بينما ظل التضخم عند 2.9%، وارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.7%.
أما بشأن الضرائب، فزعمه بأنه قدّم أكبر خفض ضريبي في تاريخ أميركا غير دقيق، إذ تشير المقارنات إلى أن القانون الجديد الذي أقرّه عام 2025 يأتي ثالثاً فقط ضمن أكبر التخفيضات منذ ثمانينيات القرن الماضي.
الطاقة وأسعار الكهرباء
ترامب انتقد الصين قائلاً إنها لا تعتمد على طاقة الرياح وتكتفي ببيع التوربينات، وهو ادعاء وصفه المدققون بأنه “خاطئ تماماً”، فالصين تمتلك 44% من قدرة العالم في طاقة الرياح، أي أكثر بثلاثة أضعاف من الولايات المتحدة.
كما زعم أن أسعار الكهرباء والبنزين في أميركا “انخفضت كثيراً”، لكن الأرقام الرسمية أظهرت العكس: الكهرباء ارتفعت 4.9% منذ توليه الحكم، والبنزين ظل شبه مستقر عند مستويات قريبة مما كانت عليه.
الهجرة والأطفال المهاجرون
من أكثر تصريحات ترامب إثارة للجدل قوله إن إدارة بايدن فقدت 300 ألف طفل مهاجر، بعضهم “مات أو اختفى”. لكن تقرير وزارة الأمن الداخلي أوضح أن نحو 32 ألف طفل لم يحضروا جلسات محاكم الهجرة بين 2018 و2023 (جزء منها خلال فترة رئاسة ترامب نفسه)، وهو ما يعرضهم لخطر الاستغلال، لكن لا دليل على أنهم “مفقودون أو قتلى” كما قال.
كذلك وصف تدفق المهاجرين بأنه يشمل “مجرمين ومرضى عقليين أُطلق سراحهم من السجون والمصحات”، وهو ادعاء بلا أي أساس موثق.
خطاب ترامب أمام الأمم المتحدة جاء مليئاً بالتصريحات المثيرة، لكنه لم يصمد أمام التدقيق. فقد ضخّم إنجازاته في إيقاف الحروب، وبالغ في نجاحاته الاقتصادية، وقدّم معلومات غير صحيحة عن الطاقة والهجرة. وبينما أراد إظهار قوته أمام خصومه، فإن الحقائق تكشف صورة أكثر تعقيداً وأقل بريقاً مما قدّمه من على منبر الأمم المتحدة.
ترامب يأمر بنشر قوات مسلحة في بورتلاند ويسمح لها باستخدام “القوة الكاملة” ضد المتظاهرين
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر قوات أمريكية في مدينة بورتلاند، بولاية أوريغون، وسمح لها باستخدام “القوة الكاملة” عند الحاجة، لقمع الاحتجاجات التي تستهدف مراكز احتجاز المهاجرين.
وقال ترامب إنه “وجّه وزير الحرب بيت هيجسيث، بتوفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند التي مزقتها الحرب”.
وزعم ترامب أن هذه الخطوة ستساعد في حماية “أي من مرافق دائرة الهجرة التي تحاصرها هجمات حركة (أنتيفا) وغيرها من الإرهابيين المحليين”.
وأضاف الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: “أُسمح أيضاً (لهذه القوات) باستخدام القوة الكاملة، عند الحاجة”.
وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة من المشرعين الديمقراطيين، الذين أكدوا عدم وجود حاجة لنشر قوات فيدرالية في المدينة.
يمثل إعلان ترامب توسعاً إضافياً في نشر القوات في المدن الأمريكية، التي جاءت في إطار حملة أوسع لإدارة ترامب على الهجرة غير الشرعية.
لم يحدد منشور ترامب ما إذا كان ينوي تفعيل عمل الحرس الوطني أو الجيش الأمريكي النظامي. كما لم يحدد في المنشور ما يقصده باستخدام “القوة الكاملة”.
وقال المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) شون بارنيل، لبي بي سي: “نحن على أهبة الاستعداد لتعبئة أفراد الجيش الأمريكي لدعم عمليات وزارة الأمن الداخلي في بورتلاند بتوجيه من الرئيس”.
ترامب يصنّف “أنتيفا” منظمة إرهابية محلية
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يصنّف بموجبه حركة “أنتيفا“، وهي مجموعات يسارية مناهضة للفاشية، “منظمة إرهابية محلية”، وذلك بعد أيام من اغتيال حليفه المحافظ البارز تشارلي كيرك.
وقال بيان للرئاسة الأميركية إن القرار جاء بسبب “نمط من العنف السياسي المصمّم لقمع النشاط المشروع وعرقلة سيادة القانون”، واصفاً الحركة بأنها “فوضوية” وتهدف إلى إسقاط الحكومة بالقوة. ترامب كان قد ألمح قبل أيام عبر منصته “تروث سوشيال” إلى عزمه اتخاذ هذه الخطوة، واصفاً أنتيفا بأنها “كارثة يسارية راديكالية وخطرة”.
ترامب ألقى باللوم على الحركة منذ ولايته الأولى، معتبراً أنها مسؤولة عن أعمال عنف ضد الشرطة وأحداث شغب، حتى خلال اقتحام الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021. ورغم ذلك، فإن القانون الأميركي لا يتضمن قائمة رسمية بـ”منظمات إرهابية داخلية”.
وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق كريس راي قد صرّح عام 2020 بأن “أنتيفا” ليست منظمة بل أيديولوجيا. فيما يصف ناشطو الحركة أنفسهم بأنهم مناهضون للعنصرية ولليمين المتطرف، ويعتبر بعضهم اللجوء إلى العنف أحياناً وسيلة مشروعة.
وبرزت “أنتيفا” بقوة بعد انتخاب ترامب عام 2016، لا سيما عقب أحداث شارلوتسفيل بولاية فرجينيا عام 2017، حين صدمت سيارة متظاهرين مناهضين للفاشية خلال احتجاج ضد جماعات يمينية متطرفة.
رسوم ترامب الجديدة على تأشيرات “إتش-1 بي”: جدل حول مستقبل الكفاءات الأجنبية في أميركا
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار للحصول على تأشيرات “إتش-1 بي” – الخاصة بالعمال الأجانب ذوي الكفاءات العالية – جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والقانونية، مع مخاوف من انعكاساته على مختلف القطاعات داخل الولايات المتحدة.
برنامج محوري للشركات والكوادر
تعد تأشيرات “إتش-1 بي” أداة رئيسية سمحت لعشرات الآلاف من المهندسين والأطباء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والطاقة والبترول بالعمل داخل الولايات المتحدة. ورغم أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وآبل وغوغل استفادت بشكل كبير من هذا البرنامج، إلا أن نطاقه لا يقتصر عليها، بل يشمل المستشفيات والجامعات والقطاعات الصناعية التي تعتمد بشكل متزايد على الكفاءات الأجنبية.
ويستقبل البرنامج سنوياً نحو 85 ألف تأشيرة، يتقدم لها ملايين حول العالم. ويخضع المتقدمون لاختبارات وإجراءات صارمة، ما يجعل الحصول عليها فرصة نادرة وذات قيمة عالية.
تأثيرات متفاوتة
بينما ترى إدارة ترامب أن الرسوم الجديدة ستشجع الشركات على إعطاء الأولوية للعمال الأميركيين وتحد من استقدام الأجانب برواتب أقل، يعتقد محللون أن القرار سيؤدي عملياً إلى إضعاف المستشفيات والجامعات والشركات الصغيرة التي لا تملك القدرة على دفع 100 ألف دولار لكل موظف أجنبي تحتاجه.
في المقابل، فإن شركات التكنولوجيا الكبرى ستكون الأقل تأثراً، إذ تمتلك أرباحاً هائلة تتيح لها امتصاص هذه الرسوم والاستمرار في استقدام الكفاءات الأجنبية، ما قد يعزز هيمنتها أكثر على حساب المؤسسات الأصغر.
انعكاسات على الاقتصاد الأميركي
يشير خبراء الهجرة والاقتصاد إلى أن القرار قد يترك آثاراً سلبية على مجمل الاقتصاد الأميركي، إذ لا تقتصر أهمية تأشيرات “إتش-1 بي” على قطاع التكنولوجيا فقط، بل تمتد إلى قطاعات حيوية مثل الصحة والطاقة والبحث العلمي، ما يجعل فرض هذه الرسوم عقبة أمام استمرار تدفق العقول المهاجرة التي لعبت دوراً محورياً في تعزيز الابتكار والإنتاجية في أميركا.
رغم أن البيت الأبيض حاول طمأنة الرأي العام بالتأكيد على أن الرسوم الجديدة ستُطبق فقط على المتقدمين الجدد، يبقى الغموض مسيطراً على آليات التنفيذ. وبينما يحتفي مؤيدو القرار باعتباره خطوة لحماية فرص العمل المحلية، يرى معارضوه أنه قد يُضعف الاقتصاد على المدى الطويل، ويعمّق الفجوة بين الشركات العملاقة القادرة على دفع هذه التكاليف، وبقية القطاعات التي ستجد نفسها عاجزة عن المنافسة.
ترامب يعيد طرح “باغرام”.. قاعدة أفغانية تتحول إلى عقدة جيوسياسية
عاد اسم قاعدة باغرام الجوية ليشعل الجدل من جديد بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بلندن في 18 سبتمبر/أيلول، أن واشنطن تسعى لاستعادة القاعدة نظراً لقربها من مواقع صينية حساسة، بينها منطقة تجارب نووية في شينغيانغ. ترامب وصف فقدان باغرام بأنه خطأ تاريخي لإدارة بايدن، معتبراً أن الانسحاب الأميركي عام 2021 مثّل لحظة “إهانة” للولايات المتحدة.
رمزية باغرام في الخطاب الأميركي
منذ الانسحاب، برزت باغرام كرمز للهزيمة الأميركية في أفغانستان، خاصة مع ترك مخزون عسكري ضخم شمل آلاف العربات المدرعة، وعشرات الطائرات والمروحيات، و300 ألف قطعة سلاح فردي، إضافة إلى أجهزة مراقبة متطورة. وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث حمّل المسؤولية للجنرالات الذين – حسب قوله – استفادوا من خسارة المعدات للحصول على صفقات جديدة مع شركات السلاح.
أهمية القواعد الأميركية
تاريخياً، شكّلت القواعد الخارجية محوراً في السياسة الأميركية، من “المدمرات مقابل القواعد”، منذ عام 1940 وصولاً إلى الحرب الباردة، حيث أصبحت أدوات لإبراز القوة وضمان التفوق. ومع صعود الصين وعودة روسيا، عادت هذه القواعد إلى قلب الإستراتيجية الأميركية، ما يجعل باغرام ورقة بالغة الأهمية في الحسابات الحالية.
الموقف الأفغاني
في المقابل، أبدت حركة طالبان رفضاً قاطعاً لأي نقاش حول القاعدة. رئيس الأركان الأفغاني فطرت الله فصيح وصف أي تنازل بأنه “خيانة”، فيما أكد وزير الخارجية أمير خان متقي أن حتى الاعتراف الأميركي الكامل بالإمارة الإسلامية لن يكون ثمناً كافياً للتفريط في باغرام أو أي شبر من الأرض الأفغانية.
باغرام بين واشنطن وبكين وموسكو
تكتسب القاعدة وزناً مضاعفاً مع التحولات الجيوسياسية؛ فروسيا اعترفت رسمياً بحكومة طالبان في يوليو/تموز 2025، فيما تسعى الصين لدمج أفغانستان في “مبادرة الحزام والطريق”. هذا يجعل واشنطن أكثر تمسكاً بورقة باغرام لتقليص نفوذ خصومها في قلب آسيا.
خلاصة
بينما يراها الأميركيون نقطة ارتكاز ضرورية للردع ومراقبة الصين وإيران وباكستان، يصر الأفغان على أنها رمز لانتصارهم على الاحتلال. وهكذا تبقى باغرام أرضية صراع محتمل قد يفتح جبهة توتر جديدة بين واشنطن وكابل، في وقت لم تلتئم فيه بعد جراح الحرب الطويلة.
عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز 345 مليار دولار في أغسطس ويقترب من تريليوني دولار منذ بداية العام المالي
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها المالي الشهري أن العجز الفدرالي بلغ 345 مليار دولار خلال أغسطس/آب 2025، ليرتفع إجمالي العجز منذ بداية السنة المالية في أكتوبر الماضي إلى نحو 1.97 تريليون دولار.
ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي حتى نهاية أغسطس 6.66 تريليون دولار، في حين لم تتجاوز الإيرادات 4.69 تريليون دولار. وتصدرت ضرائب الدخل الفردي قائمة الإيرادات بواقع 2.36 تريليون دولار، تلتها ضرائب الضمان الاجتماعي والتأمينات وضرائب الشركات التي حققت نحو 390 مليار دولار.
أما على صعيد المصروفات، فجاءت برامج الضمان الاجتماعي في المقدمة بقيمة 1.61 تريليون دولار، تلتها الرعاية الصحية (Medicare) بحوالي 1.44 تريليون دولار، بينما بلغت نفقات الدفاع الوطني نحو 841 مليار دولار، في حين ارتفعت خدمة الفوائد على الدين العام إلى 885 مليار دولار.
ويرى محللون أن هذه الأرقام تعكس عمق التحديات التي تواجهها الإدارة الأمريكية في ضبط مستويات الدين العام، وسط التزامات متزايدة لتمويل البرامج الاجتماعية الضخمة وتعزيز القدرات الدفاعية.
“على خطى هتلر وستالين: هل يضع ترامب وبوتين القارة الأوروبية بين فكّي كماشة؟”
على العلن، لا يوجد تحالف رسمي يجمع بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي، لكن مصالح الرجلين ونهجهما يسيران جنباً إلى جنب، خاصة حين يتعلق الأمر بأوروبا. هذا ما يناقشه مقال في صحيفة الغارديان، يرى كاتبه بأن ترامب وبوتين يسعيان لمحاربة “القيم الديمقراطية الأوروبية”.
في صحيفة الجارديان، كتب سيمون تيسدال مقالاً طرح فيه أوجه الشبه بين سياسات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب “العدائية” تجاه القارة الأوروبية، ويعقد مقارنة بين الوضع الحالي وما حدث قبيل الحرب العالمية الثانية سنة 1939 في الاتفاقية السرية بين ستالين وهتلر، التي تقاسما بموجبها بولندا.
يرى تيسدال أن الولايات المتحدة بقيادة ترامب، وروسيا بقيادة بوتين، تخوضان “لعبة” قد تكون ضحيتها أوروبا. ورغم تباين وجهات النظر بشأن أوكرانيا الذي طفا على السطح خلال الأيام الماضية، إلا أن الزعيمين يتشاركان أهدافاً أساسية متقاربة في هذا الشأن، برأي الكاتب.
يُكمل تيسدال في سرد أوجه التشابه بين ترامب وبوتين تجاه أوروبا، فيقول إن جهود الولايات المتحدة “للسيطرة” على أوروبا تتمثل في “التدخل السياسي، والتخريب الأيديولوجي، والابتزاز الاقتصادي وفرض المعتقدات”، فيما يبدو أسلوب بوتين “أكثر فظاظة”، لكنه “يحاكي أجندة ترامب”، إذ لن يتخلى الرئيس الروسي عن أوكرانيا، كما أنه “يكثف ويستغل” التهديد العسكري الروسي، إلى جانب التخريب والهجمات الإلكترونية والتصيد عبر الإنترنت والمعلومات المضللة، التي أصبحت “حقيقة واقعة في الحياة اليومية لأوروبا الغربية”.
صحيح أن ترامب وبوتين ليسا في تحالف رسمي، ولم يتوصلا إلى اتفاق على غرار اتفاقية عام 1939 بين الاتحاد السوفياتي وألمانيا النازية، إلا أن هناك – برأي الكاتب – أرضية مشتركة واسعة بينهما، فكلاهما “يحتقر الديمقراطية الليبرالية الأوروبية، والمساواة في الحقوق، والتعددية الثقافية”، وكلاهما “يعادي الاتحاد الأوروبي، ويتوق إلى الأمجاد الإمبريالية السابقة”.
ويعلّق تيسدال على التوتر الأخير في العلاقات بين بوتين وترامب على خلفية الحرب في أوكرانيا، ويفسّر هذا التوتر من منطلق “الفرص الربحية الهائلة” التي تحدّث عنها ترامب، فالرئيس الأمريكي حين اشتكى من تعرّضه للخذلان من قبل بوتين، لم يكن يقصد “فشل قمة ألاسكا” التي هدفت إلى إيجاد حلّ في أوكرانيا، بل كان يقصد رفض الرئيس الروسي “إبرام صفقة وتحقيق استفادة منها” بالنسبة للأمريكيين، مقتبساً في هذا السياق تصريحات لترامب قال فيها إن روسيا تواجه “مشكلة اقتصادية كبيرة”، إذ يرى أن تصريحاته هذه كانت تهدف إلى “دفع بوتين” للتصرف بمنطق “الأعمال التجارية” دون الاهتمام بالتهديدات الروسية التي تحدق بأوكرانيا والأوروبيين.
ويذكر الكاتب كذلك ما يقول إنها ضغوطات يمارسها كلا الرجلين من أجل التدخل في الانتخابات ودعم شخصيات وأحزاب بعينها في الدول الأوروبية، إذ “يدعم كلاهما الأحزاب والسياسيين اليمينيين المتطرفين والقوميين والشعبويين في أوروبا”.
ويشير الكاتب إلى تقرير “متفائل” للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، يتحدث عن أن “الهجوم المزدوج” من الشرق والغرب ضد القارة الأوروبية، سيوحّد الأوروبيين. ويرى أن ما ينقص الأوروبيين هو الفهم بأن الإدارة الأمريكية تتحول إلى “عدو صريح”، وأن الدب الروسي “قد عاد بقوة”.
يختم الكاتب بإعادة تشبيه الوضع الحالي بعام 1939، حيث تبدو أوروبا “بين فكّي كماشة”، وبرأيه، فإن الأدلة تتزايد على أن ترامب وبوتين يعملان معاً أو بالتوازي من أجل “تقويض الديمقراطية والأمن والازدهار والقيم التقدمية الأوروبية”.
“كان يمكن أن يكون رسالة بريد إلكتروني”: مسؤولون يسخرون من اجتماع هيجسيت مع الجنرالات
أثار الاجتماع المفاجئ الذي دعا إليه وزير الدفاع الأميركي بيت هيجست وجمع مئات الجنرالات في قاعدة كوانتيكو جدلاً واسعاً في الأوساط العسكرية والسياسية. فبينما قدّمه هيجسيت باعتباره محطة لإحياء “روح المحارب” وتعزيز الانضباط، رأى كثير من المسؤولين أنه أقرب إلى تجمع انتخابي يفتقر إلى القيمة العملية.
الاجتماع، الذي استمر 90 دقيقة وحضره الرئيس دونالد ترامب، تضمّن انتقادات لاذعة من هيجسيت لما وصفه بـ “الجنرالات السمان”، وطرح معايير لياقة قد تستبعد النساء من بعض الأدوار القتالية، فيما برّر ترامب فكرة نشر الجيش في المدن الأميركية، ما أثار مخاوف من عسكرة الداخل.
عدد من المسؤولين وصفوا الحدث بأنه “مضيعة للمال والوقت”، محذرين من المخاطرة الأمنية المترتبة على جمع هذا الكم من القادة في مكان واحد، واعتبروا أن محتواه كان يمكن أن يُوجز في “رسالة بريد إلكتروني”. في المقابل، دافعت وزارة الدفاع – التي أعيدت تسميتها إلى “وزارة الحرب” – عن اللقاء معتبرة أنه يعزز الروح المعنوية وينهي ما وصفته بسياسات “الصواب السياسي”.
لكن تصريحات هيجسيت حول “غباء” قواعد الاشتباك التي تحمي المدنيين، واقتراح ترامب تشكيل قوات تدخل سريع داخل المدن، فجّرت انتقادات في الكونغرس، حيث وصفها نواب بأنها غير دستورية وخطيرة على الأمن القومي. وبينما دعم بعض الجمهوريين الخطوة، اعتبرها الديمقراطيون استعراضاً سياسياً يتم على حساب المهام الاستراتيجية للجيش.
إيران
تصاعدت المؤشرات على احتمال اندلاع مواجهة كبرى بين إيران وإسرائيل، مع صفقات تسليح إسرائيلية ضخمة واستعدادات إقليمية في العراق وتركيا، ما يعكس مناخاً حربياً مفتوحاً. وفي موازاة ذلك، وجدت طهران نفسها مجدداً تحت الفصل السابع بعد تفعيل “آلية الزناد” وعودة العقوبات الأممية، وهو ما هزّ الاقتصاد الإيراني وأسقط الريال إلى مستويات قياسية. وفي محاولة لتعويض مكامن الضعف، عززت إيران قدراتها الجوية بمقاتلات ميغ-29 بانتظار تسليم سو-35 الروسية، إلى جانب منظومات دفاعية جديدة. وعلى صعيد آخر، تسعى طهران لتوسيع تعاونها النووي مع موسكو عبر بناء ثماني محطات طاقة نووية، في خطوة استراتيجية رغم العزلة. أما داخلياً، فقد برز العامل العرقي كمحرك رئيسي يعيد رسم الخريطة السياسية، حيث تحولت الأطراف المهمشة إلى بؤر احتجاجية تضع الهوية الوطنية برمتها موضع تحدٍ.
هل تلوح في الأفق حرب جديدة بين إيران وإسرائيل؟
تزداد المؤشرات في الشرق الأوسط على احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل، وفق ما نشرته صحيفة برافدا الروسية، التي رصدت حراكاً عسكرياً متسارعاً قد يجعل الحرب المقبلة أكثر اتساعاً وحدة من المواجهات السابقة. فالتقديرات لم تعد تتحدث عن تبادل محدود للغارات الجوية أو الصواريخ والطائرات المسيّرة، بل عن إمكانية انزلاق الطرفين إلى عمليات برية واسعة.
التقرير يشير إلى أن إسرائيل أبرمت صفقة ضخمة مع الولايات المتحدة لشراء أكثر من ثلاثة آلاف آلية قتالية بقيمة 1.9 مليار دولار، وهي صفقة من شأنها أن تضاعف قدراتها البرية مقارنة بما كانت عليه في حرب غزة عام 2023. وإلى جانب ذلك، تسعى تل أبيب لتعزيز مظلتها الدفاعية بحيث لا تقتصر على القبة الحديدية، بل تضاف إليها أنظمة جديدة من بينها أسلحة الليزر القتالي، في خطوة تعكس توجهها نحو عسكرة شاملة واستعداد طويل المدى لمعارك مقبلة.
غير أن الطريق إلى إيران ليس سهلاً. فالوصول البري يمر عبر الأراضي السورية والعراقية. وفي سوريا، ترى الصحيفة أن تراجع نفوذ الفصائل الموالية لطهران قد يتيح لإسرائيل فرص تفاهم ميداني محدود، لكن العراق يبقى العقدة الأصعب، مع استمرار وجود الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران إلى جانب نحو 2500 جندي أمريكي في قواعد عسكرية. وفي هذا السياق، تحدثت تقارير عن تنفيذ القوات الجوية الإسرائيلية ما يُعرف بطلعات “التطبيع”، أي اقتراب الطائرات من الأجواء الإيرانية قبل العودة أدراجها، في مسعى لاختبار الدفاعات وكسر حاجز الاستنفار النفسي لدى طهران.
الاستعدادات لم تقتصر على تل أبيب وحدها. ففي العراق، كُلّفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتشكيل احتياطات استراتيجية من الغذاء والدواء تحسباً لأي طارئ. أما في تركيا، فقد أصدر الرئيس رجب طيب أردوغان توجيهات ببناء ملاجئ في الولايات الـ81 خلال فترة لا تتجاوز 120 يوماً، على أن تُجهّز بما يكفي من المؤن لثلاثة أسابيع. وبينما تتداول أوساط سياسية أن واشنطن قد منحت إسرائيل ضوءاً أخضر لضرب الفصائل الموالية لإيران في العراق، برز تطور آخر تمثل في زيارة أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى بغداد، وهي زيارة نادرة في توقيتها ومستواها، ينظر إليها كمؤشر على أن موسكو لن تقف متفرجة أمام أي محاولة أمريكية–إسرائيلية لإعادة رسم التوازنات في المنطقة.
هكذا، وبين صفقات السلاح الإسرائيلية، والاستعدادات العراقية والتركية، والحراك الروسي غير المعتاد، تبدو المنطقة وكأنها تدخل مرحلة جديدة من التصعيد. فهل تتحول هذه المؤشرات إلى حرب إقليمية مفتوحة، أم تنجح الدبلوماسية في كبح اندفاع الأطراف نحو مواجهة قد تعيد خلط الأوراق في الشرق الأوسط بأسره؟
إعادة فرض عقوبات أممية على إيران بسبب “التصعيد النووي”، وطهران تصفها بـ”غير القانونية”
فُرضت عقوبات اقتصادية وعسكرية شاملة من قبل الأمم المتحدة على إيران بعد مرور عشر سنوات على رفعها بموجب اتفاق دولي مهم حول برنامجها النووي.
ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ بعد أن فعَّلت الدول الأوروبية الثلاث الشريكة في الاتفاق -المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا – آلية “الزناد” المعروفة باسم “Snapback”، متهمةً إيران بـ”تصعيد نووي مستمر” و”عدم التعاون”.
وكانت إيران قد علقت عمليات التفتيش الدولية على منشآتها النووية، وهو التزام قانوني بموجب اتفاق 2015، وذلك عقب قصف عدة مواقع نووية وقواعد عسكرية إيرانية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأسبوع الماضي أن بلاده لا تنوي تطوير أسلحة نووية.
ووصف بزشكيان إعادة فرض العقوبات بأنها “غير عادلة، وغير قانونية، وتفتقر إلى الإنصاف”، معتبراً أنها ضربة جديدة للاتفاق الذي يُعد – منذ توقيعه – نقطة تحول في علاقات الغرب مع الجمهورية الإسلامية التي طالما كانت معزولة.
ويضع الاتفاق المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA) قيوداً على المنشآت النووية الإيرانية، وعلى مخزونها من اليورانيوم المخصب، وعلى حجم الأبحاث والتطوير التي يمكن أن تجريها إيران.
الريال الإيراني بأدنى مستوى بعد إعادة فرض العقوبات
سجل الريال الإيراني أدنى مستوياته أمام الدولار الأحد 28 سبتمبر/أيلول قرابة الساعة 7:30 بتوقيت غرينتش بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وفق عدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في تتبع العملات.
وبحسب سعر السوق السوداء غير الرسمي، كان الدولار يُتداول بحوالي 1.12 مليون ريال، وفق موقعي بونباست وألان تشاند المرجعيين.
وقبل أن تفعّل فرنسا وبريطانيا وألمانيا “آلية الزناد”، كان سعر الدولار الواحد يزيد قليلا عن مليون ريال إيراني. (الجزيرة نت)
إيران بعد تفعيل “آلية الزناد”: بين التصعيد والدبلوماسية الصعبة
دخل الاتفاق النووي الإيراني (الموقع عام 2015) مرحلة النهاية بعد أن فعّل مجلس الأمن الدولي “آلية الزناد”، ما أعاد طهران رسمياً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بكل ما يحمله من عقوبات شاملة وصلاحيات لفرض إجراءات قد تصل إلى العمل العسكري.
نهاية الاتفاق وبداية المواجهة
مع فشل المساعي الروسية–الصينية لتمديد تعليق العقوبات، وإصرار واشنطن ولندن وباريس على إعادة إيران إلى مسار الضغط الدولي، طويت صفحة الاتفاق النووي، وعادت العقوبات على القطاعات المالية والمصرفية، وحظر السلاح، والقيود الصاروخية. وهكذا وجدت طهران نفسها أمام مواجهة مباشرة مع المنظومة الأممية في لحظة إقليمية حساسة عقب حربها الأخيرة مع إسرائيل.
تسليم كامل أم مناورة سياسية؟
يرى الباحث جواد حيران نيا أن أوروبا باتت تتحرك بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، ولم تعد مطالبها تقتصر على النووي، بل اتجهت نحو ربط أي تفاوض بملفات الصواريخ والنفوذ الإقليمي. ويشير إلى أن واشنطن لا تبحث عن “صفقة متوازنة”، بل عن ما يشبه التسليم السياسي الكامل من إيران.
ومع ذلك، تبقى طهران قادرة على استخدام أوراق ضغط مثل تقييد التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، دون الوصول إلى حد الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
سيناريوهات معقدة
يصف المحلل رضا غبيشاوي المرحلة الجديدة بأنها “الأكثر غموضاً” في تاريخ الملف النووي، موضحاً أن عودة إيران إلى الفصل السابع تجعل أي مخرج مرهوناً بتفاهم مباشر مع واشنطن، وسط ضغوط إضافية من مجلس الأمن.
ورغم توقع تصاعد العقوبات، يرى غبيشاوي أن إيران ليست غريبة عن “سياسة الضغوط القصوى”، إذ خبرت عقوبات قاسية لعقود ونجحت في تكييف اقتصادها بوسائل التفاف داخلية وخارجية.
مرحلة تصعيد مفتوحة
إعادة إيران إلى الفصل السابع لا تعني فقط استعادة العقوبات السابقة، بل مرحلة تصعيد جديدة تشمل:
- تشديد القيود الاقتصادية والمالية.
- إدخال البرنامج الصاروخي والدور الإقليمي على طاولة المفاوضات.
- احتمال دفع الأزمة نحو مواجهة عسكرية، خصوصاً مع إسرائيل بدعم أمريكي.
إيران تقف اليوم على مفترق طرق: إما قبول حوار مباشر بشروط غربية صارمة، أو المضي في سياسة التحدي مع ما يحمله ذلك من مخاطر تشديد العقوبات وربما ضربات عسكرية. وبين هذا وذاك، يبقى المشهد الإقليمي والدولي مفتوحاً على كل الاحتمالات، بينما يترقب العالم إن كانت الدبلوماسية قادرة على منع انزلاق جديد نحو صراع أوسع. (الجزيرة نت)
وصول مقاتلات “ميغ-29” إلى إيران وانتظار تسليم “سو-35” الروسية
أعلنت مصادر إيرانية أن مقاتلات ميغ-29 الروسية وصلت إلى إيران ضمن خطة مؤقتة لتعزيز قدرات سلاح الجو، في وقت تستعد فيه موسكو لتسليم طائرات أكثر تطوراً من طراز سوخوي سو-35 على مراحل خلال الفترة المقبلة.
عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أبوالفضل ظهرهوند أوضح أن وصول مقاتلات ميغ يشكل “حلاً انتقالياً” بانتظار اكتمال تسليم طائرات سو-35، مؤكداً أن الطائرات تم نشرها في قاعدة شيراز الجوية، فيما “السوخوي في الطريق”.
منظومات دفاعية جديدة
ظهرهوند أشار أيضاً إلى أن إيران تسلّمت بكميات “مهمة” منظومات دفاعية صينية من طراز HQ-9 وأخرى روسية من طراز S-400، لكن موسكو وبكين لم تؤكدا رسمياً هذه المعلومات حتى الآن.
مساعٍ للتحديث رغم العقبات
منذ سنوات تسعى طهران لتحديث قواتها الجوية التي لا تزال تعتمد بشكل أساسي على طائرات أمريكية قديمة تعود لمرحلة ما قبل ثورة 1979، إضافة إلى عدد محدود من الطائرات الروسية أو تلك التي خضعت لتحديث محلي. وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي عن تسليم الدفعة الأولى من مقاتلات سو-35، من دون توضيح عدد الطائرات الجاهزة للعمل.
تسليمات جزئية وبطيئة
محللون غربيون ذكروا أن إيران طلبت نحو 50 مقاتلة، لكن ما تم تسليمه حتى الآن لا يغطي سوى جزء من الطلب، إذ تتأخر روسيا في الوفاء بالتزاماتها بسبب حاجاتها العسكرية في أوكرانيا. كما تكشف هذه التطورات ثغرات واضحة في الدفاع الجوي الإيراني، خصوصاً بعد تدمير إسرائيل آخر أربع منظومات روسية من طراز S-300 كانت إيران قد حصلت عليها عام 2016.
إيران توقع اتفاقاً مع روسيا لبناء 8 محطات نووية
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن بلاده ستبرم خلال الأيام المقبلة اتفاقاً مع روسيا لبناء ثماني محطات للطاقة النووية داخل إيران، في خطوة تعكس توسع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الخاضعين لعقوبات دولية مشددة.
وأوضح إسلامي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أن الاتفاق يشمل إنشاء أربع محطات في بوشهر، إلى جانب محطات أخرى موزعة في مناطق مختلفة، ضمن خطة تهدف إلى توليد 20 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة النووية. وأشار إلى أن العمل جارٍ بالفعل على بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية، فيما جرى اختيار وتجهيز الأراضي اللازمة للمحطات الجديدة بعد استكمال المفاوضات والدراسات الفنية.
إسلامي، أكد أن الاتفاقية الجديدة ستدخل مباشرة مرحلة التنفيذ والتشغيل بمجرد توقيعها، لتبدأ بعدها خطوات التصميم والهندسة والإجراءات التكميلية. كما شدد على أن إيران ملتزمة بتعهداتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن استمرار التعاون مرهون بحياد الوكالة والتزامها بالقوانين والاتفاقات المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن وقّعت طهران وموسكو في إبريل/نيسان 2025 معاهدة شراكة إستراتيجية شاملة دخلت حيز التنفيذ في يوليو/تموز، وشملت مجالات الدفاع والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والزراعة والثقافة.
الهوية العرقية تعيد رسم الخريطة السياسية في إيران
لم تعد المسألة العرقية في إيران قضية هامشية داخل النقاش السياسي، بل تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي يعيد تشكيل طبيعة الاحتجاجات والنشاط السياسي في البلاد. فمنذ احتجاجات عام 2017، مروراً بانتفاضة الوقود عام 2019، و”انتفاضة العطشى” في 2021، وصولاً إلى التظاهرات الواسعة بعد وفاة مهسا أميني عام 2022، اتجه مركز الثقل السياسي تدريجياً من المدن الفارسية الكبرى في وسط إيران إلى الأطراف العرقية الممتدة على الحدود.
من طهران إلى الهوامش
الأطراف العرقية – بما تضمّه من أكراد وبلوش وعرب وأذريين – لم تعد مجرد مناطق مهمّشة، بل صارت ساحات أساسية للحراك ضد السلطة. ويشير باحثون إلى أن هذا التحوّل جعل الهوية العرقية في قلب الصراع مع النظام، ليس فقط في مواجهة الحكومة المركزية، بل أيضاً في تحدّي مفهوم المواطنة والهوية الوطنية نفسها.
وتقدّر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن الفرس يشكلون بين 51 و61% من سكان إيران، والأذريين بين 16 و24%، والأكراد بين 7 و10%، والعرب 2 إلى 3%، والبلوش نحو 2%. هذه التركيبة العرقية، إلى جانب عقود من التمييز البنيوي، أسست لوعي سياسي متنامٍ يقوم على المطالبة بالاعتراف الثقافي واللغوي، وحكم محلي، وتوزيع عادل للموارد.
الأطراف كجغرافيا استراتيجية
الجغرافيا العرقية لإيران تضيف بعداً أمنياً بالغ الحساسية:
- الشمال الغربي: الأقاليم الأذرية المحاذية لتركيا وأرمينيا وأذربيجان، حيث تتقاطع القومية الأذرية مع النزاعات الحدودية.
- الجنوب الغربي: خوزستان العربية الغنية بالنفط، التي جعلها التوترات العرقية والسياسية نقطة تماس مباشر مع العراق وأمن الطاقة الإقليمي.
- الجنوب الشرقي: بلوشستان على حدود باكستان وأفغانستان، مسرح التهريب والجماعات المسلحة.
هذه المواقع جعلت الأطراف ليست فقط هوامش مهمّشة، بل أيضاً بوابات استراتيجية قد تهدد استقرار الداخل الإيراني وتؤثر في علاقاته مع الجوار.
بين القمع والوعي الجديد
الاحتجاجات في المناطق العرقية تواجه عادة قمعاً أعنف من باقي الأقاليم، ويشير تقرير إلى أن معظم ضحايا احتجاجات 2022-2023 كانوا من البلوش والأكراد. ومع ذلك، لم يوقف العنف تنامي التعبئة، بل عزز التضامن بين الجماعات المهمشة، مدفوعاً بالإعلام الرقمي ووسائل التواصل التي ربطت الداخل بالشتات الخارجي.
الأكراد يبدون الأكثر نشاطاً وتنظيماً، يليهم البلوش والعرب، بينما يبقى الأذريون أقل انخراطاً بفعل اندماجهم في هوية الدولة الشيعية.
المستقبل: استيعاب أم تمثيل؟
رغم استمرار القمع، يبرز المسار الانتخابي كأداة بديلة للتعبئة، كما ظهر في انتخابات 2024 التي صعد فيها مسؤولون من أصول غير فارسية. غير أن التساؤلات تبقى مطروحة: هل ستقود هذه المشاركة إلى تمثيل فعلي للمجتمعات العرقية، أم ستتحول إلى مجرد وسيلة لاحتواء نخبها ضمن النظام القائم؟ (العرب)
متابعات عربية
التحالف السعودي الباكستاني.. هندسة أمنية جديدة ومظلة ردع في الخليج
في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، وقّعت السعودية وباكستان في 17 سبتمبر/أيلول 2025 اتفاقية دفاع مشترك بالرياض، وُصفت بأنها تحول نوعي في معادلات الأمن الخليجي بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة، وما تبعها من تراجع الثقة بالمظلة الأمنية الأميركية التقليدية.
الاتفاق يكرّس مبدأ الدفاع المتبادل ويؤسس لتعاون عسكري شامل في التدريب والتسليح والصناعات الدفاعية، مع رسائل ردع مزدوجة لخصوم إقليميين وحلفاء دوليين. كما فتح الباب أمام تكهنات بوجود “مظلة نووية ضمنية” عبر القدرات الاستراتيجية الباكستانية، رغم غياب أي إعلان رسمي عن البعد النووي.
العلاقات بين البلدين تعود إلى 1947، وشهدت محطات بارزة من التعاون في الحرب الأفغانية ضد السوفييت، والدعم الاقتصادي السعودي لإسلام آباد، وصولاً إلى بناء قدراتها العسكرية. ورغم توترات سابقة، خصوصاً في ملف اليمن وكشمير، فإن الاتفاق الأخير يعكس مسار إعادة ترميم الثقة مع حكومة شهباز شريف.
يأتي التحالف في إطار تحوّل العقيدة الأمنية السعودية نحو تنويع الشركاء، بالتوازي مع حضور متزايد للصين الداعمة لباكستان عسكرياً وتكنولوجياً، ما يعزز مكانة إسلام آباد كقوة ردع إقليمية. ويرى محللون أن الاتفاق يعيد رسم معادلة التوازن مع إسرائيل، ويضع الخليج أمام حقبة “مظلات أمنية متعددة” تتجاوز الاعتماد على واشنطن وحدها.
بهذا، لا يُعد الاتفاق ثنائياً فحسب، بل جزءاً من مشهد إقليمي ودولي أوسع، يعيد تعريف أدوار القوى في الخليج، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الوساطة والصراع العربي الإسرائيلي في ظل هندسة أمنية جديدة. (الجزيرة نت)
واشنطن تضغط على العراق لفك ارتباطه عن إيران
أكد ثلاثة مسؤولين عراقيين في بغداد لـ”العربي الجديد” أن الإدارة الأميركية تمارس منذ أسابيع ضغوطاً غير معلنة على العراق، تحت ما بات يُعرف بـ”فك الارتباط عن إيران”. الضغوط لم تعد تقتصر على ملف الفصائل المسلحة، بل طاولت القضاء والقطاع المالي، في محاولة لإبعاد مؤسسات الدولة عن نفوذ الجماعات الحليفة لطهران.
وتأتي هذه الخطوات بعد إعلان الخارجية الأميركية إدراج أربع فصائل عراقية جديدة موالية لإيران على لائحة الإرهاب، بينها حركة النجباء وكتائب سيد الشهداء. القرار صدر وفق مذكرة أمن قومي موقعة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تنص على “أقصى ضغط” لقطع تمويل إيران وشبكاتها. وبهذا يرتفع عدد الفصائل العراقية المصنفة إرهابية إلى ثمانية، فيما تخضع شخصيات بارزة كقيس الخزعلي وفالح الفياض لعقوبات من وزارة الخزانة.
مراقبة مالية وقضائية
المصادر العراقية أوضحت أن الضغط الأميركي يتركز حالياً على القطاع المصرفي، حيث باتت البنوك الحكومية والخاصة تخضع لرقابة شبه كاملة من الخزانة الأميركية. التحويلات المالية تمر عبر بنوك وسيطة في الأردن والإمارات، في مسعى لوقف أي منفذ يمكن أن تستفيد منه إيران.
وفي موازاة ذلك، كشف دبلوماسي عراقي أن واشنطن تضغط لفتح محاكمات علنية ضد قادة فصائل متهمين بجرائم حرب وانتهاكات إنسانية، في خطوة تُعد حساسة للغاية داخل المشهد العراقي.
رسائل مقلقة
برلمانيون عراقيون أكدوا أن واشنطن تطرح ثلاث ملفات رئيسية: دمج الفصائل المسلحة أو حلها، ضبط التدخل في القضاء، وإصلاح القطاع المالي. هذه الضغوط تترافق مع تسريبات عن قلق “الإطار التنسيقي” الحاكم من أن تمثل هذه الإجراءات غطاءً لإسرائيل لتنفيذ ضربات داخل العراق.
وكشفت مصادر أن الوفد العراقي المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة حمل رسالة سرية لواشنطن يسأل فيها عن التزاماتها الأمنية، وجدول الانسحاب المتفق عليه، وحماية العراق من أي اعتداء خارجي.
سياق إقليمي
المحللون يرون أن العراق يواجه تحديات خارجية متصاعدة، وسط انفتاح الأجواء أمام ضربات إسرائيلية واشتداد الضغط الأميركي. الخبير الأمني سرمد البياتي حذر من أن بغداد مطالبة بتمكين مؤسساتها الأمنية والسيادية لمواجهة أي أزمة، مشيراً إلى أن حادثة قصف الدوحة أظهرت “استهتار إسرائيل بالسيادة الإقليمية”.
تجدر الإشارة إلى أن الخلافات الأميركية-العراقية ليست جديدة؛ ففي 2021 أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق ترامب على خلفية اغتيال قاسم سليماني قرب مطار بغداد. كما أدرجت واشنطن مطلع 2025 خمسة بنوك عراقية جديدة على لائحة العقوبات، ليرتفع عدد البنوك المعاقبة إلى 28، بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال والتعامل مع جهات إيرانية.
هل يتصدّع تحالف “الثنائي الشيعي” في لبنان؟
يُنظر إلى العلاقة بين حزب الله وحركة أمل منذ عقود باعتبارها الركيزة الأساسية للوجود السياسي الشيعي في لبنان، تحت ما يُعرف بـ”الثنائي الشيعي”. هذا التحالف رسم حدود الدور الشيعي في نظام المحاصصة الطائفية، ووفّر غطاءً متبادلاً بين جناح المقاومة العسكري من جهة، والتمثيل السياسي والمؤسساتي من جهة أخرى.
لكن مع التحولات الأخيرة في الإقليم، واغتيال عدد من قادة حزب الله، وفي مقدمتهم الأمين العام السابق حسن نصر الله، تعاظم دور رئيس مجلس النواب نبيه بري كواجهة أساسية في تحديد مستقبل الطائفة الشيعية، خصوصاً بعدما تولّى مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل وفتح قنوات مباشرة مع واشنطن لمناقشة “الورقة الأمريكية” المتعلقة بنزع سلاح الحزب.
جذور العلاقة: من الانقسام إلى الوحدة
- السبعينيات: نشأت حركة أمل بقيادة الإمام موسى الصدر كإطار يسعى لإدماج الشيعة في الدولة اللبنانية.
- الثمانينيات: خرج حزب الله من رحم أمل متأثراً بالثورة الإيرانية، ما قاد إلى مواجهات مسلحة بين الطرفين، قبل أن يعيد العداء لإسرائيل صياغة العلاقة.
- التسعينيات: برعاية سورية–إيرانية، تبلورت معادلة جديدة: حزب الله يحتفظ بجبهة المقاومة المسلحة، فيما تحافظ أمل على حضورها في الدولة ومؤسساتها.
- 2006 وما بعدها: حرب تموز عزّزت التحالف، لتولد صيغة “الثنائي الشيعي” الراسخة، حيث تقاسمت أمل والحزب الأدوار بين السياسة والمقاومة.
خلافات أم تمايزات؟
اليوم، يظهر التباين في الموقف من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل عام 2024، والذي نصّ على انسحاب تدريجي، وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني بدعم من “اليونيفيل”.
- حزب الله يرى أن الخروقات الإسرائيلية اليومية تجعل الاتفاق بلا قيمة.
- بري يتعامل مع “الورقة الأمريكية” كنص قابل للنقاش مستقبلاً، شرط حفظ “كرامة المقاومة”.
ومع ذلك، أوكل الحزب علناً إلى بري مهمة إدارة التفاوض السياسي، ما يشير إلى استمرار وحدة الاستراتيجية العامة: حماية السلاح وتفادي الانقسام الداخلي.
الشارع الشيعي: بين الولاء والانتقاد
رغم التداخل الاجتماعي الكبير بين أنصار الحزبين، برزت طبقة “ناقدة” بعد الانهيار المالي عام 2019، توجه أصابع الاتهام للثنائي بالمسؤولية عن الفساد والمحاصصة. ومع ذلك، ما زالت ترى في الحزبين ضمانة ضد إسرائيل، وإن كانت تطالب بخطاب اقتصادي واجتماعي أكثر واقعية.
وفي الختام فإن تحالف حزب الله وأمل ليس تحالفاً انتخابياً عابراً، بل هو بنية متجذرة صنعتها أربعة عقود من الدماء والتضحيات والمصالح المشتركة. ما يظهر من تناقضات في الخطاب لا يرقى إلى مستوى الانقسام، بقدر ما يعكس اختلافاً في التكتيك لا في الاستراتيجية.
الاختبار المقبل لن يكون فقط على جبهة الجنوب، بل في الداخل اللبناني المأزوم، حيث يُنتظر من “الثنائي الشيعي” أن يقدّم إجابات على أسئلة الحكم والاقتصاد والعيش اليومي، تماماً كما يدافع عن حدود البلاد.
السودان يطلق “إنذاراً أحمر” مع تدفقات غير مسبوقة من سد النهضة تهدد بفيضانات واسعة
تعيش السودان لحظات حرجة مع الارتفاع القياسي في منسوب نهر النيل، ما دفع وزارة الري لإعلان “الإنذار الأحمر” على طول الشريط النيلي تحسباً لفيضانات قد تجرف المنازل والأراضي الزراعية وتهدد حياة آلاف الأسر.
تصريف غير طبيعي يضاعف المخاطر
تشير البيانات الرسمية إلى أن إيراد النيل الأزرق تجاوز 730 مليون متر مكعب يومياً لليوم الرابع على التوالي، وهو معدل يفوق الطبيعي بنحو 300 مليون متر مكعب. كما ارتفعت التصريفات في سدود الروصيرص وسنار ومروي إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي ضاعف الضغط على البنية التحتية والمناطق المأهولة على ضفاف النهر.
اتهامات لإثيوبيا وقلق متصاعد
وزير الري الأسبق عثمان التوم أوضح أن إثيوبيا رفعت منسوب بحيرة سد النهضة لأغراض “احتفالية”، ما أدى إلى تصريف مفرط من المياه نحو السودان. وحذّر من أن استمرار هذا التدفق مع نهاية موسم الفيضان قد يجعل السيطرة على الأوضاع أكثر تعقيداً ويعرض السودان لـ”كارثة مائية”.
دعوات إلى تنسيق عاجل
التوم دعا إلى تنسيق فوري مع السلطات الإثيوبية لضبط التصريف ضمن الحدود الطبيعية، مشيراً إلى أن أي تفاهم سريع يمكن أن يخفف الضغط على السدود السودانية خلال أيام، ويمنع تفاقم الأزمة شمال الخرطوم.
تحذيرات متكررة وذكريات مؤلمة
الإدارة العامة لشؤون مياه النيل أكدت أن المناسيب ستواصل ارتفاعها في الخرطوم وشندي وعطبرة وبربر وجبل أولياء، مع توقع أن تتأثر ولايات النيل الأبيض والأزرق وسنار بشكل خاص. الخبراء وصفوا الوضع بأنه “الإنذار الأخير قبل الكارثة”، فيما يستعيد السودانيون ذكريات الفيضانات السابقة التي جرفت آلاف المنازل وشرّدت مئات الأسر.
اختبار لقدرة الدولة
المشهد الحالي يعكس اختباراً صعباً لقدرة السودان على إدارة أزمة مائية معقدة تتزامن مع تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية. وفيما يسابق المواطنون الوقت لإنقاذ ممتلكاتهم، يرى الخبراء أن التعاون الدولي والإجراءات الوقائية السريعة وحدها كفيلة بمنع تحول النيل إلى مصدر دمار جديد.
الاعتراف بدولة فلسطين: كرة الثلج التي تدحرجت في الغرب
أعادت حرب غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 رسم المشهد السياسي الدولي، ليس فقط من خلال المآسي الإنسانية الهائلة التي خلّفتها، بل أيضاً عبر موجة غير مسبوقة من الاعترافات الغربية بدولة فلسطين.
فبعد قرن على وعد بلفور الذي مهد الطريق لقيام إسرائيل، باتت دول كبرى ترى أن الوقت قد حان لتصحيح مسار التاريخ. بريطانيا وكندا وأستراليا انضمت حديثاً إلى قائمة الدول التي اعترفت بفلسطين، بعد أن سبقتها إسبانيا وأيرلندا والنرويج، لتشكّل اعترافات متتالية شبّهها باحثون بـ”كرة ثلج” تتدحرج نحو عواصم الغرب.
الغضب الشعبي محرك أساسي
الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت العواصم الأوروبية والأمريكية، ورفرفت فيها الأعلام الفلسطينية، دفعت الحكومات الغربية إلى إعادة حساباتها. الصور المروعة لغزة المدمرة، وتصاعد الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة، ولّدت شعوراً واسعاً بأن الصمت تواطؤ، ما فرض ضغوطاً داخلية على قادة كفرنسا وبريطانيا للاعتراف بفلسطين كخطوة سياسية تهدئ الشارع وتفتح أفقاً للحل.
تحول في المقاربة الأوروبية
تقارير بحثية، مثل تقرير معهد أبحاث السلام في أوسلو، أكدت أن الاكتفاء بشعارات “حل الدولتين” لم يعد مقنعاً، وأن الاعتراف بفلسطين قد يتحول إلى نقطة بداية لأي مفاوضات، لا مجرد خاتمة بعيدة المنال. وبذلك، يصبح الكيان الفلسطيني واقعاً سياسياً لا يمكن القفز عنه، فيما ينصبّ النقاش حول كيفية ترجمته إلى دولة قابلة للحياة.
رمزية كبرى وأثر عملي
الاعتراف الأخير اكتسب أهمية مضاعفة لكونه جاء من دول مؤثرة مثل بريطانيا وفرنسا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، وهو ما يعزز الوزن الدبلوماسي للفلسطينيين في أي محادثات قادمة. وعلى المدى القريب، يلزم هذا الاعتراف الحكومات بالتصدي لسياسات التوسع الاستيطاني، ويفتح الباب لمراجعة الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل.
الولايات المتحدة خارج المعادلة
ورغم تدحرج “كرة الثلج”، لا يُتوقع أن تصل قريباً إلى واشنطن. فالعلاقة الاستراتيجية العميقة التي تربط الولايات المتحدة بإسرائيل، ودور الأخيرة المحوري في السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط، تجعل الاعتراف الفلسطيني خياراً مستبعداً. إدارة ترامب، التي تصف نفسها بأنها “الأكثر دعماً لإسرائيل”، ما زالت تفضّل مسار الخطط الأمنية والسياسية على أي خطوة دبلوماسية من هذا النوع، كما تجلّى في استخدام واشنطن للفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.
توقيفات وإصابات.. احتجاجات جيل” Z“متواصلة في الدار البيضاء
تتواصل الاحتجاجات الشعبية في العاصمة الرباط والدار البيضاء ومدن عدة للتنديد بالأوضاع التي تعيشها البلاد، والمطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية، وهو ما أسفر عن إصابات وتوقيفات في صفوف المتظاهرين.
وفي الدار البيضاء، حج مئات الشباب إلى ساحة السراغنة استجابة لدعوات “جيل Z”، إلا أن قوات الأمن حالت دون احتشادهم في مكان واحد، ما أدى إلى تظاهر عدة مجموعات في مواقع متفرقة من حي درب السلطان.
وتشهد أزقة وشوارع الحي في هذه الأثناء مطاردات بوليسية وتوقيفات بالجملة، كما سجت صحيفة “صوت المغرب” وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين نتيجة التدخل الأمني الذي كان عنيفا في كثير من الأحيان.
وهتف المتظاهرون بطالب اجتماعية مم قبيل “الشعب يريد إسقاط الفساد”، و ”الصحة أولا مابغيناش كأس العالم”، و ”حرية كرامة عدالة اجتماعية”.
وعن سبب خروجهم للاحتجاج، قال ناشطون في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إنهم يريدون “القطع مع الحياة التي عاشها آباءهم، وإنهاء الصمت حيال الأوضاع المتدهورة”، مشيرين إلى أن مطالبهم بسيطة وتتعلق بقطاعات هامة من بينها التعليم والصحة والتشغيل.
وكان الشارع المغربي قد عاش على وقع احتجاجات عارمة اجتاحت مختلف مدن البلاد، مطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية في عدة قطاعات، أبرزها التعليم والصحة، وهو ما أسفر عن موجة توقيفات واسعة شملت عددا من الشباب والنشطاء.
وتستمر الدعوات الاحتجاجية التي أطلقها شباب على مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي، وسط استنفار أمني بعدد من المدن.
متابعات إفريقية
مالي تنهي تعاونها الأمني مع فرنسا
دخلت العلاقات بين باماكو وباريس مرحلة أكثر توتراً بعد إعلان المجلس العسكري الحاكم في مالي وقف التعاون مع فرنسا في مجال مكافحة الإرهاب، وطرد خمسة موظفين من السفارة الفرنسية في العاصمة باماكو. القرار ورد في مذكرة رسمية مؤرخة في 17 سبتمبر/أيلول، وصفت الموظفين بأنهم “أشخاص غير مرغوب فيهم”، من دون تقديم توضيحات إضافية.
مصادر دبلوماسية فرنسية ربطت الخطوة بقرار باريس الأسبوع الماضي طرد ضابطي استخبارات ماليين يعملان في سفارتها بفرنسا وتعليق التعاون الأمني. التوترات تعود جذورها إلى أغسطس/آب الماضي عندما اعتقلت السلطات المالية ضابط استخبارات فرنسي متهماً بمحاولة تدبير انقلاب بالتعاون مع جنرالات ماليين.
يأتي هذا التطور امتداداً لمسار اتخذته مالي منذ الانقلابين العسكريين الأخيرين، حيث أنهت وجود القوات الفرنسية على أراضيها ولجأت إلى روسيا للحصول على الدعم الأمني. ورغم استمرار بعض أشكال التعاون الاستخباراتي بعد الانسحاب الفرنسي، فإن القرار الأخير يضع حداً لأي تعاون رسمي في مكافحة الإرهاب بين البلدين، في مؤشر على قطيعة سياسية وأمنية آخذة في الاتساع. (أفروبوليسي)
إثيوبيا وروسيا توقعان خطة عمل لتطوير مشروع نووي
في خطوة تعكس توسع التعاون الإستراتيجي بين موسكو وأديس أبابا، وقعت إثيوبيا وروسيا خطة عمل لتطوير مشروع للطاقة النووية في إثيوبيا. الاتفاق جرى تبادله في الكرملين يوم 25 سبتمبر/أيلول 2025 بين أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة روساتوم الروسية، ووزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الخطة تضع الأسس العملية للتعاون بين روساتوم وشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية في بناء محطة للطاقة النووية، كجزء من خارطة طريق أوسع تشمل مجالات الطاقة والزراعة والرعاية الصحية والدفاع. آبي أحمد، الذي يشارك في المنتدى الذري العالمي بموسكو، أكد أن المشروع يجسد طموح بلاده لتوسيع شراكاتها مع روسيا وتبني خيارات جديدة لتأمين الطاقة.
من جانبه، أوضح منسق البرنامج النووي الإثيوبي، الدكتور تكلماريام تيسيما، أن بلاده تخطط لبناء مفاعلات نووية للأبحاث وأخرى لإنتاج الكهرباء، في إطار رؤية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية. (أفروبوليسي)
متمردون مدعومون من رواندا يعرضون مجندين جدداً، مما يثير تساؤلات حول اتفاق السلام في الكونغو
نظمت حركة “إم23” المتمردة في شرق الكونغو عرضاً عسكرياً واسعاً نهاية الأسبوع، قدمت خلاله أكثر من 7 آلاف مجند جديد، في خطوة أثارت الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق السلام الذي جرى التوصل إليه بوساطة قطرية بين كينشاسا ورواندا، الداعم الأبرز للحركة.
وبحسب بيان المتمردين، فإن صفوفهم الجديدة تضم جنوداً من الجيش الكونغولي استسلموا خلال جولات القتال الأخيرة، إضافة إلى عناصر من ميليشيات محلية انضمت إليهم. لكن جماعات حقوقية حذرت من أن كثيراً من الشباب والجنود السابقين تعرضوا لضغوط للالتحاق بالحركة.
المشهد، الذي جرى في مدينة غوما الإستراتيجية، أثار قلقاً متزايداً من أن تتحول “إم23” إلى كيان أشبه بـ “دولة داخل الدولة”، خاصة مع استمرار الاتهامات المتبادلة بينها وبين القوات الحكومية بخرق وقف إطلاق النار، وتسجيل مناوشات متفرقة في المنطقة.
ويرى محللون أن استعراض القوة هذا لا يعكس فقط تجذر نفوذ المتمردين على الأرض، بل يضع اتفاق السلام المرتقب أمام اختبار حقيقي قد يحدد مستقبل الاستقرار في الكونغو. (أفروبوليسي)
المشرعون التشاديون يؤيدون فترات رئاسية غير محدودة لمدة سبع سنوات.
أقر البرلمان التشادي، بأغلبية ساحقة بلغت 171 صوتاً مقابل صوت واحد فقط، تعديلاً دستورياً مثيراً للجدل يمدد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، مع إلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات، ما يفتح الباب أمام بقاء الرئيس في السلطة إلى أجل غير مسمّى.
المشروع، الذي تقدمت به حركة الإنقاذ الوطني (MPS) الحاكمة، لا يقتصر على تمديد ولاية الرئيس، بل يتضمن أيضاً إنشاء منصب نائب رئيس الوزراء، وتمديد فترة البرلمان من خمس إلى ست سنوات. كما نصّ على رفع الحصانة عن الوزراء في حال تورطهم بجرائم اقتصادية أو مالية، ليخضعوا للمحاكمة أمام القضاء العادي.
وسيُحال التعديل إلى مجلس الشيوخ في 13 أكتوبر/تشرين الأول، حيث يحتاج إلى موافقة ثلاثة أخماس الأعضاء لاعتماده رسمياً. ورغم تأكيد رئيس مجلس النواب، علي كولوتو، أن التصويت الحالي مجرد “دراسة للدستور وليس تعديلاً فورياً”، إلا أن مراقبين يرون في الخطوة تمهيداً لترسيخ حكم طويل الأمد، يثير مخاوف بشأن مستقبل التداول الديمقراطي للسلطة في البلاد. (أفروبوليسي)
متابعات دولية
الصين والإبادة في غزة: حياد محسوب يحمي المصالح
بعد مرور نحو عامين على حرب غزة، يواصل الموقف الصيني إثارة الجدل بين الخطاب المعلن في المحافل الدولية والممارسة الفعلية على الأرض. ففي مقالة كتبها السفير الصيني لدى إسرائيل شياو جونتشنغ خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى الهولوكوست، ربط هجمات السابع من أكتوبر برواية معاداة السامية، متجاهلاً سياق الاحتلال والفصل العنصري، ما اعتُبر دعماً مباشراً للرواية الإسرائيلية وتغطية على جرائم الإبادة.
ورغم تقديم الصين نفسها كقائد للجنوب العالمي، فإنها لم تلعب أي دور قيادي في مواجهة الحرب، ولم تتخذ إجراءات ملموسة مثل خفض العلاقات أو فرض عقوبات على إسرائيل. بل اكتفت بخطاب عام يطالب بالوحدة الفلسطينية وإحالة المسؤولية إلى مجلس الأمن، مع تجنّب استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية”. وزاد الموقف غموضاً مع تقارير تثبت استخدام إسرائيل طائرات مسيّرة صينية في عمليات القصف بغزة، ما أثار أسئلة حول حياد بكين.
ترى المذكرة أن هذا “الحياد المنحاز” تحكمه خمسة دوافع رئيسية: عدم اعتبار غزة ساحة استراتيجية ضمن صراع القوى الكبرى، تهميش فلسطين في مشروع الحزام والطريق، تركيز الصين على طموحاتها العسكرية والاقتصادية البعيدة، استغلال تراجع مركزية القضية الفلسطينية عربياً، وأخيراً الاستفادة من تآكل مصداقية الغرب دون تحمّل مسؤولية مباشرة.
وبينما تُكثّف الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل، تفضّل بكين استثمار التناقضات لتعزيز صورتها كقوة بديلة، دون تقديم خطوات عملية. ومن هنا، توصي الدراسة الفلسطينيين بإعادة تقييم علاقتهم بالصين، والضغط على بكين لوقف أي تواطؤ اقتصادي مع المستوطنات، ومساءلتها عن خطابها السياسي الذي يصف إسرائيل بـ”الدولة اليهودية”. كما تدعو إلى تطوير أجندة بحثية نقدية حول السياسة الصينية، وإطلاق حوار استراتيجي مع الأكاديميين الصينيين لنقل الموقف الفلسطيني بشكل مباشر. (الشبكة)
أوراسكوم كونستراكشون و “أو سي أي جلوبال” تبحثان اندماجاً لخلق عملاق للبنية التحتية
تدرس أوراسكوم كونستراكشون وأو سي أي جلوبال – وكلاهما مدعوم من الملياردير المصري ناصف ساويرس – الاندماج في كيان موحد للبنية التحتية والاستثمار، مقره أبوظبي ومدرج في سوقها المالي، وفق بيان مشترك.
بموجب المقترح، ستُدمج “أو سي أي” في أوراسكوم كونستراكشون، مع شطب أسهمها من بورصة أمستردام، فيما سيجري تبادل أسهم بين المساهمين وفق قيمة عادلة تحدد بعد الفحص المالي.
الصفقة تهدف لدمج خبرة أوراسكوم في مشروعات بقيمة 14 مليار دولار مع محفظة استثمارات “أو سي أي”، بما يوفر منصة قادرة على تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الطاقة، المياه، الطيران، النقل، والقطاع الرقمي عبر الولايات المتحدة، أوروبا، مصر، ودول الخليج.
ساويرس وصف الاندماج بأنه خطوة للتحول من الأسمدة والكيماويات إلى البنية التحتية، مؤكداً خططاً لاستثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في البنية التحتية الأميركية، خصوصاً مراكز البيانات.
يأتي ذلك بعد سلسلة تخارجات نفذتها “أو سي أي جلوبال”، شملت بيع حصتها في فيرتيجلوب وأصول للأمونيا والميثانول بأكثر من 9 مليارات دولار، ما يعكس إعادة توجيه أنشطتها نحو البنية التحتية العالمية.
على صعيد السوق، ارتفعت أسهم أوراسكوم 3.8% في سوق أبوظبي، بينما تراجعت 1.6% في البورصة المصرية، في ظل ترقب المستثمرين لخطوات الدمج المقبلة.
البرلمان الفنزويلي يوافق مبدئياً على معاهدة “شراكة استراتيجية” مع روسيا وسط تهديدات أمريكية
صادق البرلمان الفنزويلي بشكل مبدئي على مشروع معاهدة جديدة للتعاون والشراكة الاستراتيجية مع روسيا، في خطوة وُصفت بأنها تعزز التحالف القائم بين البلدين في مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا.
وأوضح النائب روي دازا، عضو لجنة السياسة الخارجية في البرلمان، أن المعاهدة تمثل “رسالة سلام وسيادة في ظل السياق الجيوسياسي الراهن”، مؤكداً أنها تقوم على مبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ بنوده.
المعاهدة – التي ستخضع لمزيد من المشاورات والنقاش قبل التصويت النهائي عليها – تأتي امتداداً لاتفاقات سابقة بين كاراكاس وموسكو، كان آخرها توقيع الرئيسين نيكولاس مادورو وفلاديمير بوتين اتفاق تعاون لعشر سنوات يشمل مجالات عدة، من بينها الاستفادة من نظام الملاحة الروسي “غلوناس”.
وتحظى الخطوة بأهمية خاصة في ظل التصعيد الأميركي ضد فنزويلا، حيث أرسلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوات بحرية واسعة إلى الكاريبي بذريعة مكافحة المخدرات. وقد شنت القوات الأميركية خلال الأسابيع الماضية هجمات على ثلاثة زوارق قالت إنها كانت تحمل شحنات مخدرات متجهة إلى الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً، من دون تقديم أدلة قضائية تثبت الاتهامات الموجهة لفنزويلا.
في المقابل، نفت تقارير من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وجود سجل لإنتاج المخدرات في فنزويلا، مشيرة إلى أن دورها في مسارات التهريب العالمي هامشي.
من جهته، أدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التصعيد العسكري الأميركي، مجدداً دعم موسكو لكاراكاس. كما انضمت الصين إلى الانتقادات، ووصفت سياسة واشنطن في المنطقة بأنها “إكراه وترهيب”، داعية إلى وقف التهديدات العسكرية.
ورداً على الضغوط، نفذت القوات المسلحة الفنزويلية مناورات عسكرية واسعة شملت سلاح البحرية والقوات الجوية والمدفعية، ظهرت خلالها مقاتلات روسية الصنع من طراز سوخوي سو-30 MK2، في استعراض واضح للجاهزية والتنسيق العسكري مع موسكو.
البنك المركزي الأوروبي ينصح بالاحتفاظ بالعملات الورقية في المنازل تحسباً للأزمات
في خطوة أثارت الجدل، دعا البنك المركزي الأوروبي الأسر في منطقة اليورو إلى الاحتفاظ بجزء من أموالها نقداً داخل المنازل لمواجهة أي طوارئ محتملة، مثل انقطاع الكهرباء أو انهيار الأنظمة الرقمية.
التوصية التي جاءت ضمن تقرير اقتصادي حديث، بدت لافتة في توقيتها، إذ تأتي في ظل توسع غير مسبوق في استخدام البطاقات البنكية والدفع الإلكتروني، ما يثير تساؤلات حول مستقبل أنظمة الدفع إذا واجهت أوروبا أزمات مفاجئة.
التقرير أشار إلى أن الطلب على النقد يزداد بشكل حاد في أوقات الأزمات، كما حدث أثناء جائحة كورونا أو مع بداية الحرب في أوكرانيا، حيث يلجأ الناس إلى الأوراق النقدية باعتبارها ملاذاً آمناً. كما بيّن أن الأزمات المفاجئة مثل انقطاع الكهرباء الواسع في إسبانيا عام 2025 أظهرت أن النقود الورقية كانت الوسيلة الوحيدة المتاحة للشراء لساعات طويلة.
ويرى محللون أن هذه التوصية تحمل في طياتها رسالة إنذار مبكر، فالبنك المركزي الأوروبي يلمح إلى هشاشة البنية التحتية المالية الرقمية في حال حدوث أزمات واسعة، ما قد ينذر بكارثة اقتصادية أو اجتماعية إذا لم تكن هناك بدائل جاهزة.