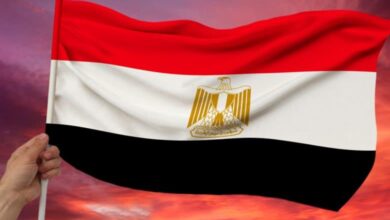نحن والعالم عدد 22 يناير 2026

يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 16 يناير 2026 وحتى 22 يناير 2026 .
شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الفترة من 16 إلى 22 يناير 2026 تسارعاً لافتاً في التحولات السياسية والأمنية، عكس عمق التصدعات في النظام الدولي القائم، وتزايد إدارة الأزمات بمنطق القوة والصفقات لا القواعد والمؤسسات.
من سوريا، حيث أُغلق فصل كامل من الصراع شرق الفرات، إلى واشنطن التي تعيد تعريف دورها العالمي وتحالفاتها الرئيسية عبر أدوات ضغط غير مسبوقة، وصولاً إلى إيران التي تقف على حافة انفجار داخلي–خارجي معقّد، تتقاطع هذه التطورات في رسم مشهد دولي وإقليمي أكثر هشاشة وأقل قابلية للاحتواء. ويقدّم هذا التقرير قراءة تحليلية لأبرز هذه الملفات وانعكاساتها على التوازنات العربية والإقليمية.
سوريا
دخل المشهد السوري خلال هذا الأسبوع مرحلة مفصلية مع تفكك قوات سوريا الديمقراطية وعودة السيطرة المركزية للدولة على شرق الفرات، في تحول أنهى فعلياً أحد أكثر نماذج الصراع تعقيداً منذ عام 2015.
لم يكن ما جرى نتيجة تسوية سياسية بقدر ما كان حصيلة انهيار ميداني واقتصادي واجتماعي متسارع، بتوافق أمريكي، فرض على الفاعلين القبول باتفاق اندماج اضطراري. غير أن انتقال السيطرة لا يعني نهاية التوتر، إذ تفتح ملفات السجون، والمخيمات، وإعادة بناء الإدارة والأمن بوصفها الاختبار الحقيقي لقدرة الدولة السورية على تثبيت هذا التحول ومنع ارتداداته.
من انهيار شرق الفرات إلى هدنة الحسكة: كيف تفككت «قسد» خطوةً خطوة؟
لم يكن اتفاق وقف إطلاق النار ودمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، الذي وُقّع في 18 كانون الثاني/يناير 2026، نتيجة مسار تفاوضي ناضج بقدر ما كان إعلاناً سياسياً متأخراً عن واقع ميداني انهار بسرعة قياسية شرق الفرات. فخلال أقل من أربعٍ وعشرين ساعة، انتقلت «قسد» من موقع السيطرة شبه الكاملة على الموارد والجغرافيا، إلى القبول باتفاق اندماج كامل، بعد أن فقدت ركائز قوتها واحدة تلو الأخرى.
بحسب ما تكشفه المعطيات الميدانية والدبلوماسية، فإن التحول لم يبدأ في الحسكة، ولا في لحظة التوقيع، بل قبل ذلك بساعات وأيام، مع إطلاق الجيش السوري عملية عسكرية متدرجة أعادت رسم خريطة السيطرة شرق سوريا، ووضعت «قسد» أمام مأزق وجودي غير مسبوق.
من دير حافر إلى الطبقة: كسر التوازن الميداني
الشرارة الأولى جاءت من الشرق الحلبي، حيث دخلت وحدات من الجيش السوري إلى دير حافر ومسكنة، قبل أن تتوسع العمليات باتجاه غرب الفرات، وصولاً إلى مدينة الطبقة وسد الفرات. هذا التقدم لم يكن تحركاً معزولاً، بل مساراً محسوباً استهدف تطويق مركز ثقل «قسد» في الرقة وريفها، وقطع خطوط الإمداد التي تربط شرق الفرات بغربه.
في الوقت نفسه، اندلعت تحركات عشائرية واسعة في دير الزور والحسكة، استهدفت مواقع «قسد» وعناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. هذه التحركات، التي جرت هذه المرة ضمن إطار عشائري جامع، أربكت خطوط الدفاع، وساهمت في انهيار سريع للمواقع، في ظل انسحابات متتالية لعناصر «قسد» وعجز قيادتها عن إعادة تجميع الوحدات المنتشرة على جبهات متباعدة.
مصادر ميدانية أشارت إلى أن التقدم لم يواجه مقاومة حقيقية، ليس بسبب التفوق العسكري فقط، بل نتيجة تفكك داخلي واضح، وقرار سوري بعدم ترك الملف مفتوحاً على استنزاف طويل.
الموارد الاستراتيجية: الضربة القاصمة
مع اتساع العمليات، انتقلت المعركة إلى جوهر القوة الاقتصادية لـ«قسد». فقد تمكن الجيش السوري، بمساندة عشائرية مباشرة، من السيطرة على مدينة الطبقة وسد الفرات، ثم على قواعد جوية ومواقع عسكرية وحقول نفط وغاز تُعدّ الأهم في البلاد، وفي مقدمتها حقل العمر، إلى جانب كونيكو والجفرة والتنك وصفيان.
وفق تقديرات عسكرية سورية، استعادت الدولة ما بين 70 و80% من إنتاج النفط والغاز خلال أيام قليلة. هذه الخسارة لم تكن تقنية أو رمزية، بل أصابت صلب البنية المالية والإدارية لـ«قسد»، وجرّدتها من القدرة على تمويل أجهزتها العسكرية والأمنية، أو الاستمرار في إدارة نموذج «الدولة الموازية» الذي قامت عليه الإدارة الذاتية طوال السنوات الماضية.
العامل العشائري: من الاحتقان إلى الحسم
التطور الأبرز الذي سرّع الانهيار تمثل في التحول العشائري. فبحسب مصادر حكومية، لعبت القبائل العربية في دير الزور والرقة والبوكمال دوراً مزدوجاً: عسكرياً عبر الهجمات المباشرة، وسياسياً عبر الدعوة إلى الانشقاق عن «قسد»، في خطاب تماهى مع طرح الدولة السورية حول وحدة البلاد ورفض السلاح خارج مؤسساتها.
هذا الحراك اختلف عن محطات سابقة بقيت محدودة وقابلة للاحتواء، إذ جاء هذه المرة على وقع تراجع الغطاء الدولي، وتغير فعلي في موازين القوى، ما أفقد «قسد» قدرتها على المناورة أو شراء الوقت.
في هذا السياق، كشفت مصادر سورية أن إخراج مقاتلي «قسد» من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب لم يكن نتيجة ضغط عسكري مباشر فقط، بل ثمرة مسار تنسيقي داخلي بدأ قبل أسابيع، شمل قنوات تواصل عشائرية فاعلة، وأسهم في تحييد جزء من القوة المقاتلة، وتفادي معركة داخل أحياء مكتظة.
اتفاق الاندماج: مخرج اضطراري لا تسوية متكافئة
أمام هذا الانهيار المتسارع، جاء توقيع الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي في 18 يناير، بوصفه مخرجاً اضطرارياً أكثر منه تسوية سياسية متكافئة. الاتفاق نصّ على وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وتسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية، واستلام الدولة كامل المعابر وحقول النفط والغاز، ودمج عناصر «قسد» بشكل فردي ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.
كما تضمّن دمج المؤسسات المدنية في الحسكة ضمن هياكل الدولة، والتزام قيادة «قسد» بعدم ضم فلول النظام السابق، وتسليم قوائم بأسمائهم. وبذلك، لم يعد الحديث عن إدارة مشتركة أو تقاسم نفوذ، بل عن تفكيك كامل لبنية «قسد» ككيان مستقل.
من الاتفاق إلى الفوضى: السجون ومخيم الهول
غير أن الاتفاق، على الرغم من شموليته، دخل فوراً في اختبار بالغ الخطورة مع انفجار ملف السجون ومخيم الهول. ففي الشدادي جنوبي الحسكة، فرّ عشرات من عناصر تنظيم الدولة من السجن الذي كان تحت سيطرة «قسد»، ما دفع القوات الحكومية إلى دخول المدينة وفرض طوق أمني واسع، وإطلاق عمليات تمشيط أسفرت عن اعتقال العشرات.
بالتوازي، تصاعد التوتر حول سجن الأقطان في الرقة، وسط اتهامات متبادلة بشأن محاولة فتح السجون أو استخدام ملف المعتقلين كورقة ضغط. وفي قلب هذا المشهد، جاء انسحاب «قسد» من محيط مخيم الهول، الذي يضم عشرات الآلاف من عائلات مقاتلي التنظيم، دون تنسيق معلن، ما اعتبرته دمشق خطوة خطيرة تهدد بفراغ أمني قد يعيد تنشيط خلايا التنظيم.
الحكومة السورية أعلنت أنها أخطرت الجانب الأميركي بنيّة الانسحاب، وتحركت سريعاً لسد الفراغ، مؤكدة جاهزيتها لاستلام المخيم والسجون، ورافضة ما وصفته بـ«الابتزاز الأمني» باستخدام ملف الإرهاب.
الحسكة: لحظة الاختبار الأخير
وسط هذا التصعيد، أعلنت دمشق في 20 يناير وقفاً لإطلاق النار لمدة أربعة أيام عقب تفاهم مشترك مع «قسد» بشأن مستقبل محافظة الحسكة. الهدنة قُدّمت كفرصة أخيرة لتنظيم عملية الدمج، مع تعهّد بعدم دخول القوات الحكومية إلى مراكز الحسكة والقامشلي، والاكتفاء بالانتشار على الأطراف.
لكن الوقائع الميدانية أظهرت أن المشكلة لم تعد في نصوص الاتفاق، بل في القدرة على تنفيذها. فغياب المركزية داخل «قسد»، وتعدد مراكز القرار، واستمرار مجموعات متمردة، جعل من الحسكة ساحة اختبار حقيقي: إما تثبيت مسار التفكيك والدمج، أو الانزلاق إلى مواجهات جديدة. وقد حدثت بالفعل خلال ال 24 ساعة الأولى من توقيع الاتفاق خروقات مهمة من عناصر محسوبة على قسد، سواء ضد المدنيين في الحسكة، أو باستهداف عناصر واليات للقوات السورية.
نهاية مشروع لا نهاية توتر
تتقاطع القراءات العسكرية والدبلوماسية على أن ما جرى شرق الفرات لا يمثل مجرد تحول عسكري عابر، بل نهاية مسار سياسي كامل بُني على توازنات لم تعد قائمة. فقوات سوريا الديمقراطية، بوصفها كياناً جامعاً تأسس عام 2015، فقدت قاعدتها الاجتماعية، وغطاءها الدولي، ومواردها الاقتصادية، لتتحول في النهاية إلى نواة محدودة مرتبطة بوحدات حماية الشعب، منزوعة القدرة على فرض مشروع مستقل.
بهذا المعنى، فإن ما تشهده الحسكة اليوم ليس بداية الأزمة، بل محطتها الأخيرة. فالاتفاق لم يأتِ ليؤسس شراكة جديدة، بل ليُغلق فصلاً كاملاً من الصراع على شرق الفرات، ويعيد المنطقة إلى معادلة السيطرة المركزية، وسط تحديات أمنية معقدة سيبقى ملف السجون والمخيمات عنوانها الأخطر.
تحليل المعهد المصري:
في ضوء التطورات المتسارعة شرق الفرات، يمكن القول إن تفكك «قسد» لم يكن نتيجة فشل تفاوضي بقدر ما كان انعكاساً لانهيار بنيوي أصاب المشروع برمّته. فخلال فترة زمنية وجيزة، فقدت «قسد» عناصر قوتها الثلاثة التي شكّلت أساس وجودها منذ عام 2015: التفوق العسكري النسبي، والموارد الاقتصادية المستقلة، والقدرة على ادّعاء تمثيل اجتماعي عابر للهويات.
التقدم الميداني السريع للجيش السوري، المترافق مع انخراط عشائري واسع، لم يكتفِ بتغيير خرائط السيطرة، بل كسر معادلة الردع النفسية التي منحت «قسد» هامش المناورة لسنوات. ومع سقوط حقول النفط والغاز، انتقلت الأزمة من مستوى السيطرة إلى مستوى الاستدامة، حيث بات الكيان عاجزاً عن تمويل ذاته أو إدارة فضائه الأمني والإداري. من هنا، جاء اتفاق الاندماج بوصفه مخرجاً اضطرارياً فرضه ميزان القوة الجديد، لا تسوية سياسية متوازنة.
والأهم أن ما جرى لا يشير فقط إلى نهاية صيغة حكم محلي، بل إلى إغلاق مرحلة كاملة من إدارة الصراع شرق الفرات، وعودة المنطقة إلى مركزية الدولة، مع بقاء تحديات أمنية كامنة – وفي مقدمتها ملف السجون والمخيمات، والتهديدات التي يمكن أن تأتي عبر الحدود مع العراق – قد تشكّل اختبارات مبكرة لقدرة الدولة على تثبيت هذا التحول ومنع تحوّله إلى توتر مزمن.
العامل الأمريكي مهم في التوصل إلى هكذا نتيجة، بعد أن تخلت بوضوح عن دعم “قسد”، وقالت بدون خجل، على لسان توم براك، ما معناه أن هذه الميليشيات قد استنفذت الغرض منها، وأن التعاون مع الدولة السورية سيكون أكثر فعالية في محاربة الرهاب متمثلاً في تنظيم الدولة. إلا أنه في تقديرنا أن أمريكا لم تنشأ هذا السيناريو ابتداءً، ولكنها اضطرت للتعامل في إطاره في ظل الفعالية والكفاءة التي تعاملت بها الدولة مع هذا الأمر.
في تقييم فرص نجاح الاتفاق، يبرز عامل واحد بوصفه المحدِّد الأساسي لمساره، وهو مدى التزام ميليشيات قسد بتنفيذ ما وقّعت عليه قيادتها السياسية والعسكرية، فالاتفاق، من حيث المبدأ، يستند إلى واقع ميداني حاسم وإرادة سياسية مركزية واضحة بإنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، من دون اللجوء إلى منطق الإقصاء أو العقاب الجماعي.
غير أن العقبة الفعلية لا تكمن في نصوص الاتفاق ولا في نيات الدولة، بل في سلوك شبكات مسلّحة داخل «قسد» تعاملت مع السيطرة السابقة بوصفها مكتسباً فصائلياً خاصاً لا نتيجة ظرفية لحرب وتوازنات مؤقتة. هذه المجموعات، المرتبطة تنظيمياً وأيديولوجياً بحزب العمال الكردستاني خارج سوريا، أظهرت ميلاً واضحاً لخرق التفاهمات، وتعطيل إجراءات الدمج، واستخدام ملفات حسّاسة كالسجون والمخيمات وأحياء مختلطة سكانياً كورقة ضغط، في محاولة للحفاظ على نفوذ الأمر الواقع.
وعليه، فإن نجاح الاتفاق لا يرتبط بقدرة الدولة على فرضه بقدر ما يرتبط بقدرتها على تفكيك هذه البُنى المتمرّدة وعزلها سياسياً وأمنياً، ومنعها من مصادرة القرار الكردي أو الزجّ بالمكوّن الكردي في مواجهة مع الدولة. فإذا جرى احتواء هذه المليشيات وتجريدها من أدوات التعطيل، فإن الاتفاق يمتلك كل مقومات التحوّل إلى إطار استقرار طويل الأمد؛ أما إذا استمر التمرّد الفصائلي، فسيغدو الفشل مسؤولية الجهات التي ترفض الانتقال من منطق الغنيمة إلى منطق الدولة.
توم برّاك: دور «قسد» العسكري انتهى والاندماج ضمن الدولة السورية هو المسار الواقعي
قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك إن المرحلة الراهنة تمثل، برأي واشنطن، أفضل فرصة أمام الأكراد في سوريا، في ظل الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، مؤكداً أن السياق السياسي والأمني الحالي يفتح باباً مختلفاً عمّا كان قائماً خلال سنوات الحرب.
وأوضح برّاك أن الدور الذي أُنشئت من أجله قوات سوريا الديمقراطية، باعتبارها قوة رئيسية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، قد انتهى عملياً على الأرض، مشيراً إلى أن الدولة السورية باتت اليوم مؤهلة لتولي مسؤوليات الأمن، بما في ذلك إدارة السجون ومراكز احتجاز عناصر التنظيم.
وأضاف أن الولايات المتحدة لا ترى مصلحة في بقاء وجود عسكري طويل الأمد في سوريا، معتبراً أن المرحلة الحالية تتيح مساراً جديداً يقوم على الاندماج الكامل ضمن دولة سورية موحدة، مع ضمان حقوق المواطنة لجميع المكوّنات.
وشدد المبعوث الأميركي على أن أولوية بلاده تتمثل في القضاء على ما تبقى من تنظيم الدولة، وتعزيز وحدة سوريا واستقرارها، مؤكداً في الوقت نفسه أن واشنطن تدعم مسارات المصالحة الوطنية، ولا تؤيد أي مشاريع انفصالية أو فدرالية يمكن أن تهدد وحدة البلاد.
وكشف برّاك أن الإدارة الأميركية أجرت اتصالات مكثفة مع الحكومة السورية وقيادة «قسد» بهدف تأمين اتفاق دمج واضح، ورسم إطار عملي لتنفيذه، موضحاً أن الاتفاق ينص على دمج مقاتلي «قسد» ضمن الجيش الوطني السوري.
وبيّن أن التفاهم يشمل أيضاً تسلّم دمشق للبنية التحتية الحيوية، والمعابر الحدودية، والسجون، إلى جانب ضمان حقوق سياسية ومدنية للأكراد وصفها بأنها أوسع بكثير مما أتاحه نموذج الحكم الذاتي الجزئي خلال سنوات الحرب.
وحذّر برّاك من أن أي توجه نحو الانفصال قد يفتح الباب أمام عدم الاستقرار أو عودة تنظيم الدولة، مؤكداً أن المسار الذي تدفع إليه واشنطن يقوم على تثبيت الحقوق ضمن إطار الدولة، لا خارجها.
وجاءت تصريحات المبعوث الأميركي عقب إعلان الرئاسة السورية، التوصل إلى تفاهم مشترك مع قوات سوريا الديمقراطية حول قضايا تتعلق بمستقبل محافظة الحسكة، بما في ذلك منح «قسد» مهلة أربعة أيام للتشاور الداخلي ووضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق والمؤسسات على الأرض.
الجيش الأميركي يبدأ نقل معتقلي “داعش” من شمال شرقي سوريا إلى العراق ضمن عملية أمنية منسّقة
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إطلاق مهمة جديدة لنقل معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية من سجون شمال شرقي سوريا إلى العراق، في خطوة قالت إنها تهدف إلى ضمان احتجازهم في مرافق “أكثر أماناً” ومنع أي محاولات هروب قد تهدد أمن المنطقة.
وذكرت سنتكوم أن العملية بدأت بنقل 150 معتقلاً من منشآت احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع آمن داخل العراق، مشيرة إلى أن الخطة قد تشمل لاحقاً نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من عناصر التنظيم الموجودين في السجون السورية إلى مرافق خاضعة لسيطرة السلطات العراقية.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر إن العملية تُنفَّذ “بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم الحكومة العراقية”، مؤكداً أن النقل المنظم والآمن للمعتقلين يُعد عنصراً أساسياً لمنع أي تهديد مباشر للولايات المتحدة أو لاستقرار المنطقة.
تنسيق مع دمشق وبغداد
وفي هذا السياق، أعلنت سنتكوم أن كوبر أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تناول وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا، ودعم عملية نقل معتقلي “داعش” إلى العراق. وأوضحت القيادة الأميركية أن كوبر شدد خلال الاتصال على ضرورة التزام القوات السورية وجميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وتجنب أي تحركات قد تعرقل سير عملية النقل.
وأضاف البيان أن الجانبين أكدا التزامهما المشترك بضمان “الهزيمة الكاملة” لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية.
من جهتها، أعلنت القوات المسلحة العراقية أن المجلس الوزاري للأمن الوطني وافق، بالتعاون مع التحالف الدولي، على استلام معتقلي التنظيم من السجون التي كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية الحكومية. وأكدت بغداد تسلّم الدفعة الأولى، التي تضم 150 معتقلاً من العراقيين ومن جنسيات أخرى.
استنفار أمني عراقي على الحدود مع سوريا وسط مخاوف من عودة تهديد داعش
رفعت السلطات العراقية مستوى التأهب الأمني على طول الحدود مع سوريا، ودفعت بتعزيزات عسكرية وأمنية مكثفة، عقب فرار عدد من معتقلي تنظيم «الدولة الإسلامية» من سجون كانت تديرها قوات سوريا الديمقراطية، على خلفية الصدامات الأخيرة مع الحكومة السورية. هذه التطورات أعادت إلى الواجهة تساؤلات عراقية حول احتمال تكرار سيناريو عام 2014، عندما اجتاح التنظيم مساحات واسعة من الأراضي العراقية.
وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية العراقيتان، إلى جانب هيئة الحشد الشعبي، تنفيذ خطة أمنية شاملة لتأمين الشريط الحدودي، تقوم على إنشاء ثلاثة أطواق أمنية متداخلة، تشمل انتشاراً بشرياً مكثفاً وإجراءات مراقبة نارية وتقنية. وأكدت الجهات الأمنية أن أي محاولة اقتراب لعناصر التنظيم من الحدود ستُواجه برد فوري وحاسم.
وفي السياق نفسه، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رفع درجات الجاهزية الأمنية وعدم الاستهانة بالتطورات الجارية في سوريا، مطالباً القوات العسكرية والأمنية بتشديد الرقابة على الحدود والمنافذ، وإرسال تعزيزات عاجلة، إلى جانب حث المواطنين على الإبلاغ عن أي تحركات أو نشاطات مشبوهة.
قراءات أمنية: خطر قائم دون عودة سيناريو 2014
ويرى خبراء أمنيون أن تنظيم «داعش» لا يزال يشكّل عامل تهديد، لكنه فقد القدرة التي مكّنته سابقاً من السيطرة على مدن ومحافظات كاملة. وقال الخبير الأمني العراقي مخلد حازم إن التنظيم بات اليوم «أداة للمناورة الإقليمية أكثر من كونه مشروع تمكين»، مشيراً إلى أن البنية القيادية والتنظيمية التي سمحت له بالتمدد في السابق لم تعد قائمة.
وأوضح حازم أن الأجهزة الأمنية العراقية شهدت تطوراً كبيراً منذ عام 2014، سواء على مستوى التنسيق أو جمع المعلومات أو ثقة الشارع، ما يجعل البيئة الحالية غير مهيأة لاحتضان التنظيم من جديد. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن غياب «الأمن المطلق» يفرض استمرار التحصينات، خاصة في المناطق الحدودية الحساسة.
سنجار… الثغرة الأخطر
من جانبه، اعتبر السياسي العراقي ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي أن الاستنفار الأمني العراقي إجراء طبيعي في ظل هشاشة الوضع على الجانب السوري، وغياب الثقة الكاملة بين الحكومتين. إلا أنه حذّر من أن التحدي الحقيقي يتمثل في منطقة جبل سنجار، التي وصفها بأنها «خارج السيطرة الفعلية للدولة العراقية»، في ظل وجود عناصر من حزب العمال الكردستاني، وصعوبة وصول القوات الأمنية إلى بعض مناطقها الجغرافية الوعرة.
وأشار النجيفي إلى أن بعض المخاوف الداخلية تحاول الربط بين النظام السوري الجديد وتنظيم «داعش»، لكنه اعتبر أن المعيار الفعلي هو موقف التحالف الدولي، الذي يتعاون مع دمشق في ملف مكافحة الإرهاب، ما يقلل من فرص عودة التنظيم إلى المشهد الإقليمي.
اضطرابات محتملة خارج إطار «داعش»
وفي تقييم أوسع للمشهد الأمني، لفت النجيفي إلى أن المخاطر التي قد تواجه العراق في المرحلة المقبلة لا ترتبط بالضرورة بتنظيم «داعش»، بل باحتمالات اضطراب داخلي ناتج عن تراجع النفوذ الإيراني أو ضعف قدرة الحكومة على ضبط الفصائل المسلحة. وأضاف أن انسحاب مقاتلين غير سوريين من حزب العمال الكردستاني من الأراضي السورية باتجاه العراق، ولا سيما إلى سنجار، قد يشكّل مصدر تهديد أمني جديد.
وبينما تستبعد غالبية التقديرات تكرار سيناريو عام 2014، تجمع القراءات الأمنية والسياسية على أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة عالية، وتنسيقاً إقليمياً مستمراً، لمعالجة الثغرات الحدودية ومنع أي فراغ أمني قد تستغله الجماعات المسلحة.
عبد الرحمن سلامة… من أمانة الرئاسة إلى محافظة الرقة
برز اسم عبد الرحمن سلامة خلال السنوات الأخيرة بوصفه أحد الوجوه القيادية التي تنقلت بين العمل العسكري والإداري، قبل أن يُعيَّن محافظاً لمحافظة الرقة في 19 كانون الثاني/يناير 2026، في مرحلة تشهد تحولات سياسية وأمنية واسعة شمالي وشرقي سوريا.
سلامة، الذي شغل سابقاً منصب نائب محافظ حلب، كان أول من تولّى منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية بعد انتصار الثورة السورية وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد، وظهر مراراً إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع خلال استقبال الوفود الرسمية والزيارات الخارجية، قبل أن يغادر القصر الرئاسي مع تعيين ماهر الشرع أميناً عاماً للرئاسة.
وُلد عبد الرحمن إبراهيم سلامة، المعروف بكنية “أبي إبراهيم”، عام 1971 في مدينة عندان بريف حلب، وينتمي إلى عائلة عُرفت بمعارضتها لنظام الأسد. ومن أبرز شخصيات العائلة عبد العزيز سلامة، القائد السابق للواء التوحيد، أحد أبرز فصائل الجيش السوري الحر، ثم القائد العام لـ“الجبهة الشامية” حتى منتصف عام 2015.
مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، كان سلامة يعمل في قطاع مقالع الحجارة، قبل أن ينخرط في الحراك الثوري ويلتحق لاحقاً بالمجموعات المسلحة في ريف حلب. وبحلول عام 2012، انضم إلى جبهة النصرة، وتولى منصب “أمير قطاع حلب” فيها حتى عام 2016.
عقب سيطرة قوات النظام السابق، بدعم روسي وإيراني، على مدينة حلب أواخر عام 2016، انتقل سلامة إلى إدلب، حيث قاد لواء عمر بن الخطاب ضمن هيئة تحرير الشام التي تشكلت عام 2017. وخلال تلك المرحلة، شارك في إدارة مناطق خارجة عن سيطرة النظام، وتولى مسؤوليات اقتصادية وخدمية، من بينها منصب المدير التنفيذي لشركة الراقي للإنشاءات، وإدارة مشروعات شملت مدارس ومستشفيات وتوسعة شبكات الطرق.
بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، عاد اسم سلامة إلى الواجهة السياسية، إذ شغل منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، قبل أن يُعيَّن في 24 نيسان/أبريل 2025 نائباً لمحافظ حلب، بقرار من المحافظ عزام الغريب، ومشرفاً إدارياً وأمنياً على مناطق عفرين، أعزاز، الباب، جرابلس، ومنبج في ريف حلب الشمالي والشرقي.
وأوضح قرار محافظ حلب آنذاك أن تعيين سلامة جاء في إطار تعزيز الإدارة المحلية، وتحسين التنسيق الخدمي والأمني، وتكثيف الحضور الإداري في المناطق المذكورة، ضمن خطة شاملة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان.
وفي 19 كانون الثاني/يناير 2026، صدر قرار بتعيين عبد الرحمن سلامة محافظاً للرقة، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. ورحّب محافظ حلب بتعيينه في منشور على حسابه الرسمي، واصفاً سلامة بأنه “صديق الكفاح ومسيرة التحرير”، ومشيداً بدوره خلال فترة عمله في محافظة حلب.
وجاء تعيين سلامة في سياق تصعيد ميداني سبق الاتفاق، عقب عملية عسكرية نفذها الجيش السوري في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، وسط اشتباكات متكررة مع قوات قسد، التي اتهمتها الحكومة بخرق التزاماتها الواردة في اتفاقي 10 مارس/آذار والأول من أبريل/نيسان 2025، وهو ما أدى لاحقاً إلى توسع المواجهات نحو مناطق الجزيرة السورية، وصولاً إلى إعادة ترتيب المشهد الإداري والأمني في محافظة الرقة.
مسؤول سوري: «شل» طلبت الخروج من حقل العمر والحكومة تتفاوض على تسوية نهائية
أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، أن شركة شل تقدّمت بطلب رسمي للانسحاب من حقل العمر النفطي شرقي سوريا، ونقل حصتها إلى الجهات الحكومية السورية، في تطور لافت يعكس التحولات الجارية في قطاع الطاقة بعد استعادة الدولة سيطرتها على أهم مكامن النفط.
وأوضح قبلاوي، خلال مؤتمر صحفي عُقد من داخل حقل العمر النفطي، أن دمشق لا تزال في مرحلة تفاوض مع «شل» بشأن بنود تسوية مالية تهدف إلى استعادة الملكية الكاملة للحقل، مشيراً إلى أن المباحثات تتركز على الجوانب المالية والقانونية المرتبطة بمرحلة ما قبل الانسحاب.
وفي سياق متصل، كشف المسؤول السوري عن اهتمام متزايد من شركات نفط أميركية بالاستثمار في قطاع الطاقة السوري، لافتاً إلى وجود تواصل مع شركتي شيفرون وكونوكو فيلبس، سواء في مجال النفط أو الغاز، ولا سيما في محافظة الحسكة، في مؤشر على عودة الاهتمام الدولي بالموارد السورية عقب الترتيبات السياسية والأمنية الأخيرة.
وبيّن قبلاوي أن حقل العمر، الذي يُعد أكبر حقل نفطي في سوريا والعمود الفقري لصادراتها النفطية، كان ينتج قبل الحرب نحو 50 ألف برميل يومياً، إلا أن إنتاجه تراجع خلال السنوات الماضية إلى نحو 5 آلاف برميل فقط، نتيجة ما وصفه بـ«الأساليب البدائية وغير الصحية» التي استُخدمت في استخراج النفط خارج المعايير الفنية.
وأكد أن الشركة السورية للبترول أعدّت خطة شاملة لإعادة تأهيل الحقل، تعتمد معايير تشغيل عالمية، وتهدف إلى رفع الإنتاج تدريجياً ليصل إلى ما بين 40 و50 ألف برميل يومياً، بما يضع الحقل مجدداً في قلب المعادلة النفطية السورية.
وأشار قبلاوي إلى أن الحكومة السورية تعمل بالتنسيق مع الجيش لاستلام جميع الحقول النفطية في شرق البلاد، موضحاً أن الشركة بدأت فعلياً بتسلّم عدد من الحقول الرئيسية، من بينها حقل العزبة، والعمر، والجفرة، والتنك، والثورة، على أن تُستكمل عملية الاستلام تباعاً خلال المرحلة المقبلة.
وعن الصورة العامة للإنتاج النفطي، أوضح أن سوريا كانت تنتج قبل عام 2011 ما بين 400 و500 ألف برميل يومياً، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي نحو 100 ألف برميل، بسبب الاستنزاف غير المنظم للآبار خلال سنوات الصراع، مؤكداً أن برامج إعادة التأهيل ستسهم في رفع الإنتاج تدريجياً وصولاً إلى مرحلة التصدير.
وختم قبلاوي بالإشارة إلى أن الشركة السورية للبترول تسعى لإحداث نقلة نوعية في قطاعي النفط والغاز، عبر شراكات مدروسة مع شركات محلية وأجنبية، تقوم على مبدأ السيادة الوطنية، وتحقق عوائد اقتصادية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد السوري خلال مرحلة التعافي.
تحقيق استقصائي يكشف معطيات جديدة عن اختفاء الصحفي الأميركي أوستن تايس في سوريا
كشف تحقيق استقصائي بثّه برنامج المتحري تفاصيل غير مسبوقة تتعلق بملف اختفاء الصحفي الأميركي أوستن تايس في سوريا، في إطار عملية اختراق رقمي واسعة استهدفت شبكات مرتبطة بفلول نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد عقب سقوطه.
التحقيق، الذي حمل عنوان «تسريبات فلول الأسد.. الاختراق الكبير»، استند إلى آلاف الدقائق من التسجيلات الصوتية، وبيانات ووثائق مسربة، إضافة إلى حسابات رقمية جرى اختراقها، كاشفاً عن شبكة معقدة أعادت تنظيم نفسها سياسياً وأمنياً ومالياً، وسعت إلى استعادة نفوذها عبر تحالفات إقليمية ودولية، في موازاة محاولات لإعادة التموضع داخل المشهد السوري.
وضمن هذا السياق، أزاح التحقيق الستار عن معطيات حساسة تتعلق بقضية أوستن تايس، الذي دخل سوريا عام 2012 في مهمة صحفية، قبل أن يُحتجز ويختفي أثره منذ ذلك الحين، في واحدة من أكثر القضايا غموضاً في العلاقة بين دمشق وواشنطن.
ومن أبرز ما توصل إليه التحقيق، تمكّن شخص يُدعى موسى، قال إنه عمل مرافقاً شخصياً للأسد بين عامي 2008 و2012، من التنصت على مكالمات هاتفية للواء بسام الحسن، المستشار الأمني السابق في القصر الجمهوري والمسؤول عن ملف الأسلحة الكيميائية، والذي تُوجَّه إليه اتهامات أميركية بالتورط في ملف الصحفي المفقود.
وكانت تقارير إعلامية غربية قد أشارت في العام الماضي إلى احتمال مقتل أوستن تايس بأوامر صادرة من أعلى مستويات القرار في النظام السوري السابق، وهي فرضية أعاد التحقيق إحياءها في ضوء التسريبات الجديدة.
وخلال إحدى المكالمات الهاتفية الموثقة، نفى بسام الحسن أن يكون طرفاً مباشراً في احتجاز تايس، مؤكداً أنه سعى منذ البداية إلى التعاون وتقديم معلومات تتعلق بالقضية، وطرحها في اجتماعات مع مسؤولين أميركيين بعلمهم الكامل. وأضاف أن تلك اللقاءات انتهت باتفاق غير معلن على عدم الخوض في تفاصيل الملف أو تسريب أي معلومات، ما أدى –وفق روايته– إلى تجميد مسار الكشف عن مصير الصحفي لاحقاً.
وفي ما يخص ظروف الاعتقال، قال الحسن إن العملية لم تكن مخططة مسبقاً، واصفاً ما جرى بأنه أقرب إلى حادث عرضي، وليس جزءاً من سيناريو أمني مُعدّ سلفاً.
كما تطرقت المكالمة إلى مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً، ظهر فيه أوستن تايس برفقة أشخاص وُصفوا بأنهم “جهاديون”. ووفق رواية الحسن، فإن فكرة تصوير المقطع نُقلت إليه على أنها توجيه رسمي صادر عن لونا الشبل، التي كانت تشغل منصب مسؤولة المكتب الإعلامي في القصر الرئاسي آنذاك. وأكد الحسن أنه عارض الفكرة واعتبرها غير مقنعة، إلا أن تنفيذ الفيديو مضى قدماً رغم اعتراضه.
ويضع التحقيق هذه المعطيات ضمن صورة أشمل، تُظهر كيف سعت شبكات مرتبطة بالنظام السابق إلى إعادة بناء نفوذها عبر المال والسلاح والدعم الخارجي، مستفيدة من علاقات مع روسيا وإيران، قبل أن تُكشف تحركاتها من داخل بياناتها الصوتية والرقمية المسربة.
وتعيد هذه التسريبات تسليط الضوء على ملف أوستن تايس بوصفه قضية مفتوحة لم تُغلق بعد، وسط مطالب متجددة بكشف مصيره ومحاسبة المسؤولين عن احتجازه، في ضوء ما يصفه معدّو التحقيق بأنه أدلة ومعطيات غير مسبوقة قد تعيد تحريك أحد أكثر الملفات حساسية في التاريخ الحديث للعلاقات الأميركية السورية.
أمريكا
كشفت تحركات الإدارة الأميركية خلال هذا الأسبوع عن ملامح نهج جديد يقوم على إعادة هندسة النظام الدولي عبر أدوات ضغط اقتصادية وأمنية مباشرة، بعيداً عن الأطر متعددة الأطراف. من “مجلس السلام” كبديل وظيفي للأمم المتحدة، إلى اتفاق غرينلاند الذي منح واشنطن نفوذاً استراتيجياً دائماً دون ضم رسمي، مروراً بالصدام المفتوح مع الاحتياطي الفيدرالي، تتضح ملامح سياسة تضع الهيمنة فوق الاستقرار. هذا المسار، وإن وفّر مكاسب تكتيكية سريعة، يطرح تساؤلات عميقة حول كلفة تآكل الثقة بالحليف الأميركي ومستقبل القيادة الغربية للنظام العالمي.
مجلس السلام لغزة: بين إدارة ما بعد الحرب وشبح الوصاية الدولية – تحليل أولي للمعهد المصري للدراسات
لم يكن إعلان الإدارة الأميركية عن تشكيل ما أُطلق عليه اسم مجلس السلام لإدارة قطاع غزة، وما يصاحبه من أليات ومؤسسات، مجرد تفصيل إداري في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بل شكّل لحظة سياسية كاشفة عن تحوّل عميق في مقاربة إدارة الصراع. فالانتقال هنا ليس من الحرب إلى السلام، بقدر ما هو انتقال من الحرب إلى نموذج إدارة دولية–أمنية، تُعاد فيه صياغة السلطة، والشرعية، وحدود القرار الفلسطيني، تحت سلطة “انتداب” واضح.
المجلس الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنفسه، ويضم “مجلسه التنفيذي التأسيسي” شخصيات أميركية وغربية وازنة مثل ماركو روبيو وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وتوني بلير وروبرت جابرييل، لا يُخفي طبيعته: إدارة مركزية أميركية للمرحلة الانتقالية في غزة، مع واجهات إقليمية ودولية أقل وزناً في سلّم القرار.
وفق الهيكلية المعلنة، تُدار غزة عبر هيكل معقد يتكون من أربع طبقات متداخلة:
1. مجلس السلام: المرجعية السياسية العليا، برئاسة ترامب شخصياً، وصاحب التفويض الدولي والقدرة على توجيه المسارات كافة. وقد عين ترامب مستشارين للمجلس (أحدهما حاخام صهيوني) لقيادة العمليات اليومية والاستراتيجيات!
2. المجلس التنفيذي التأسيسي: نواة القرار الأميركي–الغربي، حيث تُحدَّد الأولويات ويتابع تنفيذ الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.
3. مجلس غزة التنفيذي: يضم بعض أهم أعضاء المجلس التأسيسي، مضاف إليهم شخصيات إقليمية ودولية، ويؤدي دوراً داعماً للممثل الأعلى (وهو من بين أعضاء المجلس التنفيذي وسيعمل كممثل أعلى لغزة، أي مندوباً سامياً بوضوح اكبر!)، ولحكومة التكنوقراط في تبني “الحوكمة الفعالة”، وتقديم الخدمات الداعمة “للسلام والاستقرار ورفاهية أهل غزة”.
4. اللجنة الوطنية الفلسطينية (التكنوقراط): الذراع التنفيذية اليومية داخل القطاع.
هذه البنية تُظهر بوضوح أن السلطة موزعة شكلياً، لكنها مركّزة فعلياً في المستوى الأعلى. فاللجنة الفلسطينية، رغم طابعها المهني ورئاسة علي شعث لها، تعمل تحت إشراف مباشر من الممثل السامي، وضمن سقف سياسي وأمني لا تملكه.
ورغم الغطاء القانوني الدولي المستند إلى قرار مجلس الأمن 2803/2025، والطابع الانتقالي المُعلن، تكشف الصلاحيات الأمنية الممنوحة لقوة الاستقرار الدولية الخاضعة لهذه الإدارة، ولا سيما في ملف نزع السلاح، عن تقديم الأمن بوصفه شرطاً سابقاً للإغاثة والإعمار، بما يعيد إنتاج معادلة “الاستقرار مقابل الحقوق”.
ميدانياً، يتقاطع هذا الإطار مع قبول فلسطيني اضطراري تمليه الكارثة الإنسانية، لكنه يقترن بقلق سياسي عميق من تحوّل المؤقت إلى دائم، ومن استبدال الاحتلال العسكري بصيغة وصاية دولية تُدار فيها غزة إدارياً دون تمكين سيادي حقيقي لأي طرف فلسطيني.
يظهر في الخلفيات المهنية للشخصيات المكلّفة بإدارة ملف غزة ضمن «مجلس السلام» أن الإطار المطروح يتجاوز المقاربة المدنية–الإنسانية، ليقوم على ائتلاف نخب أمنية وسياسية ومالية وإدارية مُعدّ لإدارة مناطق ما بعد الصراع وفق منطق الضبط والاستقرار المشروط.
يتولى الجانب الأمني ضابط رفيع المستوى، اللواء جاسبر جيفرز، الذي يشغل منصب نائب مدير العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب في هيئة الأركان الأميركية، بما يعكس أولوية المقاربة العسكرية–الاستخباراتية.
ويُسند الدور الميداني–التنسيقي (المندوب السامي) إلى نيكولاي إفتيموف ملادينوف، البلغاري صاحب التاريخ الطويل في إدارة بعثات أممية متعددة في بيئات نزاع.
أما البعد الإداري–التعاقدي، فيمثله أحد مستشاري مجلس السلام، جوش غرينباوم، المفوض لدائرة المشتريات الفيدرالية الأميركية ، أما المستشار الثاني فهو الحاخام الصهيوني آرييه لايتستون، الرئيس التنفيذي لمعهد اتفاقيات أبراهام، المرتبط بمسار دمج إسرائيل إقليمياً عبر «السلام الاقتصادي».
إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وتوني بلير وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يشمل المجلس التنفيذي التأسيسي روبرت غابرييل الابن، وهو نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، القادم من صلب منظومة صنع القرار الأمني في واشنطن. كما يبرز على المستوى المالي–الاقتصادي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة Apollo Global Management، بما يربط إعادة الإعمار بآليات التمويل الدولي والاستثمار عالي المخاطر.
كما ينبغي التوقف عند تركيبة مجلس غزة التنفيذي من حيث التمثيل الإقليمي، إذ يضم شخصيات رفيعة المستوى تمثل دولاً محورية هي مصر وقطر والإمارات وتركيا بما يعكس محاولة أميركية لتأمين غطاء عربي–إقليمي متنوع يجمع بين أدوار الوساطة الأمنية (مصر)، والتمويل والدعم السياسي (قطر والإمارات)، والانخراط الإقليمي ذي الطابع السياسي–الأمني (تركيا).
غير أن اللافت هو الغياب السعودي عن هذه الصيغة، وهو غياب ذو دلالة سياسية، يشير إما إلى تحفظ سعودي على نموذج الوصاية المقترح، أو إلى رغبة الرياض في عدم الانخراط المباشر في إطار تنفيذي قد يتحول إلى إدارة طويلة الأمد لغزة خارج مسار التسوية الشاملة.
القراءة الأوسع لتشكيل نموذج الوصاية الدولية في غزة لا تقف عند حدود إدارة قطاع مُدمَّر أو تنظيم مرحلة ما بعد الحرب، بل تكشف عن مختبر سياسي–أمني يُراد له أن يكون قابلاً للتعميم إقليمياً. فغزة، بحكم صغر مساحتها، وكثافة أزمتها الإنسانية، وانهاك بنيتها السياسية، تُشكّل بيئة مثالية لاختبار نموذج حكم تُدار فيه الجغرافيا عبر أدوات دولية ظاهرها إنساني وتنموي، وجوهرها أمني–سياسي.
الأخطر في هذا النموذج أنه لا يحتاج إلى إنهاء الصراع، بل إلى تجميده وإدارته، بما يضمن لإسرائيل أمناً طويل الأمد، وللولايات المتحدة دوراً مركزياً في إعادة تشكيل الشرق الأوسط.
إن التشكيل المعقد رفيع المستوى لمجلس السلام ومؤسساته، والذي لا يزال في طور التجريب، لا يبدو لنا أنه سيركز فقط على إدارة غزة، ولكنه قد يتطور لإدارة المنطقة بأكملها، أو حتى لإدارة العالم من خلال “هيئة أمم متحدة” خاصة بترامب!
ترامب يدعو بوتين للانضمام إلى «مجلس السلام» ويهدد فرنسا برسوم جمركية قاسية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى ما وصفه بـ«مجلس السلام العالمي»، وهي مبادرة تقودها واشنطن وتركّز في الأساس على ملف الحرب في قطاع غزة، مع توسيع صلاحياتها لاحقاً لمعالجة نزاعات دولية أخرى.
وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في ولاية فلوريدا رداً على سؤال حول ما إذا كان قد دعا بوتين إلى الانضمام للمجلس: «نعم، لقد دُعي»، مشيراً إلى أن العضوية الدائمة في المجلس مشروطة بدفع مساهمة مالية قدرها مليار دولار.
وفي موسكو، أكد الكرملين تلقي الدعوة، إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الرئيس بوتين تلقى بالفعل دعوة للانضمام إلى «مجلس السلام»، مضيفاً أن موسكو تعمل حالياً على «توضيح كل التفاصيل الدقيقة» المتعلقة بالمبادرة مع الجانب الأميركي، من دون الكشف عن موقف نهائي حتى الآن.
تهديد مباشر لفرنسا
في المقابل، صعّد ترامب لهجته تجاه فرنسا، ملوّحاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات النبيذ والشمبانيا الفرنسية، إذا استمرت باريس في رفض الانضمام إلى المبادرة.
وقال ترامب إن هذه الخطوة ستدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة النظر في موقفه، مضيفاً بسخرية رداً على سؤال بشأن رفض ماكرون: «هل قال ذلك؟ لا أحد يريده أصلاً لأنه سيغادر منصبه قريباً جداً».
وأضاف الرئيس الأميركي: «سأفرض رسوماً جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين… سينضم ماكرون إلى المجلس، لكنه ليس مضطراً لذلك»، في إشارة اعتبرها مراقبون تصعيداً اقتصادياً ذا طابع سياسي واضح.
وبحسب مصدر مقرّب من الرئاسة الفرنسية، فإن باريس تعتزم في هذه المرحلة عدم الانضمام إلى المبادرة الأميركية، معتبرة أن صيغة «مجلس السلام» ما تزال غامضة ولا تتوافق مع الرؤية الفرنسية لمعالجة النزاعات الدولية.
خلفية المبادرة
وكان ترامب قد طرح فكرة إنشاء «مجلس السلام» للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن خطة أعلنها لإنهاء الحرب في غزة. غير أن دعوات رسمية وُجهت إلى عدد من قادة العالم خلال الأسبوع الماضي أظهرت توسّعاً في دور المجلس ليشمل ملفات نزاعات عالمية أوسع، مع ربط المشاركة فيه باعتبارات سياسية واقتصادية.
رسائل متبادلة مع ماكرون
وفي سياق متصل، نشر ترامب عبر منصته «تروث سوشيال» صوراً لمقتطفات من رسائل قال إنها تلقاها من الرئيس الفرنسي، تتضمن اقتراحاً بعقد اجتماع لمجموعة السبع في باريس بعد ظهر يوم الخميس، عقب منتدى دافوس الاقتصادي.
كما أظهرت الرسائل المنشورة دعوة من ماكرون لترامب لتناول العشاء في باريس في اليوم نفسه. ولم يُعرف ما إذا كان ترامب قد ردّ على المقترح، في وقت لم يصدر فيه تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن هذه المراسلات.
ويأتي هذا السجال في ظل توترات متزايدة بين واشنطن وعدد من حلفائها التقليديين حول مقاربة إدارة ترامب للملفات الدولية، واستخدامها أدوات اقتصادية وتجارية للضغط السياسي ضمن مبادراتها الدبلوماسية الجديدة.
نتنياهو يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام”
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبول الأخير دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام” المعني بقطاع غزة.
وقال المكتب في بيان: “أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبوله دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسينضم عضوا في المجلس الأعلى للسلام، الذي سيتألف من قادة العالم”.
وما زالت دول كثيرة مترددة بالانضمام إلى مجلس السلام المقرر أن يعلن ترامب رسميا عن أعضائه، الخميس، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا.
وجاءت دعوة ترامب لنتنياهو للمشاركة في “مجلس السلام” على الرغم من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 لرئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تأتي رغم محاكمة نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
تحليل المعهد المصري:
يمكن قراءة قبول بنيامين نتنياهو الانضمام إلى “مجلس السلام” الخاص بغزة بوصفه ذروة مفارقة سياسية وأخلاقية تعكس تحوّلاً عميقاً في منطق إدارة الصراعات الدولية، لا باعتباره خطوة نحو السلام بقدر ما هو إعادة تموضع للفاعل المتهم بالجريمة داخل بنية الحل؛ فـبنيامين نتنياهو، المسؤول سياسياً وعسكرياً عن حرب وُصفت على نطاق واسع بأنها إبادة جماعية، والملاحق بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، يُنقل فجأة من خانة المتهم إلى موقع “الشريك في السلام”، في عملية تُفرغ مفهوم العدالة من مضمونه وتستبدله بإدارة سياسية للنتائج.
المجلس، كما يظهر من ميثاقه وتركيبته، لا يأتي بعد المحاسبة بل يعمل عملياً كبديل عنها، إذ يُعاد تعريف السلام بوصفه “استقراراً أمنياً” و“نزع سلاح” و“إدارة انتقالية”، وهي المفردات ذاتها التي استخدمتها إسرائيل لتبرير الحرب، ما يمنحها حقاً غير معلن في تحديد شروط ما بعد الدمار. إدخال نتنياهو إلى هذا الإطار، برعاية مباشرة من دونالد ترامب، يحقق له مظلة سياسية دولية، ويُعيد تسويق صورته كرجل دولة فاعل لا كمرتكب جرائم حرب، ويخلق تضاداً عملياً مع أي مسار قضائي دولي، إذ يصعب ملاحقة من يجلس على طاولة “السلام العالمي”.
وفي الوقت ذاته، يكشف هذا القبول طبيعة السلام المطروح: سلام بلا إنهاء للاحتلال، بلا مساءلة، وبلا تمثيل حقيقي للضحايا، حيث تُحوَّل غزة من قضية حقوق وعدالة إلى ملف أمني–اقتصادي يُدار بعد كسرها، ويُدمج مرتكبو العنف في هندسة المستقبل بدل محاسبتهم. الرسالة هنا مزدوجة: للعالم، أن الجرائم الكبرى قابلة للتجاوز إذا كان مرتكبها حليفاً استراتيجياً؛ وللفلسطينيين، أن من قاد تدمير غزة سيشارك في تقرير مصيرها، في تجلٍّ صارخ لتحول النظام الدولي من خطاب “القواعد والقانون” إلى منطق “إدارة ما بعد القوة”، حيث يُكافأ الفاعل الأقوى بمقعد في الحل، لا بمساءلة على ما ارتكبه. خريطة المواقف الدولية من “مجلس السلام” الذي أطلقه ترامب: قبول عربي–إقليمي ورفض أوروبي وتحفّظ دولي
تتواصل ردود الفعل الدولية على مبادرة “مجلس السلام” التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت تتضح فيه تدريجياً خريطة الدول المؤيدة والرافضة والمتحفظة على الانضمام إلى المجلس، الذي يُتوقع أن يتولى إدارة ملفات إقليمية ودولية، وعلى رأسها وقف إطلاق النار في غزة.
وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قد قال إن ما بين 20 و25 من قادة العالم وافقوا بالفعل على الانضمام إلى المجلس، مشيراً إلى أن إعلاناً رسمياً بهذا الشأن سيصدر خلال أيام على هامش منتدى دافوس. وبحسب معطيات متقاطعة، فإن نحو 50 دولة تلقت دعوة رسمية من واشنطن للمشاركة، في حين تفاوتت ردودها بين القبول والرفض والتحفظ.
دول أعلنت قبولها الانضمام
أبدت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب إسرائيل وبعض الدول الأخرى، موافقتها على دعوة الانضمام إلى “مجلس السلام”، معتبرة أن الخطوة قد تسهم في دفع مسار وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار، ولا سيما في غزة. ومن أبرز هذه الدول:
- مصر: أعلنت القاهرة قبول الدعوة، وبدء استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة.
- قطر: وافقت الدوحة على الانضمام ضمن بيان مشترك مع دول عربية وإسلامية.
- تركيا: أكد الرئيس رجب طيب أردوغان مشاركة بلاده عبر وزير الخارجية هاكان فيدان.
- أذربيجان: أعلنت إرسال كتاب الموافقة الرسمي إلى واشنطن.
- إسرائيل: أفاد مكتب رئيس الوزراء بأن بنيامين نتنياهو قبل الدعوة وسينضم إلى المجلس الأعلى للسلام.
- الإمارات: رأت أبوظبي أن الانضمام يعكس دعمها للتنفيذ الكامل لخطة السلام في غزة.
- المغرب: أعلن الملك محمد السادس الرد بالإيجاب على الدعوة، مشيداً برؤية ترامب.
- البحرين: أكدت أن قرارها يأتي دعماً لتطبيق خطة السلام.
- باكستان: قالت إسلام آباد إن مشاركتها تهدف إلى تحقيق سلام دائم في غزة.
- بيلاروسيا: أعلن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو توقيع وثيقة الانضمام، معرباً عن أمله في المساهمة أيضاً في السلام بأوكرانيا.
- الأردن وإندونيسيا: انضمتا ضمن بيانات مشتركة مع دول عربية وإسلامية أخرى.
دول رفضت الانضمام
في المقابل، أعلنت عدة دول أوروبية رفضها الانضمام إلى المجلس، معربة عن مخاوف تتعلق باحترام القانون الدولي وهيكلية الأمم المتحدة:
- فرنسا: اعتبرت أن لوائح المجلس تتجاوز ملف غزة وتثير تساؤلات بشأن احترام مبادئ الأمم المتحدة.
- ألمانيا: ذكر المستشار الألماني أنه مستعد للانضمام لمجلس السلام من أجل غزة، لكننا لا نستطيع قبول الخطة بصيغتها الحالية.
- إيطاليا: أبدت تحفظاً دستورياً على الانضمام إلى كيان يقوده رئيس دولة واحدة.
- النرويج: شددت على ضرورة توضيح علاقة المجلس بالأطر الدولية القائمة.
- السويد: أكدت أنها لن تشارك في المبادرة.
- فنلندا: رأت أن الأمم المتحدة تبقى الإطار الأفضل للوساطة في النزاعات.
- سلوفينيا: أعلنت التزامها بالنظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة.
دول متحفظة ولم تحسم موقفها
اختارت دول أخرى التريث، مبديةً ملاحظات سياسية أو قانونية دون إعلان موقف نهائي:
- الصين: أكدت تمسكها بالنظام الدولي الذي تشكل الأمم المتحدة عموده الفقري.
- كندا: أبدت رغبة في “الوجود على الطاولة”، لكنها رفضت دفع أموال مقابل الانضمام (وقد سحب ترامب دعوته لكندا لاحقاً!).
- ماليزيا: وصفت المجلس بأنه لا يشكل حلاً معقولاً في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.
- أوكرانيا: أشار رئيسها فولوديمير زيلينسكي إلى صعوبة تخيل وجود بلاده وروسيا في مجلس واحد.
دول تلقت الدعوة ولم تعلن موقفها
وأكدت دول عديدة تسلمها دعوات رسمية من واشنطن، من بينها: بولندا، اليابان، بريطانيا، إسبانيا، الهند، البرازيل، أستراليا، هولندا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، النمسا، اليونان، أيرلندا، البرتغال، رومانيا، نيوزيلندا، وتايلاند، من دون إعلان قرار نهائي حتى الآن.
الموقف الروسي
وفي تطور لافت، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه كلف وزارة الخارجية بدراسة الدعوة الأميركية والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين قبل الرد، قبل أن يعلن ترامب لاحقاً أن موسكو وافقت على الانضمام، في خطوة لم يصدر بشأنها تأكيد روسي رسمي نهائي.
تحفّظ دولي واسع على «مجلس السلام» الذي اقترحه ترامب مقابل مليار دولار للمقعد الدائم
قوبلت مبادرة دونالد ترامب لإنشاء ما أطلق عليه اسم «مجلس السلام» بردود فعل متحفظة من عدد من الدول، وسط جدل سياسي وقانوني واسع بشأن طبيعة المجلس، وصلاحياته، واشتراطه دفع مليار دولار للحصول على مقعد دائم فيه، في خطوة اعتبرها دبلوماسيون خروجاً غير مسبوق عن الأعراف الدولية.
المجلس الذي طُرح في البداية كآلية للإشراف على إعادة إعمار غزة بعد وقف إطلاق النار، تبيّن – وفق ميثاق حصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية – أنه يتمتع بصلاحيات أوسع بكثير، تشمل التدخل في حل النزاعات المسلحة حول العالم، ما جعله يبدو، في نظر منتقديه، ككيان موازٍ أو بديل محتمل لمنظومة الأمم المتحدة.
تحفظ غربي وتساؤلات قانونية
في كندا، قال مصدر حكومي إن أوتاوا «لن تدفع مقابل الحصول على مقعد»، موضحاً أن رئيس الوزراء مارك كارني لا يزال يدرس الدعوة من حيث المبدأ، من دون الالتزام بالصيغة المالية المطروحة.
أما فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، فقد أعلنت صراحة أنها لا تعتزم الانضمام إلى المجلس في هذه المرحلة. ونقلت مصادر قريبة من الرئيس إيمانويل ماكرون أن المبادرة «تثير تساؤلات جوهرية»، خصوصاً لجهة احترام مبادئ وهيكلية الأمم المتحدة، معتبرة أن إنشاء كيان موازٍ للسلام والأمن الدولي يمس بجوهر النظام متعدد الأطراف.
قبول مغربي ودراسة أردنية
في المقابل، أعلنت المغرب قبولها الدعوة، إذ أفادت وزارة الخارجية بأن الملك محمد السادس أشاد بـ«رؤية ترامب للسلام» ووافق على الانضمام، مع التعهد بالمصادقة على الميثاق التأسيسي للمجلس.
كما تلقّى عبد الله الثاني دعوة رسمية، وأكدت الخارجية الأردنية أن عمّان تدرس الوثائق المرتبطة بالمبادرة وفق الإجراءات القانونية الداخلية، من دون إعلان موقف نهائي.
تصادم مباشر مع منظومة الأمم المتحدة
يثير «ميثاق مجلس السلام» انتقادات حادة، إذ يوجّه اتهامات مباشرة إلى «المقاربات والمؤسسات التي فشلت مراراً»، في إشارة واضحة إلى الأمم المتحدة، ويدعو إلى التحلي بـ«الشجاعة للانفصال عنها».
هذا الطرح دفع مسؤولين أمميين إلى الرد علناً. فقد شدد فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، على أن مجلس الأمن وافق على إنشاء آلية مرتبطة بخطة غزة «لهذا الغرض تحديداً»، وليس لإنشاء كيان بديل عن الأمم المتحدة.
كما أكدت لانيس كولينز أن «المنظمة العالمية المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين هي الأمم المتحدة»، في رفض واضح لفكرة الازدواجية المؤسسية.
مجلس برئاسة ترامب وصلاحيات استثنائية
وفق الميثاق، سيكون ترامب أول رئيس لمجلس السلام، ويتمتع بصلاحيات واسعة، من بينها تجديد عضوية الدول. كما ينص على أن مدة عضوية أي دولة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إلا الدول التي تدفع أكثر من مليار دولار خلال السنة الأولى، إذ تُمنح عملياً امتيازات دائمة، ما حوّل المبادرة إلى ما يشبه «نادي اشتراك سياسي–مالي» بدل إطار دولي توافقي.
سياق سياسي وإنساني ضاغط
يأتي الجدل حول المجلس في وقت تشهد فيه غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة. فبحسب الأمم المتحدة، نزح نحو 90% من سكان القطاع، أي ما يقارب 1.9 مليون شخص. كما سجلت وفيات بين الأطفال بسبب البرد القارس، وسط تحذيرات من الأونروا من انتشار أمراض بمستويات قياسية نتيجة انهيار النظام الصحي.
في هذا السياق، يرى مراقبون أن ربط «مجلس السلام» بإعادة إعمار غزة يمنحه غطاءً إنسانياً، لكنه في جوهره يعكس رؤية ترامب للعالم: تقليص دور المؤسسات متعددة الأطراف، واستبدالها بهياكل تقودها الولايات المتحدة وتُدار بمنطق النفوذ والتمويل.
التحفظ الدولي على «مجلس السلام» لا يتعلق فقط بقيمة المليار دولار، بل بجوهر النظام الدولي نفسه. فالمبادرة تضع الدول أمام معادلة حساسة:
إما الانضمام إلى إطار جديد تقوده واشنطن بشروط مالية وسياسية غير مسبوقة، أو التمسك بشرعية الأمم المتحدة كنظام عالمي، رغم ما يعانيه من أزمات وفشل.
وبينما قبلت بعض الدول الدعوة أو تدرسها، يبدو أن القوى الكبرى في أوروبا تتعامل معها بوصفها اختباراً خطيراً لمستقبل التعددية الدولية، لا مجرد مبادرة سلام عابرة.
ترامب يعلن “وصولاً أميركياً كاملاً” إلى غرينلاند باتفاق إطار مع الناتو… وسيادة دنماركية على الورق
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه توصل إلى اتفاق إطار مع حلف شمال الأطلسي يمنح الولايات المتحدة “وصولاً كاملاً ودائماً” إلى غرينلاند، في خطوة خففت من حدة التوتر المتصاعد مع أوروبا بعد أسابيع من التصعيد، لكنهــا فتحت في الوقت نفسه نقاشاً واسعاً حول مستقبل السيادة والأمن في القطب الشمالي.
وجاء الإعلان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بعد تراجع ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية على أوروبا واستبعاده استخدام القوة لضم الجزيرة. وقال ترامب إن الاتفاق الجديد سيكون “أكثر سخاءً بكثير للولايات المتحدة”، مؤكداً أن الوصول الأميركي “لا سقف زمنياً له”، ومتجنباً الإجابة المباشرة عن أسئلة تتعلق بالسيادة.
في المقابل، شددت الدنمارك على أن سيادتها على غرينلاند “ليست موضع نقاش”، فيما أكد رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن أن بلاده منفتحة على تحسين الشراكة، لكن “السيادة خط أحمر”. وأضاف أنه لا يزال يفتقر إلى تفاصيل كثيرة حول مضمون الاتفاق.
تعزيز عسكري وحظر استثمارات روسية وصينية
وبحسب مصادر مطلعة، اتفق ترامب مع الأمين العام للناتو مارك روته على إطلاق محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند لتحديث اتفاق الدفاع الموقّع عام 1951، بما يسمح بتوسيع الوجود العسكري الأميركي وتعزيز البنية الدفاعية في الجزيرة. كما يشمل الإطار منع الاستثمارات الروسية والصينية في غرينلاند، في مسعى لاحتواء نفوذ موسكو وبكين في القطب الشمالي.
وقال روته إن على قادة الناتو العسكريين العمل على تحديد المتطلبات الأمنية الإضافية بسرعة، معرباً عن أمله في الانتهاء من ذلك خلال عام 2026. وأشار إلى أن استغلال المعادن لم يُبحث في اجتماعه مع ترامب، على أن تُناقش التفاصيل لاحقاً بين الأطراف المعنية.
ارتياح الأسواق وقلق الحلفاء
وأدى تراجع ترامب عن التصعيد إلى ارتداد إيجابي في الأسواق الأوروبية واقتراب مؤشرات وول ستريت من مستويات قياسية، غير أن مسؤولين أوروبيين حذروا من أن الضرر الذي لحق بالثقة عبر الأطلسي قد يكون عميقاً. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن العلاقات مع واشنطن “تلقت ضربة كبيرة”، فيما دعت دول مثل فنلندا وبريطانيا إلى تعزيز الوجود الدائم للناتو في القطب الشمالي.
غرينلاند بين الأمن والسيادة
ويستند الاتفاق القائم إلى ترتيبات تعود للحرب الباردة، إذ يمنح اتفاق 1951 الولايات المتحدة حق إنشاء قواعد عسكرية والتحرك بحرية داخل أراضي غرينلاند مع إخطار كوبنهاغن ونووك. وتحتفظ واشنطن بقاعدة بيتوفيك الجوية في شمال الجزيرة، بينما يرى خبراء دنماركيون أن النقاشات المقبلة ستتركز على منظومات دفاع صاروخي وقدرات إنذار مبكر، إضافة إلى تحجيم أي دور روسي أو صيني.
من جهتها، نفت الصين الاتهامات الأميركية، معتبرة أن وصفها “تهديداً” في القطب الشمالي لا يستند إلى وقائع، ومؤكدة أن أنشطتها العلمية والتجارية تلتزم بالقانون الدولي.
رغم التأكيدات المتكررة على احترام السيادة الدنماركية، يرى دبلوماسيون ومحللون أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة نفوذاً أمنياً واستراتيجياً غير مسبوق في غرينلاند، ويحوّل الجزيرة عملياً إلى محور مركزي للدفاع الأطلسي في القطب الشمالي. وبين ارتياح مؤقت في الأسواق وقلق متزايد لدى الحلفاء، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا “الوصول الكامل” سيعيد الاستقرار عبر الأطلسي أم يرسّخ نمطاً جديداً من الضغوط الأميركية على شركائها.
دافوس 2026: تصدّع النظام الدولي وهيمنة القوة تتصدران نقاشات المنتدى
انعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام في ظرف دولي بالغ الحساسية، وصفه مراقبون بأنه مرحلة انتقالية في بنية النظام العالمي، مع تراجع النموذج القائم على القواعد وصعود منطق القوة والنفوذ. وخلال جلسات المنتدى، حذّر قادة دول ومسؤولون دوليون من تآكل النظام الدولي الحالي، داعين إلى إعادة التفكير في مفاهيم السيادة، والتحالفات، والاستقلال الاستراتيجي.
وبرزت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، لاعباً محورياً في مشهد دافوس، حيث هيمنت تصريحاته ومبادراته على النقاشات، وأثارت في الوقت ذاته ردود فعل أوروبية ودولية متباينة.
غرينلاند والسيادة الأوروبية
كان ملف غرينلاند في صدارة القضايا المثيرة للجدل، بعد تصريحات ترامب التي أكد فيها أن المفاوضات بشأن الجزيرة ما تزال جارية، معتبراً أن واشنطن تسعى إلى “وصول كامل” إليها من دون سقف زمني، مع نفيه اللجوء إلى القوة العسكرية. هذه التصريحات وُصفت بأنها اختبار مباشر لمفهوم السيادة الأوروبية في ظل النفوذ الأميركي.
وأثارت المواقف الأميركية غضب قادة أوروبيين، حيث شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن “ينحني لقانون الأقوى”، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن سيادة غرينلاند وسلامة أراضيها غير قابلة للتفاوض، معلنة سعي الاتحاد إلى تعزيز استقلاليته الاستراتيجية.
غزة ومجلس “السلام”
في الملف الفلسطيني، أعلن ترامب من دافوس إطلاق ما أسماه “مجلس سلام غزة”، بوصفه آلية لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع ضمن رؤية “غزة منزوعة السلاح”. وأشار إلى أن السلام، من وجهة نظره، يرتبط بالبناء الاقتصادي أكثر من الأطر السياسية التقليدية.
غير أن هذه المبادرة قوبلت بتحفظات أوروبية ودولية، وسط مخاوف من أن تتحول إلى مسار بديل أو موازٍ للأمم المتحدة، بما يهمش المرجعية الدولية القائمة. وامتنعت عدة دول أوروبية عن الانضمام إلى المجلس، مفضلة التمسك بالشرعية الدولية رغم بطئها وتعقيداتها.
أوكرانيا وانتقاد التردد الأوروبي
وفي خطاب وُصف بالأكثر حدة في دافوس، وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقادات مباشرة للدول الأوروبية، داعياً إياها إلى التحرك بشكل مستقل وعدم انتظار الإشارات الأميركية، في ظل الحرب المستمرة مع روسيا. ورغم لقاء جمعه بترامب على هامش المنتدى، لم يُعلن عن أي اختراق سياسي جديد، مكتفياً بتأكيد ضرورة أي تسوية تحترم سيادة أوكرانيا وأمنها.
فنزويلا وتجاهل السيادة
كما أعاد المنتدى تسليط الضوء على فنزويلا، من زاوية التحولات الاقتصادية وسيناريوهات ما بعد الأزمة، متجاوزاً مسألة السيادة والقانون الدولي، ومركزاً على إعادة دمج كاراكاس في سلاسل الطاقة والاستثمار العالمية، وهو ما أثار انتقادات بشأن انتقائية التعامل مع المبادئ الدولية.
دافوس بين الحوار وواقع القوة
ووفق تقارير إعلامية غربية، بينها صحيفة “غارديان”، يُنظر إلى دافوس 2026 على أنه فرصة أخيرة أمام النخب العالمية لمحاولة إنقاذ ما تبقى من النظام الدولي القائم على القواعد. إلا أن مشاركة ترامب، بخطابه التصعيدي ونهجه القائم على الصفقات، عكست التناقض بين شعار المنتدى “روح الحوار” وواقع التنافس الحاد بين القوى الكبرى.
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي شارك في المنتدى، من أن تجاهل القانون الدولي يجري “في العلن”، وأن سلوك الدول الكبرى يسرّع من تفكك النظام العالمي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية.
خلاصة المشهد
كشف منتدى دافوس 2026 بوضوح أن “السلام” و ”السيادة” و ”القانون الدولي” لم تعد مفاهيم ثابتة، بل أدوات ضمن صراع نفوذ عالمي متصاعد. وبينما تدفع الولايات المتحدة نحو ترتيبات سريعة قائمة على القوة والصفقات، تحاول أوروبا ودول أخرى الحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد، في عالم يبدو أنه يتجه بثبات نحو مرحلة أكثر اضطراباً وتنافساً. (انظر) (انظر) (انظر)
ترامب في دافوس: استعراض إنجازات داخلية وتصعيد في خطاب القوة والسيادة
ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطاباً مطولاً أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ركّز فيه على ما وصفه بـ«التحول التاريخي» الذي تشهده الولايات المتحدة بعد عام واحد من عودته إلى البيت الأبيض، مستعرضاً إنجازات اقتصادية وأمنية، ومطلقاً مواقف حادة تجاه أوروبا، والهجرة، والطاقة، وحلف شمال الأطلسي، وقضية غرينلاند.
وأكد ترامب في مستهل كلمته أن الاقتصاد الأميركي يعيش «أفضل مراحله على الإطلاق»، معلناً القضاء على التضخم وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، ومشيراً إلى ارتفاع حجم الاستثمارات من أقل من تريليون دولار في عهد الإدارة السابقة إلى نحو 18–20 تريليون دولار حالياً. واعتبر أن «نمو أميركا يعني نمو العالم»، في تأكيد لدور بلاده القيادي في الاقتصاد العالمي.
هجوم على سياسات بايدن والهجرة
وهاجم ترامب بشدة إدارة سلفه جو بايدن، محمّلاً إياها مسؤولية ما وصفه بأسوأ تضخم في تاريخ الولايات المتحدة، وتراجع القدرة الشرائية للعائلات الأميركية. كما انتقد السياسات الغربية المتعلقة بالهجرة والطاقة، معتبراً أن «الهجرة غير المنضبطة» و«الخداع الأخضر» أدّيا إلى تآكل القوة الاقتصادية للدول الغربية، وارتفاع الديون، وتراجع النمو.
وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية «لم تعد قابلة للتعرّف عليها»، داعياً أوروبا إلى التخلي عن سياسات العقد الأخير، والعودة إلى نموذج التنمية التقليدية، مؤكداً أن الولايات المتحدة «حليف حقيقي» لأوروبا، لكنها تريدها «قوية لا ضعيفة».
الطاقة والتجارة والرسوم الجمركية
وفي ملف الطاقة، أعلن ترامب زيادة الإنتاج النفطي الأميركي بشكل كبير، وتراجع أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة منذ ولايته السابقة، إلى جانب الموافقة على بناء مفاعلات نووية جديدة. وانتقد الاعتماد الأوروبي على طاقة الرياح، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الكهرباء وتراجع الإنتاج في دول كألمانيا والمملكة المتحدة، ومقارناً ذلك بالنموذج الصيني القائم على الفحم والغاز والطاقة النووية.
كما شدد على أن إدارته نجحت في تقليص العجز التجاري بنسبة 77% من دون التسبب بتضخم، عبر مزيج من خفض الضرائب ورفع الرسوم الجمركية على الدول التي «تضر بالاقتصاد الأميركي».
غرينلاند والأمن القومي
وكان ملف غرينلاند من أكثر القضايا إثارة للجدل في الخطاب، إذ اعتبر ترامب أن الجزيرة تمثل «قضية أمن قومي واستراتيجي»، مؤكداً أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على حمايتها في ظل التهديدات العالمية المتزايدة. واستند إلى سردية تاريخية تعود إلى الحرب العالمية الثانية، ملوّحاً بأن واشنطن كان بإمكانها الاحتفاظ بالجزيرة آنذاك.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة «تطلب قطعة من الجليد مقابل السلام العالمي»، في إشارة إلى غرينلاند، معتبراً أن رفض ذلك يتجاهل الدور الأميركي في حماية أوروبا وحلف الناتو.
الإنفاق العسكري والصناعات الدفاعية
وفي الشأن العسكري، أعلن ترامب تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة الأميركية، ومنع الشركات من توجيه أرباحها إلى إعادة شراء الأسهم بدل الاستثمار في القدرات الإنتاجية. واستعرض تطوير منظومات صاروخية وطائرات مقاتلة متقدمة، مؤكداً أن «أميركا تصنع أفضل سلاح في العالم»، وأن قوة الجيش الأميركي هي أساس أمن الناتو.
سياسات داخلية وأمن المدن
وتطرق الرئيس الأميركي إلى قضايا الأمن الداخلي، معلناً خفض معدلات الجريمة في عدد من المدن الأميركية بعد نشر الحرس الوطني والجيش، ومشدداً على تشديد سياسات الهجرة، ومنع المهاجرين غير النظاميين من الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.
خاتمة خطاب القوة
واختتم ترامب كلمته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تعيش «أفضل وضع اقتصادي وأمني في تاريخها»، داعياً قادة الأعمال المشاركين في دافوس إلى الاستثمار في أميركا والمساهمة في «بناء مستقبل الغرب». واعتبر أن العالم يمر بمرحلة استثنائية مليئة بالتحديات والفرص، وأن بلاده تقود هذا التحول في مجالات الاقتصاد والطاقة والذكاء الاصطناعي.
الخطاب، الذي قوبل بتصفيق متفاوت، عكس بوضوح نهج ترامب القائم على استعراض القوة، وربط الأمن القومي بالاقتصاد، وإعادة تعريف العلاقات مع الحلفاء من موقع الهيمنة والمصالح المباشرة، في وقت يشهد فيه النظام الدولي تصاعداً في التوترات وعدم اليقين.
ميثاق “مجلس السلام” في دافوس: صلاحيات واسعة لترامب ومخاوف من تجاوز دور الأمم المتحدة
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الميثاق التأسيسي لما أطلق عليه اسم “مجلس السلام” خلال أعمال منتدى دافوس، مؤكداً أن المجلس سيعمل “بالتنسيق” مع الأمم المتحدة، رغم ما تضمّنه الميثاق من انتقادات مباشرة لمقارباتها.
ويأتي إنشاء المجلس في الأصل ضمن خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، إلا أن بنود الميثاق تكشف عن طموحات أوسع، تشمل السعي إلى حل نزاعات مسلحة أخرى وتعزيز الاستقرار على المستوى العالمي.
وخلال مراسم التوقيع، قال ترامب إن “مجلس السلام” قد يصبح “واحداً من أكثر الهيئات تأثيراً التي أُنشئت على الإطلاق”، معرباً عن فخره برئاسته، ومشيراً إلى أن “تقريباً كل دولة تريد أن تكون جزءاً منه”.
تباين المواقف الدولية
في المقابل، أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن مجلس الأمن وافق على إنشاء المجلس الوارد في خطة ترامب “لهذا الغرض تحديداً”، في إشارة إلى غزة، ما يعكس تحفظاً أممياً على توسيع ولايته خارج هذا الإطار.
كما أبدت الصين شكوكاً واضحة حيال المجلس، رغم تلقيها دعوة للانضمام إليه. وأكدت بكين تمسكها بـ“النظام الدولي المتمحور حول الأمم المتحدة”، معتبرة أن أي مبادرات دولية يجب أن تنطلق من هذا الأساس.
من جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للمساهمة بمليار دولار في مجلس السلام لدعم الفلسطينيين، على أن يكون التمويل من أصول روسية مجمّدة في الولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن قيام دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد لتحقيق تسوية دائمة.
أما المملكة المتحدة، فأعلنت على لسان وزيرة خارجيتها أنها لن تشارك في مراسم التوقيع على الميثاق، في مؤشر على الحذر الأوروبي من طبيعة المجلس وصلاحياته.
مضامين الميثاق وصلاحيات استثنائية
وبحسب نص الميثاق، المؤلف من ثماني صفحات، فإن ترامب سيكون أول رئيس لمجلس السلام بصلاحيات واسعة، فيما تُمنح الدول الأعضاء ولاية قصوى مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس المجلس. ويستثني الميثاق الدول التي تدفع أكثر من مليار دولار نقداً خلال السنة الأولى، حيث تحصل على وضع خاص، و”مقعد دائم”.
وينتقد الميثاق صراحة “المقاربات والمؤسسات التي فشلت مراراً”، في إشارة تُفهم على نطاق واسع بأنها موجهة إلى الأمم المتحدة، داعياً إلى التحلي بـ“الشجاعة” من أجل “الانفصال عنها”، ما أثار مخاوف من أن يشكّل المجلس إطاراً موازياً أو بديلاً للمنظمة الدولية.
تساؤلات أوروبية وتحذيرات خبراء
ونقلت مصادر قريبة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الميثاق “يتجاوز مسألة غزة”، ويطرح أسئلة جوهرية حول احترام مبادئ وهيكلية الأمم المتحدة، وهي أمور “لا يمكن التشكيك فيها تحت أي ظرف”.
كما حذّر خبراء ومراكز أبحاث، من بينهم معهد كوينسي، من أن إدارة ترامب تسعى إلى توسيع نفوذ مجلس السلام تدريجياً، وربما استخدامه كأداة لإعادة تشكيل النظام الدولي القائم، معتبرين أن غزة قد تكون “نقطة الانطلاق” وليس المحطة النهائية.
غزة بين الإعمار ونزع السلاح
بالتوازي، عرض جاريد كوشنر، صهر ترامب، ملامح خطط استثمارية لإعادة إعمار غزة، متحدثاً عن “غزة جديدة” تقوم على مشاريع اقتصادية وصناعات متطورة، مع طموح للوصول إلى بطالة صفرية. غير أنه شدد على أن إعادة الإعمار مشروطة بنزع سلاح حركة حماس، واعتبر ذلك أساسياً لضمان الأمن والاستقرار.
وفي السياق ذاته، قال ترامب إن الحرب في غزة “توشك فعلياً على الانتهاء”، محذّراً من أن عدم التزام حماس بنزع سلاحها سيقود إلى “نهايتها”، وفق تعبيره.
يعكس ميثاق “مجلس السلام” توجهاً أميركياً لإطلاق إطار دولي جديد لمعالجة النزاعات، يبدأ من غزة لكنه يتجاوزها إلى ملفات عالمية أوسع. وبينما تراه واشنطن أداة فعّالة وسريعة، تتزايد المخاوف الدولية من أن يتحول إلى مسار يهمّش الأمم المتحدة ويعيد رسم قواعد إدارة السلم والأمن الدوليين وفق ميزان القوة والنفوذ.
دافوس 2026: كارني يعلن نهاية النظام العالمي القائم… وخطاب يهزّ أسس الهيمنة الأميركية وترامب يرد بسحب دعوة كندا من “مجلس السلام”
تحوّل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام إلى مسرح لإعلان سياسي غير مسبوق، بعدما أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خطاباً وُصف بأنه من أخطر وأعمق ما قيل في هذا المحفل منذ عقود، معلناً صراحة “نهاية النظام العالمي القائم على القواعد” الذي تقوده الولايات المتحدة، ومؤكداً أن هذا النظام “انتهى ولن يعود”، في وقت تتزايد فيه حروب النفوذ والضغوط الاقتصادية واستخدام التكامل العالمي كسلاح.
وفي خطاب لاقى تصفيقاً حاراً ونادراً في دافوس، دعا كارني الدول متوسطة القوة إلى التوقف عن التمسك بما سماه “الوهم المريح” للنظام الدولي القديم، محذراً من أن الاستمرار في التعامل معه بوصفه واقعاً فاعلاً سيحوّل هذه الدول إلى ضحايا لطموحات القوى الكبرى. وقال بعبارة أثارت صدى واسعاً: “إذا لم نكن على الطاولة، فنحن على قائمة الطعام… وعندما لا تعود القواعد تحميك، عليك أن تحمي نفسك”.
كسر الوهم… لا مجرد توصيف سياسي
ما ميّز خطاب كارني، وفق مراقبين، ليس مضمونه السياسي فحسب، بل دلالته البنيوية العميقة. فكارني، القادم من خلفية مصرفية مركزية، يُعرف بإدراكه العميق لقوة الأفكار والمعتقدات في تشكيل الواقع. وقد بدأ خطابه بإعلانه “إنهاء الخيال اللطيف” للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة، في إشارة مباشرة إلى أن النظام العالمي، شأنه شأن الثقة بالعملة أو بالنظام المالي، يقوم في جوهره على الإيمان الجماعي بوجوده.
ويرى محللون أن كارني، باستحضاره استعارة المفكر التشيكي فاتسلاف هافل حول “العيش داخل الكذبة”، تعمّد نقل هذا الإيمان من حيّز المسلّمات الصامتة إلى حيّز التشكيك العلني. فبحسب منطقه، فإن أنظمة القوة لا تستمر إلا لأن الجميع يتصرف “كما لو أنها قائمة”، وما إن يتوقف فاعل واحد مؤثر عن هذا الأداء، حتى تبدأ المنظومة كلها بالتصدع. وفي هذا السياق، اعتبر كارني أن لحظة الاعتراف العلني بزيف الرواية هي اللحظة التي يبدأ فيها النظام بالانهيار.
رسالة مباشرة إلى واشنطن
ورغم أن كارني لم يذكر دونالد ترامب بالاسم، فإن خطابه تضمّن انتقاداً واضحاً لسياسات الولايات المتحدة، ولا سيما استخدام الرسوم الجمركية، والبنية التحتية المالية، وسلاسل الإمداد كأدوات إكراه. وأكد أن العالم لم يعد يعيش مرحلة انتقالية، بل “قطيعة”، حيث بات الاعتماد المتبادل مصدر ضعف لا ضمانة سلام.
وفي إطار ترجمة هذه الرؤية عملياً، أعلن كارني عن نهج جديد أسماه “الواقعية القيمية”، يقوم على بناء تحالفات مرنة ومتغيرة “قضية بقضية”، بدل الارتهان لمعسكر واحد. وكشف عن شراكات استراتيجية مع الصين وقطر، واتفاقات تجارية قيد الإعداد مع الهند ودول رابطة جنوب شرق آسيا، إضافة إلى تعميق التقارب مع الاتحاد الأوروبي، في مسعى لتنويع مسارات التجارة وتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة.
ردّ أميركي سريع وعقابي
لم يتأخر ردّ ترامب. فبعد أيام من خطاب دافوس، أعلن سحب دعوة كندا للانضمام إلى “مجلس السلام” الذي أطلقه لإدارة ملفات النزاعات وعلى رأسها غزة. وكتب ترامب، موجّهاً حديثه مباشرة إلى كارني، أن على كندا اعتبار ذلك إعلاناً رسمياً بسحب الدعوة، معتبراً أن رئيس الوزراء الكندي “لم يكن ممتناً بما فيه الكفاية”، ومضيفاً أن “كندا تعيش بفضل الولايات المتحدة”.
وجاء هذا القرار ليحوّل الخلاف من مستوى الخطاب إلى مستوى الإجراء السياسي، ويعكس حساسية واشنطن تجاه أي تشكيك علني بشرعية قيادتها للنظام الدولي.
كندا ترد: لا نعيش بالامتثال
من جانبه، ردّ كارني بلهجة حازمة عقب عودته إلى بلاده، قائلاً إن “كندا لا تعيش بفضل الولايات المتحدة، بل تزدهر لأننا كنديون”، مع إقراره بعمق الشراكة التاريخية بين البلدين. لكنه شدد على أن الامتثال لم يعد يوفر الحماية، وأن الدول المتوسطة مطالبة ببناء قدر أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية في الطاقة والغذاء والدفاع وسلاسل الإمداد.
ما بعد دافوس: خطاب مفصلي
يرى مراقبون أن خطاب كارني قد يُسجَّل بوصفه أحد أهم الخطب التي ألقاها زعيم عالمي خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ليس لأنه أعلن تحوّلاً جارياً فحسب، بل لأنه ساهم في تسريع هذا التحول عبر كسر الإيمان الجماعي بالنظام القائم. فالحرب الباردة، بحسب هذا المنطق، تتطلب وجود نظامين متنافسين، لكن إعلان كارني يعني عملياً أن أحد هذين النظامين لم يعد قائماً حتى على مستوى الادعاء.
وبينما تتواصل الانقسامات حول “مجلس السلام” وترفض دول أوروبية بارزة الانضمام إليه، يكشف مشهد دافوس 2026 عن عالم يدخل مرحلة جديدة: قوى كبرى تفرض شروطها بالقوة، ودول متوسطة تحاول شق “مسار ثالث” عبر التكتل وكسر الأوهام، في نظام دولي لم يعد يُدار بالقواعد، بل بإدارة ما بعد القواعد. (انظر)
ترامب يقع في الفخ السني
في مقال في صحيفة إسرائيل اليوم الإسرائيلية، كتب عكيفا بيغمان: الاتفاق في غزة، والمشاهد في سوريا، والتردد حيال إيران ليست أحداثاً منفصلة، بل نتائج مباشرة لسياسة أميركية فاشلة في الشرق الأوسط.
سياسة دونالد ترامب الخارجية تقوم نظرياً على مبدأ “أميركا أولاً”، أي السعي الحازم وراء المصلحة الأميركية دون اكتراث بالقيود التقليدية أو بالحلفاء. في أوروبا، أوكرانيا، أميركا الوسطى، وحتى داخل حلف الناتو، يطبق ترامب هذا المنطق بصرامة تصل أحياناً إلى حد “أميركا وحدها”. غير أن هذا النهج يتبخر عندما يصل إلى الشرق الأوسط.
هنا، يتخلى ترامب عن استقلالية القرار ويعود للاعتماد على منظومة التحالفات الإقليمية، فيقع أسيراً لمصالح القوى السنية الكبرى. آلية إنهاء الحرب في غزة مثال واضح: بدل التعامل مع غزة كقضية أمنية إسرائيلية محلية تتطلب حلاً سريعاً وحاسماً، اختارت واشنطن تدويل الصراع، وإشراك تركيا وقطر ومصر ودول أخرى عبر “مجلس السلام”، ما يضمن تعقيد الأزمة واستدامتها. أي تحرك أمني إسرائيلي مستقبلي سيصطدم الآن بمصالح هذه الدول وقواتها ونفوذها الميداني — وهو تدويل للصراع بأقصى درجاته.
الأمر ذاته ينطبق على إيران. نية واشنطن ضرب النظام الإيراني وإسقاطه تصطدم بمعارضة شديدة من تركيا وقطر والإمارات والسعودية. هذه الدول، رغم خطابها المعادي لإيران، تستفيد استراتيجياً من استمرار التهديد الإيراني الذي يمنحها وزناً إقليمياً خاصاً لدى الولايات المتحدة. سقوط طهران بيد نظام موالٍ للغرب سيجعل هذه الدول أقل أهمية، ولذلك فهي تكبح القرار الأميركي. وهكذا تتحول “قوة التوازن” السنية إلى عبء مباشر على السياسة الأميركية.
المفارقة أن ترامب، الذي لا يتردد في فرض عقوبات وتهديد حلفائه الغربيين، لا يستخدم أي أدوات ضغط حقيقية ضد هذه الدول. لا تعريفات جمركية، لا تهديدات، ولا كلفة سياسية. للمعسكر السني مكانة استثنائية في حسابات الإدارة الأميركية — سواء بدافع المال، أو النفط، أو الإعجاب بـ”الزعيم القوي” — لكن النتيجة واحدة: سياسة سيئة.
السنوات الأخيرة كشفت فخاً بنيوياً في السياسة الأميركية: الإدارات الديمقراطية راهنت على المحور الشيعي (إيران)، والجمهورية تراهن على المحور السني. وكأن صراع كربلاء في القرن السابع أصبح عاملاً حاسماً في صنع القرار الأميركي في القرن الحادي والعشرين.
في سوريا، يتجلى الفشل بوضوح. واشنطن تسعى لاحتواء الجولاني وإدماجه في النظام الإقليمي الجديد، لكنها تكتشف أن نفوذها عليه محدود. قواته تعيد السيطرة على مناطق كردية كانت تحت رعاية أميركية، بالتنسيق مع تركيا. حتى حلفاء ترامب في الكونغرس يعترفون بأن “الحكومة السورية الجديدة” تعمل ضد المصالح الأميركية، لكن دون أي رد فعلي حقيقي. لو كان الفاعل كندا، لفرضت عليه العقوبات فوراً.
التناقض يمتد إلى ملف الإخوان المسلمين. ترامب يتبنى خطاباً معادياً لهم في لبنان ومصر والأردن، لكنه في الوقت ذاته يعزز تحالفه مع دول ترتبط قياداتها عضوياً بالإخوان، مثل تركيا وقطر. تُجمّد حسابات مصرفية هنا، وتُباع طائرات F-35 هناك.
لقد أثبت ترامب في الماضي قدرته على تصحيح المسار. لكن في الشرق الأوسط، حيث تتجاهله أنقرة، وتناور الدوحة، وتضغط الرياض، يبدو أن “أميركا أولاً” تحولت إلى “مصالح الحلفاء أولاً”. وقد آن الأوان لإعادة الحسابات.
يبدو، من وجهة نظرنا، أن هذا المقال يأتي في إطار الضغط المستمر على ترامب لتبني سياسات أكثر مواءمة للرغبات الإسرائيلية.
ترامب والاحتياطي الفيدرالي: صراع السلطة الذي يهدد أسس الهيمنة الأميركية
لم يكن الصدام العلني بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حدثاً عابراً أو خلافاً تقنياً حول أسعار الفائدة، بل تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى معركة بنيوية تمسّ جوهر النظام المالي الأميركي ومكانته العالمية. فالصراع الذي بدأ في الولاية الأولى لترامب، بلغ في يناير/كانون الثاني 2026 مرحلة غير مسبوقة، عندما خرج باول علناً محذراً من استهداف سياسي مباشر لاستقلالية البنك المركزي، مستخدماً للمرة الأولى لغة المواجهة بدل الصمت المؤسسي التقليدي.
من تغريدة إلى أزمة ثقة
في 23 أغسطس/آب 2019، فاجأ ترامب الرأي العام الأميركي بسؤال استفزازي طرحه على حسابه في تويتر آنذاك:
“من هو العدو الأكبر لأميركا: جيروم باول أم الرئيس الصيني شي جين بينغ؟”
ورغم أن السؤال بدا في حينه أقرب إلى الشعبوية السياسية، فإنه كشف مبكراً عن طبيعة نظرة ترامب إلى الاحتياطي الفيدرالي، بوصفه عقبة داخلية لا تقل خطورة عن الخصوم الخارجيين.
منذ ذلك التاريخ، دخل ترامب في مواجهة مفتوحة مع باول، مطالباً بخفض سريع وكبير لأسعار الفائدة لدعم النمو والأسواق، بينما تمسّك الأخير بمبدأ استقلالية القرار النقدي وربطه بالبيانات الاقتصادية لا بالإملاءات السياسية. وعلى خلاف أسلافه، لم يتردد ترامب في مهاجمة رئيس الفيدرالي علناً وبصورة شخصية، في سابقة لم يعرفها التاريخ الأميركي الحديث.
11 يناير 2026: كسر الصمت المؤسسي
بلغ التوتر ذروته في 11 يناير/كانون الثاني 2026، عندما بثّ جيروم باول مقطع فيديو قصيراً، كشف فيه أن وزارة العدل الأميركية سلّمت الاحتياطي الفيدرالي مذكرات استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى، تلوّح بتوجيه تهم جنائية تتعلق بشهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في يونيو/حزيران الماضي.
ورغم أن الذريعة القانونية تمحورت حول مشروع تجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي، فإن باول أكد بوضوح أن الاستهداف الحقيقي مرتبط برفضه تنفيذ توجيهات سياسية بشأن أسعار الفائدة، لا بمخالفات إدارية أو مالية. وقال في رسالته إن ما يجري يمثل تهديداً مباشراً لاستقلالية أهم بنك مركزي في العالم، مؤكداً أنه خدم تحت إدارات جمهورية وديمقراطية، ولن يغيّر سلوكه تحت الضغط أو التهديد.
ارتدادات فورية في الأسواق
ردّ فعل الأسواق لم يتأخر. فخلال ساعات من بث الفيديو، شهدت الأسواق الأميركية حالة فزع واضحة، تمثلت في:
- تراجع مؤشرات الأسهم،
- ارتفاع عوائد سندات الخزانة،
- انخفاض الدولار،
- اندفاع المستثمرين نحو الذهب الذي سجّل مستوى تاريخياً متجاوزاً 4600 دولار للأونصة.
هذا التفاعل السريع عكس حساسية الأسواق العالمية لأي مساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، بوصفه حجر الزاوية في الثقة بالدولار وبالديون الأميركية.
وهم تمويل الجيش بالتعريفات الجمركية
في خضم هذا التوتر، أعلن ترامب في 7 يناير 2026 نيته رفع ميزانية الجيش الأميركي إلى 1.5 تريليون دولار، مدعياً أن الزيادة ستموَّل من عائدات التعريفات الجمركية. غير أن هذا الطرح، بحسب دراسات صادرة عن نموذج وارتون للميزانية بجامعة بنسلفانيا، يفتقر إلى الدقة.
فالعائدات الجمركية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 لم تتجاوز 124.5 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 7% فقط من عجز الموازنة الفيدرالية السنوي البالغ 1.7 تريليون دولار. كما أن التعريفات المرتفعة تؤدي عملياً إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وتقليص الإيرادات الضريبية الأخرى، ما يقلّص أثرها الصافي.
في الواقع، تُموَّل الميزانية العسكرية الأميركية – كما تؤكد دراسات معهد واتسون بجامعة براون – أساساً عبر الاقتراض من الأسواق العالمية، لا من الضرائب أو الرسوم، وهو ما يربط مباشرة بين قوة الجيش الأميركي وبين الثقة العالمية في الدولار وسندات الخزانة.
معضلة ترامب الكبرى
هنا تكمن المفارقة المركزية:
ترامب يسعى إلى توسيع الإنفاق العسكري عبر الاقتراض، وفي الوقت نفسه يضرب المؤسسة التي تشكّل الضمانة الأساسية لقدرة الولايات المتحدة على الاقتراض بثمن منخفض. فاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي هي ما يجعل المستثمرين حول العالم يقبلون على شراء الدَّين الأميركي، ويمنح واشنطن ما وصفه شارل ديغول منذ 1965 بـ”الامتياز الباهظ” للدولار.
أي مساس بهذه الاستقلالية يرفع كلفة الاقتراض، ويضعف الطلب على الدولار، ويقلّص الموارد المتاحة للإنفاق العسكري، ما يعني أن الهجوم على الفيدرالي يهدد مباشرة العمود الفقري للإمبراطورية الأميركية.
خطر يتجاوز الصين
يرى العديد من الخبراء أن هذا المسار أخطر على الولايات المتحدة من أي تهديد خارجي، بما في ذلك الصين. فبينما تقوم المنافسة مع بكين على نماذج اقتصادية مختلفة، يقوم النظام المالي الأميركي على افتراض أساسي: أن السياسة النقدية محصّنة من النزوات السياسية.
وإذا نجح ترامب في فرض سيطرته على الاحتياطي الفيدرالي، خصوصاً مع انتهاء ولاية باول في مايو/أيار المقبل، فإن ذلك قد يشكّل بداية تآكل الهيمنة الأميركية بشكل متسلسل، حيث تتهاوى الثقة بالدولار، ثم بالسندات، ثم بالقدرة على تمويل القوة العسكرية.
ما يجري ليس خلافاً شخصياً ولا معركة انتخابية عابرة، بل صدام بين منطق الدولة ومنطق الزعامة الفردية. فترامب، في سعيه لفرض إرادته على الاحتياطي الفيدرالي، لا يهاجم مؤسسة تقنية فحسب، بل يعبث بأساس النظام المالي العالمي الذي مكّن الولايات المتحدة من التفوق لعقود. إنها معركة قد لا تُحسم اليوم أو غداً، لكنها تحمل في طياتها خطراً وجودياً على الدور الأميركي في العالم، إذا ما استمر الخلط بين السلطة السياسية وإدارة النقد.
إيران
تواجه إيران خلال هذه الفترة واحدة من أخطر لحظاتها منذ قيام الجمهورية الإسلامية، في ظل تزامن غير مسبوق بين تصعيد عسكري أميركي–إسرائيلي محتمل، واضطرابات داخلية واسعة النطاق، وضغوط اقتصادية خانقة. فبين حشود عسكرية تُنذر بخيارات قسرية، واحتجاجات دامية تهدد تماسك الداخل، تجد طهران نفسها أمام معادلة ضيقة: احتواء داخلي سريع أو انكشاف استراتيجي واسع. ويشير تداخل المسارين إلى أن أي خطأ في الحسابات قد يدفع بالمنطقة إلى مواجهة تتجاوز حدود إيران نفسها.
ما قبل الانفجار الكبير: قراءة محدثة للمعهد المصري في الحشد العسكري الأمريكي واستعدادات ضرب إيران
منذ عدة أيام، أصدر المعهد المصري للدراسات تحليلاً حول احتمالات توجيه ضربة إيرانية وشيكة على إيران، وخلص التحليل إلى أن غياب الاستعداد العسكري الكافي يرجح تأجيل الضربة (إن كانت تقررت بالفعل) لعدة أيام، واللجوء إلى أي من البدائل التي ذكرها التحليل، والتي لا تتضمن ضربة شاملة ساحقة.
وبالفعل لم يتم بدء العملية العسكرية، التي كانت مصادر كثيرة قد رجحت أن تبدأ الخميس 15 يناير.
نتابع من خلال التحليل التالي المستجدات المتعلقة بتواصل الاستعدادات الأمريكية، التي تجعل من توجيه ضربة قوية إلى إيران خلال أسبوع من الآن أمراً ممكناً، تتلافى من خلاله الولايات المتحدة عدداً من المخاطر التي دفعتها لتأجيل العمل العسكري، وهو ما يتفق مع تحليلنا السابق الإشارة إليه.
أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة حرّكت ثلاث حاملات طائرات إلى منطقة الشرق الأوسط. وتشير معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر إلى أن أقرب هذه الحاملات هي حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، التي كانت آخر التقارير تشير إلى وجودها في بحر الصين الجنوبي، على بُعد يقارب 8000 كيلومتر من الخليج العربي.
وترافق حاملة الطائرات عادةً طرادات صواريخ موجّهة، وسفناً حربية مضادّة للطائرات، إلى جانب مدمرات أو فرقاطات مخصّصة لمكافحة الغواصات.
ويقدّر محللون أن وصول الحاملة إلى الخليج قد يستغرق ما بين خمسة وسبعة أيام (منذ يوم 18 يناير).
كما بدأت حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس روزفلت» بالتحرك من الساحل الغربي، ويرى مراقبون أن خط سيرها قد يكون باتجاه الشرق الأوسط أو عبر بحر الصين الجنوبي. وإضافة إلى ذلك، بدأت حاملة الطائرات «جورج بوش»، المتواجدة على الساحل الشرقي قرب نيويورك، بالتحرك نحو المحيط الأطلسي.
وعلى الرغم من أن البنتاغون أعلن رسمياً أن حاملة «أبراهام لينكولن» هي فقط التي ستتجه إلى منطقة الشرق الأوسط، فإن مراقبين يرجّحون أن الحاملتين الأخريين ستتجهان أيضاً إلى المنطقة (قد يتجه أي منهما لمواقع في البحر المتوسط للمساهمة في الدفاع عن إسرائيل حال نشوب نزاع كبير)، في ظل حالة الحشد العسكري الأمريكي لمواجهة إيران.
وبالإضافة إلى ذلك، رُصدت أربع طائرات نقل عسكرية تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز C-17A في طريقها إلى قاعدة دييغو غارسيا الجوية، من بينها ثلاث طائرات أقلعت من قاعدة رامشتاين الجوية:
-RCH866، الرقم التسجيلي: 06-6160
-RCH870، الرقم التسجيلي: 06-6158
-RCH830، الرقم التسجيلي: 98-0056
كما جرى رصد أسطول من طائرات النقل الاستراتيجي C-17 يتجه نحو قاعدة دييغو غارسيا. وجدير بالذكر أن طائرة C-17، رغم كونها في الأساس طائرة نقل، فإن لدى الجيش الأمريكي برنامجاً يتيح تهيئتها للقيام بدور قاذفة استراتيجية لإطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز JASSM، وذلك في إطار تكامل عملياتي مع المقاتلات الشبحية F-35.
وتملك الولايات المتحدة مخزوناً كبيراً جداً من هذا النوع من الصواريخ، ما يتيح لها الحفاظ على مخزون صواريخ «توماهوك»، مرتفعة الثمن والمتوافرة فقط بأعداد محدودة، واستبدالها بهذه المنظومات إذا ما قررت توجيه ضربة قاصمة للنظام الإيراني.
يضاف لما سبق، الاستعدادات الجارية في قاعدة موفق السلطي الأردنية لتكون الأردن، فيما يبدو، منصة الإطلاق الرئيسية للمقاتلات التكتيكية، بما في ذلك طائرات ال “F-15E “Strike Eagel التي يمكن اعتبارها “شاحنة قنابل طائرة”، ويمكنها اختراق الدفاعات الإيرانية وتدمير مراكز القيادة والأنفاق المحصنة. التقديرات تشير إلى تواجد 35 طائرة من هذا الطراز، ما يعني القدرة على ضرب مئات الأهداف في موجة واحدة.
وتشير هذه التحركات إلى إمكانية أن تكون الضربة الأمريكية–الإسرائيلية، في حال اتخاذ القرار بتنفيذها، ضربة كبيرة ومدمّرة وغير تقليدية وشاملة، تفوق في تأثيرها ما جرى خلال حرب الاثني عشر يوماً.
تشير مجمل هذه التطورات إلى أن التحركات الأمريكية نحو المنطقة تأتي في إطار حشد عسكري قد يكون تمهيداً للإعداد والتجهيز لتوجيه ضربة كبيرة ضد النظام الإيراني، في سياق مساعٍ أمريكية–إسرائيلية لإزاحته أو تحييده، باعتبار أن شكل «الشرق الأوسط الجديد» الذي تعمل واشنطن وتل أبيب على صياغته لا يسمح بوجود نظام كالنظام الإيراني، الذي يعادي الكيان الإسرائيلي ومخططاته بشكل صريح.
في المقابل، يمكن أن تفقد الولايات المتحدة يوماً بعد يوم الذريعة التي تتيح لها توجيه ضربة لإيران تحت شعار حماية المتظاهرين، لا سيما مع تراجع وتيرة التحركات الاحتجاجية وأعمال الفوضى والتخريب داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نتيجة تصدّي مؤسسات النظام لتلك الاحتجاجات، والتي شهد بعضها ممارسات عنف من قبل المتظاهرين. وبذلك تجد واشنطن نفسها أمام خيارات أكثر تعقيداً، بعدما بدأت تفقد غطاء العدوان والتخفي خلف مطالب الشعب.
وبناء على ذلك، يمكن أن تعجّل الولايات المتحدة، وإسرائيل من خلفها، بتوجيه ضربة لإيران قبل اختفاء هذا الغطاء الشعبي تماماً، وقبل أن تصبحا في مواجهة مباشرة مع الشعب الإيراني نفسه. وفي هذه الحالة، يحافظ الحشد العسكري الذي تمت الإشارة إليه على بديل الضربة الساحقة قائما، وفي حال تبني هذا الخيار وعدم اللجوء إلى أي من البدائل الأخرى المذكورة في تحليلنا السابق، نرجح ألا تتأخر هكذا ضربة، إن تمت، عن عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، أو بعدها بعدة أيام حال استكمال الحشد العسكري والاستعدادات.
أما إذا رجحت الولايات المتحدة عدم توجيه هذه الضربة الآن بسبب الخشية من تداعياتها، ففي الأغلب ستعمل على الاستمرار في إضعاف النظام على المدى المتوسط، بإثارة المزيد من القلاقل الداخلية، مع دعم استعدادات قوى عسكرية داخلية معارضة، كما أوضحنا في تحليلنا السابق.
كاتب أميركي: ترامب عالق في إيران بعد تفكيك أدوات القوة الناعمة الأميركية
حذّر الكاتب والمحلل الأميركي ماكس بوت من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواجه مأزقاً متفاقماً في تعاملها مع ملفات خارجية معقّدة، وفي مقدّمها إيران، نتيجة ما وصفه بـ«التدمير المنهجي لأسس القوة الناعمة الأميركية» التي شكّلت لعقود العمود الفقري للنفوذ الأميركي في العالم.
وفي مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست، يرى بوت أن واشنطن تدفع اليوم ثمن تقليصها المتعمّد لأدوات التأثير غير العسكري، مؤكداً أن القوة العسكرية وحدها – مهما بلغت شدتها – لا يمكنها إنتاج نتائج سياسية مستدامة، سواء في إيران أو في ساحات أخرى مثل نيجيريا وفنزويلا.
إدمان القوة الصلبة
يشير بوت إلى أن المقاربة التي يعتمدها ترامب تقوم على إيمان شبه مطلق بفعالية القوة العسكرية بوصفها أداة حاسمة وسريعة، وهو ما دفع إدارته، خلال فترة زمنية قصيرة، إلى تنفيذ أو التهديد بتنفيذ عمليات عسكرية ضد عدد كبير من الدول. ووفق المقال، هاجمت الولايات المتحدة سبع دول خلال عام واحد فقط، وهو الرقم نفسه الذي سجلته طوال الولاية الأولى لترامب، إضافة إلى تهديدات علنية طالت دولاً أخرى من بينها إيران وكولومبيا والمكسيك وكوبا وحتى غرينلاند.
ويرى الكاتب أن هذا النهج لا يعكس فقط نزعة تصعيدية، بل يكشف أيضاً عن تجاهل متعمّد للأدوات التي تجعل التدخل العسكري أقل كلفة وأكثر فعالية، وفي مقدمتها الدبلوماسية، والمساعدات، والإعلام، ودعم المجتمع المدني.
تفكيك أدوات النفوذ الأميركي
بحسب بوت، لم تكتفِ إدارة ترامب بتهميش القوة الناعمة، بل أضعفتها فعلياً عبر استهداف مؤسسات محورية مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والوكالة الأميركية للإعلام العالمي، وهي مؤسسات لعبت دوراً أساسياً في بناء النفوذ الأميركي، وتعزيز صورة واشنطن، ودعم الحلفاء، والتأثير في المجتمعات المغلقة.
ويؤكد الكاتب أن تآكل هذه الأدوات جعل الولايات المتحدة أقل قدرة على تشكيل البيئات السياسية قبل أو بعد أي عمل عسكري، ما يحدّ من مردودية القوة الصلبة ويضاعف كلفتها السياسية والاقتصادية.
نجاحات تكتيكية… وإخفاقات استراتيجية
لا ينكر بوت أن بعض العمليات العسكرية الأميركية حققت أهدافاً محدودة، مثل اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلا أنه يعتبر هذه النجاحات تكتيكية ومؤقتة، ولا تعالج جذور الأزمات. بل يحذّر من أن اللجوء المفرط إلى القوة قد يأتي بنتائج عكسية.
ويضرب مثالاً بالضربة الأميركية في نيجيريا، حيث أطلق الجيش الأميركي 16 صاروخ «توماهوك» – تبلغ كلفة الواحد منها نحو مليوني دولار – ضد جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة. وبرغم الخسائر التي ألحقتها الضربة ببعض المقاتلين، فإنها لم تمس القيادات العليا، ولم تُنهِ نشاط الجماعات المسلحة، بل تلتها موجة عنف أكبر ضد المدنيين. وينقل الكاتب عن مسؤول أميركي سابق قوله إن «قيمة الأهداف التي ضُربت لا تساوي حتى قيمة صاروخ واحد».
إيران: المأزق الأكبر
يرى بوت أن إيران تمثل الحالة الأكثر تعقيداً وخطورة بالنسبة لإدارة ترامب. فبعكس ساحات أخرى، لا توجد معارضة مسلحة منظمة يمكن التعويل عليها ميدانياً، كما أن أي ضربة عسكرية واسعة قد تؤدي إلى توحيد النظام الإيراني بدلاً من إضعافه، فضلاً عن مخاطر الانزلاق إلى مواجهة إقليمية شاملة.
وفي هذا السياق، يؤكد الكاتب أن البديل الأكثر واقعية يتمثل في استعادة أدوات القوة الناعمة، عبر دعم الاحتجاجات الشعبية، وتسهيل تدفق المعلومات، وكسر الرقابة، وتعميق الانقسامات داخل النخب الحاكمة، وهي أدوات يرى أنها أكثر فاعلية على المدى الطويل من الصواريخ والطائرات.
صحوة متأخرة في الكونغرس
يشير المقال إلى أن الكونغرس بدأ أخيراً يدرك خطورة تجريد واشنطن من أدوات نفوذها غير العسكرية، فسعى إلى إعادة تمويل بعض مؤسسات القوة الناعمة. غير أن بوت يحذّر من أن الضرر الذي لحق بهذه المؤسسات خلال سنوات لا يمكن إصلاحه بسرعة، وأن استعادة الثقة والنفوذ تحتاج إلى وقت وإرادة سياسية مغايرة.
يخلص ماكس بوت إلى أن القوة الناعمة ليست بديلاً عن القوة العسكرية فحسب، بل شرطاً أساسياً لنجاحها وتقليص كلفتها. ومن دونها، تجد الولايات المتحدة نفسها – في إيران وغيرها – أمام معضلة حقيقية: قوة عسكرية هائلة، لكنها بلا أدوات سياسية وثقافية قادرة على تحويل التفوق العسكري إلى نفوذ دائم ونتائج مستقرة.
تصعيد غير مسبوق في إيران: آلاف القتلى وضغوط لرفع قيود الإنترنت
أعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، ومقرّها الولايات المتحدة، أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 ارتفعت إلى 3919 قتيلاً، في واحدة من أكثر موجات الاضطرابات دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية الحديث.
وقالت الوكالة، في بيان صدر الاثنين، إن 24 ألفاً و669 شخصاً اعتُقلوا خلال الاحتجاجات التي عمّت مختلف المدن الإيرانية، في وقت لم تصدر فيه السلطات الرسمية في طهران أي أرقام دقيقة بشأن عدد القتلى أو الجرحى من المدنيين. وكانت «هرانا» قد أعلنت، قبل يوم واحد فقط، أن عدد القتلى بلغ 3308 أشخاص، ما يعكس تسارعاً لافتاً في وتيرة العنف والقمع.
في المقابل، أقرّ مسؤولون إيرانيون بحجم الخسائر في صفوف قوات الأمن. إذ قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن أكثر من 3700 عنصر شرطة أُصيبوا خلال المواجهات، إضافة إلى تضرر أكثر من 2200 مركبة أمنية، و250 مدرسة، و300 مسجد، دون تقديم أرقام عن عدد القتلى من المدنيين أو قوات الأمن. وكانت وكالة تسنيم الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 111 عنصراً من قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات.
بزشكيان يلوّح بتخفيف القيود
وسط هذا التصعيد، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى رفع القيود المفروضة على شبكة الإنترنت في أقرب وقت ممكن، في خطوة لافتة تعكس إدراكاً رسمياً لتداعيات الحصار الرقمي على الاقتصاد والحياة اليومية.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، أوصى بزشكيان أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني باتخاذ خطوات عملية لتخفيف القيود، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التعامل مع ملفات المعتقلين «بالعدالة والدقة»، والتمييز بين المشاركين السلميين في الاحتجاجات، ومن تصفهم السلطات بقادة «أنشطة إرهابية».
خلفيات الاحتجاجات والضغوط الخارجية
وانطلقت الاحتجاجات أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي على خلفية انهيار قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتوسع من طهران إلى عشرات المدن. وقد أقرّ بزشكيان نفسه بوجود حالة استياء شعبي واسعة، في ظل صعوبات معيشية خانقة.
في السياق الدولي، تتزامن الاحتجاجات مع تصاعد الضغوط الأميركية والإسرائيلية على طهران، بينما تتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة بالسعي إلى استغلال العقوبات والاضطرابات الداخلية لـ«نشر الفوضى وخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام».
أزمة متعددة الأبعاد
تعكس هذه التطورات أن إيران تواجه أزمة مركّبة تتجاوز بعدها الأمني، لتطال الاقتصاد، والشرعية السياسية، وملف الحريات الرقمية. وبين أرقام الضحايا غير المسبوقة، وتزايد أعداد المعتقلين، والتلويح برفع قيود الإنترنت، تبدو البلاد أمام مفترق طرق حاسم: إما احتواء الغضب الشعبي بإصلاحات ملموسة، أو الانزلاق نحو مزيد من التصعيد الذي قد يعمّق عزلة إيران داخلياً وخارجياً.
تركيا
دوران: استهداف العلَم التركي قرب نصيبين–قامشلي استفزاز يهدد الاستقرار
أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن الهجوم الذي نفذه أنصار تنظيم YPG على العلَم التركي في سوريا، قرب خط نصيبين–قامشلي الحدودي، يشكّل استفزازاً مباشراً يهدف إلى زعزعة الاستقرار وتقويض ما وصفه بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مكافحة الإرهاب.
وفي بيان نشره عبر منصة «إن سوسيال»، شدد دوران على أن أي تهديد لأمن تركيا أو اعتداء على رموزها وقيمها «سيُقابل بأشدّ الردود حزماً»، محذراً من أن الدولة لن تتسامح مع مثل هذه الأفعال التي تستهدف وحدتها الوطنية وأمنها القومي.
وأضاف أن الحادثة تكشف عودة نشاط القوى التي تسعى، بحسب تعبيره، إلى إفشال هدف «تركيا الخالية من الإرهاب»، مؤكداً أن هذه المحاولات لن تُضعف عزيمة الدولة، ولن تؤثر على تماسك المجتمع أو تضامنه الداخلي.
وأشار دوران إلى أن الجهات التركية المختصة باشرت تحقيقاً فورياً في الواقعة، مؤكداً أن هوية المنفذين والجهات التي تقف خلفهم ستُحدَّد ضمن إطار سيادة القانون، وأن جميع الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة ستُتخذ دون تأخير، مضيفاً أن «أي هجوم أو استفزاز لن يمر دون عقاب».
سياق ميداني هش
يأتي هذا التصعيد على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 18 يناير/كانون الثاني 2026 بين الحكومة السورية وتنظيم YPG، إذ أفادت تقارير بوقوع اشتباكات محدودة الثلاثاء في مناطق متفرقة من محافظتي الرقة والحسكة، ما يعكس هشاشة التهدئة على الأرض.
كما أعاد البيان التركي التذكير بتنصّل تنظيم YPG سابقاً من تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار 2025 مع الحكومة السورية، والذي كان ينص على إدماج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن هياكل الدولة، وضمان حقوق متساوية لجميع المكونات، بما فيها المكون الكردي.
خلفية سياسية أوسع
وتندرج هذه التطورات ضمن مرحلة حساسة تشهدها سوريا، في ظل مساعي إدارة الرئيس أحمد الشرع إلى بسط الأمن وإعادة فرض السيطرة المركزية على كامل الجغرافيا السورية، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
ويرى مراقبون أن حادثة العلَم التركي، وما رافقها من اشتباكات متفرقة، تعكس استمرار وجود أطراف مسلحة تحاول اختبار حدود التفاهمات الجديدة، سواء مع دمشق أو مع أنقرة، في وقت تُعاد فيه صياغة التوازنات الأمنية والسياسية في شمال وشرق سوريا.
مسؤول تركي: اتفاقيات جديدة تعمّق الشراكة الدفاعية مع قطر
أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون توقيع سلسلة اتفاقيات جديدة مع دولة قطر، قال إنها من شأنها تعزيز التعاون الدفاعي القائم بين البلدين والارتقاء به إلى مستويات أكثر تقدماً.
وجاءت تصريحات غورغون، على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026)، حيث أكد أن التعاون الدفاعي الاستراتيجي بين أنقرة والدوحة «يتعمّق بشكل أكبر عبر هذه الاتفاقيات»، واصفاً الخطوات الجديدة بأنها ترجمة عملية للرؤية الاستراتيجية المشتركة التي أرساها البلدان خلال السنوات الماضية.
وأشار المسؤول التركي إلى أن الصناعات الدفاعية تتصدر مجالات الشراكة الاستراتيجية مع قطر، لافتاً إلى امتلاك تركيا قدرات متقدمة في تطوير المنصات والأنظمة والحلول الدفاعية القادرة على تلبية احتياجات الدوحة، فضلاً عن قابليتها للتكيّف مع متطلبات دول أخرى.
حضور تركي واسع واتفاقيات صناعية
وأكد غورغون أن تركيا تشارك في «ديمدكس 2026» بأكبر عدد من شركات الصناعات الدفاعية مقارنة ببقية الدول، موضحاً أن المعرض شهد عقد لقاءات مع وزراء دفاع من دول مختلفة، إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات تعاون.
وفي هذا السياق، أوضح أن اتفاقيات التعاون وُقّعت بما يتماشى مع احتياجات قطر بين شركة برزان القابضة التابعة لوزارة الدفاع القطرية، وعدد من الشركات التركية المتخصصة، من بينها أسيلسان، STM، أسفات، تايس، إضافة إلى شركات الصناعات الكيميائية والميكانيكية التركية.
وبيّن أن الاتفاقيات تغطي مجالات حيوية تشمل إنتاج الذخائر، وهندسة الأنظمة، والمنصات البحرية، وتبادل التكنولوجيا، وبناء شراكات صناعية دفاعية مستدامة.
نمو لافت للصناعات الدفاعية التركية
وعلى صعيد متصل، استعرض غورغون مؤشرات النمو في قطاع الصناعات الدفاعية التركية، موضحاً أن القطاع أنهى عام 2024 بنمو بلغ 28%، مع صادرات وصلت إلى 7.1 مليارات دولار، في حين حقق خلال العام الماضي نمواً بنسبة 48%، مع صادرات تجاوزت 10 مليارات دولار.
ويُذكر أن معرض «ديمدكس 2026» انطلق، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالعاصمة الدوحة، ويستمر حتى 22 يناير/كانون الثاني، بمشاركة واسعة من شركات وصنّاع القرار في قطاع الصناعات الدفاعية حول العالم.
قفزة في واردات إسرائيل من نفط أذربيجان عبر تركيا رغم الحظر المعلن من أنقرة
أظهرت بيانات تتبّع السفن ارتفاع واردات إسرائيل من النفط الأذربيجاني المنقول عبر ميناء جيهان التركي إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات خلال عام 2025، في تطور يسلّط الضوء على قدرة تل أبيب على تأمين إمدادات الطاقة رغم القيود السياسية المعلنة. ووفق تقرير نشرته رويترز، ارتفعت الإمدادات بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 94 ألف برميل يومياً، ما جعل أذربيجان أكبر مورد نفطي لإسرائيل خلال العام الماضي، متقدمة على روسيا.
وتأتي هذه الزيادة رغم إعلان تركيا وقف التبادل التجاري مع إسرائيل منذ يونيو/حزيران 2024، احتجاجاً على الحرب في غزة، حيث تُظهر البيانات التركية الرسمية أن حجم التجارة بين البلدين بلغ صفراً منذ ذلك التاريخ. غير أن أنقرة أوضحت في وقت سابق أنها لا تتحكم في وجهة بيع النفط الأذربيجاني الذي يُضخ عبر خط أنابيب باكو–تفليس–جيهان، مؤكدة أن الشركات المصدّرة “احترمت” قرارها بإنهاء التجارة المباشرة مع إسرائيل، وأنه لا يتم شحن النفط إليها كوجهة مُعلنة.
لكن بيانات شركة “كبلر” المتخصصة بتتبع الشحنات كشفت استمرار تدفق الخام الأذربيجاني إلى الموانئ الإسرائيلية، في مؤشر على بقاء قنوات الإمداد مفتوحة بطرق غير مباشرة. ويعزز ذلك ما وصفته رويترز بنمط متكرر في تجارة الطاقة، إذ تواصل إسرائيل التعامل مع شركات في دول تعلن حكوماتها معارضة الحرب على غزة. ولفت التقرير إلى أن جنوب أفريقيا، التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية، كانت أكبر مورد للفحم إلى إسرائيل في 2025.
من جانبها، امتنعت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية عن التعليق على مصادر واردات النفط، فيما قالت الحكومة الإسرائيلية سابقاً إن الحظر التجاري التركي يتجاهل اتفاقات دولية قائمة. ويعكس هذا المشهد تبايناً بين الخطاب السياسي والإجراءات الاقتصادية الفعلية، خصوصاً في ملف الطاقة، الذي يبدو أقل تأثراً بالقيود المعلنة وأكثر ارتباطاً باعتبارات السوق وسلاسل الإمداد العالمية.
متابعات عربية
التلفزيون السعودي يلوّح بإجراءات ضد الإمارات وسط تصعيد غير مسبوق
شهد الخطاب الإعلامي الرسمي السعودي تصعيداً لافتاً تجاه دولة الإمارات، بعدما بثّت قناة الإخبارية السعودية تقريراً حمل نبرة تهديد واضحة، لوّحت فيه باتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد أبو ظبي، متهمةً إياها بالعمل بما يتعارض مع المصالح الأمنية للمملكة.
وأكد التقرير أن المملكة العربية السعودية لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة ضد أي طرف يمس أو يهدد أمنها الوطني، في إشارة مباشرة إلى الإمارات العربية المتحدة، مع تلميح إلى أن قرارات عملية قد تكون وشيكة.
واتهمت القناة حكومة أبو ظبي بالتحرك بعكس الدعوات السعودية المتكررة للحفاظ على العلاقات الثنائية، زاعمة أنها قامت بـ«تنظيم عملية تهريب» لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي من اليمن إلى أبو ظبي، وقدّمت له ولأنصاره دعماً مالياً للتحريض ضد الرياض.
وبحسب التقرير، شمل هذا التحريض اتهام السعودية بدعم جماعة الإخوان المسلمين وتمكين تنظيم القاعدة، إلى جانب ترويج مزاعم عن احتجاز أعضاء من وفد جنوبي كان مستضافاً في الرياض، وهي اتهامات اعتبرتها القناة جزءاً من حملة إعلامية وسياسية منظمة.
كما أشار التلفزيون السعودي إلى اتهامات يمنية موجّهة للإمارات بـ«تنظيم وتمويل تحركات ومظاهرات تصعيدية في عدن»، بهدف إفشال مسار الحوار الجنوبي–الجنوبي، الذي كان من المقرر عقده في العاصمة السعودية، ضمن جهود لإعادة ترتيب البيت الجنوبي والوصول إلى تسوية داخلية.
الإنذار الأخير
وفي سياق متصل، ذكّرت القناة بالبيان الصادر عن مجلس الوزراء السعودي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، معتبرة إياه «دعوة نهائية» لوقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف في اليمن. وأكد التقرير أن مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على ذلك البيان، دون تغيّر في السلوك الإماراتي بحسب وصفه، دفع الرياض إلى التلويح بإجراءات رادعة لحماية أمنها القومي.
ويأتي هذا التصعيد الإعلامي بعد اتهام سعودي صريح لأبو ظبي بمحاولة إحباط مسار الاتفاق اليمني–اليمني، الذي تضمّن حل المجلس الانتقالي الجنوبي وفتح الطريق أمام تسوية شاملة لقضية جنوب اليمن.
دلالات سياسية
يرى مراقبون أن لهجة التقرير تمثل تحولاً نوعياً في مستوى الخلاف السعودي–الإماراتي، إذ انتقلت من تباينات غير معلنة إلى مواجهة إعلامية مباشرة عبر قناة رسمية، ما يعكس عمق التوتر حول الملف اليمني، وتحديداً مستقبل الجنوب ودور الفاعلين الإقليميين فيه.
وفي حال ترجمة هذا التصعيد الإعلامي إلى خطوات سياسية أو اقتصادية ملموسة، فقد يشكّل ذلك محطة مفصلية في مسار العلاقات بين الرياض وأبو ظبي، التي ظلت لسنوات تُقدَّم بوصفها نموذجاً للتحالف الوثيق داخل الخليج، رغم الخلافات المتراكمة في الملفات الإقليمية.
الجدير بالذكر، أن حالة التراشق الإعلامي الصريح بين البلدين قد وصلت مؤخراً إلى مستويات غير مسبوقة، ما يترافق مع أنباء عن فشل محاولات جرت مؤخراً لرأب الصدع وتهدئة الخلافات بين الرياض وأبو ظبي.
الإمارات والهند تتجهان نحو شراكة دفاعية إستراتيجية
خطت دولة الإمارات العربية المتحدة والهند خطوة جديدة في مسار تعميق علاقاتهما الثنائية، بعد توقيع خطاب نوايا لشراكة إستراتيجية في المجال الدفاعي، خلال زيارة رسمية خاطفة أجراها رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، يصاحبه وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة الهندية نيودلهي.
وجرى التوقيع بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ضمن حزمة أوسع من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي بين البلدين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وذكرت الوكالة أن أحد أبرز هذه الخطابات يتعلق بتأسيس شراكة إستراتيجية دفاعية، من دون الكشف عن تفاصيل فنية أو عسكرية إضافية، في مؤشر على رغبة الطرفين بترك المجال مفتوحاً لتطوير التعاون تدريجياً وفق متطلبات المرحلة المقبلة.
ووقّع خطاب النوايا من الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان، بينما وقّعه عن الجانب الهندي وزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار.
وفي تعليق لافت، أكد وزير الخارجية الهندي أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة انخراط بلاده في صراعات إقليمية، في إشارة إلى حساسية التوازنات الأمنية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وسعي نيودلهي إلى الحفاظ على سياسة خارجية قائمة على الشراكات المتعددة دون الانزلاق إلى محاور عسكرية مباشرة.
من جهته، رحّب الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله بالاتفاق، واعتبره نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن الشراكة قد تمتد إلى مشاريع متقدمة تشمل مجالات حساسة مثل الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا النووية السلمية.
ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي متغير، لا سيما بعد إعلان إسلام آباد إعداد مسودة اتفاق دفاعي ثلاثي يضم باكستان والسعودية وتركيا، ما يعكس سباقاً متسارعاً لإعادة رسم شبكات التحالفات الأمنية في آسيا والشرق الأوسط.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لم تقتصر التفاهمات الإماراتية-الهندية على الملف الدفاعي، إذ وقّع الجانبان صفقة بقيمة 3 مليارات دولار لتزويد الهند بالغاز الطبيعي المسال من الإمارات لمدة عشر سنوات، في خطوة تعزز أمن الطاقة الهندي وتكرّس موقع الإمارات مورداً موثوقاً للطاقة.
كما اتفق الطرفان على مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 200 مليار دولار بحلول عام 2032، وهو هدف طموح يعكس حجم الرهان المشترك على الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد.
وفي مجال الفضاء، شهد الزعيمان تبادل خطاب نوايا بين وكالة الإمارات للفضاء والمركز الوطني الهندي لتعزيز واعتماد أنشطة الفضاء، لإطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تطوير صناعة الفضاء وتمكين التعاون في مجالات البحث والتكنولوجيا المتقدمة.
بهذه الحزمة من الاتفاقات، تؤكد أبو ظبي ونيودلهي سعيهما للانتقال من علاقة تعاون تقليدية إلى شراكة متعددة الأبعاد، تمتد من الدفاع والطاقة إلى الاقتصاد والفضاء، في وقت يشهد فيه النظام الدولي تحولات متسارعة وإعادة تشكيل لموازين القوة والتحالفات.
الصومال وقطر توقّعان اتفاقية تعاون دفاعي لتعزيز الشراكة الأمنية
وقّعت جمهورية الصومال الفيدرالية ودولة قطر اتفاقية للتعاون الدفاعي، في خطوة تهدف إلى تطوير العلاقات العسكرية وتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، وفق ما أعلن وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي.
وقال فقي، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، إن الاتفاقية تأتي في إطار التزام مقديشو بتعزيز قدرات الجيش الوطني الصومالي ورفع جاهزيته للدفاع عن وحدة البلاد وسيادتها، مؤكداً أن التعاون مع الدوحة يشكّل إضافة نوعية لمسار بناء المؤسسة العسكرية الصومالية.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية، وقّع الاتفاقية عن الجانب القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري، بحضور مسؤولين من الجانبين.
وأوضحت الوكالة أن الاتفاق يهدف إلى توسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزّز الشراكة الدفاعية بين دولة قطر وجمهورية الصومال الفيدرالية، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بنطاق التعاون أو مدته.
ويأتي هذا التطور في سياق تحركات إقليمية متزايدة لتعزيز الشراكات الدفاعية في منطقة القرن الأفريقي، حيث تسعى مقديشو إلى تنويع علاقاتها العسكرية وتطوير بنيتها الأمنية، في ظل تحديات داخلية وإقليمية مستمرة.
الجيش الباكستاني يعلن وصول وحدة جوية إلى السعودية للمشاركة في مناورات رماح النصر 2026
أعلن الجيش الباكستاني، وصول وحدة تابعة لـ سلاح الجو الباكستاني إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في مناورات جوية قتالية متعددة الجنسيات.
وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني أن الوحدة تضم مقاتلات من طراز F-16 بلوك 52، إلى جانب أطقم جوية وأرضية متخصصة، وقد وصلت إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية للمشاركة في تدريبات رماح النصر 2026.
ووفق البيان، تشهد المناورات مشاركة واسعة من قوات جوية وعناصر دعم قتالي من عدة دول، من بينها السعودية وباكستان وفرنسا وإيطاليا واليونان وقطر والبحرين والأردن والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في إطار تمرين يُعد من أكبر التدريبات الجوية متعددة الجنسيات في المنطقة.
وأشار الجيش الباكستاني إلى أن هذه التدريبات توفّر منصة متقدمة لتعزيز قابلية التشغيل البيني والتآزر العملياتي بين القوات المشاركة، إضافة إلى تطوير التفاهم المتبادل وبناء القدرات، ولا سيما في مجالات توظيف القوات الجوية الكبيرة، وتنفيذ العمليات الجوية المركبة ليلاً، ودمج قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، والعمل في بيئات حرب إلكترونية متقدمة.
وأكد البيان أن مشاركة سلاح الجو الباكستاني في هذه المناورات تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية العملياتية في ساحات قتال حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز القدرة على العمل المشترك مع القوات الجوية الشريكة في بيئات تنافسية ومعقدة.
وختم الجيش الباكستاني بالتأكيد على أن المشاركة في «رماح النصر 2026» لا تعكس فقط التزام إسلام آباد بالتعاون العسكري الإقليمي والدولي، بل تبرز أيضاً المستوى المهني العالي لسلاح الجو الباكستاني وقدرته المؤكدة على العمل بكفاءة إلى جانب القوات الجوية الحديثة والرائدة عالمياً.
شائع الزنداني… مسار دبلوماسي طويل يقود إلى رئاسة الحكومة اليمنية
تولّى الدبلوماسي اليمني المخضرم شائع محسن الزنداني رئاسة الحكومة في 16 يناير/كانون الثاني 2026، متوّجاً مسيرة سياسية ودبلوماسية امتدت لعقود، شغل خلالها مناصب رفيعة داخل اليمن وخارجه، كان آخرها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
الزنداني يُعد من أبرز الوجوه الدبلوماسية اليمنية، إذ مثّل بلاده سفيراً فوق العادة ومفوّضاً في عواصم مؤثرة، من بينها لندن وروما وعمّان والرياض، كما اضطلع بأدوار تمثيلية لدى منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، ما منحه خبرة تراكمية في إدارة الملفات السياسية والإقليمية المعقّدة.
النشأة والتحصيل العلمي
وُلد شائع محسن الزنداني في 16 سبتمبر/أيلول 1954 بمديرية جحاف في محافظة الضالع جنوبي اليمن. وهو متزوج وله أربعة أبناء. حصل على بكالوريوس في الحقوق، ثم واصل دراساته العليا لينال دكتوراه في فلسفة القانون، إضافة إلى دكتوراه فخرية في العلوم الدبلوماسية تقديراً لإسهاماته الأكاديمية والمهنية.
وبرز نشاطه العام مبكراً من بوابة العمل الطلابي؛ إذ ترأس الاتحاد الوطني العام لطلبة اليمن عام 1974، ثم شغل منصب السكرتير العام للاتحاد العام لطلبة العرب عام 1976، قبل انتقاله إلى المسار الأكاديمي والدبلوماسي.
من الجامعة إلى السلك الدبلوماسي
عمل الزنداني مدرساً في جامعة عدن بين عامي 1978 و1981، ثم التحق بالسلك الدبلوماسي، ليتدرج في مناصب داخلية وخارجية. شغل منصب وزير مفوّض وقائم بأعمال السفارة اليمنية في بغداد (1981–1982)، ثم نائب وزير الخارجية في اليمن الجنوبي (1986–1990)، فـنائب وزير الخارجية برتبة وزير بعد الوحدة (1990–1991).
وخلال التسعينيات والألفية الجديدة، مثّل اليمن سفيراً في المملكة المتحدة (1991–1994)، ثم سفيراً ومستشاراً للوفد الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف (1994–1997)، قبل أن يتولى مهام سفير فوق العادة في إيطاليا، وسفيراً غير مقيم لدى اليونان وصربيا وألبانيا وسان مارينو (2005–2010). كما كان مندوباً دائماً لليمن لدى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بين 2008 و2010.
لاحقاً، شغل منصب سفير اليمن لدى الأردن (2010–2015)، ثم سفيراً لدى السعودية ومندوباً دائماً لدى منظمة التعاون الإسلامي (2017–2024). وفي 27 مارس/آذار 2024، عُيّن وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
أدوار ومشاركات دولية
شارك الزنداني في عضوية هيئات ولجان رسمية وفكرية، منها اللجنة العليا للإصلاح السياسي والاقتصادي (1989)، ومجلس تعزيز التفاهم العربي–البريطاني، ومنتدى الفكر العربي، إضافة إلى عضويته في مجلس أمناء المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا التابع للأمم المتحدة. كما ترأس وفد اليمن في مناسبات مفصلية، أبرزها اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم إعلان الوحدة اليمنية في 22 مايو/أيار 1990.
إلى رئاسة الحكومة
في 16 يناير/كانون الثاني 2026، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قراراً بتكليف الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتشكيله حكومة جديدة، عقب استقالة رئيس الوزراء السابق سالم صالح بن بريك. ووفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، جاء القرار في سياق السعي إلى «تعزيز وحدة القرار السيادي»، في ظل تغيّرات ميدانية وسياسية شهدتها المحافظات الجنوبية.
وبموجب القرار، تستمر الحكومة القائمة في تصريف الأعمال إلى حين إعلان التشكيلة الجديدة، باستثناء قرارات التعيين والعزل. ويُنظر إلى تكليف الزنداني باعتباره رهاناً على خبرته الدبلوماسية الطويلة لإدارة مرحلة سياسية حساسة، تتطلب توازناً بين الداخل اليمني وتعقيدات الإقليم.
متابعات دولية
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تعلن حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة
أعلنت ساناي تاكايتشي، رئيسة الوزراء في اليابان، أنها ستقوم بحل مجلس النواب الياباني يوم 23 يناير/كانون الثاني 2026، داعية إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 8 فبراير/شباط 2026 لاختيار أعضاء المجلس، وذلك سعياً للحصول على تفويض شعبي لدعم برنامجها السياسي والاقتصادي والأمني.
جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عقدته تاكايتشي يوم الاثنين، حيث قالت إنها تريد من الشعب أن يقرر ما إذا كان يجب أن تستمر في قيادة الحكومة، معتبرة أن الانتخابات المبكرة تمنح شرعية واضحة لسياساتها وسط تحديات سياسية واقتصادية. وتكون هذه أول انتخابات يخوضها حزبها منذ تولّيها المنصب في أكتوبر/تشرين الأول 2025، حين أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ اليابان.
وستشمل الانتخابات جميع ال 465 مقعداً في مجلس النواب، وسيتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم في البرلمان الجديد. وكما هو معتاد في النظام البرلماني الياباني، فإن حل مجلس النواب واستدعاء الانتخابات عبر هذه الخطوة يعطي تاكايتشي فرصة لتعزيز تفويضها الشعبي وتمتين قيادتها داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم، الذي يتمتّع حالياً بأغلبية ضئيلة في البرلمان.
وتعتمد تاكايتشي في هذه الخطوة على نتائج استطلاعات الرأي التي تُظهر دعماً ملحوظاً لقيادتها، لاسيما في ظل توجهها إلى تعزيز الإنفاق الحكومي، خفض الضرائب الأساسية، وتبني استراتيجية أمنية أقوى في مواجهة توترات إقليمية، بما في ذلك التوترات مع الصين حول ملف تايوان.
لكن قرار إجراء انتخابات مبكرة أثار انتقادات من بعض المعارضة، التي ترى أن الدعوة إلى الانتخابات قد تؤخر مناقشة ميزانية البلاد للعام المالي 2026 وقوانين مهمة أخرى، في وقت تواجه اليابان تحديات اقتصادية بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو.