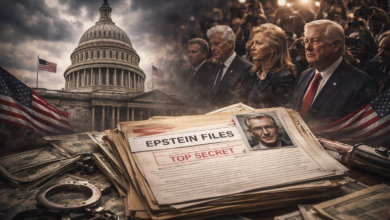نحن والعالم عدد 9 أكتوبر 2025

يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 1 أكتوبر 2025 إلى 9 أكتوبر 2025.
تغرق واشنطن في شللٍ سياسي بسبب الإغلاق الحكومي الذي يهدّد الاقتصاد الأكبر في العالم، وسط صراعات سياسية حادة، بينما يواصل ترامب عسكرة الداخل وتوسيع النفوذ الأميركي في الخارج.
وفي الشرق الأوسط، تتصدر تركيا مشهد الطاقة الخضراء وتواجه جدلاً مع إيران التي أعلنت اكتشافاً ضخماً للغاز وانتقدت أنقرة لالتزامها بالعقوبات الأممية.
أما سوريا فدخلت مرحلة سياسية جديدة بانتخاب أول برلمان بعد سقوط النظام، وسط انقسام حول جدوى التجربة، وفي نفس الوقت يتجدد القتال مع قسد بما يهدد استقرار التجربة الوليدة.
وفي إفريقيا، تتسارع التحولات بين انتخابات غينيا ونزاعات النيجر وتمدّد النفوذ التركي–الأميركي.
وعلى الساحة الدولية، تتأرجح أوروبا بين أزمة فرنسا، وتسريحات جماعية، وتراجع استهلاك، فيما تتقدّم اليابان نحو أول رئاسة وزراء نسائية في تاريخها.
أمريكا
الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يدخل أسبوعه الثاني، كاشفاً عن عمق الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين، وعن التوظيف السياسي المكثف لموضوع التمويل الفيدرالي في الحزبين الرئيسيين، وعن هشاشة التوافق السياسي الذي يهدد بإبطاء الاقتصاد الأكبر في العالم.
في الوقت ذاته، تُظهر إدارة ترامب نزعة متزايدة نحو عسكرة الداخل وتوسيع نفوذها الخارجي، سواء عبر تجميد مليارات الدولارات في مشروعات مدنية بمدن معارضة، أو عبر توجيه الجيش لما سمّاه الرئيس “محاربة العدو الداخلي”.
وفي الشرق الأوسط، تواصل واشنطن ترسيخ حضورها العسكري بتوسيع قاعدة “ثاد” في إسرائيل، في إشارة إلى تحالف أمني يتجاوز الدفاع إلى النفوذ الجيوسياسي.
أما في الفضاء الرقمي، فتتكشف خيوط تداخل التكنولوجيا بالسياسة مع تسريبات “تيك توك” التي تربط الاستثمار الأميركي بخطط “غرس حب إسرائيل” في الثقافة الأميركية.
ملف الإغلاق الحكومي في أمريكا
في هذا التقرير، يقدم المعهد المصري للدراسات ملفاً شاملاَ حول موضوع الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، نستعرض فيه المفهوم القانوني للإغلاق وتطوراته وأثاره على عمل كافة الوكالات الفيدرالية في مجالات التعليم والأمن والسفر والرعاية الصحية والإسكان وغير ذلك. كما نستعرض التداعيات الاقتصادية للإغلاق، سواء على الميزانية الفيدرالية أو على توقف رواتب الموظفين الفيدراليين في المجالات المختلفة.
نستعرض أيضاً الخلفية السياسية التي أدت لهذا الإغلاق، والخلافات والاستقطابات الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي المتنامية بشكل يفاقم من الأمر، كما نستعرض كيفية التوظيف السياسي لموضوع الإغلاق من كلا الحزبين.
كما نستعرض من خلال الملف الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة ترامب لوقف التمويل الفيدرالي لبعض المشاريع الكبيرة في بعض الولايات، حيث تُظهر إدارة ترامب اتجاهاً متصاعداً لاستخدام التمويل الفيدرالي كأداة سياسية للضغط على الولايات التي يقودها الديمقراطيون، في ظل تصاعد الاستقطاب السياسي وتزايد الرهانات قبيل الانتخابات المقبلة.
موضوع التمويل الفيدرالي والإغلاق الحكومي والملابسات المتعلقة به ما هو إلا حلقة في سلسلة التوترات الحادة التي تشهدها الولايات المتحدة على المستوى الداخلي، وتضعف كثيراً من جبهتها الداخلية، والذي سينعكس بلا شك على نفوذ الولايات المتحدة وتأثيرها الدولي على المستوى المتوسط والطويل.
الإغلاق الحكومي الأميركي يدخل أسبوعه الثاني وسط جمود سياسي وشلل إداري
دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أسبوعه الثاني، وسط حالة جمود سياسي غير مسبوقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ما تسبب في تعطيل واسع النطاق لمؤسسات الدولة الفيدرالية، وإرباك مئات آلاف الموظفين والعائلات الأميركية، في أزمة بدأت تلامس حدود الاقتصاد والسياسة معاً.
ما الذي يحدث؟
مع بداية العام المالي الجديد في 1 أكتوبر، فشل الكونجرس الأميركي في تمرير قانون تمويل الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى توقف مؤقت عن العمل (Shutdown) في عدد كبير من المؤسسات والبرامج غير الأساسية.
وبحسب وكالة رويترز، فإن أكثر من 900 ألف موظف فيدرالي تأثروا بالإغلاق، بين من فُرضت عليهم الإجازة القسرية، ومن واصلوا العمل دون أجر. وتأثرت قطاعات النقل الجوي، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، ما أعاد إلى الأذهان إغلاقات سابقة، لكن هذه المرة وسط استقطاب سياسي أكثر حدة.
جوهر الأزمة: الرعاية الصحية والرسوم الأميركية
السبب الجوهري للإغلاق يعود إلى فشل الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل إلى توافق بشأن التمويل الحكومي، وسط خلافات حادة حول ملفات شائكة أبرزها:
- تمويل برامج الرعاية الصحية (Obamacare وMedicaid)، حيث يطالب الديمقراطيون بزيادات لدعم الطبقات الفقيرة، فيما يرفض الجمهوريون هذه الخطوة ويشترطون خفض الإنفاق العام.
- التوترات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، والتي زادت الضغوط على قطاعات الإنتاج والأسواق المحلية.
وفقاً لـ الجارديان، رفض الرئيس ترامب بدء أي مفاوضات مع الديمقراطيين، مؤكداً أن “الحكومة لن تُفتح ما لم تُلبَّ شروط الجمهوريين”، في حين نفى زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ “تشاك شومر” وجود أي محادثات جارية حالياً .
أثار ملموسة على المواطنين
التداعيات العملية للإغلاق بدأت تظهر بوضوح:
- مطارات رئيسية مثل نيوارك ودنفر ولاس فيغاس شهدت تأخيرات واسعة بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية.
- بعض الوكالات، مثل إدارة الغذاء والدواء، اضطرت إلى إيقاف برامج تفتيش غذائي وصحي.
- صندوق الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية يعمل بتمويل جزئي، ما يهدد بتأخيرات في المدفوعات لاحقاً .
الاتحاد الوطني لمراقبي الحركة الجوية أصدر بياناً يحث فيه أفراده على الاستمرار بالعمل رغم انقطاع الأجور، محذراً من أي تحركات إضرابية غير قانونية.
انقسامات سياسية عميقة
بحسب تحليل بوليتيكو، فإن الأزمة ليست فقط تقنية، بل تعكس صراعاً أيديولوجياً حاداً داخل الكونجرس، حيث يرى الجناح اليميني من الحزب الجمهوري أن الإغلاق أداة مشروعة للضغط على الإنفاق الحكومي، فيما يعتبره الديمقراطيون “احتجازاً للحكومة رهينةً لمطالب متطرفة”.
في الوقت نفسه، يستغل ترامب الموقف للضغط سياسياً قبيل معركة الانتخابات البرلمانية المقبلة، متهماً الديمقراطيين بـ”عرقلة الأمن الاقتصادي للأميركيين”.
هل من بوادر للحل؟
حتى الآن، لا مؤشرات حقيقية على اقتراب إنهاء الإغلاق، لكن هناك سيناريوهات متداولة:
- تمويل مؤقت (Continuing Resolution) يتيح فتح الحكومة لأسبوعين ريثما تُستأنف المفاوضات.
- تدخل الجمهوريين المعتدلين داخل مجلس النواب لتمرير صيغة توافقية.
- ضغوط شعبية وإعلامية قد تدفع الكونجرس إلى تجاوز الانقسامات مؤقتاً لتجنب تعميق الضرر الاقتصادي.
الخلفية القانونية: ماذا يعني الإغلاق دستورياً؟
الإغلاق الحكومي هو نتيجة تلقائية لعدم تمرير قانون التمويل في موعده (1 أكتوبر)، بموجب قانون “Anti-Deficiency Act” الذي يمنع صرف الأموال الفيدرالية دون تفويض من الكونجرس.
ويُسمح فقط للبرامج “الضرورية” بالاستمرار، مثل الدفاع الوطني والرعاية الصحية العاجلة، فيما تُوقف باقي الوكالات خدماتها أو تعمل دون أجور. (انظر) (انظر) (انظر) (انظر)
الإغلاق الحكومي الأميركي يهدد بخسائر اقتصادية أسبوعية تصل إلى 15 مليار دولار
مع استمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، حذر خبراء اقتصاديون ومسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب من تداعيات اقتصادية بالغة قد تكلف البلاد مليارات الدولارات أسبوعياً، وسط غياب أي مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في تصريحات لشبكة CNBC، إن استمرار إغلاق الحكومة سيؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي والإضرار بسوق العمل الأميركي، مؤكداً أن “إغلاق الحكومة ليس وسيلة للحوار، بل خطوة تضرب الناتج المحلي وتضر بالعمال الأميركيين”.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة EY Parthenon الاستشارية، فإن كل أسبوع إضافي من الإغلاق قد يخفض النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ما يعادل خسائر بقيمة 7 مليارات دولار أسبوعياً. ويعود ذلك إلى توقف صرف أجور العاملين الفيدراليين، وتأخير إنفاق الحكومة على المشتريات والخدمات، فضلاً عن انخفاض الطلب العام.
وفي تقدير آخر أكثر تشاؤماً، ذكرت مذكرة لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، حصلت عليها صحيفة بوليتيكو، أن الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأميركي ما يصل إلى 15 مليار دولار أسبوعياً، وأن استمرار الإغلاق لمدة شهر قد يؤدي إلى فقدان 43 ألف وظيفة إضافية، إلى جانب انخفاض قدره 30 مليار دولار في الإنفاق الاستهلاكي.
وأوضحت المذكرة أن التأثيرات المحتملة تشمل انخفاض النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وتعطّل بعض البرامج الحيوية مثل الضمان الاجتماعي، وخدمات الطيران، والدعم الغذائي المقدم للنساء والأطفال. وخلص التقرير إلى أن “هذه التداعيات ستزداد حدّة كلما طال أمد الإغلاق”.
وفي السياق ذاته، حذرت شركة EY Parthenon من أن آثار الإغلاق قد لا تتوقف عند الخسائر المباشرة، بل قد تمتد إلى تراجع ثقة الأسواق المالية والقطاع الخاص، وتأخير صدور بيانات اقتصادية حيوية يعتمد عليها صناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون وقادة الأعمال، ما يزيد من حالة الضبابية في بيئة اقتصادية متقلبة أصلاً.
ويُذكر أن أطول إغلاق حكومي سابق شهدته الولايات المتحدة استمر 35 يوماً بين ديسمبر 2018 ويناير 2019، وقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تكلفته بلغت 11 مليار دولار، منها 3 مليارات كانت خسارة دائمة. ولم تشمل تلك التقديرات الآثار غير المباشرة، مثل توقف التصاريح الفيدرالية وتعطل القروض.
الإغلاق الحالي، بحسب مراقبين، لا يمثل مجرد أزمة تمويل مؤقت، بل يكشف هشاشة التوافق السياسي في البلاد، ويهدد بتفاقم التباطؤ الاقتصادي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطاً مالية عالمية ومخاطر داخلية متزايدة.
وكالات فدرالية أميركية تُحمّل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي في خطوة قد تُعد انتهاكاً للقانون
وجّهت عدة وكالات فدرالية أميركية أصابع الاتهام بشكل علني إلى الحزب الديمقراطي باعتباره المسؤول عن الإغلاق الحكومي المستمر، مستخدمة رسائل إلكترونية رسمية ومواقعها الإلكترونية لنشر رسائل ذات طابع سياسي حزبي، في خطوة اعتبرها مراقبون ومشرّعون انتهاكاً محتملاً لـ “قانون هاتش” الذي يحظر على الموظفين الفدراليين ممارسة أنشطة سياسية حزبية أثناء تأديتهم لمهامهم الرسمية.
وفي رسائل آلية تم إعدادها كإجابات خارج المكتب، طُلب من الموظفين المُحالين إلى الإجازة القسرية في بعض الوكالات توضيح أن سبب غيابهم عن العمل هو “الإغلاق الذي تسبب به الديمقراطيون”. كما ظهرت عبارات مشابهة على صفحات عدد من المواقع الإلكترونية للوكالات، مثل وزارة الخزانة الأميركية التي استخدمت لغة تصعيدية اتهمت فيها “اليسار الراديكالي” بأنه هو من اختار إغلاق الحكومة “باسم الإنفاق المتهور والتعطيل السياسي”.
وبحسب تقارير إعلامية، استخدمت وزارة الزراعة الأميركية لغة مماثلة في صفحتها الرسمية، ووصفت الإغلاق بأنه “إغلاق من تنفيذ اليسار الراديكالي الديمقراطي”. وفي وزارة التعليم، أكدت مصادر داخلية أن المسؤولين قاموا بتغيير محتوى رسائل “خارج المكتب” دون علم الموظفين، ليُضاف إليها عبارات تلقي باللوم على الديمقراطيين.
المشرّع الديمقراطي البارز جايمي راسكين، المتخصص في القانون الدستوري، وصف ما يحدث بأنه “تحويل للمواقع الحكومية المموّلة من أموال دافعي الضرائب إلى أبواق دعائية لحملة ترامب”، مضيفاً أن هذا السلوك يمثل “انتهاكاً سافراً لقانون هاتش”. وأكد أنه في أي إدارة سابقة، كان استخدام الرسائل الرسمية لتوجيه اتهامات سياسية كفيلاً بطرد المسؤول فوراً، إن لم يكن بمحاكمته.
متابعة لما كشفته صحيفة الغارديان، تبيّن أن عدداً من الوكالات الحكومية لجأت إلى هذه اللغة، ومنها: وزارة العدل، وزارة الخارجية، وزارة الخزانة، وزارة الزراعة، وزارة التعليم، وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وزارة العمل، وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وزارة التجارة، إدارة الأعمال الصغيرة، إدارة مكافحة المخدرات، مراكز السيطرة على الأمراض، إدارة الغذاء والدواء، وإدارة الأطفال والأسر.
المدير التنفيذي لمجموعة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن” (CREW)، دونالد شيرمان، اعتبر أن هذه الممارسات “غير أخلاقية وخطيرة”، وقال إن بعضها قد يكون مخالفاً للقانون، وبعضها الآخر ليس بالضرورة غير قانوني، لكنه “غير مسؤول وغير لائق بدرجة استثنائية”. وأشار إلى أن توقيت هذه الدعاية الحزبية يزيد من خطورتها، إذ يعتمد كثير من الأميركيين حالياً على المواقع الحكومية للحصول على معلومات عن خدماتهم المتوقفة.
من جهتها، قدمت منظمة “المواطن العام” (Public Citizen)، وهي منظمة حقوقية غير ربحية، شكوى رسمية ضد إدارة الأعمال الصغيرة، معتبرة أن ما ورد على موقعها من اتهام للديمقراطيين ينتهك قانون هاتش. وقال المتحدث باسم المنظمة، كريغ هولمان، إن ترامب “ألغى فعلياً أي رقابة أخلاقية داخل الإدارة الفدرالية، ما شجّع هذه السلوكيات الحزبية”.
كما أرسلت مجموعة “صندوق مدافعي الديمقراطية” (DDF) رسالة ثانية إلى مكتب المحاسبة الحكومي (GAO)، تطالب فيها بفتح تحقيق موسّع حول ما إذا كانت هذه الرسائل تنتهك القوانين الفدرالية، وعلى رأسها “قانون هاتش” و”قانون مكافحة العجز”، الذي يمنع استخدام الأموال العامة للدعاية السياسية.
في السياق ذاته، أوردت NBC News أن وزارة العمل أوصت موظفيها باستخدام صيغة تحميل الديمقراطيين المسؤولية في ردودهم الآلية عبر البريد الإلكتروني، وهي ممارسة تم تأكيدها أيضاً من قبل موظفين في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بحسب تقرير من HuffPost.
الخوف من الطرد أو الاستهداف دفع بعض الموظفين إلى طباعة إشعارات الإجازة الأخيرة وقسائم رواتبهم، تحسباً للاضطرار لتقديم طلبات بطالة في حال تصاعد التهديدات بالفصل، والتي لوّحت بها إدارة ترامب في الأيام الأخيرة.
الرقابة على هذه الانتهاكات من مسؤولية مكتب المستشار الخاص (OSC)، لكن هذا المكتب مغلق حالياً بسبب انقطاع التمويل. ويُذكر أن ترامب أقال رئيس هذا المكتب في وقت سابق من العام، وعيّن مكانه جيميسون غرير، الممثل التجاري السابق، مما أثار شكوكاً حول استقلالية التحقيقات المرتقبة.
في الوقت نفسه، واصل الرئيس ترامب استثمار الإغلاق لمهاجمة خصومه السياسيين. وقال في منشور له على منصة “تروث سوشيال” إنه يلتقي اليوم مع روس فوت، مدير مكتب الموازنة والإدارة، لبحث إلغاء تمويل ما وصفها بـ “الوكالات الديمقراطية”، واصفاً إياها بأنها “خدعة سياسية”. وأضاف: “لا أصدق أن الديمقراطيين الراديكاليين منحوني هذه الفرصة غير المسبوقة”.
تستمر حالة الإغلاق مع غياب أي اتفاق، فيما تتزايد المخاوف من أن الحكومة الفدرالية لا تستخدم أدواتها لتجاوز الأزمة، بل لتأجيج الاستقطاب السياسي وتوسيع نطاق المعركة الحزبية في المؤسسات العامة.
كيف يؤثر الإغلاق الحكومي الأميركي على المواطنين؟
مع بدء الحكومة الأميركية في حالة إغلاق بعد فشل الكونجرس في تمرير قانون تمويل جديد. ونتيجة لذلك، تم إحالة عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إلى إجازة قسرية، بينما يُجبر آخرون على العمل دون أجر حتى إشعار آخر. وفيما يلي شرح لأبرز انعكاسات هذا الإغلاق على الحياة اليومية للمواطنين الأميركيين:
1. الرواتب والموظفون الفيدراليون
يواصل الموظفون “الضروريون” – مثل عناصر الأمن، الجيش، عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وموظفي الأمن في المطارات (TSA) – أداء مهامهم دون راتب. في المقابل، تم إيقاف فئات كبيرة من العاملين “غير الأساسيين” عن العمل دون أجر.
ووفقاً لقانون صدر عام 2019، سيُصرف لاحقاً أجر جميع الموظفين الفيدراليين المتضررين، لكن هذا لا يشمل المتعاقدين مع الحكومة الذين قد لا يتلقون أي تعويض عن فترة التوقف.
بحسب البيانات الرسمية، تعرّضت بعض الوكالات لضربات كبيرة، أبرزها:
وكالة حماية البيئة (EPA) 89% من موظفيها أُحيلوا إلى الإجازة.
وزارة التعليم: 87%
وزارة التجارة: 81%
وزارة العمل: 76%
وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD): 71%
وزارة الخارجية: 62%
وزارة الداخلية: 53%
وزارة الزراعة: 49%
وزارة الدفاع (مدنيين): 45%
وزارة الصحة والخدمات الإنسانية: 41%
وزارة الأمن الداخلي: 5% فقط، لكن معظم الموظفين يعملون دون أجر.
وزارة شؤون المحاربين القدامى: 97% من موظفيها يواصلون العمل.
2. السفر والنقل
ستستمر الرحلات الجوية، حيث لا يزال مراقبو الحركة الجوية وضباط التفتيش يعملون، لكن من دون أجور، مما قد يؤدي إلى تأخيرات وطوابير أطول.
خدمات إصدار جوازات السفر والتأشيرات مستمرة، مع احتمالات تأخير في حال طال أمد الإغلاق.
3. المنافع العامة والرعاية الصحية
يستمر صرف استحقاقات الضمان الاجتماعي، ميديكير وميديكيد، رغم احتمال تأخيرات في الخدمات كاستبدال البطاقات أو تأكيدات الأهلية.
برامج المساعدات الغذائية مثل SNAP وWIC ستستمر بالعمل.
مستشفيات معهد الصحة الوطني (NIH) ستواصل استقبال المرضى الحاليين، لكنها لن تستقبل حالات جديدة إلا عند الضرورة الطبية.
إدارة الغذاء والدواء (FDA) ستواصل بعض عمليات التفتيش، لكن الموافقات الجديدة على الأدوية والأجهزة ستتأخر، كما سيتم تجميد منح الأبحاث الجديدة.
4. الحدائق الوطنية
ستبقى الممرات والمتنزهات والمواقع المفتوحة متاحة بشكل عام للزوار، لكن الخدمات مثل التوجيه، التنظيف، والمخيمات قد تكون محدودة أو مغلقة بالكامل.
بعض المواقع النائية أو غير المأهولة قد تُغلق، وقد تُلغى الجولات الرسمية للمرافق مثل مبنى الكابيتول أو مقر الـ FBI.
5. المتاحف والمؤسسات الثقافية
ستبقى متاحف مؤسسة سميثسونيان وحديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن مفتوحة حتى 6 أكتوبر باستخدام تمويل متبقٍ من العام السابق. ولم تُحدد بعد خطط ما بعد هذا التاريخ في حال استمرار الإغلاق.
أما مركز كينيدي للفنون، فسيواصل برامجه دون تأثر، نظراً إلى تمويل كبير تلقّاه بموجب قانون “مشروع ترامب الكبير للإصلاح”، الذي خصص له 257 مليون دولار لأعمال التجديد والصيانة.
6. الإسكان
توقفت أعمال وزارة الإسكان والتنمية الحضرية تقريباً ، مما يزيد من تعقيد أزمة السكن القائمة.
وبحسب شارون كورنيليسين، مديرة برنامج السكن في اتحاد المستهلكين، فإن آلاف عمليات شراء وبيع العقارات ستتوقف، خاصة في المناطق التي تعتمد على برنامج التأمين ضد الفيضانات، والذي توقفت تمويلاته.
وأضافت أن “الحصول على سكن آمن وعادل بات مستحيلاً بدون حكومة فاعلة”، متهمة الإدارة الحالية بتقويض البرامج الأساسية التي يعتمد عليها الأميركيون.
7. حماية المستهلك
الوكالات الرقابية – التي تعاني أصلاً من نقص التمويل والكوادر – باتت عاجزة فعلياً عن مراقبة السوق أو حماية المستهلكين.
وقالت إيرين ويت، مديرة شؤون حماية المستهلك في الاتحاد، إن “هذا الإغلاق ليس مجرد استعراض سياسي، بل استمرار للهجوم على حماية المستهلك”.
وأضافت أن تجميد هذه الهيئات يُعرّض العائلات الأميركية لخطر الاحتيال والرسوم التعسفية والاستغلال التجاري.
رغم أن بعض الخدمات الأساسية كالتأمين الصحي والرحلات الجوية ستستمر، فإن تداعيات الإغلاق بدأت تطال مجالات متعددة، من السكن إلى الغذاء، ومن الثقافة إلى حماية المستهلك.
الموظفون الفيدراليون هم الأكثر تضرراً، ما بين من يعملون دون أجر ومن أُجبروا على التوقف.
وإذا استمر الإغلاق، قد تتسع الفجوة بين الحكومة والمجتمع، ويُصبح المواطن هو الضحية الأوضح في هذه المعركة السياسية.
إدارة ترامب تُجمّد 2.1 مليار دولار من تمويل مشروعات النقل في شيكاغو بذريعة محاربة “التنوع القسري”
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تجميد تمويل بقيمة 2.1 مليار دولار كان مخصصاً لمشروعات البنية التحتية في قطاع النقل العام بمدينة شيكاغو، في خطوة وصفها مراقبون بأنها ضربة سياسية جديدة لمدينة يقودها الديمقراطيون، وذُرِعت بأنها تهدف إلى وقف التمويل عن برامج “التعاقد القائم على أساس عِرقي”.
وأوضح روس فوت، مدير مكتب الإدارة والموازنة (OMB)، أن الأموال المجمّدة كانت ستُستخدم في توسيع خط المترو الأحمر وتحديث شبكة النقل الحضرية في شيكاغو. وأضاف أن الوقف جاء “لضمان عدم تدفق التمويل عبر قنوات تعتمد على معايير عرقية في منح العقود”.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد وافقت على تمويل يقارب 2 مليار دولار في أواخر أيامها لتوسيع خط المترو الأحمر بمقدار 5.5 أميال، بهدف ربط الأحياء الجنوبية البعيدة من المدينة بشبكة السكك الحديدية المركزية المعروفة باسم “L” نسبة إلى Elevated Train، حيث يسير جزء كبير منها فوق الأرض.
لكن فوت أشار إلى أن وزارة النقل الأميركية أصدرت قاعدة تنظيمية جديدة دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، تسمح بإعادة فحص مدى التزام الشركات المتعاقدة بالقوانين المتعلقة بـ”التمييز الإيجابي” ومبادرات التنوع، في ما اعتُبر محاولة واضحة للضغط على المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس، في ظل استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية.
الخطوة تأتي ضمن سلسلة قرارات مماثلة اتخذتها الإدارة، أبرزها تجميد 18 مليار دولار من مشروعات النقل الكبرى في نيويورك، تشمل مشروع نفق سكة حديد يربط نيوجيرسي بمانهاتن تحت نهر هدسون، وتوسعة خط مترو “الشارع الثاني” في المدينة، بذريعة مشابهة تتعلق “بإعادة تقييم العقود الممنوحة وفق معايير التنوع”.
هذه الإجراءات أثارت مخاوف قانونية، إذ إن تجميد التمويل الفيدرالي على خلفية نزاعات سياسية حزبية قد يُواجَه بتحديات قضائية سريعة، خاصة إذا أدى إلى تأخير مشروعات حيوية في مدن تمثل عُقداً اقتصادية رئيسية.
وفي نيويورك، يُعد مشروع نفق هدسون البالغ تكلفته 17.2 مليار دولار، والذي حاز على أكثر من 11 مليار دولار من التمويل الفيدرالي، أحد أبرز مشاريع البنية التحتية في البلاد. ويشمل إصلاح نفق متضرر جراء إعصار “ساندي” عام 2012، وبناء نفق جديد لصالح شركة أمتراك وخطوط القطارات الإقليمية. وتُعد منطقة نيويورك-نيوجيرسي مسؤولة عن إنتاج 10% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، ما يجعل أي تعطيل في شبكة النقل هناك ذا أثر وطني.
وفي سياق متصل، أعلنت كاثي هوشول، حاكمة ولاية نيويورك، أن إدارة ترامب تراجعت عن قرار سابق بقطع 187 مليون دولار من تمويل الأمن في الولاية، وذلك بعد ضغوط سياسية وإعلامية متصاعدة.
الإجراءات الأخيرة من إدارة ترامب تُظهر اتجاهاً متصاعداً لاستخدام التمويل الفيدرالي كأداة سياسية للضغط على الولايات التي يقودها الديمقراطيون، في ظل تصاعد الاستقطاب السياسي وتزايد الرهانات قبيل الانتخابات المقبلة.
تاكر كارلسون يكشف “ملفات الحادي عشر من سبتمبر”: القصة التي لم تُروَ
بعد مرور ما يقارب ربع قرن على أكثر الأحداث تأثيراً في التاريخ الأميركي الحديث، عاد الإعلامي الأميركي الشهير تاكر كارلسون ليقلب السرد الرسمي لهجمات الحادي عشر من سبتمبر رأساً على عقب. في سلسلة وثائقية جريئة من ثلاثة أجزاء بعنوان “ملفات الحادي عشر من سبتمبر”، يقدّم كارلسون ما يصفه بـ “التحقيق الحقيقي الأول” في ما حدث فعلاً ذلك اليوم، متهماً أجهزة الاستخبارات الأميركية بالتواطؤ والإخفاء، ومعتبراً أن الرواية التي تلقاها الأميركيون منذ عام 2001 “كذبة كبرى غيّرت وجه العالم”.
منذ اللحظة الأولى، يعلن كارلسون موقفه بوضوح: “هذه ليست نظريات مؤامرة، هذه حقائق موثقة”. ويبدأ بسردٍ يدمج الوثائق والشهادات الحيّة، أبرزها من ضباط سابقين في وكالة المخابرات المركزية (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ومن عائلات ضحايا الهجمات الذين أمضوا أكثر من عقدين يطالبون بالحقيقة.
السلسلة تضع الإدارة الأميركية أمام اتهام خطير: أنها سمحت للهجوم أن يحدث أو تغاضت عنه عمداً لتبرير مشروعها الجيوسياسي الأكبر، وهو ما سمّاه كارلسون “الحرب العالمية على الإرهاب”، التي فتحت الطريق أمام غزو أفغانستان والعراق وتوسيع نفوذ الأجهزة الأمنية داخلياً وخارجياً.
تجدر الإشارة إلى أن كارلسون لم يتطرق في حلقاته للكثير من التفاصيل الفنية التي أثبت من أطلقها أن العملية كانت ملفقة، وذلك فيما يبدو ليتجنب اتهامه بالترويج لنظرية المؤامرة. لكنه اكتفى بسرد التفاصيل الموثقة التي تثبت، على الأقل، أن الإدارة الأمريكية غضت الطرف عن العملية، بل قد تكون مررتها، لكي تستغلها في تحقيق أهدافاً استراتيجية للولايات المتحدة.
يستعرض الجزء الأول من السلسلة تفاصيل صادمة حول الطريقة التي تتبعت بها الـCIA بعض الخاطفين قبل وقوع الهجمات، وكيف منعت مكتب التحقيقات الفيدرالي من التدخل أو حتى معرفة المعلومات. ففي عام 1999، أنشأت الوكالة وحدة خاصة باسم “محطة أليك” لمتابعة أنشطة أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، وتمكنت من رصد شخصين أصبحا لاحقاً من منفذي الهجمات، وهما خالد المحضار ونواف الحازمي. لكن المفارقة أن تلك المعلومات لم تُنقل إلى الأجهزة المعنية، رغم أن الرجلين دخلا الأراضي الأميركية بتأشيرات صادرة من القنصلية الأميركية في جدة، حين كان جون برينان – الذي سيصبح لاحقاً مديراً للـCIA يشرف على عمل المحطة هناك.
بحسب الشهادات التي عرضها كارلسون، كانت الوكالة تحاول تجنيد بعض عناصر القاعدة كمخبرين، في عملية استخباراتية سرية “خرجت عن السيطرة”. ويُظهر التحقيق أن المحضار والحازمي استُقبلا في كاليفورنيا من قبل عميل سعودي يُدعى عمر البيومي، كان يتقاضى راتبه من جهات مرتبطة بالسفارة السعودية في واشنطن. هذا العميل ساعدهما في إيجاد سكن وفتح حسابات مصرفية، في مشهدٍ يطرح تساؤلاتٍ حول ما إذا كانا مراقبين أم محميين.
يتهم كارلسون وكالة المخابرات المركزية بأنها لم تُخفِ فقط معلوماتٍ عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، بل تعمّدت التستر على دور بعض المسؤولين الأميركيين والسعوديين في تسهيل دخول الخاطفين إلى الولايات المتحدة. وعندما حاول بعض العملاء الفيدراليين تمرير المعلومات، مُنعوا من ذلك بشكل صريح، وفق ما أكده العميل السابق مارك روسيني في شهادته أمام الكاميرا.
في الجزء الثاني، ينتقل كارلسون إلى قصة “اللجنة التي صُممت لتَفشَل” – اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث 11 سبتمبر، التي أنشأتها إدارة الرئيس جورج بوش الابن تحت ضغط عائلات الضحايا. يكشف أن اللجنة التي رُوّج لها كهيئة مستقلة كانت في الواقع تحت سيطرة البيت الأبيض منذ البداية، وتم تقييد عملها بميزانية ضئيلة لا تتجاوز ثلاثة ملايين دولار، مقارنةً بعشرات الملايين التي خُصصت لتحقيقات أقل أهمية مثل فضيحة “مونيكا لوينسكي”. (المتدربة في البيت الأبيض، والتي التي كانت على علاقة بالرئيس كلينتون).
اختار البيت الأبيض في البداية هنري كيسنجر لرئاسة اللجنة، لكنه اضطر للاستقالة بعد يوم واحد من مواجهة محرجة مع أرامل الضحايا، عندما سُئل إن كان يمثل مصالح سعودية أو يتعامل مع عائلة بن لادن. وبعد استقالته، تولّى فيليب زيليكو منصب المدير التنفيذي، وهو أكاديمي كانت له علاقة وثيقة بمستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس، وشارك في كتابة وثائق “الغزو الاستباقي” التي مهّدت لحرب العراق.
يقول كارلسون إن زيليكو كتب مخطط التقرير النهائي قبل بدء التحقيقات، وفرض رقابة صارمة على موظفيه، ومنعهم من التواصل مع المفوضين أو الاطلاع على وثائق البيت الأبيض إلا بعد موافقة الإدارة. وهكذا تحوّل التقرير الرسمي الذي صدر عام 2004 إلى وثيقة سياسية أكثر منه تحقيقاً حقيقياً ، إذ تجاهل الأدلة التي تشير إلى تورط مسؤولين سعوديين، وتجنّب طرح السؤال الأساسي: كيف سمحت الأجهزة الأميركية، بكل قوتها، بوقوع هذا الهجوم الضخم في وضح النهار؟
الجزء الثالث من السلسلة يذهب إلى عمق السؤال “لماذا؟”. فبحسب كارلسون، لم تكن المشكلة في قلة المعلومات الاستخباراتية، بل في تجاهلها المتعمد. فقد تلقّى الرئيس بوش في السادس من أغسطس 2001 إحاطةً سرية عنوانها الصريح: “بن لادن عازم على ضرب داخل الولايات المتحدة”، تضمنت تفاصيل عن نشاطات مريبة تتعلق بتدريب على الطيران وتحضير لعمليات اختطاف. كما تشير تقارير الـCIA إلى أن صيف عام 2001 كان “يموج بالتحذيرات” من هجوم وشيك، لكن إدارة بوش لم تتخذ أي إجراء.
السلسلة تضع الإدارة الأميركية أمام اتهام خطير: أنها سمحت للهجوم أن يحدث أو تغاضت عنه عمداً لتبرير مشروعها الجيوسياسي الأكبر، وهو ما سمّاه كارلسون “الحرب العالمية على الإرهاب”، التي فتحت الطريق أمام غزو أفغانستان والعراق وتوسيع نفوذ الأجهزة الأمنية داخلياً وخارجياً.
يستشهد كارلسون بمقولات مسؤولين سابقين مثل ريتشارد كلارك، منسق مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، الذي أكد أن بوش وتشيني وولفويتز كانوا، منذ اليوم التالي للهجمات، يبحثون عن ذريعة لضرب العراق، لا أفغانستان. ومع ذلك، تم توجيه الرأي العام الأميركي نحو رواية واحدة مفادها أن أسامة بن لادن “فاجأ الولايات المتحدة” دون أن يعلم أحد شيئاً مسبقاً .
تُظهر السلسلة أن عملية التستر لم تكن حادثاً عرضياً بل سياسة ممنهجة. فمن حجب التقارير السرية إلى شحن حطام الطائرات خارج البلاد بسرعة غير مبررة؛ بدا وكأن الدولة تحاول إغلاق ملف أكبر عملية إرهابية في تاريخها قبل أن يُفتح فعلياً. وفي نهاية كل حلقة، يكرّر كارلسون رسالته بوضوح: “الرواية الرسمية كذبة، وحان الوقت لتحقيق حقيقي مستقل، غير خاضع للسياسة ولا لحلفاء أجانب.”
بأسلوبه الهادئ لكن المتمرد، يمزج تاكر كارلسون بين السرد الوثائقي والتحليل الاستخباراتي، مقدماً عملاً إعلامياً أقرب إلى محاكمة علنية للمؤسسة الأميركية. ومن خلال وثائق وشهادات لم يُسمح بنشرها سابقاً، يطرح سؤالاً واحداً يظل معلقاً في ذهن المشاهد بعد نهاية السلسلة:
هل كانت هجمات الحادي عشر من سبتمبر فشلاً استخباراتياً مأساوياً… أم عمليةٍ أعمق خُطط لها من الداخل لتغيير وجه العالم؟
تحذيرات من “نسخة جديدة من مشروع إعادة الضبط العالمي” في عهد ترامب
حذّر الصحفي والكاتب الأميركي مارك جودوين، مؤلف كتاب The Bitcoin Dollar، من أن ما يُعرف بـ”إعادة الضبط الكبرى” (The Great Reset) لم ينتهِ كما يعتقد البعض، بل “يعود في ثوب جديد تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، ولكن بطريقة مختلفة في العرض والتنفيذ”.
وقال جودوين خلال ظهوره على برنامج “Redacted” على يوتيوب: “العالم يتجه بسرعة نحو مجتمع بلا نقود نقدية، مع سيطرة التكنولوجيا الحيوية والرقمنة الكاملة على المعاملات المالية. ما يجري ليس صدفة، بل تصميم متعمد لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وجعل كل فرد قابلاً للتتبع والمراقبة.”
“الدولار الرقمي” وسيناريو السيطرة الاقتصادية
أوضح جودوين أن الولايات المتحدة تسعى إلى معالجة أزمة ديونها الضخمة — التي تجاوزت 37 تريليون دولار — من خلال نظام نقدي جديد يعتمد على العملات المشفرة المستقرة (Stablecoins) المدعومة مباشرة بأذون وسندات الخزانة الأميركية.
وبحسبه، فإن هذا النظام يسمح بتحويل الدولارات إلى عملات رقمية “مدعومة بالديون نفسها”، ما يُمكّن الحكومة من “تصدير التضخم” للخارج عبر الأسواق الرقمية، تماماً كما فعلت واشنطن سابقاً مع نظام البترودولار.
وأضاف أن اللوائح الجديدة المعروفة بـ “قانون Genius Act” تجبر الشركات المصدّرة للعملات المستقرة على الاحتفاظ بسندات الخزانة الأميركية كضمان، مما يعني أن النظام الرقمي العالمي أصبح “مرتبطاً بالدَّين الأميركي نفسه”.
فيتنام نموذج تجريبي للتحكم المالي
تطرق جودوين إلى خطوة مثيرة في فيتنام، حيث تمّ تجميد 86 مليون حساب مصرفي مؤخراً كجزء من “التحول إلى نظام هوية رقمية إلزامي”.
وقال إن ما يجري هناك يُعد “اختباراً عالمياً” لنظام مالي مركزي يعتمد على مراقبة الهوية البيومترية، متوقعاً تطبيق نماذج مشابهة في آسيا، وأوروبا، وحتى الولايات المتحدة.
وأضاف: “تتيح هذه الأنظمة للحكومات مراقبة كل معاملة مالية تقريباً دون الحاجة إلى إذن قضائي، مما يحوّل العملات الرقمية إلى أدوات مراقبة أكثر منها أدوات حرية اقتصادية”.
الحرب على النقد
أكد جودوين أن تراجع استخدام النقود الورقية يشكّل “أخطر ما يواجه الحريات الفردية في هذا القرن”، موضحاً أن النقد الورقي كان آخر وسيلة تحفظ الخصوصية في المعاملات.
وقال: “في عالم تُدار فيه كل المعاملات عبر الإنترنت وتُربط بالبصمة أو العين، لن يكون هناك مجال للخصوصية أو الحرية الاقتصادية الحقيقية. حتى في أوروبا، بدأ يُنظر إلى من يدفع نقداً بمبالغ كبيرة كمشتبه به بالإرهاب أو السوق السوداء.”
صعود “الدولة البيومترية” وشركة Palantir
كما حذر جودوين من التوسع المتسارع لشركات التكنولوجيا الأمنية مثل Palantir، التي وصفها بأنها “الذراع التقنية للدولة المراقِبة”، مشيراً إلى علاقاتها القوية مع إدارة ترامب ودوائر الأمن القومي الأميركية والإسرائيلية.
وأوضح أن الشركة تعمل حالياً على تطوير أنظمة هوية رقمية شاملة وبنوك رقمية مستقرة بالشراكة مع شخصيات بارزة في وادي السيليكون مثل بيتر ثيل وبالمر لاكي، لتصبح جزءاً من البنية التحتية المالية الجديدة في الولايات المتحدة.
“تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والاحتيال الانتخابي، يجري بناء قاعدة بيانات هائلة تضم بصمات ووجوه وسجلات مالية لملايين الأشخاص حول العالم”، قال جودوين.
نحو “نظام مالي مراقَب بالكامل”
اختتم جودوين تحذيره بالتأكيد أن العالم يقف على أعتاب نظام نقدي عالمي مراقَب يعتمد على الهوية البيومترية والذكاء الاصطناعي لتتبع كل حركة مالية، معتبراً أن ذلك يمثل “الوجه الحقيقي لإعادة الضبط الكبرى”.
وأضاف: “الحرية المالية مهددة أكثر من أي وقت مضى. نحن نقترب من مشهد ديستوبي تُمحى فيه الحدود بين الدولة، والبنك، والشركة التكنولوجية.”
ترامب يوجّه إلى الجنرالات: الاستخدام العسكري لمحاربة “العدو الداخلي”
في خطاب مثير للجدل ألقاه أمام كبار ضباط الجيش الأميركي في قاعدة كوينتيكو، حضّ الرئيس دونالد ترامب القوات على استخدام الجيش الوطني في مكافحة ما وصفه بـ”العدو من الداخل”، مشيراً إلى أن بعض المدن الكبرى مثل سان فرانسيسكو، شيكاغو، نيويورك، لوس أنجلوس تشكّل مسرحاً لفوضى يجب معالجتها عسكرياً “واحدة تلو الأخرى”.
وقال ترامب إن هذه المرحلة ستكون “حرباً داخلية”، مضيفاً : “هذه مدن خطيرة، وسنقوم بترتيبها واحدة تلو الأخرى… جزء كبير من المهمة سيكون للبعض في هذه القاعة”.
وشدّد على دور الحرس الوطني والقوات الفعلية في التصدي للاحتجاجات المدنية، ومنع الهجرة غير الشرعية، واستهداف مهربي المخدرات في الدول اللاتينية. وقال إنّه أوصى باستخدام بعض المدن “الخطرّة” كميدان تأهيلي للقوات، معرباً عن نيته التوجه قريباً إلى شيكاغو.
كما أكد ترامب دعمه لضربات جوية ضد مهربي المخدرات، مشيراً إلى استهداف قوارب في البحر، ومشيراً إلى أن الاستهداف قد يمتد إلى أهداف برية. وأضاف: “الجيش هو رأس الحربة الآن في مواجهة هذا العدو الشرس”.
وابتدأ ترامب كلمته بالتندر على رد فعل الضباط الصامتين في القاعة، قائلاً إنهم قِلّة، استجابتهم تختلف تماماً عن الحشود التي تشهدها تجمعاته السياسية. وأُعطي الضباط تعليمات بالتصفيق عندما يقودهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كاين.
وقال ترامب ساخراً : “إذا لم يعجبكم ما أقول، يمكنكم مغادرة الغرفة — بالطبع ستخسر رتبتك ومستقبلك”.
اللقاء جاء في ظل مراجعة الحكومة لاستراتيجية الدفاع الوطني الأميركية، التي تُعد وثيقة سنوية تحدد أولويات الإنفاق والعمليات العسكرية. ويُشير مسؤولون حاليون وسابقون إلى أن النسخة الجديدة من الاستراتيجية تضع أولوية على تأمين نصف الكرة الغربي، في سياق معارضة إدارة ترامب لحكومة مادورو، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
لكن الموازنة العسكرية تواجه ضغوطاً شديدة، مع سعي الجيش إلى تطوير الأسلحة، وتحسين الجاهزية، وتجديد مخزون الذخائر، إلى جانب مشاريع طموحة مثل مبادرة “القبة الذهبية” للدفاع الصاروخي الوطني.
كما أثار استخدام القوات داخل المدن جدلاً قانونياً وأخلاقياً حول مدى شرعية إشراك الجيش في تنفيذ مهام تنفيذ القانون داخلياً، وهو مبدأ محظور بموجب قانون Posse Comitatus الأميركي منذ عام 1878. (وول ستريت جورنال)
هيجست للجنرالات الأميركيين: “استعدّوا للحرب… انتهى زمن التبريرات السياسية”
في اجتماع استثنائي جمع مئات الجنرالات والأدميرالات في قاعدة كوينتيكو البحرية بولاية فيرجينيا، أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيجست أن المهمة الوحيدة للمؤسسة العسكرية من الآن فصاعداً هي “الاستعداد للحرب والفوز بها”، مؤكداً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعادت رسمياً تسمية وزارة الدفاع لتصبح “وزارة الحرب” لأول مرة منذ عام 1947.
قال هيجست في خطابه: “من هذه اللحظة، المهمة الوحيدة لوزارة الحرب المستعادة هي القتال. ليس لأننا نريد الحرب، بل لأننا نحب السلام”. وأضاف أن هدفه إعادة ما وصفه بـ “روح المحارب” إلى الجيش الأميركي، منتقداً بشدة ما يسميه “ثقافة الضعف والرضوخ للسياسة”.
الاجتماع الذي حضره الرئيس ترامب نفسه، جاء بعد أسابيع من مرسوم رئاسي أمر فيه بإعادة تسمية الوزارة، في خطوة يقول البيت الأبيض إنها “رسالة حازمة للأعداء والحلفاء على السواء”.
هاجم هيجست ما سماه “الثقافة المستيقظة” داخل المؤسسة العسكرية، معلناً إنهاء ما وصفه بـ “أوهام الهوية والجندر” و“عبادة المناخ”. وقال بصراحة: “لا مزيد من شهور الهوية، ولا مكاتب للتنوع، ولا رجال بفساتين، ولا شكاوى مجهولة، ولا تضييع للوقت”. وأعلن عن إصلاح شامل لبرامج المساواة ومكتب المفتش العام في البنتاغون، زاعماً أن بعض هذه الأجهزة “تحوّل إلى أدوات للشكوى والتعطيل”.
هيجست، الذي أعاد التأكيد على انضباط الجيش، قال إن “اللياقة البدنية والمظهر جزء من العقيدة العسكرية”، مشيراً إلى أن جميع أفراد القوات المشتركة سيخضعون لاختبارات وزن وطول مرتين سنوياً ، وأن وحدات القتال ستُقيَّم وفق “المعايير العليا للذكور فقط”. وأضاف: “إذا كان وزير الحرب يقوم بتدريب بدني يومي شاق، فعلى كل جندي أن يفعل ذلك أيضاً ”.
الوزير لم يُخفِ لهجته الصدامية تجاه الضباط الرافضين لنهجه، فقال: “من لا يوافق على رؤيتي بخصوص التنوع أو سياسات اللقاح أو قضايا المتحوّلين، فليقم بالتصرف الشريف ويستقِل”.
مستثمرة رئيسية في صفقة الاستحواذ على “تيك توك” سعت إلى “غرس حب إسرائيل” في الثقافة الأمريكية
كشفت تسريبات بريدية عن رسالة أرسلتها سافرا كاتز، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة أوراكل (Oracle)، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك عام 2015، عبّرت فيها عن قلقها من تنامي حركة المقاطعة لإسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في الجامعات الأمريكية، ودعت إلى “غرس حب إسرائيل في الثقافة الأمريكية”، حسب ما نقل موقع Responsible Statecraft.
وقالت كاتز في الرسالة المسرّبة:
“لقد أصبنا جميعاً بالذهول من تصاعد حركة المقاطعة في الجامعات، وخلصنا إلى أنه يجب علينا خوض هذه المعركة قبل أن يصل الأطفال إلى الجامعة. نعتقد أنه علينا غرس الحب والاحترام لإسرائيل في الثقافة الأمريكية، أي إيصال الرسالة إلى الشعب الأمريكي بطريقة يمكنهم استيعابها”.
الرسالة، التي كانت جزءاً من اختراق لحساب بريد إلكتروني لباراك، كشفت ما وصفه التقرير بأنه رؤية استراتيجية طويلة الأمد لتشكيل الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل من خلال الثقافة والإعلام.
ارتباطها بصفقة “تيك توك”
تأتي التسريبات بينما تلعب كاتز دوراً رئيسياً في صفقة استحواذ أمريكية على عمليات “تيك توك” داخل الولايات المتحدة، تشارك فيها أوراكل ضمن كونسورتيوم تقوده شركات أمريكية.
وكانت كاتز قد انتقلت في سبتمبر الماضي من منصبها التنفيذي إلى نائبة الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أوراكل، ما يجعلها من الشخصيات المركزية التي شاركت في المفاوضات المتعلقة بالصفقة.
وأكد مصدر مطلع لموقع Responsible Statecraft أن كاتز “لن تكون على أي صلة بخوارزمية تيك توك” ، في إشارة إلى أن دورها استثماري لا تقني.
سيطرة أمريكية على الخوارزمية
من جانبه، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس (JD Vance) أن “المستثمرين الأمريكيين هم من سيتولون فعلياً السيطرة على خوارزمية تيك توك” المسؤولة عن توصية المحتوى للمستخدمين بعد إتمام الصفقة.
وأضاف مسؤول أمريكي آخر أن نسخة من خوارزمية توصيات المحتوى سيتم تسليمها إلى الكيان المشترك الجديد، حيث “ستُفحص وتُعاد برمجتها بالكامل من قبل مزوّد أمني أمريكي باستخدام بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، ثم تُدار من قِبل هذا الكيان الأمريكي”.
موقف البيت الأبيض وإسرائيل
قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن أوراكل ستعمل كـ “مزود أمني موثوق لمنصة تيك توك”، وستتولى بشكل مستقل مراقبة “سلامة وأمن بيانات المستخدمين الأمريكيين”.
وفي سياق متصل، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام مجموعة من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي قائلاً:
“علينا أن نحارب بالأسلحة المناسبة لساحات المعارك التي نخوضها، وأهم هذه الأسلحة اليوم هي وسائل التواصل الاجتماعي. وأهم صفقة تُجرى حالياً هي، ما هي يا صف؟ تيك توك. نعم، تيك توك هي رقم واحد، وآمل أن تتم الصفقة لأنها قد تكون حاسمة”.
خلفية سياسية وثقافية
تُبرز هذه التطورات، وفقاً لمراقبين، تشابك السياسة الإسرائيلية مع النفوذ التكنولوجي الأمريكي، خصوصاً في ظل الدور المتزايد للشركات الخاصة في توجيه المحتوى والمزاج العام على المنصات الرقمية الكبرى.
كما أعادت الرسائل المسرّبة تسليط الضوء على العلاقة القوية بين أوراكل ومؤسسات إسرائيلية، ودور كاتز – التي وُلدت في إسرائيل – في توسيع التعاون التكنولوجي بين الطرفين.
وكان المعهد المصري للدراسات قد نشر في وقت سابق، تحليلاً عن الكيفية التي تسيطر بها إسرائيل على الولايات المتحدة الأمريكية وتوجه سياستها باستخدام التكنولوجيا والإعلام، مع التركيز على ما يقوم به الملياردير الأمريكي لاري إليسون كنموذج. (لقراءة التحليل)
الولايات المتحدة توسّع قاعدة “ثاد” للدفاع الصاروخي في إسرائيل
كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن توسّع كبير في قاعدة “ثاد” (THAAD) الأمريكية للدفاع الصاروخي في صحراء النقب الإسرائيلية، في خطوة تُعدّ إشارة واضحة على تعميق التزام واشنطن بأمن إسرائيل في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.
تفاصيل التوسّع
يقع النظام بالقرب من منشأة الرادار “الموقع 512” (Site 512)، وأظهرت الصور إضافة خمسة قواذف جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي في القاعدة إلى أحد عشر قاذفاً .
ويتيح هذا التوسّع نشر ما يصل إلى ثلاث بطاريات ثاد، ما يعزز قدرة إسرائيل على اعتراض الصواريخ الباليستية على ارتفاعات عالية.
نُشر النظام الأمريكي في إسرائيل لأول مرة في أكتوبر 2024 بعد هجوم إيراني مباشر، ولعب دوراً محورياً خلال حرب إسرائيل–إيران في يونيو 2025، حين أطلقت القوات الأمريكية أكثر من 150 صاروخ اعتراض – أي نحو ربع المخزون العالمي من منظومات “ثاد” – وهو ما كشف عن قيود الطاقة الإنتاجية الحالية للنظام.
أهمية الخطوة ودلالاتها
يرى محللون أن هذا التوسّع يُعد رسالة استراتيجية مفادها أن الولايات المتحدة ماضية في دعم إسرائيل عسكرياً رغم الانتقادات الإقليمية، لكنه في الوقت نفسه يعكس مخاوف واشنطن من تصاعد التهديدات الإيرانية.
ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن نظام “ثاد” لا يزال محدود الفعالية أمام هجمات صاروخية كثيفة أو أسلحة تفوق سرعة الصوت، وهو ما ظهر في نسب الاعتراض المتباينة خلال المواجهات الأخيرة.
خلفية النظام وقدراته
طوّرته شركة لوكهيد مارتن، ودخل الخدمة التشغيلية عام 2008، ويُصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة والمتوسطة-البعيدة المدى في المرحلة النهائية من مسارها.
ويتميّز “ثاد” بأنه لا يستخدم رؤوساً متفجرة، بل يعتمد على الطاقة الحركية لتدمير الهدف.
تتألف كل بطارية من قواذف متنقلة وصواريخ اعتراض ووحدة تحكم بالنيران ورادار من نوع AN/TPY-2.
إلى جانب إسرائيل، تنتشر منظومات “ثاد” في الإمارات والسعودية ورومانيا وكوريا الجنوبية.
وقد سجّل النظام أول اعتراض عملياتي ناجح له في الإمارات عام 2022 عندما دمّر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون من اليمن.
البعد الاستراتيجي
قرار توسيع القاعدة في النقب يؤكد المكانة المحورية لإسرائيل كحليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
تعليق المعهد المصري:
الدلالات الاستراتيجية لتوسيع قاعدة «ثاد» الأمريكية في الأراضي المحتلة
هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة أمنية أمريكية أوسع تهدف إلى تعزيز منظومات الدفاع الإقليمي المشترك، في مواجهة التهديدات الإيرانية والتطورات التكنولوجية في مجال الصواريخ. وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى:
1- تعميق الوجود العسكري الأمريكي المباشر
يُشير توسّع قاعدة THAAD إلى تعزيز الوجود الأمريكي الميداني في الأراضي المحتلة، عبر نشر أطقم فنية وعسكرية إضافية تتولى إدارة وتشغيل المنظومة الدفاعية. هذه الخطوة تُكرّس حضوراً أمريكياً فعلياً متزايداً تحت غطاء “الدفاع الصاروخي”، بما يجعل من القواعد الإسرائيلية امتداداً لمنظومة الدفاع الأمريكية في الشرق الأوسط.
2- رسالة ردع من الطرفين
تستهدف واشنطن من هذه الخطوة ردع إيران بالدرجة الأولى، في ظل تنامي قدرات طهران الصاروخية والمسيّرات بعيدة المدى.
وجدير بالذكر أن إيران بدورها ماضية في تحديث ترسانتها الدفاعية والهجومية؛ إذ حصلت مؤخراً على مقاتلات ميج-29 الروسية وتنتظر استلام طائرات سوخوي-35 من موسكو. كما أعلن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أبو الفضل ظهرهوند أن بلاده تسلمت منظومات دفاع جوي صينية وروسية من طراز HQ-9 وS-400، رغم عدم تأكيد موسكو أو بكين لذلك رسمياً .
هذا التزامن في تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية على الجانبين يُبرز تصاعد سباق التسلح بين إيران وإسرائيل في ظل دعم أمريكي مباشر للأخيرة.
الخلاصة التحليلية:
إن تسارع وتيرة التسلّح الإقليمي بين إيران وإسرائيل وتوسّع التواجد العسكري الأمريكي في إسرائيل يعكسان إدراك الأطراف الثلاثة (إسرائيل – إيران – الولايات المتحدة) لاحتمالية اندلاع مواجهة واسعة وشيكة بين إيران وإسرائيل، مدعومة من الولايات المتحدة، مرة أخرى.
فالتوسّع في قاعدة THAAD لا يُعد مجرد تعزيز دفاعي لإسرائيل، بل يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ النفوذ العسكري الأمريكي في المنطقة، ورسالة واضحة بأن أي حرب مقبلة بين إيران وإسرائيل لن تكون إسرائيلية خالصة، بل ستتم بإشراف وتخطيط أمريكي مباشر على المستويين العملياتي والدفاعي.
سوريا
سورية تنتخب أول برلمان بعد سقوط النظام: بين الأمل بالتغيير واتهامات “الشكلية السياسية”
شهدت سورية يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، أول انتخابات برلمانية بعد سقوط نظام الأسد، وسط مزيج من التفاؤل الشعبي والجدل السياسي بين من يرى في صناديق الاقتراع بداية مرحلة جديدة، ومن يعتبرها خطوة شكلية في مسار انتقال لم يكتمل بعد. افتتحت مراكز الاقتراع في مختلف المحافظات منذ الصباح، وسط حضور لافت من المرشحين والمراقبين، وإجراءات أمنية مشددة رافقت اليوم الانتخابي من دمشق حتى إدلب.
الرئيس أحمد الشرع وصف العملية بأنها “منعطف وطني نحو المشاركة”، مؤكداً أن بناء سورية الجديدة “مسؤولية جماعية تتجاوز الأفراد والأحزاب”، وأن الانتخابات “تعبّر عن قدرة السوريين على تحويل الألم إلى عمل سياسي منظم”. وأشار إلى أن المجلس القادم سيكون أمام مهمة عاجلة لإقرار القوانين المعلقة وممارسة الرقابة على الحكومة ضمن المرحلة الانتقالية.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، الاثنين 7 أكتوبر نتائج أول انتخابات تشريعية تُجرى بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، مؤكدة فوز 119 مرشحاً بعضوية مجلس الشعب الجديد، مقابل بقاء 21 مقعداً شاغراً في محافظات السويداء والرقة والحسكة لأسباب وُصفت بـ”الأمنية”.
وقال المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، إن البرلمان الجديد “يُشكّل وفقاً للإعلان الدستوري الانتقالي”، وتبلغ مدة ولايته ثلاثين شهراً قابلة للتجديد. وأوضح أن ثلثي المقاعد تم اختيارها عبر انتخابات مناطقية، بينما سيُعيَّن الثلث المتبقي من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع لضمان “التوازن التمثيلي بين المكونات”.
ضعف في تمثيل النساء والأقليات
كشفت النتائج عن تمثيل محدود للنساء بلغ 4% فقط من إجمالي الأعضاء المنتخبين، فيما حصل المسيحيون على مقعدين من أصل 210، وهو ما اعتبره مراقبون دون مستوى التوازن الاجتماعي. كما لم يتمكن المرشح اليهودي الوحيد من الفوز بمقعده. وأكد نجمة أن “التمثيل الطائفي أو العرقي غير معتمد، فكل نائب يمثل الشعب السوري بأسره”، مشيراً إلى أن الرئيس يمكنه “تدارك الخلل عبر تعيينات تكميلية”.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في 13 يونيو/حزيران الماضي المرسوم رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” استنادا إلى المادة (24) من الإعلان الدستوري التي نصت على أن يتولى المجلس السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين ستبلغ مدة ولاية المجلس 30 شهرا قابلة للتجديد.
ويتولى هذا المجلس وفقا للمادة (30) مجموعة من المهام، تشمل اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.
ويتكون المجلس الجديد من 210 أعضاء، منهم 140 يُختارون عبر لجان فرعية وهيئات ناخبة في المرحلة الأولى. فيما يختار الرئيس السوري أحمد الشرع 70 عضواً (الثلث) سواء من ضمن اللجنة الانتخابية أو من خارجها.
و يحق لأعضاء الهيئات الناخبة الترشح لعضوية مجلس الشعب، وتجرى عملية اقتراع حر ومباشر وسري بعد انتهاء الدعاية الانتخابية داخل الدوائر، ليُعلن فوز من ينال أعلى الأصوات وفق المقاعد المخصصة لكل دائرة.
وتتولى اللجنة العليا الإشراف المباشر على العملية الانتخابية، وتمثلها اللجان الفرعية في مختلف المناطق، وتشارك نقابة المحامين السوريين بدور رقابي واسع، كما يُفسح المجال للوفود الدولية والدبلوماسية والإعلامية للتغطية “الحرة والمباشرة”.
طبيعة آلية الانتخاب التي فرضت من قبل الحكومة السورية على اختيار أعضاء مجلس الشعب بانتخابات “داخلية” محصورة فقط في اللجان الناخبة، أثارت جدلاً بين مؤيدين ومعارضين، حيث اعتبر البعض أن الأعضاء المختارين لا يمثلون الشعب السوري.
فبين من يرى أن المرحلة الانتقالية الحالية، تطلب فرض حلول واقعية تملأ الفراغ المؤسسي دون تطبيق كامل للمعايير الديمقراطية، يرى آخرون أن هذا النهج يكرس “إعادة إنتاج للسلطة المركزية بوسائل انتخابية شكلية”.
كما أن غياب مناطق الشمال الشرقي والسويداء عن العملية الانتخابية أضاف بعداً آخر للجدل. فبينما اعتبر البعض أن مشاركة الأقليات من مناطق أخرى “تحقق التوازن المطلوب”، شدد آخرون على أن استبعاد هذه المناطق “يكشف خللاً بنيوياً لا يمكن تبريره أمنياً”. (انظر) (انظر) (انظر) (انظر)
هدوء حذر في حلب بعد ليلة من التصعيد بين الجيش السوري و”قسد”
سادت صباح الثلاثاء 7 أكتوبر أجواء من الهدوء الحذر في مدينة حلب، عقب ليلة عنيفة من الاشتباكات بين الجيش السوري و”قوات سوريا الديمقراطية” قسد” على أطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية، في أعنف مواجهة منذ توقيع اتفاق آذار الماضي بين الجانبين، تلاها إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار تجنباً للانزلاق في مواجهة شاملة في المدينة.
خلفية التصعيد
وقالت وزارة الدفاع السورية إن تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار في الشمال والشمال الشرقي، عقب “اعتداءات متكررة نفذتها قسد ضد المدنيين والعسكريين”، مؤكدة أن الهدف من العملية حماية السكان وليس التصعيد.
في المقابل، نفت وزارة الداخلية وجود نية لبدء عملية عسكرية شاملة، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تندرج في إطار ضبط الأمن ومنع التوتر.
مصادر ميدانية أوضحت أن المواجهات اندلعت بعد اكتشاف نفق تابع لقسد يمتد خلف مواقع الجيش في محيط حي الأشرفية، جرى تفجيره فوراً ، أعقبه هجوم نفذه عناصر من “قسد” يرتدون لباساً مدنياً استهدف نقاط الأمن الداخلي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.
إجراءات أمنية واحترازية
ردّاً على التصعيد، أعلنت الجهات الرسمية في حلب تعطيل المدارس والدوائر الحكومية، وتسهيل عمليات إخلاء المدنيين من مناطق الاشتباك. كما نفذت القوى الأمنية عمليات تمشيط واسعة في محيط الحيين لمنع أي محاولات تسلل جديدة.
وأكد المتحدث باسم الداخلية نور الدين البابا التزام الحكومة باتفاق آذار، منتقداً ما وصفه بـ”هيمنة التيار الانعزالي داخل قسد” الذي يعطل تنفيذ الاتفاق.
رواية دمشق: استفزازات وانتهاكات
مصدر أمني في حلب قال لتلفزيون سوريا إن انتشار الجيش في الشيخ مقصود والأشرفية “إجراء وقائي طبيعي” بعد تصاعد انتهاكات قسد، مضيفاً أن “عناصر قسد حرّضوا المدنيين على التجمهر قرب الحواجز وترديد شعارات انفصالية”.
وأوضح أن الأحياء شهدت نزوحاً محدوداً بسبب ممارسات قوى “الأسايش” التابعة لقسد، مؤكداً أن قوى الأمن تعمل على تأمين ممرات آمنة للمدنيين وإبعادهم عن نقاط التوتر.
وأشار المصدر إلى أن الحيين أصبحا ملاذاً لمطلوبين وفلول من النظام السابق، يتخذون من حماية قسد غطاءً للهروب من العدالة.
رواية قسد والإدارة الذاتية
في المقابل، نفت قسد تنفيذ أي هجمات على مواقع حكومية، مؤكدة أنها انسحبت من المنطقة منذ نيسان الماضي، وأن ما يجري هو “نتيجة حصار خانق تفرضه قوات دمشق على المدنيين في الحيين”.
وأضافت أن القوات الحكومية “منعت دخول المساعدات والمواد الطبية، وواصلت الاستفزازات اليومية بحق السكان”.
أما الإدارة الذاتية فوصفت الأحداث بأنها “امتداد لسياسات التمييز والانقسام”، معتبرة أن الحكومة السورية “تكرّر نفس النهج الذي أدى إلى كوارث في السويداء والساحل”، ودعت إلى تضامن شعبي ودولي مع سكان الحيين.
الدفاع والداخلية: لا نية للعمل العسكري
أكدت وزارة الدفاع السورية أن تحركات الجيش تندرج ضمن خطة إعادة الانتشار بعد تكرار اعتداءات قسد ومحاولاتها توسيع السيطرة في شمال البلاد، مشددة على أن الجيش ملتزم باتفاق آذار ولا يخطط لأي عمليات واسعة.
كما شدد المتحدث باسم الداخلية نور الدين البابا على أن الرئيس أحمد الشرع قدّم لقسد “فرصة تاريخية” للحوار، لكن “تغلغل التيار الانعزالي” داخلها يعرقل تنفيذ الاتفاق، داعياً إلى العودة للمسار السياسي.
وفي السابع من أكتوبر أعلنت وزارة الدفاع السورية أنه تم التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في حلب ومناطق الشمال الشرقي، وذلك “بهدف تثبيت الاستقرار ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية”.
وقالت مصادر ميدانية إن ضباطاً روساً لعبوا دور الوسيط بين الجانبين، بينما تمّت اتصالات أميركية – عبر المبعوث توماس باراك – مع قيادة قسد لتثبيت الالتزام بالاتفاق.
تزامن الاتفاق مع تحركات ديبلوماسية، حيث بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قسد مظلوم عبدي بحضور المبعوث الأميركي توماس باراك آليات تنفيذ الاتفاق الموقّع في مارس، في محاولة لبلورة ترتيبات تنفيذية على الأرض. (الشرق)
تركيا
أردوغان: تركيا تتصدر الاستثمارات في الطاقة الخضراء.. ونسبة الطاقة المتجددة تتجاوز 60% من إجمالي الإنتاج لعام 2025
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده باتت في مقدمة الدول المستثمرة في مجال الطاقة الخضراء، موضحاً أن نسبة الطاقة المتجددة ارتفعت لتتجاوز 60% من إجمالي الطاقة المنتجة في تركيا خلال عام 2025.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المنتدى والمعرض الحادي عشر لكفاءة الطاقة الذي عُقد في مدينة إسطنبول، حيث أشار إلى أن الطلب العالمي على الطاقة يتزايد عاماً بعد عام مع ارتفاع عدد السكان وتوسع الاقتصادات النامية.
وقال أردوغان:
“ارتفاع الطلب على الطاقة لا يعكس فقط النمو السكاني والاقتصادي، بل يدل أيضاً على تحسن مستويات الرفاهية والمعيشة، ومع هذا الازدهار يتوسع استخدام الطاقة، وخاصة الكهرباء، بشكل متسارع.”
وأضاف الرئيس التركي أن بلاده دفعت 26 مليار دولار مقابل واردات الطاقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مؤكداً أن الحكومة تعمل بجد لتقليص هذه الفاتورة عبر زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز والطاقة المتجددة.
وأوضح أن استهلاك تركيا اليومي من النفط يبلغ نحو مليون برميل، منها 160 ألف برميل تُستخرج من الموارد الوطنية.
كما أشار إلى أن الاكتشافات الأخيرة للغاز في البحر الأسود والنفط في حقل غابار تمثل تقدماً كبيراً ، لكن “لا تزال هناك مسافة يجب قطعها لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل”، على حد تعبيره.
وبيّن أردوغان أن تركيا تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في عدد سفن التنقيب النشطة، إذ تمتلك أربع سفن حفر وسفينتين للأبحاث الزلزالية، لافتاً إلى أن انضمام سفن جديدة إلى الأسطول سيرفع ترتيب تركيا إلى المركز الرابع عالمياً في هذا المجال.
وفي ختام كلمته، تطرّق الرئيس التركي إلى مستقبل الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الحكومة تتوقع رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9 تريليون دولار وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي إلى نحو 21 ألف دولار بحلول عام 2028، مؤكداً أن التحول في مجال الطاقة سيكون أحد أهم محركات هذا النمو.
الاستخبارات التركية تفكك خلية تجسس تابعة للموساد وتعتقل عميلاً في إسطنبول
أعلنت السلطات التركية، عن اعتقال شخص متورط بالعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، في إطار عملية أمنية مشتركة حملت اسم “ميترون” نُفذت في مدينة إسطنبول.
ووفقاً لمصادر أمنية تركية، فقد قاد جهاز الاستخبارات الوطنية (MIT) العملية بالتنسيق مع النيابة العامة وفرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، وأسفرت المداهمات عن توقيف المدعو “تشيتشك” بعد التثبت من قيامه بأنشطة تجسسية لصالح الموساد.
صلة مباشرة بالموساد
أوضحت التحقيقات أن الموقوف كان على اتصال بشخص يدعى “فيصل رشيد”، يُعتقد أنه أحد عناصر “المركز الإسرائيلي للعمليات عبر الإنترنت”، وقد كلّفه الأخير بجمع معلومات ومراقبة ناشط فلسطيني مقيم في حي باشاك شهير بإسطنبول، معروف بمعارضته للسياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط.
وكشفت المعلومات أن تشيتشك وافق على تنفيذ المهام التجسسية، وتلقى مقابل ذلك مبلغ 4 آلاف دولار حُوّل إليه بالعملة المشفّرة مطلع أغسطس/آب الماضي.
واجهة تجارية للأنشطة الاستخباراتية
وبحسب المصادر، كان المتهم قد ترك عمله التجاري في عام 2020، وأنشأ شركة تحمل اسم “باندورا للتحريات”، استخدمها كغطاء لممارسة أعمال مرتبطة بجمع المعلومات.
وخلال عمله كمحقق خاص، تعرف على موسى كوش – وهو معتقل حالياً بتهمة التجسس لصالح إسرائيل – وكذلك على المحامي طغرل هان ديب، وتعاون معهما في عدد من المهام الميدانية.
تفاصيل العملية والمهام المكلّف بها
تبيّن أن الجاسوس الإسرائيلي المكلّف بالتنسيق مع تشيتشك تواصل معه عبر تطبيق “واتساب” بتاريخ 31 تموز/يوليو الماضي، مقدماً نفسه على أنه محامٍ يعمل في مكتب خارج تركيا، وطلب منه تنفيذ عملية تعقب ميدانية لمدة 4 أيام تستهدف الناشط الفلسطيني.
وبعد استلام التعليمات والعنوان، توجه تشيتشك إلى الموقع المحدد مرتين متذرعاً بأنه يبحث عن شقة للإيجار، بهدف تنفيذ استطلاع ميداني للمبنى السكني.
غير أنه فشل في جمع المعلومات المطلوبة، ما دفع المسؤول الإسرائيلي إلى قطع الاتصال معه في الثالث من أغسطس/آب وإنهاء التعاون.
خلفيات وتداعيات
التحقيقات أشارت إلى أن المتهم كان على علم مسبق باعتقال شريكه السابق موسى كوش، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 19 عاماً بتهمة التعامل مع الموساد، إلا أنه اختار الاستمرار في التعاون مع الجهة الإسرائيلية رغم علمه بالمخاطر.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن عملية “ميترون” تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي تنفذها أنقرة لملاحقة شبكات التجسس الإسرائيلية النشطة على الأراضي التركية، والتي تستهدف شخصيات عربية وفلسطينية تقيم في البلاد.
تقرير أميركي: هل ينجح التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا في القارة الأفريقية؟
في ظلّ تراجع النفوذ الغربي في أفريقيا وتصاعد حضور الصين وروسيا، تبرز تركيا كقوة إقليمية صاعدة تسعى لتوسيع نفوذها في القارة السمراء، مما يفتح الباب أمام فرص تعاون جديدة مع الولايات المتحدة رغم التباينات القائمة بين الجانبين، بحسب تحليل نشره موقع “ناشونال إنترست” الأميركي.
تقارب بعد لقاء ترامب وأردوغان
يشير الكاتب ليام كار، رئيس فريق أفريقيا في مشروع “التهديدات الحرجة” التابع لمعهد أميركان إنتربرايز في واشنطن، إلى أن العلاقات التركية–الأميركية شهدت انتعاشاً ملحوظاً بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض أواخر سبتمبر الماضي، مؤكداً أن الحوار بين الزعيمين أعاد فتح ملفات التعاون المشترك في عدة مجالات.
أفريقيا.. ساحة جديدة للتعاون
يرى الكاتب أن مجالات التعاون بين أنقرة وواشنطن لم تعد تقتصر على ملفات الدفاع وصفقات المقاتلات إف-35 أو سياسات حلف شمال الأطلسي (الناتو) والشرق الأوسط، بل تمتد إلى القارة الأفريقية التي تشهد حراكاً متسارعاً في موازين القوى العالمية.
وخلال العقدين الماضيين، عززت تركيا حضورها في أفريقيا من خلال الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتعدين والنسيج، إلى جانب تنامي صادراتها من الطائرات المسيّرة التي أصبحت مطلوبة بشدة في أسواق القارة.
التعاون في مكافحة الإرهاب
يؤكد ليام كار أن مكافحة الإرهاب تمثل المجال الأهم للتعاون التركي–الأميركي في أفريقيا، حيث يقدم البلدان دعماً وتدريباً أمنياً لكل من الصومال ودول غرب أفريقيا لمواجهة التنظيمات المتطرفة.
ويقترح الكاتب أن يتم تعزيز التعاون من خلال تقاسم الأعباء وتنسيق الجهود الاستخباراتية وسدّ الفجوات في المعدات غير القتالية، بما يضمن فاعلية أكبر لبرامج الدعم الأمني في القارة.
تحديات واختلاف مصالح
رغم الفرص المتاحة، يدعو الكاتب الإدارة الأميركية إلى الواقعية في التعامل مع أنقرة، مشيراً إلى أن مصالح تركيا في أفريقيا لا تتطابق تماماً مع الأهداف الأميركية الرامية إلى احتواء النفوذ الروسي والصيني.
ومع ذلك، يرى أن تركيا يمكن أن تشكّل عنصر توازن إقليمي، خاصة بعدما استغلت موسكو تراجع النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل لتعزيز حضورها العسكري والاقتصادي، مما أثر سلباً على جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.
الطاقة والمعادن.. أفق مشترك
ويضيف التقرير أن أنقرة تعمل على تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية من خلال تنويع مصادرها الأفريقية، وهو توجه يتقاطع مع أهداف واشنطن في تقليل نفوذ موسكو.
كما يتيح التعاون في مجالي الطاقة والبنية التحتية تطوير سلاسل إمداد المعادن الحيوية التي تُعد ركيزة أساسية في الصناعات الحديثة، خصوصاً أن تركيا تأتي ثانية بعد الصين في حجم استثماراتها بمجال البنى التحتية في القارة.
يخلص التقرير إلى أن التعاون التركي–الأميركي في أفريقيا يحمل إمكانات استراتيجية واعدة، لكنه يظل محاطاً بالحذر والتعقيدات بسبب اختلاف أولويات الطرفين وطبيعة التنافس الدولي في القارة.
ويرى الكاتب أن النجاح في هذه الشراكة يعتمد على قدرة واشنطن وأنقرة على بناء تنسيق واقعي طويل الأمد يوازن بين المصالح الاقتصادية والأمنية، في قارة تشهد سباق نفوذ عالمي متسارعاً .
إيران
إيران تستبعد استئناف المفاوضات مع الترويكا الأوروبية بعد إعادة فرض العقوبات
استبعدت إيران استئناف المحادثات مع ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بشأن ملفها النووي، بعد أن أعاد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات الأممية عليها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تخطط لأي مفاوضات في الوقت الحالي، معتبراً أن الدول الأوروبية الثلاث تصرفت بـ “شكل غير مسؤول ومدمّر” عبر تفعيل آلية الزناد استجابةً للضغوط الأميركية.
وأوضح بقائي أن غياب الإجماع داخل مجلس الأمن — بعد معارضة روسيا والصين للقرار — يُثبت “عدم قانونية الإجراء الأوروبي”، مؤكداً أن طهران تدرس الخيارات القانونية للرد.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد مجدياً بعد إعادة فرض العقوبات، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية فقدت دورها المؤثر في أي مفاوضات مستقبلية.
يُذكر أن العقوبات أُعيد فرضها في أواخر سبتمبر عقب تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية تسوية الخلافات ضمن اتفاق 2015 النووي، الذي تراجعت إيران عن التزاماتها فيه بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018.
إيران تنتقد التزام تركيا بالعقوبات الأممية بعد تفعيل “آلية الزناد”
انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية قرار تركيا الامتثال للعقوبات المعاد فرضها على طهران عقب تفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن الدولي، واصفة الخطوة بأنها “غير ضرورية وغير قانونية”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي، إن “الخطوة التي اتخذتها أنقرة، كما ورد في وسائل الإعلام، لا تستند إلى أي أساس قانوني، لأن المبررات التي استندت إليها الدول الأوروبية الثلاث غير مشروعة أصلاً”.
ودعا بقائي الدول الصديقة إلى عدم الانخراط في إجراءات تعتبرها طهران غير شرعية، مشيراً إلى أن تأثير القرار محدود عملياً لأن “المؤسسات والأفراد المشمولين بالعقوبات لا يملكون أصولاً مالية داخل تركيا”، مؤكداً أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أكدت بدورها أن أي حسابات مالية لم تُجمّد.
وجاءت تصريحاته بعد أن أعلنت تركيا، الأربعاء الماضي، تجميد أصول وحسابات مصرفية لـ20 شخصية و18 مؤسسة إيرانية على صلة ببرنامج طهران النووي، بينها كيانات تعمل في إنتاج الوقود النووي وتخصيب اليورانيوم وقطاعي الطاقة والنقل البحري.
وأوضحت الحكومة التركية أن الإجراء يأتي تماشياً مع القيود الدولية المفروضة على الأنشطة النووية الإيرانية، في إطار التزاماتها بمقررات مجلس الأمن.
إيران تعلن اكتشاف 10 تريليونات قدم مكعبة من الغاز في حقل بازان
أعلن وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد عن اكتشاف جديد في حقل بازان الغازي جنوب إيران، يحتوي على نحو 10 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وفق ما نقلته وكالة وزارة النفط الإيرانية شانا.
وأوضح باكنجاد أن معدل الاسترداد المتوقع من الحقل يبلغ نحو 70%، أي ما يعادل 7 تريليونات قدم مكعبة قابلة للاستخراج، مشيراً إلى أن هذا الاكتشاف سيساعد في تغطية العجز المحلي في إمدادات الغاز خلال السنوات المقبلة.
وأضاف الوزير أن الاكتشاف جاء بعد توقف استمر 8 سنوات في أعمال التنقيب، متوقعاً أن يبدأ الإنتاج خلال 40 شهراً .
وتُعد إيران صاحبة ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، إلا أن جزءاً كبيراً من إنتاجها يُستهلك محلياً أو يُفقد عبر الحرق أثناء الاستخراج، مما يؤدي إلى اختلال في التوازن الطاقي خلال فترات الذروة.
متابعات عربية
واشنطن بوست: تدفق أسلحة متطورة يشعل حرب السودان ويهدد أمن المنطقة
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية في تقرير ميداني موسّع عن دخول أسلحة متطورة إلى ساحات القتال في السودان، ما يشير إلى تحول خطير في طبيعة الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من عامين، والتي لم تعد تعتمد على الأسلحة الخفيفة، بل باتت تشمل منظومات دفاع جوي وطائرات مسيّرة هجومية قادرة على تغيير موازين القوى في الميدان.
وذكرت الصحيفة أن مقاتلين سودانيين باتوا يمتلكون صواريخ مضادة للطائرات يمكن أن تهدد الطيران العسكري والمدني على حد سواء، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي يُعتقد أنها صينية الصنع، في انتهاك مباشر لحظر السلاح المفروض على السودان ودارفور من قبل الأمم المتحدة.
ونقلت واشنطن بوست عن مراسليها الميدانيين أنهم عاينوا شحنات من الأسلحة تم الاستيلاء عليها مؤخراً، من بينها قذائف هاون عيار 120 ملم وُجدت داخل أحد المباني في مدينة أم درمان بعد انسحاب قوات الدعم السريع منه. وأكد خبراء عسكريون للصحيفة أن هذه القذائف مزوّدة بصواعق عالية الحساسية، ما يجعلها صالحة للاستخدام عبر طائرات مسيّرة صغيرة من نوع “كوادكوبتر”، وهو ما يحوّلها عملياً إلى ذخائر انتحارية طائرة يمكن أن تلحق أضراراً هائلة بالأهداف المدنية والعسكرية.
واعتمد التقرير، بحسب الصحيفة، على تحقيقات ميدانية ومقابلات مع مسؤولين سودانيين وتقارير سرية أعدها خبراء مستقلون، بعضها تم بمشاركة أجهزة استخبارات محلية أطلعت الصحيفة على معلومات حول طبيعة هذه الأسلحة ومصادرها.
ويحذر خبراء عسكريون من أن تسرب هذا النوع من التسليح إلى أطراف النزاع يمثل مرحلة جديدة من التصعيد، إذ يمكن أن يغيّر توازن القوى على الأرض ويزيد من تعقيد جهود التسوية، فضلاً عن رفع المخاطر على المدنيين في المدن الكبرى مثل الخرطوم والفاشر ونيالا، حيث أصبحت الطائرات المسيّرة والصواريخ المحمولة على الكتف جزءاً من المعركة اليومية.
وأشار التقرير إلى أن انتشار الطائرات المسيّرة المسلحة والصواريخ المضادة للطائرات سيجعل من الصعب تأمين الأجواء السودانية، ويزيد احتمالات وقوع كوارث جوية تمس الطيران المدني، إلى جانب تفاقم الخسائر البشرية بين السكان.
واختتمت واشنطن بوست تقريرها بالتأكيد على أن تدفق الأسلحة المتطورة إلى السودان يعكس فشل المجتمع الدولي في ضبط تجارة السلاح ومنع وصولها إلى أطراف النزاع، محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد يحوّل الحرب السودانية إلى أزمة إقليمية كبرى تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره.
احتجاجات الشباب في المغرب تكشف هشاشة النموذج الاقتصادي رغم مؤشرات الازدهار
تُظهر الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت مدن المغرب أن وراء مشروعات البنية التحتية الحديثة والصورة الاقتصادية المشرقة التي تروّجها الحكومة، تتراكم أزمة اجتماعية أعمق بين الشباب الذين يشعرون بالتهميش وغياب العدالة في توزيع ثمار التنمية.
وحتى صدور هذا التقرير، تستمر الاحتجاجات لأكثر من عشرة أيام على التوالي.
جذور الغضب
اندلعت شرارة التظاهرات في نهاية سبتمبر، حين خرج مئات الشبان في مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط وأكادير، مطالبين بتحسين التعليم والرعاية الصحية، قبل أن تمتد إلى مناطق ريفية ونائية شهدت أعمال شغب واشتباكات مع قوات الأمن. كان الدافع المباشر وراء اندلاع الاحتجاجات وفاة ثمان سيدات حوامل في إحدى المستشفيات، لما يعتقد أن بسبب تدني مستوى الرعاية الصحية في البلاد.
وقُتل ثلاثة متظاهرين أثناء محاولة اقتحام مركز أمني، واعتُقل أكثر من 400 شخص، في أسوأ اضطرابات يشهدها المغرب منذ احتجاجات “الريف” عام 2016، وأوسعها منذ “الربيع العربي” عام 2011.
ويُنظر إلى هذه التحركات على أنها جرس إنذار سياسي واقتصادي، إذ تأتي قبل خمس سنوات من استضافة المغرب كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، في وقت تسعى فيه السلطات إلى الحفاظ على الاستقرار الداخلي وصورة البلاد الاستثمارية.
تنمية لا تشمل الجميع
تميّز المغرب في السنوات الأخيرة عن غيره من الاقتصادات العربية غير النفطية عبر استثمارات ضخمة في الطرق والسكك الحديدية والطاقة المتجددة والموانئ والصناعة.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد انخفض معدل الفقر إلى النصف تقريباً، وارتفعت مستويات المعيشة في مناطق الساحل الشمالي إلى مستويات تقارب نظيراتها في أوروبا.
ويتوقع البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في 2025، بعد 3.8% في 2024، فيما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز الشهر الماضي التصنيف الائتماني للمغرب إلى فئة الاستثمار.
لكن هذه المؤشرات لا تعكس، بحسب المحتجين، الواقع اليومي للمواطنين. إذ يرون أن ثمار النمو الاقتصادي لم تُوزع بعدالة، وأن الأولويات الحكومية تركّز على الصورة الخارجية بدلاً من معالجة أزمات الداخل.
في مستشفى مدينة أكادير، رفع متظاهرون الشهر الماضي شعاراً لافتاً :
“لا نريد كأس العالم.. نريد الصحة أولاً”.
ويقول ناجي عشوي (24 عاماً )، طالب الطب الذي شارك في مظاهرة أمام البرلمان:
“أعمل في غرفة طوارئ بلا جهاز أشعة مقطعية، وأرى المرضى يعانون يومياً بسبب نقص المعدات الأساسية”.
ووفق تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن ربع الشباب المغربي بين 15 و24 عاماً لا يعملون ولا يتعلمون ولا يتدربون.
وتقول جيهان رطمة (19 عاماً )، طالبة إدارة أعمال من سلا:
“نرفض العنف، لكن سواء الشباب الذين يحتجون سلمياً أو أولئك الذين لجأوا للشغب، كلّهم ضحايا السياسات العامة الفاشلة”.
من العالم الافتراضي إلى الشارع
جاءت الدعوات للتظاهر عبر الإنترنت من مجموعة شبابية مجهولة تُسمّي نفسها “جيل زد 212”، نسبة إلى رمز الاتصال الدولي للمغرب. استخدمت المجموعة تطبيقات مثل ديسكورد وتيك توك وإنستغرام لتنظيم المظاهرات، وارتفع عدد أعضائها على “ديسكورد” من 3 آلاف إلى 188 ألفاً خلال أسبوع واحد فقط.
ويقول مراقبون إن السلطات أساءت تقدير حجم الحراك في بدايته، إذ تعاملت معه بالمنع الأمني بدلاً من الحوار، ما أدى إلى تصعيد غير متوقع.
وقال المسؤول الأمني المتقاعد محمد أكضيض لرويترز:
“الحكومة والبرلمان دفنا رأسيهما في الرمل، وتركوا قوات الأمن تواجه نتائج فشل السياسات العمومية”.
الريف والبؤر الفقيرة.. أرض الغضب
في مناطق مثل آيت عميرة الزراعية، التي تُعتبر من أهم السلال الغذائية للمغرب، تبرز هشاشة التنمية الريفية.
فقد تضاعف عدد سكان البلدة أربع مرات خلال ثلاثة عقود، من 25 ألفاً إلى أكثر من 110 آلاف، لكن الخدمات العامة لم تواكب النمو السكاني، والبطالة والبناء العشوائي في تزايد مستمر.
ويقول الباحث الاجتماعي خالد العيوض:
“آيت عميرة تعيش فوق برميل قابل للانفجار”.
أزمة ثقة في السياسة
تراجعت الثقة في الأحزاب السياسية إلى 33% في 2023 مقارنة بـ50% في العام السابق، بحسب المعهد المغربي لتحليل السياسات، ما يعكس شعوراً عاماً بالعزلة السياسية بين الشباب.
وفي أعقاب الاضطرابات، تبنت الحكومة لهجة أكثر تصالحاً .
فقد اعترف وزير التشغيل يونس السكوري بـ “مشروعية” بعض مطالب الشباب، بينما دعا رئيس الوزراء عزيز أخنوش – الذي طالب المحتجون باستقالته – إلى “اعتماد الحوار كخيار وحيد للمضي قدماً ”.
ويترقب المغاربة خطاب الملك محمد السادس خلال افتتاح البرلمان هذا الشهر، وسط آمال بأن يطرح مقاربة جديدة للأزمة.
وختمت مجموعة “جيل زد 212” أحد بياناتها مقتبسة من خطاب للملك عام 2017 قال فيه:
“إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا”. (رويترز)
متابعات إفريقية
غينيا تحدد 28 ديسمبر موعداً لأول انتخابات رئاسية منذ انقلاب 2021
أعلنت السلطات الغينية، أن البلاد ستنظم انتخاباتها الرئاسية الأولى منذ الانقلاب العسكري عام 2021، وذلك في 28 ديسمبر المقبل، وفق مرسوم بثّه التلفزيون الرسمي، بعد يوم واحد من مصادقة المحكمة العليا على نتائج الاستفتاء الدستوري الأخير.
ويأتي الإعلان في أعقاب إقرار دستور جديد يُعتقد أنه يمهد الطريق أمام زعيم المجلس العسكري، العقيد مامادي دومبويا، للترشح للرئاسة، رغم أنه لم يُعلن بعد ما إذا كان يعتزم خوض السباق الانتخابي.
وكان انقلاب عام 2021، الذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي، واحداً من ثماني انقلابات شهدتها منطقة غرب ووسط أفريقيا بين عامي 2020 و2023، مما أثار قلقاً إقليمياً ودولياً بشأن تراجع المسار الديمقراطي في القارة.
وتُعد غينيا لاعباً اقتصادياً مهماً في غرب أفريقيا، إذ تمتلك أكبر احتياطيات من خام البوكسيت في العالم – وهو المادة الأساسية لإنتاج الألومنيوم – فضلاً عن احتوائها على أغنى رواسب خام الحديد غير المستغلة في منجم سيماندو، ما يجعل استقرارها السياسي ذا أهمية دولية كبيرة.
وكانت حكومة دومبويا قد اقترحت في السابق فترة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات في عام 2022، بعد مفاوضات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، لكنها لم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه.
ويحل الدستور الجديد محل الإطار الانتقالي السابق الذي كان يمنع أعضاء المجلس العسكري من الترشح للانتخابات، مما يفتح الباب أمام مشاركة دومبويا إن قرر ذلك. كما يتضمن إصلاحات مؤسسية أبرزها تمديد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستحداث مجلس شيوخ جديد ضمن هيكل الدولة.
ويرى مراقبون أن هذا الاستحقاق الانتخابي سيكون محكّاً رئيسياً لقياس جدية السلطات الغينية في العودة إلى الحكم المدني، وسط ضغوط إقليمية متزايدة لاستعادة النظام الدستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدها. (أفروبوليسي)
محكمة دولية توقف بيع اليورانيوم النيجري مؤقتاً وسط نزاع بين نيامي وشركة أورانو الفرنسية
أمرت محكمة تحكيم دولية، بوقف مؤقت لبيع مخزونات من اليورانيوم في النيجر، في إطار نزاع تجاري متصاعد بين حكومة نيامي ومجموعة “أورانو” الفرنسية للتعدين، التي تتهم السلطات النيجيرية بالاستيلاء على مخزون تابع لها بشكل غير قانوني.
وجاء القرار الصادر عن المحكمة، ومقرها واشنطن العاصمة، ليمنع حكومة النيجر من التصرف في كميات من اليورانيوم تزعم أورانو أنها “سُرقت منها”، كما أمر بالإفراج عن أحد ممثلي الشركة المحتجز منذ مايو الماضي.
وتعود جذور النزاع إلى ديسمبر من العام الماضي، عندما استولى المجلس العسكري الحاكم في النيجر على عمليات شركة أورانو ضمن حملة أوسع لتنظيم قطاع التعدين وإعادة السيطرة على الموارد الطبيعية التي كانت تديرها شركات أجنبية. وبعد أشهر من ذلك، تم تعليق ترخيص الشركة ووقف الإنتاج بالكامل.
وتقول أورانو إن أكثر من ألف طن من مركزات اليورانيوم – تُقدّر قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار – لم تُصدر إلى الخارج كما كان مخططاً، فيما تصر الحكومة النيجيرية على أن الشركة فقدت حقها القانوني في تشغيل المناجم بعد “إخلالها بالالتزامات التعاقدية”.
ويأتي هذا النزاع في سياق توتر سياسي أوسع بين النيجر وفرنسا منذ تولي المجلس العسكري السلطة عام 2023، إذ طردت نيامي القوات الفرنسية من أراضيها وعززت علاقاتها مع روسيا وتركيا، ما أدى إلى تراجع نفوذ باريس في منطقة الساحل الأفريقي الغنية بالموارد.
وبموجب قرار المحكمة، فإن انتهاك نيامي لأوامر وقف البيع سيمنح شركة أورانو الحق في مصادرة أصول أو عائدات تخص النيجر في الخارج. ورغم الطابع المؤقت للحكم، يُتوقع أن تستمر الإجراءات القضائية لأشهر وربما سنوات قبل صدور القرار النهائي.
ويرى مراقبون أن هذه القضية لا تمثل مجرد نزاع تجاري، بل اختباراً حقيقياً لتوازن القوى الجديد في غرب أفريقيا، حيث تتزايد مساعي الأنظمة العسكرية لاستعادة السيطرة على ثرواتها الطبيعية وإعادة توجيه شراكاتها الاقتصادية بعيداً عن النفوذ الفرنسي التقليدي. (أفروبوليسي)
الشرطة الكينية تُفكك شبكة لتجنيد مواطنين للقتال في صفوف القوات الروسية بأوكرانيا
أعلنت الشرطة الكينية عن تفكيك شبكة دولية يُشتبه في تورطها بالاتجار بالبشر وتجنيد كينيين للقتال في الحرب الروسية الأوكرانية، بعد أن أغرتهم بعروض عمل وهمية في موسكو.
وقالت السلطات إن العملية الأمنية، التي نُفذت الأربعاء بالتنسيق بين عدة وكالات استخباراتية، أسفرت عن إنقاذ أكثر من 20 شخصاً، بعد مداهمة شقة سكنية في ضاحية نهر آثي على مشارف العاصمة نيروبي، حيث كان الضحايا “بانتظار استكمال ترتيبات سفرهم إلى روسيا”.
وخلال المداهمة، صادرت الشرطة وثائق سفر، وعقود توظيف مزيفة، ورسائل إلكترونية تحتوي على عروض عمل، كما ألقت القبض على أحد المشتبه بهم الرئيسيين المتهم بتنسيق عمليات السفر بين سبتمبر وأكتوبر، مستهدفاً شباناً يبحثون عن فرص عمل في الخارج.
وبحسب بيان الشرطة، فإن “العصابة الإجرامية كانت تغري المواطنين بعروض عمل مجزية في روسيا، قبل أن ترسلهم فعلياً للانضمام إلى القتال في أوكرانيا”.
وأفاد الضحايا في إفاداتهم أنهم وقعوا عقوداً مع وكالة توظيف خارجية لم يُفصح عن اسمها، تلزمهم بدفع ما يصل إلى 18 ألف دولار أميركي (نحو 13 ألف جنيه إسترليني) لتغطية تكاليف التأشيرات والسفر والإقامة، فيما دفع بعضهم مقدمات بلغت 1500 دولار.
وأوضح المحققون أن بعض المجندين السابقين عادوا إلى كينيا مصابين أو يعانون من صدمات نفسية حادة، بينما اختفى آخرون تماماً بعد سفرهم إلى روسيا.
وتعد هذه الحادثة من أبرز القضايا التي تكشف عن شبكات التجنيد غير القانونية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، والتي تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في دول أفريقيا لتجنيد مقاتلين ضمن صفقات مشبوهة تُقدَّم تحت غطاء عقود عمل مدنية. (أفروبوليسي)
متابعات دولية
إسرائيل تدفع للمؤثرين 7 آلاف دولار عن كل منشور لدعم محتواها على وسائل التواصل الاجتماعي
في اجتماع خُصص لتعبئة الدعم الإعلامي المؤيد لإسرائيل، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استراتيجية تعتمد على شبكة من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لترويج الرسائل الإسرائيلية حول العالم.
وقال نتنياهو خلال اللقاء: “علينا أن نردّ. وكيف نردّ؟ عبر مؤثرينا. إنهم جزء أساسي من المعركة، ويجب التحدث إليهم لأنهم مهمّون للغاية”.
ووفقاً لوثائق حديثة لم يُكشف عنها سابقاً، يتقاضى هؤلاء المؤثرون مبالغ تصل إلى سبعة آلاف دولار عن كل منشور على منصّات مثل “تيك توك” و”إنستغرام”، مقابل نشر محتوى مؤيد لإسرائيل ضمن حملة ممولة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.
تشير الوثائق إلى أن شركة Bridges Partners، وهي شركة تعمل لصالح وزارة الخارجية الإسرائيلية، أرسلت سلسلة فواتير لشركة Havas Media Group في ألمانيا – وهي مجموعة إعلامية دولية تدير جزءاً من الحملة – بقيمة إجمالية تبلغ 900 ألف دولار للفترة الممتدة بين يونيو ونوفمبر 2025. وتهدف الحملة إلى تمويل مجموعة تتراوح بين 14 و18 مؤثراً لإنتاج محتوى دعائي مؤيد لإسرائيل.
الوثائق المسجلة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) في الولايات المتحدة أوضحت أن التمويل يغطي كلاً من “المدفوعات للمؤثرين وتكاليف الإنتاج”، دون توضيح كيفية تقسيم المبلغ بين الجانبين. وبعد خصم المصاريف القانونية والمصرفية والإدارية حتى منتصف سبتمبر، يُقدّر أن 552,946 دولاراً من المبلغ الإجمالي خُصصت مباشرة للمؤثرين، أي ما يعادل ما بين 6,100 إلى 7,300 دولار لكل منشور حسب عدد المشاركات المنتجة خلال الفترة.
ولم يُكشف بعد عن هوية المؤثرين المشاركين في البرنامج، بينما رفضت شركة Havas الرد على الاستفسارات حول تفاصيل الحملة أو أسماء المتعاونين أو قيمة العقود الفردية.
تُدار شركة Bridges Partners من قبل مؤسسيها يائير ليفي وأوري شتاينبرغ، ولكل منهما حصة بنسبة 50%. وتُعرّف الشركة نفسها بأنها “تعمل على تعزيز التبادل الثقافي بين الولايات المتحدة وإسرائيل”، بينما تُظهر سجلاتها أن مقرها يقع في حي “كابيتول هيل” بواشنطن العاصمة. كما استعانت الشركة بخدمات نَداف شتراوشلر، وهو ضابط سابق في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وبمكتب المحاماة Pillsbury Winthrop Shaw Pittman الذي سبق أن مثّل شركة برامج التجسس الإسرائيلية المثيرة للجدل NSO Group.
تحمل الحملة اسم “مشروع إستير” (Esther Project)، وهو اسم مشابه لمبادرة أطلقتها مؤسسة “هيريتج فاونديشن” اليمينية في الولايات المتحدة تحت عنوان مماثل لمحاربة معاداة السامية عبر وصم منتقدي إسرائيل بأنهم “داعمون للإرهاب”. إلا أن متحدثاً باسم “هيريتج فاونديشن” أكد لموقع Responsible Statecraft أنه “لا توجد أي علاقة بين مشروع إستير التابع لمؤسسة هيريتج والمشروع الذي تديره شركة Bridges Partners”.
ويُنظر إلى هذه الحملة على نطاق واسع بوصفها جزءاً من جهود إسرائيل المكثّفة للتأثير في الرأي العام الأميركي والغربي، عبر توظيف أدوات جديدة في الفضاء الرقمي وإعادة صياغة السرديات السياسية والإعلامية المتعلقة بالنزاع الإسرائيلي–الفلسطيني، من خلال وجوه مؤثرة ومتابعة جماهيرية واسعة.
بعد استقالة ليكورنو.. هل ينجو ماكرون من أعمق أزمة سياسية تهدد فرنسا؟
دخلت فرنسا مرحلة سياسية حرجة عقب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، مما عمّق الأزمة الدستورية التي تواجه الرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت تشهد فيه البلاد شللاً سياسياً ومالياً متزايداً. ليكورنو، الذي لم يمكث سوى بضعة أشهر في منصبه، أصبح بذلك أقصر رؤساء الوزراء خدمةً في التاريخ الفرنسي الحديث، وهو خامس رئيس حكومة منذ بدء الولاية الثانية لماكرون عام 2022، وثالثهم منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في صيف 2024 التي أفرزت برلماناً معلقاً يفتقر لأي أغلبية حاسمة.
يأتي هذا التطور في ظل انقسام البرلمان إلى ثلاث كتل رئيسية: التحالف الوسطي الداعم لماكرون، ائتلاف يساري، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وكل منها يركز على تموضعه استعداداً للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، أكثر من سعيه لبناء توافقات سياسية. وقد ساهم هذا الجمود في تفاقم العجز المالي الفرنسي الذي يقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف السقف المحدد من قبل قواعد الاتحاد الأوروبي، مع تصاعد حجم الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة ضمن الكتلة الأوروبية.
استقالة ليكورنو جاءت بعد تعرضه لانتقادات شديدة بشأن تشكيلته الوزارية التي لم تحمل التغيير الموعود، بل ضمّت أسماء بارزة من الحكومات السابقة، مما أثار حفيظة كل من اليمين واليسار، إذ رأى المحافظون أنها استمرار لنهج فشل في تحقيق الاستقرار، فيما اعتبرها آخرون دليلاً على رفض ماكرون لأي تنازلات سياسية.
تترك الاستقالة ماكرون أمام خيارات محدودة، جميعها تنطوي على تحديات. الخيار الأول يتمثل في تعيين رئيس وزراء جديد من داخل تحالفه الوسطي، لكنه قد يواجه نفس مصير ليكورنو في ظل غياب الدعم البرلماني. أما خيار الاستعانة بشخصية مستقلة أو من المعارضة المعتدلة، فقد يقتضي تقديم تنازلات كبيرة، خصوصاً في ملفات حساسة كإصلاح التقاعد، ويعرض الحكومة لمزيد من تصويتات حجب الثقة.
الخيار الثاني، وهو حلّ الجمعية الوطنية، بات ممكناً من الناحية الدستورية بعد مرور عام على آخر انتخابات، لكنه يحمل مخاطر تكرار النتيجة نفسها أو حتى تعزيز موقع اليمين المتطرف، كما حدث في انتخابات 2024 التي وُصفت حينها بأنها مغامرة غير محسوبة.
وفي حين تطالب بعض الأصوات اليسارية، خاصة داخل حزب “فرنسا الأبية”، باستقالة ماكرون نفسه، يبدو هذا السيناريو مستبعداً بالنظر إلى إصرار الرئيس على استكمال ولايته حتى 2027، علماً بأن الدستور يمنح إمكانية عزله عبر البرلمان في حال ارتكابه “إخلالاً واضحاً بواجبات المنصب”، لكن هذا المسار لم يُفعّل يوماً منذ إقراره عام 2007.
وفي ظل هذا الانسداد السياسي، تعمل فرنسا حالياً تحت سلطة حكومة تصريف أعمال، غير قادرة على تمرير ميزانية 2026 أو تنفيذ إصلاحات كبرى. استقالة ليكورنو تسببت في تأجيل عرض مشروع الميزانية، في حين يُفرض على أي حكومة مقبلة إعداد مسودة جديدة والدفاع عنها أمام البرلمان في وقت قياسي، وهو أمر شبه مستحيل بالنظر إلى ضيق الوقت وتعقيدات الانقسامات الحزبية. ويبدو أن الحلّ المؤقت قد يتمثل في تكرار ما جرى في العام الماضي، عبر اعتماد قانون خاص يسمح بتمديد العمل بميزانية العام السابق لضمان استمرارية الدولة.
أمام هذه الصورة القاتمة، يقف الرئيس ماكرون في مفترق طرق بالغ الحساسية، في لحظة سياسية دقيقة تتطلب حنكة وجرأة لتجنب شلل طويل الأمد قد تكون له كلفة اقتصادية ودستورية باهظة على فرنسا وأوروبا على حد سواء.
مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تتراجع.. هل بدأ زخم الاستهلاك بالتلاشي؟
في تطور يثير القلق بشأن متانة التعافي الاقتصادي في أوروبا، سجلت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعاً أكبر من المتوقع خلال شهر يوليو/تموز، في إشارة إلى أن القوة الشرائية للأسر الأوروبية – والتي كانت بمثابة محرك رئيسي للنمو خلال النصف الأول من العام – بدأت تفقد زخمها.
بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، انخفضت مبيعات التجزئة في الدول العشرين التي تعتمد اليورو بنسبة 0.5% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات اقتصرت على 0.2% فقط. أما على أساس سنوي، فقد سجلت المبيعات ارتفاعاً بنسبة 2.2%، لكنها جاءت أيضاً دون تقديرات المحللين التي رجّحت 2.4%.
زخم استهلاكي يفقد قوته تحت الضغط
هذا التراجع يعيد طرح تساؤلات حول قدرة الأسر الأوروبية على مواصلة الإنفاق بنفس الوتيرة التي فاجأت الأسواق في الشهور الماضية. ففي الوقت الذي اعتمد فيه الاقتصاد الأوروبي بشكل أساسي على الاستهلاك المحلي لتعويض ضعف الصادرات وتراجع ثقة المستثمرين، قد تمثل أرقام يوليو إنذاراً مبكراً بتحوّل في المزاج الاستهلاكي.
الضغوط التجارية تلوح في الأفق
يتزامن هذا التراجع مع تصاعد التوترات التجارية العالمية وفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة، وهو ما يثير مخاوف من أن تتحول حالة التباطؤ في مبيعات التجزئة إلى عبء مباشر على معدلات النمو الكلي في منطقة اليورو.
تعافٍ هش وسط مناخ غير مستقر
وكانت منطقة اليورو قد حققت نمواً مفاجئاً في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بانتعاش إنفاق المستهلكين رغم مناخ اقتصادي مضطرب وضغوط خارجية. لكن التراجع الأخير قد يشير إلى أن هذا المحرك الأساسي بدأ يفقد زخمه، في وقت لا تزال فيه الأسواق الأوروبية تواجه تحديات من بينها التضخم، الرسوم الأميركية، وتباطؤ التجارة العالمية.
تسونامي تسريحات يضرب أوروبا: الآلاف يفقدون وظائفهم وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة
تواجه القارة الأوروبية موجة عاتية من تسريحات الوظائف، مع تفاقم تباطؤ النمو الاقتصادي واشتداد الضغوط الناجمة عن الرسوم الأميركية. وتصدرت شركات عملاقة في قطاعات متعددة – من صناعة السيارات والبنوك إلى الطاقة والسلع الفاخرة – المشهد، معلنة خططاً لتقليص عشرات الآلاف من الوظائف في إطار جهود لخفض التكاليف وإعادة هيكلة نشاطها لمواجهة تحديات الأسواق العالمية، وفقاً لوكالة “رويترز”.
قطاع السيارات.. الأكثر تضرراً
جاءت صناعة السيارات في طليعة القطاعات الأكثر تأثراً، مع إعلان شركات أوروبية كبرى عن خطط واسعة لتسريح الموظفين:
بوش (ألمانيا): تقليص 13 ألف وظيفة بسبب تراجع الطلب وارتفاع التكاليف.
فولكسفاغن (ألمانيا): خفضت 7 آلاف وظيفة منذ بدء خطة التوفير في 2023.
دايملر تراك: استغنت عن ألفي وظيفة في أميركا والمكسيك، إضافة إلى 5 آلاف أخرى في ألمانيا.
فولفو (السويد): أعلنت شطب 3 آلاف وظيفة إدارية ضمن خطة إعادة الهيكلة.
رينو (فرنسا): تدرس إلغاء 3 آلاف وظيفة في مكاتبها داخل باريس ومناطق أخرى.
ستيلانتيس (إيطاليا): رفعت عدد الموظفين المشمولين بالتقاعد المبكر الطوعي إلى 2,500 شخص في 2025.
البنوك الأوروبية تشدّ الحزام
في القطاع المصرفي، بدأت موجة تقشفية شاملة:
كومرتس بنك (ألمانيا): توصل لاتفاق لخفض نحو 3,900 وظيفة بحلول 2028.
لويدز بنك (بريطانيا): يخطط لتقليص نحو نصف وظائفه البالغة 3 آلاف وظيفة بهدف تقليل النفقات.
قطاع الطاقة والصناعة ليس بمنأى
شركة OMV (النمسا): تخطط لإلغاء ألفي وظيفة، أي ما يعادل نحو ثُمن القوة العاملة.
STMicroelectronics (فرنسا-إيطاليا): تعتزم خفض 2,800 وظيفة في 2025، في إطار خطة أكبر للاستغناء عن 5 آلاف وظيفة خلال ثلاث سنوات.
السلع الفاخرة والرفاهية تدخل خط التسريحات
بربري (بريطانيا): ستستغني عن 1,700 وظيفة، أي خُمس موظفيها حول العالم.
LVMH (فرنسا): أعلنت وحدة “مويت هنسي” عن خفض 1,200 وظيفة في قطاع النبيذ والمشروبات الفاخرة.
شركات أخرى تتأثر بالموجة
Just Eat Takeaway (هولندا): تخطط لتسريح 2,000 موظف في وحدة “ليفيراندو” بألمانيا بحلول نهاية 2025.
لوفتهانزا (ألمانيا): أعلنت عن تقليص 4 آلاف وظيفة إدارية بحلول عام 2030.
نوفو نورديسك (الدنمارك): ستستغني عن 9 آلاف موظف حول العالم.
قراءة في المشهد: مؤشرات مقلقة لاقتصاد هش
تكشف هذه الموجة من التسريحات، التي طالت عشرات الآلاف من الموظفين في شتى القطاعات، عن حجم الضغوط التي تثقل كاهل الاقتصاد الأوروبي. من تباطؤ النمو، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصولاً إلى الأثر المتنامي للرسوم الأميركية – جميعها عوامل تدفع الشركات لإعادة هيكلة أعمالها وتقليص نفقاتها.
هذه التطورات تمثل ناقوس خطر بشأن استقرار سوق العمل الأوروبي في الفترة المقبلة، خاصة مع هشاشة البيئة الاقتصادية العالمية واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق.
تاكاييتشي المحافظة تستعد لتصبح أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان
تشهد اليابان تحولاً سياسياً تاريخياً مع فوز ساناي تاكاييتشي برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، مما يمهّد لتعيينها رسمياً كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد.
تاكاييتشي، البالغة من العمر 64 عاماً ، والمعروفة بتوجهاتها المحافظة وإعجابها بالزعيمة البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر، وصفت فوزها بأنه “بداية عصر جديد”، لكنها أقرت بأن أمامها “جبلاً من التحديات” لإعادة إحياء شعبية الحزب الحاكم الذي يعاني من تراجع التأييد الشعبي.
التحديات أمام تاكاييتشي
يتوقع أن يصدق البرلمان على تعيينها رسمياً في وقت لاحق من هذا الشهر، لتصبح الخامس الذي يتولى المنصب خلال خمس سنوات في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها اليابان.
ستواجه تاكاييتشي ملفات معقدة، من الشيخوخة السكانية إلى التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الجدل حول سياسات الهجرة.
وفي أولى تصريحاتها بعد فوزها، أكدت أنها لن تعيد النظر في اتفاقية التجارة الأخيرة مع الولايات المتحدة، كما أنها تستعد لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة لطوكيو في أواخر أكتوبر.
موقفها من الصين والمجتمع الدولي
تاكاييتشي تُعرف بموقفها الصارم من التوسع العسكري الصيني، وتثير زياراتها المتكررة إلى ضريح ياسوكوني، الذي يكرّم قتلى اليابان في الحروب، استياء بكين وسيول.
وفي أول رد فعل صيني على فوزها، دعت وزارة الخارجية في بكين طوكيو إلى “الالتزام بتعهداتها السياسية في قضايا التاريخ وتايوان، وانتهاج سياسة عقلانية تجاه الصين”.
أزمة سياسية داخلية وصعود اليمين الشعبوي
تأتي تاكاييتشي خلفاً لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شيغيرو إيشيبا، الذي فقد حزبه الأغلبية البرلمانية نتيجة الفضائح المالية وارتفاع الأسعار.
ويُعد صعود حزب سانسيتو اليميني، الذي يصف الهجرة بأنها “غزو صامت”، مؤشراً على التحول نحو الخطاب الشعبوي.
وقالت تاكاييتشي في حملتها إنها تؤيد “مراجعة السياسات التي تسمح بدخول أشخاص من ثقافات وخلفيات مختلفة تماماً “، رغم حاجة اليابان المتزايدة إلى العمالة الأجنبية مع انخفاض عدد السكان.
تاكاييتشي وأجندتها الاقتصادية
اقتصادياً ، تدعم تاكاييتشي ما تسميه “أبينوميكس 2.0″، وهي سياسة تستلهم نهج رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي في التحفيز المالي وخفض الفوائد لدفع الاقتصاد.
لكن رغم كونها أول امرأة تتولى المنصب، يرى محللون أنها لا تمثل مكسباً لقضايا المساواة بين الجنسين.
وقالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة توكاي، يوكي تسوجي: “تاكاييتشي لا تُبدي اهتماماً بحقوق المرأة أو بسياسات المساواة بين الجنسين”.
كما تعارض تعديل قانون يعود للقرن التاسع عشر يفرض على الأزواج مشاركة اللقب نفسه، وترفض الزواج من نفس الجنس. (AFP)