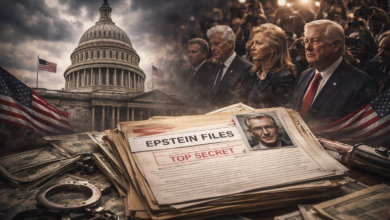نحن والعالم عدد 14 أغسطس 2025

يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 8 أغسطس 2025 إلى 14 أغسطس 2025.
تابعنا في هذه النشرة التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة هذا الأسبوع. في سوريا عاد الخلاف بين النظام الحاكم وقسد، كما عززت تركيا تحالفاتها مع دمشق عبر اتفاقات أمنية وعسكرية، في حين كثفت روسيا من تحركاتها لاستعادة نفوذها في سوريا. وكان من أبرز التطورات الدولية توقيع اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتضمن إنشاء “ممر ترامب” عبر الأراضي الأرمينية لربط أذربيجان بنخجوان، ما أثار في إيران مزيجاً من الترحيب الحذر والقلق الجيوسياسي من التواجد الأميركي قرب حدودها. وفي سياق آخر، حذرت مجلة “فورين بوليسي” من مواجهة عسكرية وشيكة بين إسرائيل وإيران قبل نهاية أغسطس الجاري، وسط تحضيرات متبادلة وتصعيد الخطاب العسكري. داخلياً، عيّن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان علي لاريجاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي في خطوة تعكس توجهاً لمقاربة أمنية شاملة تتجاوز البعد العسكري. أما في لبنان، فقد فجّر قرار حصر السلاح بيد الدولة جدلاً واسعاً مع تمسك إيران بسلاح حزب الله، وسط تقديرات باستخدامه كورقة تفاوضية في الملف النووي. وفي خلفية المشهد، تتقاطع ملفات القوقاز والشرق الأوسط في سياق صراع إقليمي ودولي مفتوح.
سوريا
تعيش الساحة السورية حراكاً سياسياً وأمنياً متسارعاً، حيث تصاعد الخلاف بين دمشق و”قسد” بعد انسحاب الحكومة من محادثات باريس، واعتبارها أن الخطوة تمثل انحرافاً عن اتفاق 10 آذار. وفي الوقت نفسه، عززت تركيا تحالفها مع دمشق عبر اتفاقيات أمنية وعسكرية تهدف إلى مواجهة مشاريع التقسيم، بينما كثفت موسكو تحركاتها لزيادة نفوذها من خلال عروض دعم مشروط سياسياً واقتصادياً. وعلى الأرض، يشهد الجنوب السوري توتراً متصاعداً مع تراجع سلطة الحكومة في السويداء لصالح مجموعات مسلّحة محلية. وفي خضم هذه الأزمة، ظهر مقطع فيديو يوثق قيام مليشيات درزية برسم العلم الإسرائيلي على مسجد للمسلمين السنة بعد استهدافه بالرشاشات الثقيلة، ما أثار موجة غضب واسعة وزاد من حدة الانقسام الطائفي.
رهان مضاعف: زعيم سوريا بين خيار القتال أو التفاوض
في تحليل معمق نشر على موقع “Syria in Transition”، ذكر أنه بعد مرور تسعة أشهر على توليه الحكم، يواجه الرئيس السوري أحمد الشرع أزمة سياسية حادة تهدد مشروعه لتوحيد البلاد تحت سلطته. الشرع، الذي حظي في البداية بدعم قطاعات واسعة من السنّة العرب ورعاية إقليمية خاصة من تركيا والسعودية، اصطدم بواقع معقد؛ إذ أدت إخفاقاته في تحقيق شمولية حقيقية، واندلاع جولات من العنف الطائفي، إلى دفع الطائفة الدرزية للانفصال سياسياً عن دمشق، مقتدية بتجربة الأكراد الذين أسسوا حكماً ذاتياً في شمال شرق سوريا خلال العقد الماضي.
الخطوة الدرزية نحو حكم ذاتي في الجنوب لقيت دعماً إسرائيلياً، إذ ترى تل أبيب منذ سنوات في تفكك سوريا مصلحة استراتيجية. ففي 24 يوليو، وخلال اجتماع في باريس جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بوفد إسرائيلي، برعاية فرنسية ووساطة أميركية، مارست إسرائيل ضغوطاً كبيرة على دمشق، ما أسفر عن انسحاب القوات الحكومية من السويداء وتسليم إدارة المحافظة لمجلس محلي من زعماء الدروز. هذه التطورات أطلقت موجة أوسع من الدعوات إلى اللامركزية، كان أبرزها في مؤتمر الحسكة بتاريخ 8 أغسطس، حيث اجتمع ممثلو مكونات إثنية ودينية متعددة للمطالبة بدستور جديد يضمن التعددية الدينية والثقافية والإثنية، وبنظام حكم لامركزي.
الورقة التركية – الروسية
التوجه نحو اللامركزية أثار قلق أنقرة، التي تعارض بشدة أي صيغة تمنح الأكراد حكماً ذاتياً. مصادر تركية أكدت أن الحكومة ضغطت على الشرع للانسحاب من جولة جديدة من المفاوضات الفرنسية-الأميركية مع الأكراد، رفضاً لأي دور إسرائيلي أو فرنسي، واحتجاجاً على استمرار الدعم العسكري الأميركي لـ”قسد”، حيث أعلنت واشنطن مؤخراً تخصيص 130 مليون دولار إضافية لتمويل عملياتها ضد “داعش” حتى عام 2026.
السعودية من جانبها منحت الشرع غطاءً عربياً ودعماً سياسياً في صورته، لكنها امتنعت عن تمويل مباشر لحكومته، وفشلت في حمايته من ضغوط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومع تراجع تحالفاته الإقليمية، تجد تركيا نفسها الطرف الأكثر تأثيراً على دمشق، لكنها تفتقر إلى حلفاء كثر يشاركونها هدف إعادة بناء دولة مركزية قوية.
في هذا السياق، نصحت أنقرة الشرع بالعودة إلى تعميق التحالف مع موسكو، معتبرة أن الشراكة الروسية – التركية، كما في صيغة “أستانا” سابقاً، يمكن أن تشكل توازناً أمام النفوذ الإسرائيلي والغربي، وتوفر دعماً عسكرياً للحكومة السورية، خصوصاً إذا قررت أنقرة ودمشق شن عملية عسكرية ضد الأكراد شبيهة بعمليات 2016 و2018 و2019 التي جرت بتنسيق وثيق مع روسيا.
موسكو بدورها وضعت شروطاً: إعادة ضباط حقبة الأسد المرتبطين بها إلى الجيش، إعادة توظيف ضباط دروز وعلويين في إدارة الأمن بالمناطق ذات الأغلبية منهم، إعادة هيكلة الديون السورية المقدرة بـ 50 مليار دولار، ومنح قواعدها العسكرية وضعاً قانونياً دائماً.
معضلة الشرع
الشرع، مثل سلفه، يواجه خيارين لا ثالث لهما: الحفاظ على دولة مركزية موحدة أو المخاطرة بمزيد من التفكك. التحالف الوثيق مع موسكو قد يمنحه دعماً عسكرياً وسياسياً لفرض “حل بالقوة” ضد تحالف الأقليات، لكنه قد يثير استياء جزء من قاعدته السنية التي ترى في النفوذ الروسي امتداداً لحقبة الأسد.
أما الانفتاح على الغرب فيعني القبول بتسوية سياسية قائمة على تقاسم السلطة مع الأكراد والأقليات الأخرى، وهو ما يرفضه الشرع لأنه يقوض سيطرته المطلقة على مؤسسات الدولة. في المقابل، يطالب الغرب بحل سياسي وفق القرار 2254، يوازن بين وحدة الدولة وتمثيل مكوناتها.
ثمة دعوات لعقد مؤتمر دولي واسع على غرار “أصدقاء سوريا”، يجمع الولايات المتحدة وتركيا وروسيا وإسرائيل والدول العربية والأوروبيين، بهدف صياغة خارطة طريق ثلاثية السنوات تشمل عودة النازحين، وإعادة الإعمار، وإنعاش الاقتصاد، على أن تكون كلها مشروطة بحوار وطني شامل يضم جميع القوى السورية: الحكومة، السنّة، الأكراد، العلويين، الدروز، وبقية الأقليات.
قرار حاسم
أزمة السويداء شكّلت ضربة قاسية للشرع؛ إذ حاول فرض هيبة الدولة على الدروز، وفي الوقت نفسه إرسال رسالة ردع للأكراد، لكنه انتهى بخسارة سيطرة ميدانية وتعرض وزارة دفاعه للقصف. كلما طال أمد هذه الأوضاع، زادت احتمالية تحوّل الترتيبات المؤقتة إلى أمر واقع دائم.
الشرع الآن أمام مفترق طرق: إما المضي في نهج القوة، بدعم تركي-روسي، لاستعادة السيطرة الكاملة، أو الانفتاح على تسوية سياسية تتضمن لامركزية محدودة وتعددية سياسية. لكن بالنظر إلى سجله السياسي، يبدو أنه يميل إلى خيار التصعيد والمناورة السياسية، مراهناً على خطاب “لم أتراجع” لتعزيز صورته كرجل قوي في نظر مؤيديه، حتى لو كانت النتيجة المزيد من العزلة والتوتر الداخلي.
تفاصيل اتفاق التعاون العسكري بين سوريا وتركيا
وقّعت وزارتا الدفاع السورية والتركية، مذكرة تفاهم مشتركة للتدريب والاستشارات العسكرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز وتطوير إمكانيات الجيش السوري. وقد جرى التوقيع في أنقرة عقب مباحثات جمعت كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وأفادت وزارة الدفاع التركية، أن الوزير يشار غولر ونظيره السوري مرهف أبو قصرة وقّعا الاتفاقية، التي تلت لقاءات مكثفة شملت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة، ركزت على قضايا الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي.
من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش السوري وتطوير مؤسساته وهيكليته، بالإضافة إلى دعم عملية إصلاح شاملة لقطاع الأمن.
وتشمل بنود الاتفاقية تبادل الأفراد العسكريين للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة لرفع الجاهزية العملياتية، والتدريب على مهارات متخصصة في مجالات مثل مكافحة الإرهاب، إزالة الألغام، الأمن السيبراني، والهندسة العسكرية، فضلاً عن عمليات حفظ السلام. كما تتضمن الاتفاقية تقديم مساعدة فنية عبر إرسال خبراء لدعم عملية تحديث الأنظمة والهياكل العسكرية.
تعليق المعهد المصري:
تأتي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين سوريا وتركيا في المجالات العسكرية، في وقت حساس وحاسم جداً في مستقبل سوريا، وهو أمر طال انتظاره منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي. أهمية هذه المذكرة أنها تعكس من جهة رغبة دمشق في بناء شراكة إستراتيجية عميقة في مختلف المجالات مع أنقرة، ومن ناحية أخرى، فإن التنسيق بين البلدين من الناحية العسكرية هو ضرورة حتمية وليس مجرد خيار استراتيجي لدمشق وأنقرة على حد سواء، في ظل التهديدات التي تواجهها الحكومة الوليدة في شمال شرقي سوريا والمتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، خاصة بعد انهيار مفاوضات باريس عقب تنظيم “قسد” مؤتمراً وصف بمؤتمر الأقليات جمعت فيه شخصيات تعتبرها دمشق انفصالية، مطالبة بسوريا لامركزية، المؤتمر الذي تلى تطورات هامة في الجنوب السوري على خلفية أحداث السويداء، واستمرار التغلغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مما يترك سوريا ساحة مفتوحة للصراعات في ظل انعدام قدرة الحكومة الجديدة على تشكيل جيش جديد وتدريبه وتسليحه وإقامة منظومة دفاعية متينة في وجه التحديات الأمنية والعسكرية، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأمن القومي التركي المتداخل بشكل وثيق مع الأمن القومي السوري.
وعلى الرغم أن الاتفاق الذي تم توقيعه لازال في إطار مذكرة التفاهم، وليس اتفاقا تعاقدياً ملزماً، ومن غير المعروف كافة تفاصيله بعد، إلا أنه ينطلق من ضرورة استراتيجية لكلا البلدين وسط تحديات متشابكة ومشتركة.
لقاء فيدان والشرع… رسائل سياسية وتوقيت لافت
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس 7 أغسطس/آب، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق التقى خلالها الرئيس أحمد الشرع، في مباحثات وُصفت بأنها شملت ملفات ثنائية وأخرى إقليمية حساسة، في ظل تحولات سياسية وأمنية متسارعة في المنطقة.
الزيارة، التي تأتي بعد يومين فقط من تغييرات على مستوى القيادة العسكرية في تركيا، تحمل – بحسب الباحث في الشأن السوري وائل علوان – أبعاداً إستراتيجية ترتبط بإعادة رسم سياسة أنقرة في الشرق الأوسط عقب سقوط نظام بشار الأسد وتسلّم الحكومة السورية الجديدة زمام السلطة.
علوان يرى أن المرحلة المقبلة تستدعي شراكات سياسية ودبلوماسية أوسع بين أنقرة ودمشق، يمكن أن تفتح الباب أمام تخفيف العقوبات الدولية على سوريا، وإطلاق مسار تطبيع كامل، وصولاً إلى التنمية الاقتصادية. كما يشير إلى أن الدبلوماسية التركية قد تلعب دور الوسيط غير المباشر في ملفات شائكة مع أطراف مثل إسرائيل، بما يهيئ لفرص استثمارية وتنموية تحتاجها دمشق.
على الصعيد الداخلي السوري، يؤكد علوان أن أنقرة “لن تسمح بفراغ أمني أو فوضى جديدة”، وأنها تسعى إلى تفاهمات عاجلة مع الحكومة السورية لضمان استقرار أمني وعسكري وسياسي يهيئ الأرضية لمشاريع إعادة الإعمار والازدهار الاقتصادي.
الخبير العسكري فايز الأسمر من جهته يرى أن سقوط نظام الأسد أوجد “آفاق تعاون واسعة” بين الجانبين، إلى جانب ملف إعادة الإعمار واستثمارات الشركات التركية في سوريا.
الأسمر لم يستبعد أن تبحث القيادتان مستقبلاً اتفاقية دفاع مشترك أو حتى إقامة قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي السورية، باعتبار ذلك امتداداً للتنسيق الأمني بينهما.
أما عن البعد الإقليمي، فيشير علوان إلى أن أنقرة تعمل على بناء شراكات إستراتيجية مع دمشق على غرار علاقاتها الوثيقة مع أذربيجان والسعودية وقطر، الحلفاء الرئيسيين للحكومة السورية الجديدة، مستفيدة من الموقع الجغرافي لسوريا كممر إستراتيجي نحو مشاريع تنموية عربية – تركية أوسع. (الجزيرة نت)
قسد تجمع زعماء دروز وعلويين في مؤتمر الحسكة والحكومة السورية ترفض وتصفه بمحاولة تقسيم
دخل الخلاف بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مرحلة جديدة من التصعيد، عقب مؤتمر “وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا” الذي استضافته مدينة الحسكة في 8 أغسطس/آب، حيث أعلنت دمشق انسحابها من مباحثات باريس المرتقبة، متهمة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالانقلاب على اتفاق 10 آذار/مارس الموقع بين قائدها مظلوم عبدي والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.
المؤتمر، الذي ضم شخصيات دينية وزعماء عشائر من مختلف المكونات السورية – بينهم الشيخ حكمت الهجري من الطائفة الدرزية والشيخ غزال غزال من الطائفة العلوية – اعتبرته دمشق خطوة استفزازية، خاصة أنه جاء قبل أيام من جولة تفاوضية برعاية فرنسية وأمريكية، وبعد فشل محادثات دمشق وعمّان.
وشهد المؤتمر كلمة مصوّرة للشيخ حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في السويداء، دعا فيها إلى وحدة الصف الوطني وحماية حقوق جميع السوريين، في حين دعا غزال غزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، إلى إقامة دولة مدنية علمانية تعددية ولامركزية باعتبارها الضمانة لوحدة البلاد وحماية تنوعها.
مشاركة زعماء من الطائفتين الدرزية والعلوية – اللتين ارتبطتا تاريخياً بدمشق – اعتُبرت خطوة لافتة من جانب قسد لتوسيع تحالفاتها مع الأقليات خارج نطاق سيطرتها، في محاولة لبلورة جبهة سياسية أوسع لما بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقال مدير إدارة الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية، قتيبة إدلبي: إن المؤتمر تضمّن “محاولة للاستقواء بأطراف خارجية”، معتبراً أن تصريحات “قسد” والشيخ حكمت الهجري جسّدت ذلك التوجّه.
إدلبي شدّد على رفض دمشق “تكرار تجارب حزب الله، أو أي نماذج مشابهة على الأراضي السورية”، منتقداً منح “قسد” منصات لشخصيات– مثل الهجري– قال إنها “لا تمثل المكونات التي تتحدث باسمها”. وأوضح أن الحكومة السورية منفتحة على مبدأ “اللامركزية الإدارية” لكنها ترفض “أي لامركزية سياسية” رفضاً قاطعاً.
من جانبها، أكدت مصادر في “قسد” وأخرى دبلوماسية فرنسية، أن القوات لم تتلقّ حتى الآن إخطاراً رسمياً بانسحاب دمشق من المفاوضات، ما يترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من التوتر أو احتمالات العودة للحوار، وسط ترقب للموقف الفرنسي من هذا التطور. (البلاد)
سوريا… القرار في دمشق لا في باريس – مقال تحليلي
أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسين ألبتكين في مقال تحليلي نشرته وكالة الأناضول التركية أن التطورات الدبلوماسية الأخيرة في سوريا، إلى جانب انحراف ميليشيا “قسد” عن اتفاق 10 آذار، تكشف أن مستقبل سوريا سيتحدد في دمشق لا في باريس، وأن محاولات فرض مشاريع سياسية خارجية في شمال شرق البلاد، وخاصة من قبل فرنسا وإسرائيل، تصطدم بواقع الميدان وتوازنات القوى.
حراك دبلوماسي مكثف وزيارة مفصلية إلى دمشق
شهدت سوريا الأسبوع الماضي نشاطاً دبلوماسياً واسعاً، حيث قام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في يوم الخميس 7 أغسطس بزيارة عمل إلى دمشق، التقى خلالها بالرئيس السوري أحمد الشرع. وتعد هذه الزيارة الثالثة لفيدان إلى سوريا منذ “ثورة 8 ديسمبر” التي أطاحت بنظام بشار الأسد قبل ثمانية أشهر.
أهمية هذه الزيارة تكمن في توقيتها، إذ جاءت قبيل حدثين مهمين:
- المؤتمر الذي كانت ميليشيا “قسد” – تحت مسمى “قوات سوريا الديمقراطية” – تعتزم عقده في الحسكة.
- لقاء كان مقرراً في باريس بين الحكومة السورية و ”قسد”.
هذا التوقيت جعل لقاء فيدان–الشرع يحظى باهتمام إعلامي واسع، ليس فقط في تركيا وسوريا، بل أيضاً في الصحافة الأوروبية. وتطورات ما بعد الزيارة أوضحت أن مسار تقرير مستقبل سوريا لن يُرسم في باريس، بل في دمشق.
مؤتمر الحسكة: خطاب تقسيمي وتجاهل للهجمات الإسرائيلية
بعد يوم واحد من زيارة فيدان، نظمت “قسد” في مدينة الحسكة مؤتمراً بعنوان “مؤتمر الموقف المشترك لمكوّنات شمال وشرق سوريا”، حضره قرابة 500 مشارك.
البيان الختامي للمؤتمر تبنى خطاب “مكوّنات سوريا” المبعثر، بدلاً من مفهوم الدولة السورية الموحدة، وأغفل تماماً الإشارة إلى الهجمات الإسرائيلية وأعمال العصابات في السويداء، رغم أن القضية كانت ضمن جدول أعمال المؤتمر. البيان أعلن الإصرار على “نموذج الإدارة الذاتية” كصيغة للحكم.
في كلمتها، اشترطت ممثلة “قسد” إلهام أحمد ما وصفته بـ “حقوق المكوّنات” كأساس لأي نظام سياسي جديد في سوريا. كما شارك عبر رسالة فيديو حكمت الهجري، المتهم بالتعاون مع إسرائيل لإثارة اضطرابات وأحداث مسلحة في السويداء.
اختيار المتحدثين ومضمون البيان أظهرا بوضوح أن “قسد” متمسكة بمشروع يهدف إلى تقسيم سوريا إلى كيانات عرقية وطائفية، على حساب نموذج الدولة المركزية الموحدة.
الانحراف عن اتفاق 10 آذار
هذا المؤتمر مثل انحرافاً واضحاً عن “اتفاق 10 آذار” الموقّع في مارس الماضي بين الحكومة السورية و ”قسد”، والذي رسم خارطة طريق لدمج “قسد” ضمن الدولة السورية.
الاتفاق نص على:
- دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، بما يشمل المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، في إدارة الدولة السورية.
- التأكيد على وحدة الأراضي السورية.
- عدم الإشارة مطلقاً إلى أي صيغة “إدارة ذاتية” أو وضع خاص.
تنصل “قسد” من هذه التعهدات خلال مؤتمر الحسكة أثار غضب دمشق، التي دعت الميليشيا إلى الالتزام بما وقعته في مارس، وأعلنت عدم مشاركتها في اجتماعات باريس.
رهان على فرنسا وإسرائيل في ظل تراجع الدعم الأميركي
تشير المعطيات إلى أن “قسد” تسعى، عبر التقارب مع جماعات تنفذ أجندات إسرائيلية داخل سوريا، إلى موازنة وضغط الحكومة السورية. ومع بروز مؤشرات على نية الولايات المتحدة تقليص دعمها، ترى “قسد” في فرنسا وبعض الدول الأوروبية بديلاً محتملاً لملء الفراغ.
لكن باريس، التي لا تملك أي حضور ميداني في سوريا، غير قادرة على لعب دور الولايات المتحدة. في المقابل، تعمل الحكومة السورية، باعتبارها السلطة الشرعية، على تعزيز قدراتها بدعم من دول إقليمية كتركيا، ما يزيد من صعوبة فرض أي مشروع تقسيمي من الخارج.
حدود النفوذ الفرنسي والإسرائيلي
فرنسا تحاول إيجاد موطئ قدم في مستقبل سوريا من خلال تحركات دبلوماسية عن بعد، لكنها واجهت رفضاً مباشراً من دمشق. أما إسرائيل، فكما ظهر في أحداث السويداء، فهي تستغل الفرص التي تصنعها بنفسها لزعزعة استقرار سوريا، لكنها عاجزة عن فرض مشروع سياسي في مناطق تخضع لسيطرة “قسد” على حدود تركيا، دون موافقة أنقرة.
الرسالة الواضحة: لا مشروع سياسي دون تركيا ودمشق
في ظل هذه الظروف، لن تتمكن إسرائيل من فرض تسوية سياسية دائمة، ولن تستطيع فرنسا إقصاء تركيا عن أي مفاوضات تتعلق بمستقبل سوريا. كما أن محاولات “قسد” لتقويض اتفاق 10 آذار بالبحث عن داعمين جدد ستصطدم برفض محور تركيا–سوريا.
خيارات “قسد” المقبلة
أمام “قسد” خياران لا ثالث لهما:
- الالتزام الكامل بتعهداتها في اتفاق 10 آذار والانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية.
- الاستمرار في سياسة الرفض والانفصال، وهو ما قد يفتح الباب أمام عملية عسكرية جديدة ضدها في المستقبل القريب.
بين الإنجازات والانتهاكات.. أداء جهاز الأمن السوري تحت المجهر
في تقرير تحليلي لباسل المحمد على “الجزيرة نت“، ذكر أنه مع دخول سوريا مرحلة سياسية جديدة بعد سقوط النظام المخلوع، برز جهاز الأمن العام، الذي أعيدت تسميته بعد إعادة هيكلة لقوى الأمن والشرطة ليصبح “الأمن الداخلي”، كواحد من أبرز المؤسسات التي أنيط بها حفظ الأمن والاستقرار في ظل تحديات داخلية وخارجية معقدة.
وقد شكل الزج بهذا الجهاز في المحافظات السورية المختلفة، بعدما كان يعمل في إدلب فقط في ظل حكومة الإنقاذ، خطوة ضرورية لتنظيم المشهد الأمني في مرحلة انتقالية شديدة الحساسية، وجاء في لحظة فراغ كان من شأنه أن يهدد بتفكك الدولة والمجتمع معا.
ومنذ اللحظة الأولى، وجد الجهاز نفسه أمام اختبارات صعبة، تتعلق بكيفية تحقيق الأمن من جهة، وبناء علاقة جديدة مع الشارع السوري من جهة أخرى، في ظل إرث ثقيل من انعدام الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية.
وتتعدد وجهات النظر حول أداء الأمن الداخلي بين مؤيدين يرون فيه صمام أمان ضروري، وناقدين يرون أن الانتهاكات ما زالت حاضرة رغم تبدل الوجوه.
في التقرير ، تم تسليط الضوء على أداء هذا الجهاز، كاشفا حدود قوته ونقاط ضعفه، ومجيبا عن سؤال: هل يمكن لهذا الجهاز أن يرسخ الأمن بعيدا عن الانتهاكات والتجاوزات؟ (الجزيرة نت)
عمامات مرجعيات دروز سوريا في ذات الخندق من جديد
في مشهد قلب التوازنات داخل المرجعيات الدينية الدرزية في سوريا، أصدر شيخ العقل حمود الحناوي، السبت 9 أغسطس/آب، بياناً مصوراً حمل هجوماً حاداً على الحكومة السورية، متراجعاً عن مواقفه السابقة التي اتسمت بالمهادنة وقبول التفاهمات مع السلطة. الحناوي، الذي ينحدر من قرية سهوة البلاطة جنوب السويداء، وصف الحكومة بـ”سلطة الغدر” التي “باعت الوطن” و”ارتضت أن تكون سيفاً مسلولاً على رقاب الأبرياء”، مطالباً برفع الحصار عن المحافظة وفتح ممرات إنسانية والتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق أبناء الجبل.
المفاجأة تضاعفت مساء اليوم نفسه، حين خرج الشيخ جربوع، المعروف بقربه من السلطة، ببيان متزامن تقريباً مع الحناوي، مهاجماً الحكومة، وواصفاً ما جرى في السويداء بأنه “تطهير طائفي ممنهج”، مطالباً بلجنة تحقيق دولية ووقف القتال والإفراج عن المخطوفين وفتح المعابر الإنسانية. بيانا الحناوي وجربوع شكّلا اصطفافاً غير مسبوق مع الهجري منذ سنوات، وأثارا تساؤلات حول تنسيق محتمل بين المرجعيات الثلاث (الهجري، الجربوع، الحناوي).
في موازاة هذا التصعيد الداخلي، دفعت الدنمارك بمسودة بيان إلى مجلس الأمن تندد بالعنف في السويداء وتدعو لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين. المسودة، التي مرت بمفاوضات مطوّلة واعتراضات، تضمنت أيضاً إشارات إلى الغارات الإسرائيلية على سوريا وضرورة احترام سيادتها، بالإضافة إلى تحذيرات أممية من عمليات إعدام ميدانية وقتل تعسفي وخطف ونهب، ونزوح نحو 191 ألف شخص، وتضرر الخدمات الأساسية. (إندبندنت عربية)
تعليق المعهد المصري:
بهذا المشهد، تقف السويداء أمام إعادة تشكيل غير مسبوقة لخارطة المواقف داخل بيت مشيخة العقل، وتوازنات سياسية وعسكرية قد تعيد صياغة مسار الجنوب السوري برمته.
بالنسبة لحكمت الهجري، فإن هذه التحولات تعني شرعية مضاعفة، ليس فقط كزعيم يسيطر على الشارع، بل كمرجعية باتت مواقفه تُقرأ بأثر رجعي كـ”رؤية صائبة” في نظر جمهوره. وهذا يضع دمشق أمام معضلة: مواجهة الهجري الآن هي مواجهة مع الطائفة ككل، لا مع فصيل منها.
ورغم أن الاصطفاف الثلاثي يبدو قوياً، إلا أن استدامته غير مضمونة. تاريخ الخلافات بين هذه المرجعيات، وتباين رؤاهم حول شكل الحل النهائي (من الحكم المحلي إلى الفيدرالية أو البقاء تحت سلطة دمشق)، قد يعيد الانقسام عند أول اختبار حقيقي، خصوصاً إذا دخلت العوامل الإقليمية على خط دعم طرف دون آخر. إلا أنه على الجانب الأخر، قد تدعم إسرائيل مثل هذا الاصطفاف بما يخدم تحقيق أهدافها في إبقاء الجنوب السوري دائماً في حالة من عدم الاستقرار.
أمريكا تساوم سوريا: تخفيف العقوبات مقابل ترسيم الحدود مع لبنان
كشفت مصادر سورية مطلعة عن مبادرة أمريكية بتخفيف إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا، في حال إتمام عملية ترسيم الحدود البرية والبحرية بين سوريا ولبنان.
ويأتي المقترح الأمريكي بهدف معالجة المشاكل الحدودية بين سوريا والمتواصلة منذ سنوات؛ ما أسهم في استمرار حالة الفوضى الأمنية في هذه المناطق التي أصبحت تشكل ممرات لتهريب الأسلحة والأفراد والمخدرات، وعطل بالتالي انتشار الجيش اللبناني وخلق مناطق ذات سيادة منقوصة.
وأوضحت المصادر أن المبادرة الأمريكية، تحظى بدعم فرنسي ومن الأمم المتحدة، وتستهدف ضبط الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية وكذلك تعزيز الاستقرار في المنطقة.
وتشمل المناطق الحدودية اللبنانية – السورية، التي تستهدفها المبادرة الأمريكية مواقع وبلدات إستراتيجية، مثل: شمال البقاع، وادي خالد، وسلسلة جبال لبنان الشرقية، والتي شهدت طيلة السنوات الماضية غياب اتفاق سوري لبناني على ترسيمها؛ ما سمح بإنشاء مسارات للتهريب عبرها.
وأشارت المصادر، إلى أن المبادرة تتضمن أيضاً إجراء مباحثات سورية لبنانية لضبط الأوضاع الأمنية في بلدات حدودية، مثل: الهوامل-القصير، عرسال-القلمون، والاتفاق على ترسيمها بالاعتماد على خرائط الانتداب الفرنسي (1933)، وسجلات عقارية تاريخية. ويرى الخبير السياسي نعمان أبو ردن، أن اقتراح تخفيف العقوبات المشروط يعكس إستراتيجية أمريكية لتشجيع الجانب السوري على ترسيم الحدود مع لبنان، رغم أن الشروط تتضمن قيام دمشق بتقديم تنازلات. (سكاي برس)
اتفاق أردني سوري أميركي لدعم وقف إطلاق النار في السويداء
أعلنت الخارجية السورية الاتفاق على تشكيل مجموعة سورية أردنية أميركية لدعم جهود الحكومة لوقف إطلاق النار بمحافظة السويداء جنوبي البلاد، في ختام اجتماع ثلاثي بالعاصمة الأردنية عمان.
وأضافت الخارجية السورية أن الاجتماع السوري الأردني الأميركي، الذي عقد الثلاثاء 12 أغسطس/آب بعمان، بحث تعزيز التعاون لخدمة استقرار سوريا وسيادتها وأمنها.
وقبيل الاجتماع عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اجتماعا مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية أردنية أميركية، لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار بمحافظة السويداء، والعمل على إيجاد حل شامل للأزمة.
كما تم الترحيب بجهود الحكومة السورية في المجال الإنساني، لا سيما ما يتعلق باستعادة الخدمات الأساسية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى منازلهم، وفق الوكالة السورية. (الجزيرة نت)
المليشيات الدرزية ترسم العلم الإسرائيلي على مسجد بعد استهدافه بالرشاشات الثقيلة
تداولت وسائل إعلام محلية مقاطع مصوّرة من مدينة السويداء في يوليو/تموز الماضي، كمشاهد تُظهر عناصر من مليشيات درزية مسلّحة يعتقد أنها تتبع لقوات حكمت الهجري، وهي ترسم العلم الإسرائيلي على جدار أحد مساجد المسلمين السنة في المدينة، وذلك عقب استهدافه بالرشاشات الثقيلة خلال التوترات الأمنية التي شهدتها المحافظة.
ويظهر في الفيديو، الذي وثّق الحادثة أثناء الأزمة، العلم الإسرائيلي مرسوماً بشكل واضح على جدار المسجد المتضرر، في خطوة أثارت موجة استنكار وغضب واسعَيْن بين الأهالي ونشطاء سوريين، الذين اعتبروها استفزازاً صارخاً وتعبيراً عن نهج عدائي يستهدف الهوية الدينية والوطنية للسكان. (شاهد الفيديو)
أمريكا
شهدت الساحة الأميركية خلال الأيام الأخيرة سلسلة تطورات سياسية واقتصادية لافتة، أبرزها توقيع اتفاق تاريخي في البيت الأبيض بين أرمينيا وأذربيجان برعاية الرئيس دونالد ترامب حول “ممر زنغزور”، الذي بات يعرف باسم “ممر ترامب للسلام والازدهار -تريب” ويخضع لإدارة واشنطن لمدة مئة عام، ما يمنح الولايات المتحدة نفوذاً مباشراً على حدود إيران ويقوّض الحضور الروسي في جنوب القوقاز.
وفي موازاة هذا التحرك الجيوسياسي، تتواصل معارك الجدل حول السياسات التجارية لترامب، إذ يرى محللون أن اتفاقاته مع الاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا تحمل مكاسب آنية لكنها محفوفة بتكاليف اقتصادية طويلة المدى وتحديات قانونية قد تضر بالشركات الأميركية.
وعلى الصعيد الداخلي، صعّد ترامب هجومه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مهدداً برفع دعوى قضائية على خلفية ما اعتبره إهداراً لثلاثة مليارات دولار في مشروع إنشاء مبانٍ جديدة للبنك المركزي.
سياسياً، هزّت أزمة جيفري إبستين ثقة الرأي العام بالمؤسسات الأميركية، بعد أن أظهرت استطلاعات تراجع شعبية ترامب بشكل حاد وارتفاع نسبة المشككين في الرواية الرسمية لوفاة إبستين، في ظل اتهامات بالتستر وغياب الشفافية. وزاد الجدل اشتعالاً مع نشر صورة حصرية لإبستين وهو يرتدي قميصاً يحمل شعار الجيش الإسرائيلي، ما أثار موجة تكهنات جديدة حول خلفياته وعلاقاته.
“ممر ترامب” في جنوب القوقاز: تحول جيوسياسي وتحديات جديدة لإيران وروسيا
في تحول جيوسياسي مفاجئ في منطقة جنوب القوقاز، وقع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان حيدر علييف في البيت الأبيض، يوم 8 أغسطس 2025، اتفاقاً تاريخياً بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن “ممر زنغزور”.
ويفضي الاتفاق إلى أن هذا الممر الحيوي، الذي يربط أذربيجان بأراضيها المنفصلة جغرافياً عن تركيا (إقليم ناخيتشيفان)، سيخضع لإدارة الولايات المتحدة لمدة 100 عام، ما يغير المعادلة الجيوسياسية في المنطقة، ويُعد تحولاً في علاقات القوى الكبرى في المنطقة.
الممر الذي كان يُعرف باسم “ممر زنغزور” أصبح الآن يحمل اسم “ممر ترامب للسلام والازدهار الدوليين TRIPP”، وهو ما يعكس الدور المتزايد للولايات المتحدة في النزاع التاريخي بين أرمينيا وأذربيجان. يَمنح هذا الممر الولايات المتحدة نفوذاً في المنطقة، مما يجعلها دولة جوار لإيران، ويضعها في مواجهة مباشرة مع طهران في شمالها الشرقي، وهو ما يعيد للأذهان “الجوار” الأمريكي لإيران أثناء الاحتلال الأميركي لأفغانستان.
إيران، التي لطالما اعتبرت القوقاز ساحة نفوذها الحيوي، ترى في هذا الممر تهديداً مباشراً لمصالحها الجيوسياسية. فالممر يمتد عبر الأراضي الأرمينية الجنوبية، ليصل إلى باكو عاصمة أذربيجان، مروراً بتركيا. هذا التواجد الأميركي بالقرب من حدودها الشمالية يضع طهران في موقف حساس، خاصة مع وجود علاقات متنامية بين أذربيجان وإسرائيل، ما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لإيران.
في المقابل، تُعتبر روسيا الخاسر الأكبر من هذا التحول، حيث فقدت آخر معاقلها من النفوذ المباشر في المنطقة بعد قرون من الهيمنة على القوقاز. روسيا كانت تقليدياً القوة المهيمنة على المنطقة، ولكن مع التحركات الأميركية الأخيرة، أصبح نفوذها في جنوب القوقاز مهدداً.
الوجود العسكري الأمريكي في القوقاز
يشير الباحثون إلى أن “ممر ترامب” يفتح الباب أمام تواجد عسكري أميركي محتمل في المنطقة، وهو ما يثير قلق إيران وروسيا على حد سواء. الولايات المتحدة، من خلال إشرافها على الممر، قد تكون قادرة على تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، بالتوازي مع التعاون مع حلف الناتو وتركيا، ما يعزز من حضورها في منطقة تمثل أهمية استراتيجية حاسمة لإيران وروسيا.
إيران، التي كانت تراقب التحركات الأميركية في المنطقة بحذر، تجد نفسها الآن في مواجهة تحدٍ كبير يتمثل في تزايد الوجود الأمريكي في جاراتها المباشرة. هذا الوضع قد يُضعف من موقفها التفاوضي في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، مثل الملف النووي والعلاقات مع القوى الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن السيطرة الأميركية على هذا الممر قد تؤدي إلى تقليص فرص إيران في الوصول إلى أسواق أوروبا وآسيا الوسطى، وتحد من قدرتها على استخدام طرق التجارة التي كانت تشكل جزءاً من استراتيجيتها الاقتصادية. (180بوست) (رؤية الإخبارية)
“انتصار ترامب في قضية التعريفات الجمركية ليس كما يبدو”: تحليل لآثار السياسات التجارية الأمريكية
في مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، يطرح إساور بارساد، أستاذ السياسة التجارية في كلية دايسون بجامعة كورنيل، تساؤلات حول النتائج الحقيقية للسياسات التجارية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعرضاً اتفاقياته التجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا وآخرين، والتي تبدو وكأنها انتصارات لصالح الولايات المتحدة.
اتفاقيات تهيمن عليها الولايات المتحدة
يفتتح بارساد مقالته بتأكيد أن ترامب يبدو أنه يحقق انتصارات في “الحروب التجارية”، حيث تتفق دول الشركاء التجاريين على إزالة رسومها الجمركية على بعض الواردات الأمريكية، وزيادة شراء الطاقة الأمريكية، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات الأمريكية. ولكن، بينما تبدو هذه الاتفاقات في صالح أمريكا، فإنها تشوبها العديد من التساؤلات حول فائدتها الحقيقية على المدى البعيد.
التكاليف الباهظة على المدى الطويل
برغم أن تلك الاتفاقيات قد تبدو ناجحة في ظاهرها، إلا أن الكاتب يعتقد أن هذا “الانتصار” سيكون مكلفاً للغاية بالنسبة للأسر والشركات الأمريكية. ففرض الرسوم الجمركية على عشرات الدول، مع تعزيز هذه السياسات الأحادية الجانب من قبل ترامب، قد يضر العلاقات التجارية الأمريكية على المدى الطويل، ويؤثر سلباً على مكانة الولايات المتحدة في العالم.
مفاجآت غير سارة بشأن الاستثمارات والتحديات القانونية
يوضح بارساد أن نقطة زيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة، والتي تعد جزءاً أساسياً من هذه الاتفاقيات، لا تزال غامضة. كما أن العديد من الدول لم توقع على هذه الاتفاقيات بعد. بالإضافة إلى ذلك، يواجه فرض الرسوم الجمركية تحديات قانونية، إذ تجاوز ترامب صلاحيات الكونغرس في تطبيق هذه السياسة.
الآثار السلبية على الشركات الأمريكية
المقال يعرض أيضاً تساؤلات حول تأثيرات السياسات التجارية لترامب على الشركات الأمريكية. ويشير إلى أن بعض الشركات الأمريكية، مثل شركات صناعة السيارات، قد تجد نفسها في وضع غير مواتٍ مقارنة بمنافسيها الأجانب بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة على المواد الخام مثل الصلب والألمنيوم والمحركات. لذلك، لا يرى الكاتب أن السياسات التجارية لترامب ستساهم بشكل إيجابي في خفض العجز التجاري الأمريكي أو في خلق فرص عمل كما يُروج له.
تحديات عدم اليقين والشكوك
يتساءل بارساد عن مدى استدامة الاتفاقيات التجارية التي جرى التفاوض عليها حتى الآن. ويشير إلى أن حالة عدم اليقين التي أثارها ترامب بشأن السياسات الأمريكية ستعيق الاستثمار التجاري، مما يقلل من إمكانية تحقيق النمو في الوظائف. في النهاية، تعتبر وعود الدول الأخرى بتشجيع شركاتها على الاستثمار في الولايات المتحدة “مجرد وعود جوفاء” وفقاً للكاتب، الذي يعتقد أن الشركات الأجنبية ستتردد في توسيع عملياتها في أمريكا بسبب تزايد هشاشة سيادة القانون في البلاد.
كل ما يلمع ليس ذهباً: نطاق واستدامة اتفاقات التجارة الجديدة لترامب
نشرت وكالة الأناضول التركية، تحليلا تناولت فيه التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ على العديد من المنتجات القادمة من دول مختلفة.
وكانت هذه الخطوة جزءاً من سلسلة من الاتفاقات التي تم توقيعها مع دول مثل الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، واليابان. هذه الاتفاقات تثير عدة تساؤلات: ما هي الأسباب وراء قبولها؟ ما هي المكاسب التي تسعى الأطراف لتحقيقها؟ وهل يمكن تنفيذ هذه الاتفاقات فعلاً؟ وهل ستمنع هذه الاتفاقات حدوث نزاعات تجارية في المستقبل؟
الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة:
مع اقتراب الولايات المتحدة من أزمة اقتصادية، تتزايد الضغوط السياسية داخلياً وخارجياً على إدارة ترامب. العديد من الدول مثل فيتنام والصين وإندونيسيا، التي تعتمد على تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، تسعى لتخفيف تأثير التعريفات الجمركية على صادراتها، حيث تحاول تقليل تأثير الرسوم على منتجاتها.
أهداف الاتفاقات التجارية:
تتجاوز هذه الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودول مختلفة مجرد القضايا المتعلقة بالتعريفات الجمركية، حيث تشمل جوانب اقتصادية أخرى. على سبيل المثال، تركز الاتفاقية مع الإمارات على قطاعات مثل الطيران والطاقة، بينما الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تشمل استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة. أما الاتفاقية مع اليابان فتتناول مجالات حيوية مثل الطاقة، الأدوية، والمعادن.
التحديات القانونية والاقتصادية:
على الرغم من الأرقام الكبيرة التي يتم الإعلان عنها، إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقات لا يخلو من تحديات. الاتفاقات قد تواجه مقاومة قانونية، سواء من دول الشركاء أو حتى داخل الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي زيادة التعريفات الجمركية إلى مشاكل طويلة المدى للشركات الأمريكية، مثل شركات صناعة السيارات، التي ستواجه رسوماً جمركية على المواد الخام التي تحتاجها.
المستقبل غير الواضح لهذه الاتفاقات:
من الصعب التنبؤ بما إذا كانت هذه الاتفاقات ستظل ثابتة في المستقبل، فالتاريخ يشير إلى أنه يمكن تعديل أو استبدال الاتفاقات التجارية بناءً على التحولات السياسية. المثال الأبرز هو استبدال اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) باتفاقية (USMCA). هذا يعكس الطبيعة المتغيرة للعلاقات التجارية في ظل تزايد التنافس الجيوسياسي.
الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة:
رغم المكاسب الاقتصادية المحتملة لهذه الاتفاقات، يهدف ترامب من خلالها إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة في مواجهة الصين وروسيا. الاتفاقات ليست فقط عن تحقيق مكاسب تجارية، ولكن أيضاً جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز النفوذ الأمريكي في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية. هذه الاستراتيجيات قد تضمن استمرار العلاقات الاقتصادية والأمنية مع حلفاء الولايات المتحدة، سواء عبر هذه الاتفاقات أو من خلال تعزيز نفوذها السياسي في مختلف المناطق.
في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى تحسين الاقتصاد الأمريكي من خلال فرض رسوم جمركية على الدول الأخرى وتوقيع اتفاقات تجارية، تبقى هذه الاتفاقات موضوعاً معقداً، حيث تواجه تحديات قانونية واقتصادية قد تؤثر على استدامتها. فيما تبقى الاستراتيجيات الجيوسياسية جزءاً مهماً من الأهداف التي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها من خلال هذه الاتفاقات، وسط تضارب المصالح الدولية والداخلية.
ترامب يهدد برفع دعوى كبرى ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي بسبب “هدر 3 مليارات دولار”
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع “دعوى قضائية كبرى” ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على خلفية ما وصفه بسوء إدارة مشروع إنشاء مبانٍ جديدة للبنك المركزي.
وفي منشور على منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب إنه “يفكر في السماح بالمضي قدماً في دعوى قضائية كبيرة ضد باول بسبب العمل الفظيع وغير الكفؤ على الإطلاق الذي قام به في إدارة مشروع مباني الاحتياطي الفيدرالي”، مضيفاً: “ثلاث مليارات دولار لمشروع كان يجب أن يكلف 50 مليون دولار فقط للتجديد… أمر غير مقبول!”
كما جدد ترامب مطالبه لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، عقب صدور أحدث بيانات التضخم.
ويأتي هذا التصعيد بعد مواجهة علنية بين ترامب وباول في يوليو/تموز الماضي، أثناء زيارة الرئيس لموقع مشروع البناء، حيث اعترض باول على وصف ترامب لتكاليف المشروع.
أزمة إبستين تهز شعبية ترامب وتفتح معركة الثقة بالمؤسسات الأميركية
شهدت الأوساط السياسية الأميركية جدلاً متصاعداً بعد تراجع حاد في شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط أزمة تتعلق بقضية جيفري إبستين وما يرافقها من اتهامات بغياب الشفافية المؤسسية.
بحسب تحليل خبير الاستطلاعات مارك ميتشل، كان ترامب يسير على منحنى تصاعدي في شعبيته خلال الأشهر الماضية، مدعوماً بإنجازات تشريعية واقتصادية، وارتفاع مؤشرات الثقة الاقتصادية، إضافة إلى مكاسب سياسية في ملفات إيران والحروب الخارجية. لكن أزمة إبستين، وما وُصف بـ”التراجع المفاجئ” عن وعود المحاسبة وكشف الحقائق، أدت إلى انعطاف سلبي حاد في استطلاعات الرأي، حيث انخفض صافي التأييد 12 نقطة خلال أسبوع واحد.
الاستطلاعات التي أجريت بعد إعلان وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي إغلاق ملف إبستين، أظهرت أن 47% من الأميركيين يعتقدون أنه قُتل، مقابل 31% فقط يقولون إنه انتحر. كما أن 56% لا يصدقون الرواية الرسمية بشأن عدم وجود “قائمة عملاء” مرتبطة بالقضية، مع تراجع ثقة المستقلين بترامب إلى صافي -19 نقطة، رغم أنه بدأ ولايته الرئاسية الحالية بزيادة 6 نقاط لديهم.
ويرى ميتشل أن القضية تحولت إلى رمز لانهيار الثقة بالمؤسسات وازدواجية العدالة، وهو ما يهدد قدرة الجمهوريين على الحفاظ على الأغلبية في انتخابات 2026 إذا لم تُتخذ خطوات جذرية لاستعادة الثقة، مثل إطلاق تحقيقات واضحة المعالم وتقديم شفافية أكبر للجمهور.
كما حذر من أن الديمقراطيين، الذين يتفوقون حالياً بهامش طفيف على الجمهوريين في استطلاعات الاقتراع العام، سيستغلون ملف إبستين كورقة سياسية رئيسية، وربما يفتحون لجان تحقيق إذا استعادوا السيطرة على الكونغرس، الأمر الذي قد يضع إدارة ترامب في موقف دفاعي طويل الأمد.
الخلاصة، أن أزمة إبستين لم تعد مجرد ملف جنائي قديم، بل تحولت إلى معركة سياسية حول المصداقية المؤسسية، وقد تكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار المشهد السياسي الأميركي خلال العامين المقبلين. (شاهد)
للوقوف على خلفية وافية عن جيفري ابستين وقضيته، شاهد هذا الفيديو الهام.
إبستين بقميص الجيش الإسرائيلي… صورة حصرية تثير الجدل
نشرت صحيفة The Telegraph البريطانية، الجمعة 8 أغسطس 2025، صورة حصرية التقطت في يناير 2019 للممول الأميركي الراحل جيفري إبستين على متن طائرته الخاصة، وهو يرتدي قميصاً يحمل شعار الجيش الإسرائيلي.
الصحيفة أشارت إلى أن هذه اللقطة قد تكون من آخر الصور المعروفة لإبستين قبل اعتقاله في يوليو من العام نفسه بتهم الاتجار الجنسي بالقاصرات. وتأتي الصورة وسط اتهامات متكررة – لم تثبت رسمياً – عن ارتباطه المحتمل بالاستخبارات الإسرائيلية، وهي مزاعم كان محاموه السابقون يسخرون منها علناً.
إبستين بدا في الصورة مبتسماً وهادئاً، في تناقض مع الرواية الرسمية لانتحاره بعد أسابيع، وهو ما يعزز الشكوك التي أثارها مقربون منه حول ظروف وفاته.
تركيا
حزب الشعب الجمهوري التركي يطرح حزمة إصلاح ديمقراطي من 29 مادة أمام لجنة المصالحة الوطنية
في خطوة وُصفت بأنها من أبرز مبادرات المعارضة في الآونة الأخيرة، قدّم حزب الشعب الجمهوري (CHP) إلى لجنة التضامن الوطني والأخوّة والديمقراطية في البرلمان حزمة ديمقراطية شاملة من 29 مادة، تهدف إلى معالجة أزمات الحريات، وسيادة القانون، والمشاركة السياسية، مع تركيز خاص على حلّ القضية الكردية في إطار إصلاح شامل للنظام السياسي والقضائي.
خلال مؤتمر صحفي في البرلمان، شارك فيه مراد أمير (نائب رئيس الكتلة البرلمانية) وغوكجه غوكجن (نائبة رئيس الحزب)، إلى جانب أعضاء بارزين بينهم توركان إلجي، أوكان كُونورالب، ونورحيات ألتاجا قايش أوغلو، استعرضت قيادة الحزب تفاصيل الحزمة، مؤكدة أن الهدف هو رفع المعايير الديمقراطية وبناء سلام مجتمعي مستدام، بعيداً عن المقاربات الضيقة التي تحصر الإصلاح في بعد واحد.
نظرة شاملة للحزمة
أكدت مقدمة الوثيقة أن حلّ مشكلات الديمقراطية والعدالة في تركيا يتطلب رؤية واسعة لا تتجاهل القضية الكردية، لكنها في الوقت نفسه لا تحصر الإصلاح بها فقط. وانتقدت الحزمة عدم تنفيذ الحكومة حتى لمعايير الدستور القائم، وتدخل السياسة في القضاء، معتبرة أن تنفيذ الإصلاحات المقترحة ليس مستحيلاً وإنما يحتاج إرادة سياسية حقيقية.
أبرز البنود والمطالب
- تأسيس لجنة برلمانية كاملة الصلاحيات تحت مسمى لجنة المصالحة المجتمعية والعدالة والتوافق الديمقراطي، تضم جميع الأحزاب – سواء كانت ممثلة بكتل برلمانية أو لا – إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، وخبراء، وجمعيات عائلات الشهداء والمحاربين القدامى.
- تنفيذ فوري لقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، خاصة في قضايا شخصيات مثل جان أطلاي، طيبون قهرمان، عثمان كافالا، صلاح الدين دميرطاش، وفيغن يوكسك داغ.
- ضمان حرية التعبير عبر وقف الخطابات الإقصائية وخطاب الكراهية، وإزالة القيود السياسية على الرأي.
- تبني سياسة ديمقراطية لحل القضية الكردية، تقوم على التراجع عن الإجراءات التي ضيقت المجال السياسي المشروع، وإنهاء النهج الأمني الأحادي.
- إلغاء نظام تعيين الأوصياء (الكايوم) وإعادة الاعتبار لشرعية صناديق الاقتراع.
- الإفراج الفوري عن رؤساء البلديات والسياسيين الموقوفين، ووقف ما وصفته الحزمة بـ”هندسة السياسة عبر القضاء” والمداهمات المخالفة للقانون.
- تحسين الحقوق الوظيفية والمالية لعناصر الأمن والقوات المسلحة والموظفين المدنيين العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية.
- إلغاء القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الرقابة، وإزالة العوائق المؤسسية أمام حرية الصحافة والتنظيم.
- تجريم خطاب الكراهية والعنف ضد النساء والأطفال، ومكافحة التعذيب والجرائم ضد الإنسانية بفاعلية.
- إرساء مبدأ حياد الدولة تجاه المعتقدات، وضمان المحاكمة العادلة، ومنع استخدام الشهود السريين كأداة انتهاك للحقوق.
رسالة سياسية واضحة
شدّد حزب الشعب الجمهوري على أن هذه الحزمة ليست مجرد قائمة مطالب تقنية، بل خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وإرساء نظام ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات، ويعزز المشاركة السياسية لجميع المكونات، بما فيها الأكراد، في إطار جمهورية قوية تحترم القانون والدستور.
وإليكم النص الكامل للمواد الـ29 كما ورد:
- إنشاء “لجنة المصالحة المجتمعية والعدالة والتوافق الديمقراطي” كاملة الصلاحيات في البرلمان.
- لا يمكن إعداد دستور في ظل حكومة علّقت الدستور.
- تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
- حرية التعبير لبناء السلام المجتمعي.
- سياسة ديمقراطية لحل القضية الكردية.
- إنهاء الكايوم وترسيخ حكم محلي قوي.
- إنهاء هندسة السياسة عبر القضاء، والإفراج الفوري عن كل السياسيين والبيروقراطيين الموقوفين ظلماً ضمن ما يُعرف بـمحاولة انقلاب 19 مارس.
- الإفراج عن المحتجزين على خلفية قضايا قمع المعارضة المجتمعية وفي مقدمتها قضية غيزي.
- ترسيخ مبدأ اليقين القانوني في قانون مكافحة الإرهاب.
- تحسين الحقوق الوظيفية لعناصر الأمن والموظفين المدنيين في الأجهزة الأمنية.
- معالجة إشكالية جريمة إهانة رئيس الجمهورية والموظف العام.
- إعادة تنظيم جريمة التحريض على الكراهية والعداء.
- تجريم خطاب الكراهية وجرائم الكراهية.
- جعل مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا مستقلة.
- مكافحة جرائم ضد الإنسانية والتعذيب بفاعلية.
- سحب مشاريع القوانين «المستوردة من أنظمة سلطوية» نهائياً من الأجندة.
- مكافحة فعّالة للعنف ضد النساء والأطفال.
- معالجة حجب الوصول باعتباره عائقاً أمام حق الجمهور في المعرفة.
- إلغاء قانون الرقابة.
- إزالة العوائق المؤسسية والقانونية أمام حرية الصحافة.
- إزالة كل العوائق القانونية والعملية أمام حرية التنظيم.
- تشريعات تنفيذ أحكام عادلة وشاملة وتصون كرامة الإنسان.
- إنهاء انتهاك الحق في محاكمة عادلة عبر نظام الشاهد السري.
- وضع حدّ فوري لتحوّل نظام التوبة الفعّالة إلى أداة افتراء.
- التراجع عن القيود المفروضة على حقّ الدفاع.
- منع القرارات التعسفية للجان إدارة ومراقبة السجون.
- إعادة تقييم أوضاع المفصولين بمراسيم (KHK) ضمن إطار قانوني.
- إرساء نظام تكون فيه الدولة محايدة تجاه المعتقدات.
- إنهاء اغتصاب الصلاحيات من جانب مكاتب النيابة العامة في التحقيقات السياسية.
استقالة رئيسة بلدية أيدن التركية من حزب الشعب الجمهوري وانضمامها للعدالة والتنمية
شهدت الاحتفالات بالذكرى الـ 24 لتأسيس حزب العدالة والتنمية (AKP)، في 14 أغسطس، انضمام أوزليم تشيرتشي أوغلو، رئيسة بلدية أيدين الكبرى، إلى صفوف الحزب الحاكم، بعد أكثر من عقدين قضتهما في حزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض.
خلال الحفل، وضع الرئيس التركي ورئيس الحزب رجب طيب أردوغان شارة الحزب على كتف تشيرتشي أوغلو، وسط تصفيق حار من الحضور، في خطوة وُصفت بأنها من أبرز الانتقالات السياسية هذا العام.
تشيرتشي أوغلو، المعروفة بلقب “توبوقلو إفه”، كانت تشغل منصب رئيسة بلدية أيدين منذ عام 2009، وفازت بالمنصب لأربع دورات متتالية، واشتهرت بمشاريعها التنموية ومواقفها الحادة تجاه الحكومة قبل انتقالها المفاجئ.
قرار انضمامها أثار ردود فعل قوية داخل حزب الشعب الجمهوري، حيث هاجمها رئيس الحزب أوزغور أوزال واعتبرها قد “تخلت عن المروءة السياسية”، وربط انتقالها بملفات تحقيقات وضغوط سياسية. في المقابل، لم تصدر تشيرتشي أوغلو حتى الآن أي تعليق رسمي حول أسباب قرارها.
هذا الانتقال يُنظر إليه على أنه مكسب سياسي مهم لحزب العدالة والتنمية في منطقة أيدين، ذات الثقل الانتخابي، وخطوة تعزز مساعي الحزب لاستقطاب شخصيات بارزة من المعارضة قبيل الاستحقاقات المقبلة. ((BBC
أردوغان: وحدة الجهود لمواجهة الكوارث ومكافحة الفساد وترسيخ السلام الداخلي
في كلمة شاملة عقب اجتماع الحكومة، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة التعامل مع ملف التحول العمراني كـ “قضية تعبئة وطنية”، داعياً الحكومة والمعارضة والإدارات المحلية وسكان المدن إلى تجاوز الخلافات الأيديولوجية ووضع الأيدي معاً لتجديد البنية التحتية لمواجهة أخطار الزلازل. وجاء حديثه بعد زلزال بقوة 6.1 ضرب ولاية باليكسير، مؤكداً تعبئة مؤسسات الدولة لدعم المتضررين.
أردوغان أشاد بتشكيل “لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية” بمشاركة المعارضة كخطوة لتعزيز مسار “تركيا بلا إرهاب”، مبيّناً أن القرارات الأولى بالإجماع تعكس أجواء إيجابية يجب الحفاظ عليها. وأكد أن تركيا دولة لكل مواطنيها بمختلف أعراقهم ومذاهبهم، وأن الخلافات السياسية لا ينبغي أن تتجاوز المصلحة الوطنية.
في الشأن الخارجي، استعرض أردوغان سلسلة لقاءات واتفاقيات مع قادة من كازاخستان وأفريقيا وإيطاليا وليبيا، ومباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن التصدي لخطط إسرائيل في غزة، مجدداً موقف أنقرة الرافض لـ”الاحتلال والجرائم” ودعمها الكامل للفلسطينيين. كما رحب بالتفاهمات بين أذربيجان وأرمينيا، معتبراً إياها فرصة لسلام دائم في القوقاز.
اقتصادياً، أشار إلى تحسن المؤشرات: تراجع التضخم 14 شهراً متتالياً، وارتفاع إيرادات السياحة إلى أرقام قياسية، وزيادة احتياطيات البنك المركزي إلى 169 مليار دولار، بجانب دعم موسع للمشروعات الصغيرة. وأكد أن “تركيا لن تسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بعرقلة صعودها في القرن الجديد”.
وفي ملف مكافحة الفساد، هاجم أردوغان ما وصفه بـ “محاولات المعارضة تسييس قضايا الرشوة”، مشدداً على أن الدولة هي من كشفت وأحالت المتورطين إلى العدالة، وأن “لا أحد فوق القانون”. وانتقد الحملات التي تستهدف المدارس الدينية والشباب، داعياً إلى “التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن استغلال القضايا لتصفية الحسابات”.
كما حذر من تنامي ظاهرة المقامرة والرهان عبر الإنترنت، واصفاً إياها بـ”الآفة المدمرة للأسر والنسيج المجتمعي”، معلناً عن إعداد خطة عمل وطنية بالتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهتها على المستويات الأمنية والصحية والاجتماعية.
وختم بالقول: “تركيا وطن الجميع، وسنواصل مسيرة البناء داخلياً وخارجياً، متسلحين بدعاء وثقة شعبنا” (الأناضول)
النهار: الهجرة محور قمة إسطنبول الثلاثية… ساحل ليبيا في عهدة تركيا؟
استضافت مدينة إسطنبول قمة ثلاثية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، ما أثار تساؤلات حيال دلالات توقيتها.
وتصدّر ملف مكافحة الهجرة غير النظامية جدول أعمال القمة، بعدما أعلن الدبيبة قبيل انعقادها حملة أمنية جديدة لملاحقة المهاجرين وأوكار عصابات تهريب البشر في الغرب الليبي.
وعلمت “النهار” أن اتفاقاً يجري بلورته يقضي بأن تضطلع أنقرة بالدور الرئيس في حراسة السواحل الليبية ومنع انطلاق مراكب المهاجرين نحو شواطئ جنوب أوروبا.
وبحسب مصادر ديبلوماسية للصحيفة اللبنانية، جاء الاتفاق بمبادرة تركية قبلتها عواصم أوروبية، في مقدمها روما، مستندة إلى الحضور العسكري لأنقرة في الغرب الليبي وتحالفها مع قادة في الشرق. وينص الاتفاق على تسيير دوريات بحرية تركية على السواحل الليبية، والمشاركة في إعادة تأهيل القوات البحرية الليبية وتدريبها، في مقابل حصول أنقرة على حصة وازنة من حقول النفط والغاز الليبية على البحر المتوسط. (صحيفة النهار)
إيران
أثار توقيع اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعاً في إيران، حيث رحّبت طهران به شكلياً لكنها أبدت قلقاً جيوسياسياً من “ممر ترامب” الذي يربط أذربيجان بنخجوان عبر الأراضي الأرمينية، باعتباره تهديداً لنفوذها وممراً محتملاً لتواجد أميركي وإسرائيلي قرب حدودها. وتباينت المواقف الإيرانية بين تصريحات متشددة لمستشار المرشد علي أكبر ولايتي، ودعوات رئاسية لاحتواء المخاطر عبر التنسيق مع أطراف الاتفاق.
وفي موازاة ذلك، حذرت مجلة “فورين بوليسي” من مواجهة عسكرية وشيكة بين إسرائيل وإيران قبل نهاية أغسطس الجاري، وسط تحضيرات متبادلة واستراتيجية إسرائيلية للضربات الوقائية، مقابل تأكيد طهران استعدادها لرد فوري وحاسم.
وعلى الصعيد الداخلي، عيّن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان علي لاريجاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، في خطوة تعكس انتقال إيران إلى مقاربة أمنية شاملة تضم الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي لبنان، برز الخلاف حول قرار حصر السلاح بيد الدولة، إذ رفضت إيران المساس بسلاح حزب الله في ظل تقديرات بأنه ورقة تفاوضية بيد طهران في مفاوضاتها النووية مع واشنطن. هذا المشهد المعقد يضع إيران أمام تحديات متشابكة بين الجبهات الدبلوماسية والأمنية والعسكرية، في وقت تتقاطع فيه ملفات القوقاز والشرق الأوسط على خط صراع مفتوح.
إيران تعلق على اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا: قلق جيو-استراتيجي وتحفظات على ممر “ترامب”
في تعليقها على اتفاق السلام التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا الذي وقع في البيت الأبيض في 8 أغسطس 2025، أبدت إيران ترحيباً ظاهرياً بالسلام ولكن مع تحفظات جيو-استراتيجية بارزة على التغييرات التي قد تطرأ على التوازنات الإقليمية في القوقاز. الاتفاق الذي رعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتضمن تأسيس “ممر ترامب” الذي يمر عبر الأراضي الأرمينية، ويُعتبر تحدياً جيوسياسياً لإيران.
في بيان رسمي، رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بالمبادرة كخطوة نحو السلام المستدام، لكنها أعربت في الوقت ذاته عن “قلقها من التداعيات السلبية لأي تدخل خارجي بالقرب من حدودها”، معتبرة أن ممر “ترامب” الذي يربط تركيا بأذربيجان عبر أراضي أرمينيا قد يهدد استقرار المنطقة ويقوض الاتصال البري المباشر بين طهران وأوروبا.
إيران ترى في الاتفاق تهديداً مباشراً لأمنها القومي، حيث يخشى المسؤولون الإيرانيون من أن هذا المشروع قد يؤدي إلى تعزيز التواجد الأميركي في المنطقة، ويضع طهران في مواجهة جيوسياسية مع قوة عظمى على حدودها الشمالية الشرقية لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. كما حذر المحللون الإيرانيون من أن ممر ترامب قد يشكل فرصة لدخول أطراف من حلف الناتو إلى المنطقة بالقرب من الحدود الإيرانية.
وفي وقت سابق قال مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، لوكالة تسنيم الإيرانية: جنوب القوقاز ليس أرضاً بلا صاحب ليستأجرها ترامب، بل سيصبح مقبرة لمرتزقته، وادعاء استئجار الممر من قبل ترامب ساذج ومستحيل كاستئجار قناة بنما.
وأضاف، الممر الأميركي يغيّر الجغرافيا ويستهدف تقسيم أرمينيا والشعب الأرميني يرفض تقسيم أرضه مهما كانت مواقف حكومته متقلبة.
اقتراح حسين شريعتمداري بشأن قضية “زنغزور”: إغلاق مضيق هرمز
تناولت صحيفة “كيهان” الإيرانية في مقال لها حول الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا بشأن إنشاء “ممر زنغزور” وما تبعه من تداعيات على إيران. حيث اقترح حسين شريعتمداري أن تستخدم إيران “أدواتها المتاحة” لمواجهة هذا التطور، بما في ذلك فرض عقوبات على مرور السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل عبر مضيق هرمز.
وفقاً للمقال، قال شريعتمداري إن الرئيسين الأرميني والأذربيجاني سافرا إلى الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية مع الرئيس الأمريكي ترامب حول “ممر زنغزور الاستراتيجي” الذي ستقوم شركة عسكرية أمريكية بإدارته لمدة 99 عاماً. وأضاف أن هذا الاتفاق يعد “خيانة كبيرة” من قبل أرمينيا وأذربيجان، حيث سيسمح بإنشاء قاعدة عسكرية واستخباراتية أمريكية وإسرائيلية بالقرب من الحدود الإيرانية.
وفي إطار الرد الإيراني المحتمل، اقترح شريعتمداري أن تقوم إيران باستخدام “أدواتها المتاحة” ضد هذا الاتفاق، ومن بينها فرض حظر على عبور السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل عبر مضيق هرمز. وقال إن إيران يمكنها استخدام اتفاقيات دولية مثل “اتفاقيات جنيف” و”اتفاقيات جامايكا” كإطار قانوني لفرض هذا الحظر.
كما أشار المقال إلى أن بعض المسؤولين الإيرانيين قد لا يكونون قد أدركوا بالكامل تداعيات هذا الاتفاق، مستخدماً مثلاً يعكس التردد في فهم ما يحدث وقال: “إذا كنت تشعر بالبرد، ماذا تفعل؟ تقترب من المدفأة. وإذا شعرت بالبرد مرة أخرى، تقترب أكثر. ولكن إذا شعرت بالبرد مرة أخرى، فستشعل المدفأة”.
بزشكيان: تمت مراعاة مطالبنا في اتفاق أرمينيا وأذربيجان
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه تمت مراعاة جميع مطالب إيران بشأن ممر زنغزور بما في ذلك وحدة الأراضي وعدم إغلاق الطريق نحو أوروبا.
وأكد بزشكيان، في تصريحات نقلتها وكالة مهر للأنباء، أن موضوع ممر زنغزور “ليس كما تم تضخيمه في الأخبار، فجميع الأطراف راعت مطالب إيران بشأنه، وقلقنا الوحيد هو أن شركة أميركية تريد إنشاء هذا الممر”.
وبدوره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ بلاده ترحب بأي سلام بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدا أن البيان المشترك لباكو ويريفان يتضمن احترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها ورفض أي تغيير في الحدود، وهو ما يتماشى مع الموقف الإيراني.
وأضاف عراقجي، في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإيرانية، أن طهران لديها مخاوفها الخاصة وتراقب التطورات عن كثب.
وأكد أن طهران ترفض تغيير الحدود الدولية ولها مخاوف خاصة، ويمكن أن تكون للوجود الأجنبي آثار سلبية على استقرار المنطقة. (الجزيرة نت)
ما سبب التناقض الإيراني حيال ممر ترامب؟ خبراء يجيبون
تشهد إيران جدلاً واسعاً حول الموقف من “ممر ترامب” أو ممر زنغزور في جنوبي القوقاز، وسط تصريحات متناقضة بين قيادتها السياسية.
مستشار المرشد للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أكد أن طهران ستمنع إقامة الممر، سواء بالتعاون مع روسيا أو دونها، معتبراً أنه تهديد لأمن المنطقة ويغيّر خريطتها الجيوسياسية.
في المقابل، قال الرئيس مسعود بزشكيان إن جميع مطالب إيران تمت مراعاتها في الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا، بما في ذلك وحدة الأراضي وعدم إغلاق الطريق نحو أوروبا.
الممر، الذي ترعاه واشنطن، يربط أذربيجان بمقاطعة نخجوان عبر الأراضي الأرمينية، ويثير مخاوف من تهميش دور إيران وتقليص نفوذها في شبكات المواصلات الإقليمية.
خبراء إيرانيون يرون أن الاتفاق همّش المطالب الإيرانية، وأن الحضور الأميركي قرب الحدود يمثل تحدياً استعمارياً طويل الأمد.
صحيفة “جمهوري إسلامي” ربطت توقيع الاتفاق بين باكو ويريفان بوساطة ترامب مع أحداث متزامنة في غزة ولبنان، واعتبرتها جميعاً تصب في مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.
حشمت الله فلاحت بيشه، الرئيس الأسبق للجنة الأمن القومي في البرلمان، حذر من أن قطع الحدود بين إيران وأرمينيا ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وقد يستفز رداً قوياً من طهران.
الباحث حميد آصفي وصف الموقف الحكومي الإيراني بأنه محاولة لتفادي التصعيد مع واشنطن، خاصة في ظل تقديرات رسمية باندلاع حرب وشيكة مع إسرائيل.
كما اعتبر أن واشنطن تسعى من خلال الممر إلى تهميش إيران من شبكة الممرات الدولية، في وقت فشلت فيه طهران في استثمار موقعها لربط أسواق أوروبا والقوقاز وشرق آسيا.
الباحث صلاح الدين خديو أرجع التناقض إلى تباين بين الموقف الثابت الرافض لأي حضور غربي على الحدود، والمقاربة الدبلوماسية التنسيقية مع أرمينيا.
ويرى محللون أن أوراق إيران لوقف المشروع محدودة، ما يدفعها للبحث عن دور اقتصادي في تنفيذه بدل المواجهة المباشرة.
كما يُستبعد أن تلجأ طهران لعمل عسكري لمنع إنشاء الممر، مع ترجيح استمرار التنسيق الأمني والسياسي مع يريفان.
الجانب الأرميني، بحسب خديو، يستخدم إشراك الولايات المتحدة اقتصادياً لاحتواء الطموحات التركية الداعية لسيطرة كاملة لأذربيجان على الممر.
هذا المشهد يعكس معادلة معقدة في القوقاز، حيث تتداخل الحسابات الإقليمية مع الصراعات الدولية.
وفي ظل ذلك، يبقى مستقبل “ممر ترامب” مرهوناً بقدرة إيران على التوفيق بين رفضها السياسي ومحاولاتها للاستفادة من المشروع اقتصادياً. (الجزيرة نت)
“فورين بوليسي”: مواجهة وشيكة بين إسرائيل وإيران قد تكون الأعنف
حذّر نائب الرئيس التنفيذي لمعهد “كوينسي“، تريتا بارسي، في مقال بمجلة فورين بوليسي، من أن إسرائيل تستعد لشن حرب جديدة على إيران قبل نهاية عام 2025، وربما في وقت أقرب، مع ترجيحات لاندلاعها في أواخر أغسطس الجاري. ويؤكد أن طهران بدورها تتوقع هذه المواجهة وتتهيأ لرد فوري وحاسم، على عكس حرب يونيو الماضي التي تعاملت معها إيران كصراع طويل الأمد.
استعدادات وتصعيد متبادل
تشير الحسابات العسكرية إلى أن الحرب المقبلة، إذا وقعت، ستكون أكثر دموية من سابقتها، إذ تسعى إسرائيل لتنفيذ استراتيجية “القصاص المسبق” أو “جزّ العشب” عبر ضربات وقائية متكررة لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الصاروخية والدفاعية. في المقابل، تؤكد طهران أنها سترد فوراً وبقوة على أي هجوم، بهدف جعل تكلفة الحرب على إسرائيل باهظة.
حرب يونيو: أهداف جزئية وإنجازات محدودة
يرى بارسي أن هجوم إسرائيل في يونيو لم يكن فقط لاستهداف البرنامج النووي الإيراني، بل كان جزءاً من مشروع أوسع لتغيير موازين القوى في الشرق الأوسط. حدّدت تل أبيب ثلاثة أهداف رئيسية:
- جرّ الولايات المتحدة إلى مواجهة مباشرة مع إيران.
- إضعاف النظام الإيراني وقطع رأس قيادته.
- تحويل إيران إلى ساحة شبيهة بسوريا أو لبنان يمكن قصفها دون تبعات كبرى.
ورغم نجاح إسرائيل في استدراج واشنطن للمشاركة، فإن تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان محدوداً، ما أدى إلى وقف إطلاق النار قبل تحقيق كامل أهداف تل أبيب.
إخفاقات إسرائيل وتماسك إيران
فشلت إسرائيل في شل القيادة الإيرانية، إذ تمكّنت طهران من تعويض خسائرها القيادية خلال أقل من 18 ساعة، وشنّت هجمات صاروخية كثيفة أثبتت قدرتها على الرد السريع. كما لم تنجح تل أبيب في إثارة انقسامات داخلية أو احتجاجات شعبية ضد النظام؛ بل على العكس، وحّدت الهجمات المجتمع الإيراني حول خطاب قومي داعم للدولة.
انعكاسات الحرب على الداخل الإيراني
الهجمات الإسرائيلية، بحسب المقال، عززت تماسك النظام داخلياً وضيّقت الفجوة بين الدولة والمجتمع، في مفارقة مع أهداف تل أبيب. كما كشفت الحرب محدودية قدرة إسرائيل على فرض هيمنة جوية مستقلة عن الدعم الأميركي، إذ اعتمدت بشكل كبير على أنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية، ما كان حاسماً في استمرارها 12 يوماً.
المشهد القادم
يؤكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير أن حرب يونيو كانت “المرحلة الأولى” فقط، وأن فصلاً جديداً من الصراع قد بدأ. بالنسبة لواشنطن، أي تدخل جديد سيضعها أمام خيارين لا ثالث لهما: الانخراط الكامل في الحرب أو البقاء خارجها تماماً، وهو ما يتطلب مقاومة ضغوط إسرائيلية مستمرة، أمر لم يبدِ ترامب استعداداً كافياً له حتى الآن.
في النهاية، يرى بارسي أن نتيجة أي حرب مقبلة ستعتمد على الطرف الذي سيتعلم من تجربة الحرب الأولى ويتحرك أسرع، وسط أسئلة مفتوحة حول قدرة إسرائيل على سد ثغرات دفاعها الجوي، وإمكانية إيران في تحسين أساليب اختراقها لهذه الدفاعات.
علي لاريجاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي: تحولات في سياسة إيران بعد الحرب مع إسرائيل
في خطوة سياسية بارزة، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تعيين علي لاريجاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفاً لعلي أكبر أحمديان.
يُعتبر علي لاريجاني من أبرز الشخصيات السياسية الإيرانية بفضل قدرته الفائقة على التوفيق بين الاتجاهات المختلفة في الساحة السياسية الإيرانية. يوصف بكونه “إصلاحياً محافظاً وأصولياً معتدلاً” في آن واحد، كما أن علاقاته الواسعة عبر مختلف التيارات تمنحه موقعاً مهماً في إدارة الملفات الداخلية والإقليمية.
تزامن تعيين لاريجاني مع إعلان تأسيس “مجلس الدفاع الوطني” في إيران، وهو هيئة جديدة تهدف إلى دراسة الخطط الدفاعية وتعزيز القدرات العسكرية، ما يعكس رغبة الحكومة الإيرانية في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية في ظل بيئة إقليمية غير مستقرة.
يعتبر المراقبون أن لاريجاني سيكون “رجل المرحلة” في إيران، وأن عودته إلى واجهة القرار السياسي والأمني ستسهم في تقديم إيران على المسار الصحيح نحو التفاعل الإقليمي والدولي.
الباحث السياسي مهدي شكيبائي يرى في تصريح للجزيرة نت أن تعيين لاريجاني يشير إلى دلالتين رئيسيتين: الأولى هي أن الأمن القومي الإيراني لم يعد حكراً على الجوانب العسكرية فقط، بل أصبح يشمل الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهو تحول لافت في كيفية تناول الدولة لهذا الملف. أما الدلالة الثانية فهي الانتقال من النهج العسكري التقليدي إلى مقاربة شاملة، ما يعزز فرص الدبلوماسية والتفاوض في المستقبل، سواء على المستوى النووي أو الإقليمي.
ويعتقد شكيبائي أن هذه الخطوة قد تكون إشارة من طهران إلى الولايات المتحدة بشأن إمكانية فتح حوار ضمن شروط محددة، بينما تراه أوروبا فرصة لإعادة بناء العلاقات مع إيران. كما أن روسيا والصين قد تستقبلان هذه الخطوة كرسالة استقرار، خاصة في ظل العلاقة الوثيقة بين لاريجاني وقيادات دبلوماسية إيرانية في هاتين الدولتين.
بكل هذه المعطيات، يظهر أن إيران تتجه نحو مرحلة جديدة من التفاعل الداخلي والخارجي، مع توجه أكبر نحو تعزيز الأمن المجتمعي وتوسيع نطاق الحوار السياسي والدبلوماسي. في ظل هذه التحولات، يبقى أن نرى كيف ستترجم الحكومة الإيرانية هذه التغييرات إلى خطوات عملية على الأرض.
هل تستخدم إيران سلاح حزب الله كورقة تفاوض في ملفها النووي؟
في وقت حساس من تاريخ لبنان، حيث تسعى الحكومة اللبنانية لاستعادة سيادتها الكاملة على أراضيها وإنهاء حالة الفوضى الناتجة عن انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، تبرز إيران مرة أخرى كلاعب مؤثر يعقد المشهد السياسي والأمني في البلاد. فبينما اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً تاريخياً بحصر السلاح بيد الدولة، عبّر مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، علي أكبر ولايتي، عن رفض بلاده لهذا القرار، مؤكّداً استمرار دعم إيران لحزب الله.
تأتي هذه التصريحات الإيرانية في وقت حساس، وسط تساؤلات حول دوافع طهران وراء تمسكها بسلاح حزب الله، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى أن إيران قد تستخدم هذا الملف كورقة ضغط في مفاوضاتها مع واشنطن بشأن برنامجها النووي. ويقول عماد أبشناس، رئيس تحرير صحيفة “إيران ديبلوماتيك”، إن قرار نزع سلاح حزب الله ليس قراراً لبنانياً مستقلاً، بل هو في الواقع قرار مفروض من الولايات المتحدة على الحكومة اللبنانية عبر ضغوط سياسية، ما يضع إيران في موقف معارض لهذا القرار.
من جانب آخر، يرى أبشناس أن ملف نزع سلاح حزب الله جزء من مخططات أميركية وإسرائيلية أوسع لإعادة تقسيم المنطقة، وتقويض دور الدول الكبرى مثل لبنان وسوريا، لضمان “إسرائيل الكبرى”. وتشمل هذه المخططات محاولات لتفتيت الدول إلى دويلات صغيرة، وهو ما يعكس المخاوف الإيرانية من تأثير هذه التغيرات على مصالحها الإقليمية.
المفاوضات النووية وإيران: ضغوط جديدة
يربط العديد من المحللين بين تمسك إيران بسلاح حزب الله والتطورات في المفاوضات النووية، حيث يرى البعض أن إيران قد تضع شروطاً جديدة في المفاوضات مع الولايات المتحدة، مما يعكس تحولاً في موقفها. ووفقاً لأبشناس، فإن إيران الآن هي التي تفرض شروطها، مما يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق نووي مع واشنطن. (سكاي نيوز عربية)
متابعات عربية
تهديد إقليمي وعالمي: قرار إسرائيل بغزو غزة – تحليل للنتائج والتداعيات
في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الدولية تطورات حاسمة، جاء قرار الحكومة الإسرائيلية بغزو غزة ليشكل تهديداً ليس فقط لأمن المنطقة، بل أيضاً للميزان الجيوسياسي العالمي. في هذا السياق، طرح الأستاذ الدكتور زكريا قرشون، أستاذ السياسة في جامعة الفاتح سلطان محمد، تحليلاً يسلط الضوء على نتائج هذا القرار والتداعيات التي ستترتب عليه.
في 11 أغسطس 2025، قررت الحكومة الإسرائيلية غزو غزة بعد 22 شهراً من التصعيد العسكري، ما يعكس استمراراً للسياسات الإسرائيلية التوسعية. هذا القرار يمثل المرحلة الثالثة في سلسلة الاحتلالات الإسرائيلية، بعد نكبة 1948 وحرب 1967. يهدف الاحتلال الجديد إلى السيطرة التامة على غزة، وهو ما يهدد استقرار المنطقة ويزيد من تعقيد العلاقات الدولية لإسرائيل.
إسرائيل قد تواصل توسعها لتشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يضعها في مواجهة مع المجتمع الدولي، رغم الدعم الأمريكي المعلن. من جهة أخرى، الدول العربية والإسلامية تُظهر تردداً في اتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل، في حين أكدت تركيا على موقفها الثابت ضد هذه الانتهاكات، داعية إلى تحركات دبلوماسية فعّالة.
القرار الإسرائيلي يعكس تحدياً كبيراً للأمن الإقليمي، ويتطلب استجابة حازمة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لضمان حقوق الفلسطينيين.
نص المقترح الأمريكي لنزع سلاح حزب الله اللبناني
تنشر “المجلة” النص الحرفي لورقة توم باراك مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لبنان، التي تتعلق بإنهاء الوجود المسلح بما فيه “حزب الله” في جميع الأراضي اللبنانية ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية وترسيم الحدود مع سوريا وجاء فيه:
في نوفمبر 2024، تم طرح مقترح تمديد وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي أُبرم بهدف تعزيز الاستقرار في المنطقة وتحقيق حل دائم وشامل للنزاع. يُركز المقترح على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والذي يهدف إلى إنهاء التصعيد بين الطرفين وضمان التزامهما بوقف الأعمال العدائية.
يتضمن المقترح عدة خطوات رئيسية تهدف إلى تثبيت الهدوء القائم وحماية السيادة اللبنانية. من أهم الأهداف:
- تنفيذ اتفاق الطائف والدستور اللبناني: يتمثل هذا الهدف في ضمان التزام لبنان بالسيادة الكاملة على أراضيه وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع التأكيد على حصرية سلطة الدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، واحتكارها للسلاح.
- تعزيز قدرة الجيش اللبناني: يتضمن المقترح توفير الدعم الدولي للأجهزة الأمنية اللبنانية، خاصة الجيش اللبناني، من خلال تزويده بالوسائل العسكرية اللازمة لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، بما يشمل مراقبة الحدود وتنفيذ العمليات الأمنية.
- إنهاء الوجود المسلح غير الحكومي: يشمل المقترح نزع سلاح الميليشيات غير الحكومية، مثل “حزب الله”، من جميع الأراضي اللبنانية، وخاصة من منطقة جنوب نهر الليطاني. يُتوقع أن يتم هذا بشكل تدريجي، مع تقديم الدعم الكامل للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتسلم الأسلحة الثقيلة وإعادة توزيع القوات.
- ترسيم الحدود اللبنانية-الإسرائيلية: من أبرز النقاط التي يتناولها المقترح الترسيم الواضح والدائم للحدود بين لبنان وإسرائيل. ويشمل ذلك مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين عبر رعاية دولية، لتسوية قضايا مثل الأسرى والحدود المتنازع عليها، وضمان انسحاب إسرائيل من “النقاط الخمس” الحدودية.
- إعادة إعمار لبنان: يُقترح تنظيم مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر، بهدف دعم لبنان في عملية إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب. ويُركز المؤتمر على تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد اللبناني وفق رؤية الرئيس الأمريكي السابق ترامب، التي تسعى إلى إعادة لبنان دولة مزدهرة وقادرة على النهوض.
- مكافحة تهريب المخدرات: يُعد الإتجار بالمخدرات عبر الحدود اللبنانية-السورية تحدياً كبيراً لاستقرار لبنان. يشمل المقترح التنسيق مع السلطات السورية لمكافحة تهريب المخدرات وتحسين الرقابة على الحدود، عبر آليات تعاون متعددة الأطراف ودعم دولي.
مراحل تنفيذ المقترح:
- المرحلة الأولى (من اليوم 0 إلى اليوم 15): تشمل تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، تكثيف التعاون مع الأمم المتحدة لتفعيل مراقبة الحدود، وتأسيس آلية متابعة دولية. كما تتضمن هذه المرحلة التزام لبنان بتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله واستعادة السيطرة الكاملة على الأراضي اللبنانية.
- المرحلة الثانية (من اليوم 15 إلى اليوم 60): تركز على تطوير خطة مفصلة لانتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. كما تشمل دعم رواتب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وتحديد الخطوات اللازمة لتنفيذ خطة إعادة الإعمار.
- المرحلة الثالثة (من اليوم 60 إلى اليوم 90): تهدف إلى تعزيز وجود الجيش اللبناني في كافة الأراضي اللبنانية، بما في ذلك ترسيم الحدود مع سوريا. يتم أيضاً تعزيز قدرة الجيش على إدارة المناطق الحدودية ومنع تهريب المخدرات.
- المرحلة الرابعة (من اليوم 90 إلى اليوم 120): تشمل تثبيت الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى التفكيك النهائي للبنية التحتية العسكرية لحزب الله. كما يتم متابعة التزام الأطراف كافة بإجراءات نزع السلاح وتنفيذ ترسيم الحدود الدولي.
الآليات والضمانات:
تُتوقع آلية متابعة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، مع تقارير دورية من قبل الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لضمان التزام الأطراف. في حال خرق الاتفاق من أي طرف، يتم اتخاذ إجراءات دبلوماسية، تشمل توبيخ من مجلس الأمن أو فرض عقوبات اقتصادية.
يتضمن المقترح أيضاً حوافز دبلوماسية: حيث يسعى لبنان للحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وفرنسا، ودعم مالي مستمر من الدول المانحة، في مقابل التزامه بتنفيذ بنود الاتفاق.
ترسيم الحدود اللبنانية-السورية:
كما يتضمن المقترح المضي قدماً في ترسيم الحدود مع سوريا، والتي تظل غير واضحة في بعض المناطق الاستراتيجية، مثل سهل البقاع ووادي خالد. يتم استخدام خرائط تاريخية وتقنيات حديثة لتحديد الحدود بدقة، مع إشراف دولي من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا. يتم أيضاً إنشاء آلية مشتركة بين لبنان وسوريا، لتسوية القضايا الحدودية وحل النزاع حول مزارع شبعا.
أربع سيناريوهات لنزع سلاح حزب الله في لبنان
تناولت نخلة عضيمي في مقال منشور لها، تطورات ملف السلاح غير الشرعي في لبنان والقرارات الحكومية الأخيرة التي تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة، وفي مقدمتها سلاح “حزب الله”. أبرز النقاط التي جاءت في المقال هي:
- خلفية القرارين الصادرين عن مجلس الوزراء: القراران الصادران في 5 و7 أغسطس 2025 يؤكدان التمسك باتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن رقم 1701، مع التركيز على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. كما دعوا إلى معالجة ملف السلاح الفلسطيني، ما يزيد من تعقيد المسار.
- أهمية التنفيذ: يركز المقال على أن التحدي ليس في النصوص القانونية، بل في قدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ هذه القرارات، خاصة مع تعقيدات التوازنات الداخلية والإقليمية.
- السيناريوهات المحتملة:
- السيناريو الأول: الحل الشامل: يتضمن نزع سلاح “حزب الله” بالكامل، انسحاب إسرائيل من النقاط المتبقية، وترسيم الحدود. هذه الخطة تدعمها القوى الدولية، وقد تؤدي إلى استقرار أمني واقتصادي في لبنان، مع تراجع نفوذ إيران. لكن هذا السيناريو يحتاج إلى إرادة داخلية صلبة من الحكومة اللبنانية.
- السيناريو الثاني: التسوية الجزئية: يتضمن تخفيض قدرة “حزب الله” العسكرية، مع بقاء سلاح فردي وتكامل جزئي مع الجيش اللبناني. يمدد وقف الأعمال العدائية، ويُحسن سلطة الدولة جزئياً، لكن يبقي “حزب الله” قوياً سياسياً.
- السيناريو الثالث – المراوحة: يفشل تنفيذ القرارات وتبقى حالة الجمود مع استمرار وقف النار دون تقدم سياسي أو أمني. هذا السيناريو يُعد الأكثر خطورة ويُزيد من الأزمة الاقتصادية وتفاقم الوضع الداخلي.
- السيناريو الرابع: المواجهة الشاملة: يضم صداماً داخلياً بين “حزب الله” والجيش اللبناني أو حرباً مع إسرائيل. هذا السيناريو كارثي على المستوى الداخلي والدولي، ويشمل دماراً شاملاً وتدخلات إقليمية.
- التحديات التنفيذية: يُختتم المقال بالتأكيد على أن “العبرة بالتنفيذ” وأن نجاح الحل الشامل يعتمد على قدرة الدولة اللبنانية على تجاوز التحديات الداخلية ومواجهة الضغوط الإيرانية التي تعمل على زعزعة الاستقرار.
“مواجهة لبنان مع حزب الله”: تحديات نزع سلاح الحزب واستعادة السيادة
نشر فريق التحرير في صحيفة “وول ستريت جورنال” مقالاً تحت عنوان “مواجهة لبنان مع حزب الله”، يتناول مسألة نزع سلاح حزب الله المقرر أن يتم بنهاية الشهر الحالي وفقاً لخطة الحكومة اللبنانية. يتساءل المقال: هل سيسمح حزب الله للحكومة اللبنانية باستعادة سيادتها على أراضيها؟
المقال يشير إلى أن حزب الله سيبذل قصارى جهده لعرقلة هذه الخطة، حيث يهدف إلى إبقاء الدولة اللبنانية ضعيفة والجيش متفرجاً على الصراع الذي تُشنه الجماعة نيابةً عن إيران.
يتطرق المقال إلى موقف الحكومة اللبنانية التي تبنت “الورقة الأميركية” لفرض نزع سلاح حزب الله، مشيراً إلى الدور الأساسي الذي لعبه الضغط الأمريكي، إلى جانب الغارات الإسرائيلية، في دفع لبنان لاتخاذ خطوات حاسمة ضد الحزب. لكن في المقابل، يرى المقال أن الضغط الأمريكي قد يخفف من تأثيره إذا تم تجميد الضربات الإسرائيلية على حزب الله.
ويحذر المقال من أن حزب الله قد لا يلجأ إلى العنف الداخلي لمنع نزع سلاحه، لكنه قد يهدد بعودة الصراع الطائفي لتأجيل تطبيق القرارات الحكومية. ويتوقع أن الحزب، بالتعاون مع حلفائه في حركة أمل، قد يصور نزع السلاح كتهديد للطائفة الشيعية، مما يتيح له ممارسة “حق النقض الطائفي” لإعاقة تنفيذ هذه القرارات.
في إطار هذا المشهد المعقد، يطرح المقال السؤال الأبرز: هل لدى لبنان الإرادة السياسية لاستعادة سيادتها وتطبيق قرار نزع سلاح حزب الله، أم أن التأثيرات الخارجية والضغوط الطائفية ستمنع ذلك؟ يختتم المقال بالتأكيد على أن القرار اللبناني في هذه اللحظة التاريخية سيكون حاسماً في تحديد مسار البلاد: “هل سيعود لبنان للعمل كدولة حقيقية؟
متابعات إفريقية
بوروندي.. حكومة جديدة وسط جدل انتخابي
أدت الحكومة البوروندية المنتخبة حديثاً اليمين الدستورية، بعد انتخابات تشريعية مثيرة للجدل حصد فيها الحزب الحاكم، المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية – قوات الدفاع عن الديمقراطية (CNDD-FDD)، جميع مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 100 مقعد بنسبة أصوات بلغت 96%. وقد أثارت هذه النتائج انتقادات واسعة من جماعات حقوقية والكنيسة الكاثوليكية والمعارضة التي تحدثت عن مخالفات جسيمة.
الرئيس إيفاريست ندايشيميي أعلن تشكيل حكومة جديدة ضمت عشرة وزراء جدد من أصل 13، جميعهم من الحزب الحاكم، من بينهم الجنرال السابق في الشرطة ليونيداس نداروزانيي وزيراً للداخلية، وشانتال نيجيمبيري التي أصبحت أول امرأة تتولى وزارة الدفاع في تاريخ البلاد، في خطوة أثارت اعتراض بعض القيادات العسكرية التوتسية. ويُلزم الدستور البوروندي باحترام حصص عرقية في التعيينات الوزارية، بحيث يشكل الهوتو 60% من الوزراء مقابل 40% للتوتسي. (أفروبوليسي)
إثيوبيا.. مبعوث جديد إلى الصومال في ظل تحسّن العلاقات
سلّم المبعوث الإثيوبي الجديد، سليمان ديديفو، أوراق اعتماده للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ، في خطوة تعكس استمرار تحسّن العلاقات بين الجارتين في القرن الأفريقي. وكانت العلاقات قد توترت بشدة عقب توقيع إثيوبيا اتفاقاً مع “أرض الصومال” الانفصالية للحصول على منفذ بحري، وهو ما اعتبرته مقديشو انتهاكاً لسيادتها.
ونجحت وساطة تركية في ديسمبر 2024 في التوصل إلى إعلان أنقرة الذي هدّأ التوترات ومهّد لاستئناف الحوار، متضمّناً التزاماً بمناقشة مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري. وفي أبريل 2024، كانت الصومال قد طردت السفير الإثيوبي وأمهلته 72 ساعة للمغادرة، قبل أن تمهّد التفاهمات الأخيرة لعودة قنوات الاتصال الدبلوماسي. (أفروبوليسي)
جمهورية الكونغو الديمقراطية.. تعديل وزاري يضم المعارضة
أعلن الرئيس فيليكس تشيسكيدي، عن تعديل وزاري شمل ضمّ شخصيات معارضة بارزة، وفق مراسيم بثها التلفزيون الرسمي. الحكومة الجديدة، التي ما زالت برئاسة جوديث سومينوا تولوكا، تضم 53 وزيراً أي أقل بعضو واحد عن سابقتها.
وشمل التعديل تعيين رئيس الوزراء الأسبق وزعيم المعارضة أدولف موزيتو نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للميزانية، إلى جانب فلوريبرت أنزولوني، زعيم حزب معارض صغير، وزيراً للتكامل الإقليمي. ويأتي هذا التغيير بعد مشاورات سياسية جرت مطلع العام وسط أزمة أمنية متفاقمة في شرق البلاد، علماً أن كلا الوزيرين الجديدين كانا قد ترشحا للانتخابات الرئاسية في 2023 وحصلا على نسب تصويت متواضعة. (أفروبوليسي)
الأمم المتحدة: نزوح قرابة 60 ألف شخص جراء القتال العنيف في شمال موزمبيق
أفادت وكالة تابعة للأمم المتحدة بأن قرابة 60 ألف شخص فرّوا من مقاطعة كابو ديلجادو شمال موزمبيق خلال أسبوعين، وسط تمرد مستمر منذ سنوات لمقاتلين تابعين لتنظيم داعش.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في بيان لها أن الهجمات المتصاعدة التي بدأت في 20 يوليو/تموز أدت إلى نزوح 57,034 شخصاً، أي ما يعادل 13,343 عائلة. وكانت منطقة كيوري الأكثر تضرراً، حيث نزح أكثر من 42,000 شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، وفقاً للمنظمة.
وصرحت باولا إيمرسون، رئيسة فرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في موزمبيق، لوكالة فرانس برس: “حتى الآن، حصل حوالي 30,000 نازح على الغذاء والماء والمأوى والمستلزمات المنزلية الأساسية”. . (أفروبوليسي)
متابعات دولية
تراجع شراء الهند لنفط روسيا يدفع موسكو للبحث عن أسواق بديلة
تثير محاولات واشنطن لخنق تدفق النفط الروسي إلى الهند تساؤلات بشأن مصير ملايين البراميل التي كانت تتجه يومياً إلى شبه القارة الهندية.
تشير الدلائل إلى أن شركات التكرير الهندية المملوكة للدولة بدأت تتراجع عن الشراء من السوق الفورية في ظل غياب توجيهات رسمية من نيودلهي، بينما لا يزال من غير الواضح كيف ستتصرف المصافي الخاصة. هذه التطورات قد تعني أن كميات ضخمة من النفط، بلغت نحو 1.7 مليون برميل يومياً أرسلتها روسيا إلى الهند الشهر الماضي، باتت تبحث عن وجهة بديلة.
تعد الصين الوجهة الأكثر ترجيحاً لهذا الفائض، إذ لا تعترف بالعقوبات الأحادية الجانب، وتواصل شراء الخام الروسي والإيراني. لكنها، في الوقت ذاته، تُبدي قلقاً من الاعتماد المفرط على مورد واحد، ومن غير المؤكد إن كانت مصافيها قادرة على استيعاب كميات إضافية في ظل تباطؤ الأداء الاقتصادي.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح بفرض إجراءات صارمة ضد تدفقات النفط الروسي إلى الصين، ما قد يربك سوق الطاقة العالمية.
يرى محللون أن الصين، بما تمتلكه من ثقل اقتصادي وموارد استراتيجية، قادرة على مقاومة الضغوط الأميركية، لكن أي تصعيد من واشنطن قد يقلل جدوى هذه الواردات بالنسبة لبكين.
التقديرات تشير إلى أن تعثر تصريف النفط الروسي قد يرفع أسعار الخام عالمياً بين 10 و20 دولاراً للبرميل. بعض المصافي الصينية بدأت تتلقى عروضاً لشراء خام “الأورال” الروسي، لكنها تميل عادةً لخام “إسبو” الأرخص في النقل والخام الإيراني المخفض السعر.
تركيا تُعد أيضاً مشترٍ محتمل لكميات فائضة، لكنها تواجه قيوداً فنية وسياسية، فيما قد تضطر روسيا لتخزين الفائض أو إعادة توزيعه، رغم محدودية طاقتها التخزينية.
المحللون يؤكدون أن النفط سيجد طريقه إذا كان السعر مناسباً، لكن التحدي سياسي أكثر منه اقتصادي. (الشرق)
التحضيرات الصينية لاحتمال صراع مع الهند
رغم التصريحات المتكررة من بكين ونيودلهي عن رغبتهما في الحفاظ على علاقات سلمية، تشير التحركات الصينية إلى استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز النفوذ الإقليمي والاستعداد لاحتمال اندلاع صراع مع الهند.
تتضمن هذه التحركات تطوير البنية التحتية، تحديث القدرات العسكرية، بناء تحالفات استراتيجية، وإدارة النزاع الحدودي ضمن إطار دبلوماسي حذر.
تطوير البنية التحتية
الصين تبني منشآت مزدوجة الاستخدام (مدنية وعسكرية) على طول الحدود مع الهند، تشمل طرقاً وسكك حديدية وشبكات اتصالات. هذه المنشآت تتيح نشر القوات والإمدادات بسرعة في حال نشوب مواجهة عسكرية.
التحديث العسكري والانتشار
الجيش الصيني (PLA) يعزز قواته على خط السيطرة الفعلية (LAC) مع الهند، من خلال ترقية منظومات الأسلحة، تحسين تدريب الجنود، وتطوير قدرات المراقبة والاستطلاع، إلى جانب تكثيف الدوريات الحدودية.
التحالفات الاستراتيجية
بكين تعمّق شراكتها مع باكستان، التي تشترك في حدود مع الهند، ما يمنحها حليفاً إقليمياً محتملاً ويزيد خياراتها الاستراتيجية في حال نشوب صراع.
النزاعات الحدودية والمطالب الإقليمية
الصين تواصل الطعن في سيادة الهند على ولاية أروناتشال براديش ومناطق أخرى، بما في ذلك إطلاق أسماء صينية جديدة على مواقع تدّعي ملكيتها. هذه النزاعات تبقى مصدر توتر مزمن بين الطرفين.
الدبلوماسية الاقتصادية
على الرغم من الخلافات، تعد الصين أكبر شريك تجاري للهند، مع استثمارات متبادلة بين البلدين. لكن خبراء يرون أن بكين تستخدم هذا النفوذ الاقتصادي كأداة ضغط استراتيجي.
الصبر الاستراتيجي والأهداف البعيدة
وفق تقارير مراكز أبحاث دولية، تُعرف الصين بتخطيطها بعيد المدى في سياستها الخارجية، حيث تدمج بين التحضير العسكري، وإدارة النزاعات، وبناء التحالفات، بهدف ترسيخ نفوذها الإقليمي.
الوضع الراهن يعكس مزيجاً معقداً من التعاون والمنافسة بين الصين والهند، حيث تسير التحضيرات العسكرية جنباً إلى جنب مع المساعي الدبلوماسية لتجنب الانزلاق نحو مواجهة مباشرة. (شاهد)
خطة أميركية–روسية لاحتلال أجزاء من أوكرانيا على طريقة “الضفة الغربية”
كشفت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الولايات المتحدة وروسيا تبحثان خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا تقوم على نموذج “احتلال الضفة الغربية”، بحيث تبقى الحدود الأوكرانية رسمياً كما هي، لكن روسيا تمارس السيطرة العسكرية والاقتصادية على المناطق التي تحتلها، عبر إدارة خاصة بها، على غرار سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية منذ 1967.
الاقتراح طُرح خلال محادثات بين مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ومسؤولين روس، ويُرجَّح أن يكون ضمن أجندة قمة ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقررة في ألاسكا. الفكرة، وفق مصادر أميركية، تهدف لتجاوز عقبة الدستور الأوكراني الذي يمنع التنازل عن الأراضي دون استفتاء، وقد تمهّد لوقف إطلاق النار.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض مبدأ التنازل عن أي أرض، وأكد أن قضايا السيادة يجب أن تُناقَش بحضور كييف. كما شدد على ضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع ضمانات أمنية، وفرض عقوبات على موسكو إذا لم يتم الاتفاق.
الخطة تعكس، بحسب واشنطن، “واقعية سياسية” في ظل رفض الدول الغربية الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا، لكنها تواجه انتقادات واسعة، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الذي تستند إليه الخطة اعتبرته محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة غير قانوني.