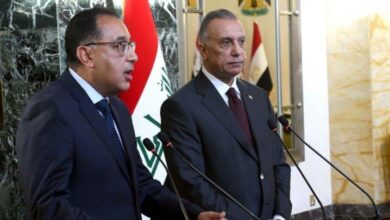سيكولوجيا المحارب الإسرائيلي: (1) هكذا يفكرون

بقدر ما يُعتبر “الجيتو” واحدة من أهم الظواهر التي رافقت المسألة اليهودية في سياقاتها الأوروبية الحديثة، بقدر ما يُعتبر أحد أهم مكونات النزعة الانعزالية في شخصيةِ اليَهودي. ولقد ظلت العزلة الاختيارية من قبل اليهود قائمة إلى أن أصدر البابا “بولس الرابع” (1550- 1559)، نشرة بابوية في العام (1555)، توصي ولأول مرة بعزل اليهود إجبارياً. أما قبل ذلك، وعلى الرغم من عدم لجوء أحد إلى إجبار اليهود على العزلة، فإن اليهود أنفسهم كانوا يلجأون إليها اختيارياً. فقد قال “إسرائيل أبراهامز”: “قبل أن تصبح السُّكْنَى في مكان محدد أو في الجيتو أمراً إجبارياً، كان اليهود أينما وُجِدُوا يجتمعون في أماكن منعزلة بالمدن التي كانوا يعيشون فيها”.
أما الزعيم الصهيوني “ناحوم جولدمان”، رئيس المنظمة الصهيونية السابق، فقد قال في هذا الشأن: “يجب أن نؤكد على أن من الخطأ القول بأن الجويم قد أَرْغَموا اليهود على الانفصال عن بقية المجتمع”.. أي وبكلمة أوضح فإنه مع صدور قرار البابا “بولس الرابع” الخاص بإنشاء أحياء اليهود المستقلة “الجيتو”، تحول النظام الاجتماعي الاقتصادي الديني للحياة اليهودية والقائم على العزلة، إلى نظام إجباري.
الفصل الأول: الجيتو اليهودي وأثره في تحديد مُكَوِّنات الشخصية اليهودية
منذ (26) يوليو عام (1555)، اضطر يهود روما إلى نقل محل إقامتهم إلى الحي الجديد على الضفة الشمالية من نهر “التَّيْبِر”، والذي أحيط على الفور بسور يعزله عن المدينة، وبعد فترة قصيرة اتُّبِعَ هذا الأسلوب المُسْتَحدث في سائر المدن الواقعة تحت سلطة البابوية، واعتباراً من عام (1562)، أُطْلِقَ على هذه المؤسسة الجديدة بشكل رسمي اسم حي اليهود في مدينة البندقية “الجيتو”.
في روسيا القصيرية كان الأمر أكثر عمقاً وشراسة، فقد أصدرت الإمبراطورة “كاترين الثانية”، إمبراطورة روسيا القيصرية، مرسوماً إمبراطورياً عام (1796)، أدى إلى تحديد إقامة اليهود. ولما تولى القيصر “نيقولا الأول” حكم روسيا عام (1825)، أوضح منذ البداية أنه يعتبر اليهود شعباً غريباً، يجب أن يَتَكَيَّف بسرعة مع الأكثرية السلافية اليونانية الأرثوذكسية، أو أنه سوف يعاني من النتائج الوخيمة لحالة اللاَّتَكَيُّف.
وفي عام (1840)، طلب القيصر من وزير الدولة “الكونت. ب. د. كيسيلييف”، عقد لجنة تكون قادرة على إصدار مبادئ جديدة وفريدة من نوعها بالنسبة لحل المشكلة اليهودية. ولقد قررت اللجنة في تقريرها أن أساس المشكلة إنما يرجع إلى التعصب الديني اليهودي وإلى الروح الانفصالية لدى اليهود. ولقد أوضحت اللجنة في ذلك التقرير أن التلمود هو الذي غَذَّى في اليهود مقولات تُكَرِّسُ في أذهانهم أنهم شعب الله المختار، وتزرع في نفوسهم الرغبة في أن يحكموا بقية العالم، وفي أن يَكْرَهوا الشعوب التي تؤمن بديانات أخرى، ولقد تنبه تقرير اللجنة إلى حقيقة هامة، وهي أن تعاليم التلمود لا تَعتبر وجود اليهود في أي مكان في العالم غير فلسطين سوى إقامة مؤقتة وإجبارية في الأسر إلى أن يأذن الرب.
إن الرغبة اللاواعية في الإحساس بحياة الأسر هي التي دفعت بالكثير من اليهود الذين كانوا يعيشون خارج الجيتو إلى الانضمام إليه بعد فترة، ولعل من أشهر الأمثلة على تسلل هذه النزعة اللاواعية إلى السلوك الواعي الدافع إلى البحث الفعلي عن أَنْساق العزلة، حالة يهود “براغ” الذين كانوا يعيشون خارج نطاق المنطقة المخصصة لليهود، ثم قرروا في القرن الخامس عشر الانضمام لإخوانهم الذين يعيشون داخل المنطقة، لا بل إن هذا التوجه الانعزالي غير الطبيعي، استغرق يهود الجيتو إلى درجة اعترافهم بالجوانب الإيجابية له، وإقامة الصلوات في المعابد كل عام في جيتو “فيرونا” وجيتو “منطونا”، احتفاء بالذكرى السنوية لإنشائهما.
تؤكد هذه النزعة الانعزالية التلقائية لدى اليهود، أنهم عزلوا أنفسهم حتى في البلدان التي لم تكن تنظر إليهم نظرة كتلك التي تحدث عنها البابا “بولس الرابع” أو قياصرة روسيا. ومن تلك البلدان، البلدان الشرقية عامة، والعربية منها خاصة، فقد أخذ شكل تواجد اليهود في “مصر” اسم “حارة اليهود”، وفي اليمن اسم “قاعة اليهود” أو “القاع قاع” أو “المَسْبَتة”، نسبة إلى يوم السبت، وفي المغرب اسم “المَلاَّح”، وفي الجزائر اسم “درب اليهود”… إلخ.
ومع أن مناطق الانعزال اليهودي في شرق أوروبا قد اتخذت مُسَمَّيات عديدة مثل “الشَّتْتِل”، وهي كلمة “يديشية” تعني المدينة الصغيرة، التي كانت حياة اليهود فيها تدور حول المعبد والمنزل ثم السوق الذي يلتقي فيه اليهود مع الأغيار. ومثل “القاهال”، وهي كلمة عبرية تعني جمهوراً أو جماعة كبيرة من الناس في مكان واحد، وهي الخلية الأساسية لتنظيم حياة اليهود في منطقة إقامتهم. والقاهال يُعَدُّ تجسيداً للحكم الذاتي داخل الدولة، فقد مَثَّلَ اليهودَ أمام السلطات في كل شيء، حتى في مسألة جمع الضرائب منهم نيابة عنها لصالح خزينة الدولة، علاوة على تعيين القضاة والحاخامات.
إلا أن “الجيتو”، يُعَد أشهر الأشكال الانعزالية اليهودية في العالم، وهو قد عُمِمَ لوصف الحياة اليهودية الانعزالية وسط الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها. وهو عبارة عن حي أو عدد من الشوارع المخصصة لإقامة اليهود. ومن المحتمل أن تكون الكلمة قد استخدمت للمرة الأولى لوصف حي من أحياء البندقية يقع بالقرب من مَسْبَك لصهر المعادن يسمى “جيتو”، كان محاطاً ببوابات وأسوار، وذلك في عام (1516)، بعد أن خُصِّصَ كمكان لإقامة اليهود فيه، وهو يقع في جزيرة منعزلة بين قنوات المدينة، وقد كانت البوابات والجسور المؤدية إلى هذا الحي تطوى خلال الليل.
ولكن من الضروري أن نشير إلى أن مؤسسة الجيتو التي كانت في جانب منها تعبيراً عن طبيعة الشخصية اليهودية وتَعاَمُلِ الآخرين معها، تحولت مع مرور الزمن بفعل الفرز الطبقي الطبيعي في التجمعات البشرية إلى بُؤَرٍ للظلم والجور تمارسه الطبقات المتنفذة في الجيتو – وهي القلة عادة – في حق الغالبية العظمى التي كانت تعيش حياة بدائية قميئة. وقد ظهرت أولى بوادر التمرد على التنظيم القاهالي والجيتوي بأكمله، في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في “لتوانيا”، حين اشتكى عدد من سكان الجيتو هناك معلنين أنهم يُعَبِّرون في شكواهم عن موقف الأغلبية.. وقد جاء في الشكوى المقدمة إلى مسئول الإقطاعيات في بلدة “شاول”: “نحن جميعاً سكان شاول من اليهود نعلن بدموع أعيننا أننا لسنا في حاجة إلى حاخام ولا إلى رؤساء، لأنهم يعملون في الابتزاز والمؤامرات ويضطهدوننا تماماً، ونظراً لأنهم يرتبطون فيما بينهم بروابط عائلية، فإنهم ينهبون “بروطاتنا” (اسم عملة) حتى آخرها من أجل أن يزدادوا ثراءً”.
ولعل شيئاً شبيها بهذا هو ما أشار إليه “يوري إيفانوف”، عندما تحدث عن مرسوم عام (1796) في روسيا قائلاً: “بعد فترة تاريخية قصيرة استطاعت العائلات اليهودية الواسعة الثراء والنفوذ، تخطي أسوار الإقامة في الجيتو، وبناء القصور الفاخرة في موسكو وبطرسبرغ، فيما بقي داخل الأسوار عشرات ثم مئات الألوف من الكادحين اليهود الذين يعانون من الفقر والتعسف”.. ينطبق على هذه التجمعات اليهودية بالتالي نفس المنطق التاريخي التطوري الذي انطبق على غيرهم من الأوروبيين. بل ربما بأثر أعمق وأشرس، ما سينعكس عليهم عندما تبدأ حركات التحرر الأوروبية بالظهور والانتشار.
ولكن، ما هو السر في هذا الطابع الانعزالي في موقف الشخصية اليهودية من الحياة مع الآخرين؟!
في الواقع لا يمكننا فهم هذا الطابع دون إلقاء الضوء على دور الدين بعامة في تكوين هذا النسق من الحياة. فعلى الرغم من أن الدين اليهودي بوصفه دينا سماوي المنبع والأصل، يحتوي من دون شك على الكثير من التعاليم السماوية التي تحض على الخير وتنبذ الشر، إلا أن المحاولات التي تمت على أيدي حاخامات اليهود، بعد أن تم تدوين التراث اليهودي الشفهي “التلمود”، أدخلت إلى هذا الدين مجموعة من الأفكار المحورية، خلقت عند اليهود استعداداً للانعزال عن الأغيار، وعمقت لديهم بعض العقائد الاستعلائية وثيقة الصلة بالانعزال مثل فكرة “الشعب المختار”، و”الشعب المقدس”، و”انتظار المسيح المخلص”، وغيرها من العقائد التي انطوى عليها التلمود الذي يضم بين دفتيه اجتهادات هؤلاء الحاخامات في تفسير الدين اليهودي.
وربما كان هذا هو ما يفسر لنا وجود كتاب مثل “شولحان عاروخ”، الذي يُعتبر بمثابة دليل للحياة اليهودية بكل تفاصيلها وجزئياتها، والذي يحتوي على نظام صارم للسلوك اليهودي في الحياة اليومية، على كل يهودي متدين أن يلتزم بالمحافظة عليه.
لقد غدا واضحاً ومؤكداً أن القوانين الدينية اليهودية المختلفة ومجموعة المحظورات التي لاقت استهزاء الآخرين، والتي فرضها حاخامات اليهود بتشدد لا يَسْمح بأي قدر من التجاوز، هي التي عمقت من طابع العزلة اليهودية، خالقة لدى اليهودي بالتالي حالة تمركز، جعلته يعيش بذهنية الانفصال والتميز والتفرد.
وعندما نحاول توصيف الديانة كما عبرت عن نفسها في موروثات الدين اليهودي وأدبياته، فإننا نجد بوضوح أن اليهودية ما برحت منذ ظهورها وحتى الآن تمثل عبادة قبلية لجماعة خاصة متفردة، قاد تَشَبُّثُها بنزعتها القَبَلِيَّة إلى تحجر الديانة اليهودية ذاتها، وفي ذلك يقول المؤرخ “أرنولد توينبي”: “إن اليهودية هي أقبح الأمثلة على عبادة الذات الفانيةً صيتا”.
وإذا كانت للديانة اليهودية تأثيراتها على هذه النزعة الانعزالية، فإن لهذه النزعة بدورها تأثيراتها على واقع اليهود وعلى سيكولوجيتهم وعلى موقف العالم منهم. فقد قَلَّلَت العزلة الجيتَوِيَّة من اختلاط اليهود بالمسيحيين يوما بعد يوم، وبالتالي فقد زادت الشبهات حولهم وتبلورت المواقف المعادية لهم والمتوجسة منهم في الذهن المسيحي، ما انعكس مجددا على واقع حياتهم ليغدو مريرا بكل المقاييس.
إن القيود التي كانت مفروضة على التوسع في مساحة الأحياء اليهودية، والاضطرار إلى التوسع الرأسي بدل الأفقي بإضافة طوابق جديدة على المباني، جعل الكثافة السكانية تزداد بشكل مخيف في أحياء اليهود عما سواها، ما أدى إلى انحطاط وتدهور المستوى الاجتماعي للحياة، وإلى تفشي الأمراض وتراكم القاذورات، ما ترك أثراً عميقاً على وجدان اليهود القاطنين في “الجيتو” وعَمَّقَ بالتالي من انفصالهم عن العالم الخارجي، وأدى كل ذلك في نهاية المطاف إلى انعدام الإحساس بالأمن لدى اليهودي عندما يكون خارج أسوار الجيتو التي كان يقف عليها حراس من المسيحيين، يُلْزَم اليهود بدفع أجورهم. وقد كانت هذه الأسوار تُغلق أثناء الليل وفي أيام الأعياد المسيحية الهامة، ما راح يعمق فكرة العزلة التي تخيم على تلك الأحياء عن محيطها المسيحي.
وهكذا فقد أصبح اليهودي يشعر بوجود عالم غريب وشرير خارج الجيتو، أما داخل الأسوار فقد كان يجد الأمن والطمأنينة والثقة، وكان يعتريه بسبب هذه العزلة إيمان عميق بأنه ينتسب إلى الأمة المقدسة وإلى الشعب المختار. لقد عمقت حياة العزلة إحساساً خاصاً لدى اليهودي بأن الجيتو هو درع الأمان للحفاظ على الجماعة اليهودية وعلى طريقتها، إلى أن يحين الوقت الذي يشاء فيه الرب إعادته إلى أرض الميعاد مع حلول الخلاص المسيحي.
الفصل الثاني بداية عصر التنوير اليهودي وظهور (الهكسالاه)
ولكن للتاريخ منطقه، وللتطور رغم كل مظاهر الانكفاء والعزلة والجمود والتحجر التي مَيَّزَت اليهود عن غيرهم، سطوته القاهرة على الحركة. فرويداً رويداً بدأت الآراء الجديدة حول حرية الإنسان من تلك التي ظهرت في أوروبا، تدخل متسللة إلى الحارات اليهودية الضيقة. وحينئذ بدأ اليهود في الجيتو يشعرون بجو “بيت همدراش”، الضيق الخانق (وهو مركز للعبادة والدراسة في آن واحد)، وبعالم “الربانيم”، القاسي والمتزمت (الحاخامات التلموديين). ولم يعد الكثير من اليهود يرون أي معنى لبعدهم الزائد عن الشعوب التي تشربت بحب الإنسان وبالحرية، وتفجرت في كل ناحية داخل الجيتو هتافات عالية مؤداها.. “لنخرج من الجيتو”، و”لنتقرب من الشعوب”، و”لنتعلم لغاتهم”، و”لنتثقف ونتعلم الحكمة والمعرفة”، لتبدأ حركة تثقيف عصرية بين اليهود كانت بدايتها في ألمانيا تم التعبير عنها بما يسمى بحركة التنوير اليهودية أو “الهكسالاه”، ولقد كان هذا المصطلح هو الذي استخدمته “يهودا جيليتس”، لأول مرة عام (1832) للدلالة على عصر النهضة الثقافية اليهودية الذي استمر من عام (1750) إلى عام (1880).
ولكن ما هو جوهر دعوات عصر الاستنارة اليهودي؟
كم يبدو الأمر غريباً ومثيراً عندما نعلم أن غضب التنويريين اليهود “المسكيليم”، انصب بشكل خاص على الدين اليهودي بكل أبعاده الانعزالية، فقد أعلنوا غضبهم من المعبد اليهودي، لأنه كان مُشبعا بالجو القومي اليهودي. وهاجموا التراث الشفوي “التلمود”، وكتاب “شولحان عاروخ”، مُبْقين فقط على التراث المكتوب “العهد القديم/التوراة”، بعيداً عن هجومهم الشرس، وقاموا بمحو كلمات “صهيون”، و”أورشليم”، من كتاب الصلوات، وحذفوا كل الصلوات التي تدعو للعودة إلى صهيون أو لإحياء مملكة إسرائيل، بل إن الأمر قد وصل بالكثيرين من دعاة الاستنارة اليهودية إلى حد إنكار الدين اليهودي ذاته. وفي معابد كثيرة مُنعَ استخدام اللغة العبرية واعتمدت الصلوات بالألمانية والفرنسية، كما كانت هناك محاولات لاستبدال يوم السبت بيوم الأحد.
لقد آمن دعاة الاستنارة اليهود بالعقل وبضرورة تقبل الواقع التاريخي المُتَعَيِّن، لذا فهم قد وجهوا سهام نقدهم إلى التراث القومي الديني اليهودي المغرق في الغيبية واللاتاريخية، فهاجموا فكرة “الماشيح”، (أي المسيح المُخَلِّص)، وأسطورة العودة، وحولوا فكرة جبل صهيون إلى مفهوم روحي أو إلى اسم للمدينة الفاضلة التي لا وجود لها إلا كفكرة مثالية في قلب الإنسان. لقد أصبح الخلاص لديهم يتمثل في انتشار العقل والعدالة وليس مرهوناً بانتظار المُخَلص في عزلة عن العالم ليحمل اليهود على أجنحته إلى أرض الميعاد. ولعل جوهر هذه الدعوة التنويرية يلتقي مع جوهر الدعوات الأوروبية في ذلك الوقت حول الإنسان وحريته وحقوقه وإنسانيته وعقليته وحياته وإخضاع مصيره لإرادته الواعية.
إذن، فقد تجلت أفكار التنوير اليهودية في عهد جديد من الدعوة إلى الاندماج في الشعوب، فقد رسم “موسى مندلسن” (1729 – 1786)، الرائد الروحي لحركة الهكسالاه البرلينية، وجهة نظر جديدة في الفكر اليهودي عندما أسدى النصح لليهود كي ينبذوا عقلية الجيتو ويندمجوا في الشعوب التي يعيشون فيها، مؤكداً على أن اليهود يمكنهم أن يكونوا مواطنين مخلصين للوطن الذي يعيشون فيه.
ولقد طور اليهودي التنويري “يهودا ليف جوردن” (1830 – 1892) هذا الفكر معبرا عنه بمقولته الشهيرة التي وجهها إلى كل اليهود: “كن يهودياً في بيتك وإنساناً خارج بيتك”. ولكن بالرغم من نجاح حركة التنوير إلى حد كبير في تحقيق أهدافها في غرب أوروبا، فإنها جوبهت بمقاومة شديدة في شرق أوروبا التي كانت أسوار الجيتو فيها أكثر سماكة، وكانت قوى معارضة التغيير فيها أكثر شراسة.
ولقد عبر عن هذه الثنائية القطبية المتنافرة في التوجه والتفكير لدى يهود أوروبا، المؤرخ اليهودي “ديفيد ونتز” قائلاً: “لقد كان هناك بديلان لوضع اليهود، فقد رأى اليهود في غرب أوروبا أن الحل يكمن في تساوي الحقوق مع باقي المواطنين، أما اليهود في شرق أوروبا فقد تطلعوا إلى النموذج القومي، معتبرين أن من الممكن صياغة قدرهم داخل إطار أمة مستقلة لا تعتمد إلا عليهم”. ولقد كان هذا المؤرخ يعتبر “أن فكرة أن اليهود يمثلون أمة هي فكرة بغيضة، فهم لا يشتركون إلا في الدين”.
وفي ظل هذا التجاذب الشديد بين رجعية يهودية تحاول الإبقاء على الوضع على ما هو عليه فكرياً ومعتقدياً داخل الجيتو انتظارا لمسيح مُخلص، يحقق انتظاره الأبدي مصالح طبقية لطبقة من اليهود أفرزتها ضرورات العزلة الجيتوية، وبين تقدمية يهودية تنويرية راحت تفعل ما تستطيع لتحول اليهودي إلى إنسان قابل للاندماج في المجتمعات الأوربية، نقول: في ظل هذا التجاذب، حصلت منطقة فراغ هائلة لم يتمكن أحد من ملئها وردم الهوة التي أنشأتها سوى الحركة الصهيونية، فقلبت وجهة التنوير اليهودية رأساً على عقب بعد أن ساندها الاستعمار الأوربي وحقنها بمقومات الاندفاع لتحقيق أغراضها التي كانت أولاً وقبل كل شيء أغراضه هو.
الفصل الثالث فشل الحل الاندماجي التنويري وظهور الحركة الصهيونية
مع استفحال التوتر في صفوف اليهود بسبب الدعوات التنويرية، وبعد فشل الطرح الاندماجي وخصوصاً في صفوف يهود روسيا وشرق أوروبا، كان اليهود قد انقسموا إلى أربعة أصناف بحسب ردود فعلهم على هذا الفشل..
– فقد ظهرت ردود فعل فردية، بأن يعتنق اليهودي ديناً آخر، بل وإذا لم يَكْفِ ذلك بأن يندمج تماماً في المجتمع عبر تغيير كافة معالم شخصيته اليهودية، بما في ذلك اتخاذه لاسم آخر، كي يمحو محواً كاملاً أي أثر لأصله اليهودي.
– وظهرت ردود فعل تمثلت في مشاركة اليهودي في الحركات الليبرالية أو الاشتراكية لتغيير الواقع الاجتماعي، على اعتبار أن ذلك التغيير سيحقق له ولليهود الخلاص من معاداة السامية.
– أما ردود الفعل القومية الإقليمية فقد تبدت عبر مطالبة بعض اليهود داخل المجتمعات التي يعيشون فيها بالاستقلال الثقافي أو الإداري الذاتي ضمن الدولة نفسها، كما فعل الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعروف باسم “البوند” في روسيا، والذي انتهى أمره بظهور الاتحاد السوفيتي.
– أما رد الفعل الراديكالي القومي الشامل الذي تمحور حول فكرة جمع كل اليهود بهدف خلق قومية يهودية لها أرضها الخاصة، فقد تم التعبير عنه فيما سُمِّيَ بالحركة الصهيونية، ولقد اتخذ هذا الاتجاه أشكالاً مختلفة ابتداء من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.
يمكننا القول إنه بفشل حركة التنوير اليهودية، فشل الحل الاندماجي لما يسمى بالمسألة اليهودية، لكن فشل هذه الحركة لم يكن وحده هو الذي أفشل الحل الاندماجي ومهد للحل الصهيوني، فقد ساهمت عدة عوامل أخرى في ذلك منها.
– تكامل القوميات في أوروبا.
– نمو الرأسمالية في العالم.
– ازدياد موجة معاداة السامية.
– حادثة اغتيال القيصر ألكسندر الثاني في مارس (1881)، واتهام أحد اليهود بقتله.
– نشوء موجة من الاضطهاد في روسيا ضد اليهود.
– رغبة الاستعمار الأوروبي في توظيف المسألة اليهودية لاختراق المسألة الشرقية.
وإذا كان السببان الأول والثاني يمثلان المؤثرات الحتمية الحدوث في بُنْيَة الفكر اليهودي، فإن الأسباب الثلاثة التالية هي في واقع الأمر مُصْطَنعة وتتعارض مع ما بدأ ينتشر في أوروبا من تسامح وحريات، وهو ما يؤكد أن السبب السادس الممثل لمحصلة السياسة الأوربية الناجمة عن السببين الأول والثاني، هو ما دفع الأوربيين إلى زج اليهود في دائرة الأسباب الثالث والرابع والخامس، ليتسنى تنفيذ مُعْطى السبب السادس، الذي غدا اتجاهاً استراتيجياً في السياسة الأوربية.
لقد عبر “ناحوم جولدمان” الرئيس السابق للحركة الصهيونية عن خطر الاندماج الذي دعت إليه حركة التنوير، بعد أن تحقق لليهود الخروج من الجيتو الأوربي، قائلاً: “إن الاندماج هو الخطر الكبير الذي يهددنا منذ اللحظة التي خرجنا فيها من الجيتو ومن المعتقلات”. ولقد عنى ذلك بوضوح من المنظور الصهيوني، أن خروج اليهودي من قوقعة الجيتو يعرضه لعوامل التطور الطبيعية التي تراها الصهيونية خطراً على يهوديته، لأنها تقضي على ذاتيته اليهودية، إن لم يتكيف كيهودي مع البيئة الاندماجية الجديدة، وهو ما خشي منه الصهاينة.
لقد نجحت حركة الاستعمار الأوربي التي فرضها تكامل القوميات الأوربية ونمو الرأسمالية في العالم، وعبر ذراعها اليهودية الشكل فقط، “الحركة الصهيونية”، في ملء الفراغ الفكري والمعتقدي والتاريخي الحاصل في بُنية الشخصية اليهودية وفي بنية الوجود اليهودي، بعد معركة التنوير وخلالها، وذلك عبر تبني واحتضان واحتواء ما سُمِّيَ بحركة التمرد اليهودي على الحياة اليهودية في أوروبا، بعد أن نجحت في توجيهها – أي في توجيه حركة التمرد هذه – نحو غاياتها هي.
فعندما هاجم دعاة الاستنارة فكرة انتظار المسيح الذي سيأتي ليقود رحلة الخلاص اليهودي إلى أرض الميعاد، منادين عبر هجومهم على تلك الفكرة، بأن على اليهود أن يحصلوا على الخلاص بأنفسهم، فإن الحركة الصهيونية نجحت بامتياز في استخدام هذه الدعوة ذاتها، وفي تجييرها لصالح فكرة الخلاص بالتوجه مباشرة وفوراً إلى أرض الميعاد، وليس بالذوبان في المجتمعات والخلاص من العزلة والحصار والنبذ، لتكون الحركة الصهيونية بذلك وعبر هذا التجيير الذكي، الذي قفزت من خلاله باليهود من الحيرة في تحديد معنى الخلاص الحقيقي، إلى اعتباره أنه هو السعي والتخطيط والتحرك للعودة إلى فلسطين، قد نجحت في إزالة الحواجز الوجدانية التي كانت تقف بين اليهود وبين الصهيونية.
وهكذا فقد أصبح من الممكن، بل من الضروري، أن يكون الخلاص الذي مثل جوهر فكرة التنويريين أنفسهم، متحققا بالتحرك اليهودي عبر المنظمة الصهيونية، وبالعمل على العودة إلى فلسطين وانتظار المسيح هناك، لا انتظاره في أوروبا ليعود بهم إلى فلسطين.. لم يعد المسيح المنتظر بسلبية هو الذي سيخلص اليهود من شتاتهم، بل غدا اليهود هم الذين سيخلصون المسيح من انتظاره الطويل في السماء.
لقد أدت آراء “موسى مَندلسون” التنويرية إلى انقسام اليهود على أنفسهم، فقد أراد جانب منهم أن يصبح مواطناً عادياً في مجتمعات أوروبا، فيما خشي الجانب الآخر من الاندماج اليهودي في الحضارات الأخرى، ومن تعرض اليهود للامتصاص الثقافي، الذي سيؤدي حتماً – في نظر هذه الفئة – إلى ضياع الصفات اليهودية المميزة.. ولقد شكلت الصهيونية فكراً وحركة، الوجه المعبر عن هذا الخوف من الامتصاص، في البعد اليهودي لها، وإن كان هذا البعد لا يمثل في مبررات وجوهر مكوناتها، البعد الأهم والأخطر، بل إن الجوهر الاستعماري الأوربي هو الذي يمثل ذلك البعد!!
وإذن فما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء نشأة الصهيونية اليهودية؟!
لم تظهر الصهيونية في نهاية القرن التاسع عشر بسبب أشواق جغرافية وتاريخية جديدة إلى فلسطين، ولا بسبب كراهية مفاجئة سيطرت على اليهود تجاه أماكن إقامتهم خارجها، فرغم أن اليهود كانوا يكرهون الشتات دائماً، إلا أنهم كانوا يفضلون الإقامة فيه، مع أن أبواب فلسطين كانت على الدوام مُشْرَعة ومفتوحة أمامهم. كما أن الأشواق الدينية إلى فلسطين لم تكن هي السبب الذي يقف وراء ظهور هذه الحركة، لأن مثل هذه الأشواق لم تحرك اليهود عبر التاريخ من أماكن إقامتهم للذهاب إلى فلسطين رغم عدم وجود معوقات أو صعوبات في هذا السبيل.
فلقد حرص الكثير من الكتاب الصهاينة وغير الصهاينة، على القول بأن فلسطين بالذات كانت قبلة اليهود على مر العصور، وأنها كانت أملاً يراودهم منذ تشردهم في الزمن القديم. وانطلاقاً من كون يهود التوراة هم أنفسهم يهود الجيتو بمستسلميه ومتمرديه (الحالوتس)، فإن من الطبيعي أن تكون فلسطين هي الاختيار المنطقي والأوحد بالنسبة لهم وهم يبحثون عن مستقر لهم بعد تمردهم على واقعهم في أوروبا. إلا أن هذا الادعاء أبعد ما يكون عن الحقيقة وعن وقائع التاريخ.
فلقد شهد التاريخ العديد من الهجرات اليهودية في مختلف العصور، ولم تكن فلسطين هي قبلة تلك الهجرات، رغم أنها كانت متاحة لها. ولا وجود لأي تفسير منطقي يوفق بين التسليم بأن فلسطين كانت أملاً وقبلةً لليهود في شتى العصور، وبين حقيقة أن وقائع التاريخ الفعلية لا تحمل ما يدل على حقيقة وجود ذلك الأمل في صورة تعبير فعلي وواقعي عنه منذ ذلك التاريخ الغابر.
فقد شهد القرنان السادس عشر والسابع عشر هجرةً لليهود من إسبانيا والبرتغال إلى القارة الأميركية، وقد شهدت أواسط القرن التاسع عشر خروجاً يهودياً واسعاً ونشطاً، حمل إلى الولايات المتحدة نحو ربع مليون يهودي. وفي بدايات القرن العشرين ظلت الولايات المتحدة هي القبلة الحقيقية التي توجه إليها في الفترة من (1885) إلى (1914) عدد هائل من يهود روسيا والنمسا والمجر ورومانيا، بلغ قرابة المليون ونصف المليون شخص. أما هجرة اليهود بسبب الاضطهاد النازي، فقد اتجه الجزء الأكبر منهم إلى العالم الجديد، وخاصة إلى الولايات المتحدة على الرغم من أوج نشاط الحركة الصهيونية آنذاك، وهو النشاط الذي كان يعمل على توجيه اليهود إلى فلسطين.
لا بل إن صراعاً داخلياً شهدته الحركة الصهيونية حول تحديد أصلح الأماكن لاستيطان اليهود، وكانت تلك الصراعات تعكس مصالح الدول الإمبريالية المتباينة. بل إنه وبعد استصدار المجموعة الموالية للإمبريالية البريطانية بزعامة “وايزمان”، قراراً بأن تكون فلسطين هي جهة الاستيطان اليهودي، قام الزعيم الصهيوني البريطاني “زانجويل” بإحداث انشقاق في صفوف المؤتمر الصهيوني، وكَوَّنَ منظمة صهيونية مستقلة تهدف إلى استعمار أوغندا أو أي مكان كالأرجنتين مثلاً.
ورغم انتهاء ذلك الانقسام في صفوف الصهاينة لصالح مجموعة “وايزمان”، فإن مجرد حدوثه واكتسابه الأنصارَ، إنما يدل في جوهره على أن فلسطين لم تكن بحال الأمل الذي استقر في أذهان اليهود جميعاً منذ التاريخ الغابر، فضلاً عن أنها لم تكن بالمستقر الذي أجمع عليه الصهاينة للوهلة الأولى ودون خلاف. فلقد تم هذا الاختيار من خلال الحركة الصهيونية ونتيجة لقيامها وليس العكس. أي أن تلك الحركة لم تقم وتنشأ ابتداء تلبية وتجسيدا لذلك الاختيار التاريخي القديم، بل إن هذا الاختيار نتج عن وجود الحركة الصهيونية، وكان لاحقاً لها، بعد المفاضلة بينه وبين بدائل أخرى، كانت كلها مطروحة على مائدة الحوار وبساط البحث، نشأت الحركة عندما نشأت قبل أن تكون قد حسمتها أيديولوجياً.
وهذا يعني أن الدلالة السيكولوجية لهذا الاختيار إنما خلقتها الحركة الصهيونية وسعت إلى تدعيمها وإرسائها في نفوس اليهود كوسيلة لخدمة الأهداف السياسية والاقتصادية لتلك الحركة بعد أن وقع الاختيار على فلسطين التي تم اختيارها بالتالي لأسباب استعمارية صرف وحسب ما أملته الأجندة الإمبريالية البريطانية آنذاك.
وبناء على ما سبق، فإن الحقيقة هي أن الحركة الصهيونية في بعدها اليهودي قد ظهرت لا بسبب تلك الأشواق المفاجئة إلى فلسطين، بل بسبب الإحساس بالخوف من الشتات، وذلك بتأثير عاملين وقعا على مصير اليهود في هذا الشتات وقع الصاعقة، وهما..
1 – ازدياد موجات الاندماج اليهودي في المجتمعات الأوربية، بما تمثله هذه الموجات من تهديد بزوال مقومات الذاتية اليهودية.
2 – موجة الاضطهاد التي بدا أنها مُصْطَنعة ومُخَطط لها لإنجاح الدعوات الصهيونية وإعطاء المشروعية الدينية والتاريخية لمبرراتها المرسومة في دوائر الاستعمار الأوربي.
وبسبب هذه الحملة المحمومة التي مارستها الحركة الصهيونية لإذكاء مشاعر الخوف لدى اليهود في أوروبا من الشتات، بعد أن نجحت في تصوير التأثير المروع والخطير للعاملين السابقين، تصويرا فعل فعله في الذهن اليهودي، فقد كانت النتيجة أن الخوف من الشتات لدى البعض تفوق على الخوف التاريخي من فلسطين، وهو الخوف الذي يحول في بُنْيَة الشخصية اليهودية بين اليهودي وبين مغامرة اتخاذ القرار بالذهاب إليها، وهذا القول يفرض علينا السؤال المهم التالي..
هل يخاف اليهود حقاً من فلسطين كجغرافيا؟!
إن الشخصية اليهودية لم ترتبط في وجودها بإطار جغرافي محدد، ومن هنا فإن الجغرافيا لم تكن جزءًا من هويتها، بحيث أن من السهل ملاحظة تعدد المراكز الجغرافية في التراث الخاص بهذه الشخصية. وبما أن اليهود القدماء وُجِدُوا أول ما وُجِدُوا في “مصر” وليس في فلسطين، وفق ما تفيد به أساطيرهم التي امتلأت بها التوراة الحالية، فإن تاريخهم السيكولوجي يكشف عن علاقة غير طبيعية بينهم وبين فلسطين التي مثلت عندهم ذروة المعتقد الجغرافي. وبما أن إعداد اليهود كشعب كان في مصر، فإن عقيدة الشتات التي تؤطر للمرحلة الانتقالية التي تفصل بين خروجهم من مصر موطن النشأة والتكوين، ودخولهم إلى فلسطين أرض الميعاد والسطوة، تسللت إلى أعماق التفكير اليهودي منذ القدم مُشَكِّلَةً بوتقة لصهر اليهود.
إن العلاقة الخاصة التي قامت بين إسرائيل وبين الرب كانت في الصحراء، فالتوراة أُعْطِيَت لموسى فيها وليس في فلسطين، ففي الصحراء إذن حُددت الصفات المميزة لهوية اليهود، في منطقة خاوية بين الشتات وبين فلسطين. ولهذا السبب فإن وجود الصحراء في الوعي اليهودي يعتبر مهماً جداً، فكل الأعياد القومية التي يحتفل بها اليهود مرتبطة بوجودهم التاريخي في الصحراء. وبما أن دخول فلسطين بناء على وصايا الرب وهم في الصحراء ارتبط بشروط قاسية، فإن اليهود يخافون من الدخول إلى فلسطين، خشية ألا يستطيعوا تنفيذ الشروط الصعبة التي حددها الرب من أجل وجودهم فيها، أو حتى من أجل القدرة على دخولها في ظل الأوصاف المخيفة التي سيطرت عليهم لساكنيها الذين يَفترضُ دخولها قتالَهم وتحقيقَ النصر عليهم.
إن خوف اليهود التاريخي من الدخول إلى فلسطين بالمعنى السابق، يعد مفتاحاً لفهم العلاقة بينهم وبين هذه الأرض. وهكذا فقد كشفت لنا أدبيات الشتات عن أن جيلاً كاملاً كان يجب أن يموت في الصحراء ليولد بدلاً منه جيل جديد يكون مؤهلاً ومجهزاً لدخول فلسطين في إطار سمات جديدة واستعداد كامل للوفاء بالالتزامات.
إن نفس الفكر الذي يطبع الشخصية اليهودية يتكرر في الوقت الحاضر، ففي الكتابات الصهيونية المعاصرة يوصف يهود الشتات بالجبن وبأنهم قُدِّمُوا للذبح دون مقاومة، ويوصف الشتات بأنه كان خزياً وعاراً. إن الحركة الصهيونية ما فتئت تؤكد أنه يتم في فلسطين خلق شخصية يهودية جديدة، قائمة على معادلة قوامها، “آخر يهودي وأول عبري”، أو بتعبير أدق، “آخر يهودي وأول صهيوني”، وهي المعادلة القديمة والأزلية في التفكير اليهودي حسب ما تؤكد عليه العلاقة التراثية لدى ذلك الفكر بين الشتات وفلسطين. إنها في الصهيونية المعاصرة الصيغة التي أطلقها المفكر الصهيوني “أحادهاعام”.
إن اليهودي الذي يخاف من مجرد التفكير في الذهاب بمبادرة منه إلى فلسطين بسبب الموروث التاريخي المرهق لذهنه والمرتبط بها، إلى درجة أنه قنع بذل الشتات وبقسوة انتظار المخلص الذي سيرحل به إلى أرضه الموعودة، إن يهوديا هذه صفاته النفسية في التعامل مع أرض فلسطين، لم يكن من السهل على أي فكر مجرد أن يقنعه بالنضال والكفاح لتخليص نفسه بنفسه في السياق الفلسطيني، خاصة وهو يرى بأم عينه أن أبواب الإنسان الأوربي الجديد مشرعة أمامه ليقتحمها بسهولة كجزء من حركة التحرر الأوربي التي انتشرت عشية ظهور الحركة الصهيونية.
وإذن فإن الحركة الاستعمارية الأوربية التي رأت في ظهور الفكر الصهيوني في بعده اليهودي ضرورة لا مفر منها للتعامل مع المسألة الشرقية تعاملاً يضمن توجيهها الوجهة المستهدفة، خاصة بعد خبرة مائتي عام فاشلة من الحروب الصليبية، لم تكن لتقف مكتوفة الأيدي أمام ظاهرة الخوف والرعب المُسْتَوْطِنَة في الذهن اليهودي من فلسطين، لترى ربيبتها الصهيونية وهي تذوي فاشلة في ملء الفراغ الذي راح الاندماجيون يمهدون الطريق لملئه.
لم يكن أمام الحركتين التوأمين، الاستعمار الأوربي والصهيونية اليهودية، سوى تحويل الدفة لصالح الخوف من الشتات ومن الاندماج، على حساب الخوف من فلسطين، كي يُصبح التفكير في الرحيل إلى أرض الخلاص أهون الشَّرَّيْن بالنسبة لليهودي. ولهذا السبب سبقت كل موجات العداء للسامية، وحملات اضطهاد اليهود المُبَرْمَجة والمدروسة ظهور الحركة الصهيونية، كل ذلك من أجل جعل الوجهة الاندماجية أشدَّ خطورة من التوجه إلى فلسطين. ولعله لهذا السبب أيضاً كانت موجات اضطهاد اليهود تتفاقم مع كل مرحلة من التاريخ تقضي بدفع اليهود إلى فلسطين، ودعم فكر الحركة الصهيونية.
هذا الذي نقوله تؤكده حقيقة أن الحركة الصهيونية كانت في بدايتها حركة قِلَّة، وقد جوبهت بالرفض من معظم الفئات اليهودية، لقد رفضها الدينيون، ورفضتها جماعة البوند ورفضها الاشتراكيون اليهود ورفضها الاندماجيون بأنواعهم، بل حتى الحالمون من اليهود رفضوها أيضاً.
لكن ماذا يعني كل ذلك على صعيد التعرف على جوهر الدعوة الصهيونية؟!
يكشف المفكر اليهودي “حاييم هازار” النقاب عن الفرق الكبير بين اليهودية والصهيونية بأقوال معبرة وجريئة، فهو يرى: “أن اليهودية والصهيونية ليستا شيئا واحدا، بل شيئان يختلف كل منهما عن الآخر، بل هما أمران متناقضان. فحينما لا يستطيع شخص يهودي أن يكون يهودياً، فإنه يصبح صهيونياً”.. إن هذا التمرد الوثني هو في رأيه جوهر الفكر الصهيوني، فالحركة الصهيونية – حسب رأيه – هي الحركة التي تمكنت الرجعية اليهودية عن طريقها من احتواء التيارات الإصلاحية والتحررية التي انتشرت في صفوف اليهود في أواخر القرن التاسع عشر.
وهو يأسف بشدة وهو يرى أن الصهيونية قد نجحت في إنجاز عملية الاحتواء هذه، بأن قدمت نفسها على أنها حركة متمردة على التراث اليهودي القديم، وتحاول طرح تصور جديد قومي علماني للشخصية اليهودية. لكنها رغم العلمانية الظاهرة التي تغلفت بها، وجدت نفسها مضطرة لأن تستند في برنامجها السياسي والثقافي إلى الأساطير القديمة، خاصة أسطورة العودة والشعب المختار.
ولعل هذا ما يفسر الأزمة الأيديولوجية في قلب الفكر الصهيوني الذي اعتمد على التمرد على التراث الديني لاحتواء حركة التمرد اليهودية في أوروبا، ليعود ويعتمد على التراث الديني ذاته مُقولبا التمرد في إطار الدعوات الصهيونية، التي لا يمكنها أن تضم في صفوفها إلا أولئك اليهود الذين فشلوا في أن يكونوا يهوداً. لكن الأزمة المدمرة للفكر الصهيوني مُسْتَحْكِمَة في صميم طبيعته المتناقضة، إذ بعد أن كانت محاربة دعوات الاندماج هي السيف الذي سلطته على رقاب اليهود كي يتصهينوا، عادت بعد أن حققت الجانب الجغرافي من حلمها، متمثلاً في استيطان فلسطين، لتكشف عن تناقضها ولتفعل المستحيل لدمج هذا الشتات المُشَوَّه القادم من كل أصقاع الأرض، في مجتمع أثبت أنه عصي على تحقيق الاندماج الفعلي لأبنائه في إطار الفكرة التي يُراد لهم أن يندمجوا فيها وبها.
إن التناقض الحقيقي الذي رافق وسيرافق الحركة الصهيونية والفكر الصهيوني إلى أن يفجرهما من الداخل، يتمثل في أن هذه الحركة التي رأت في اندماج اليهودي الروسي مع المسيحي الروسي في بوتقة اجتماعية وجغرافية روسية واحدة، كارثة تهدد الشخصية اليهودية بالزوال والاندثار، هي ذاتها التي رأت في اندماج اليهودي اليمني مع اليهودي البولندي في بوتقة اجتماعية وجغرافية إسرائيلية واحدة أمراً ممكناً، لا بل وضرورياً، رغم أن ما يجمع اليهودي الروسي بالمسيحي الروسي أكثر بكثير مما يجمع اليهودي اليمني باليهودي البولندي.
ولأن أوهام الحركة الصهيونية في دعوة الاندماج الجديدة في إسرائيل على أشلاء وأنقاض دعوات الاندماج القديمة في أوروبا، أثبتت أنها غيض من فيض جنون الصهاينة، فإن الحركة الصهيونية لم تَكُف لحظة واحدة عن السعي لإيجاد تلك الرابطة التي يمكنها أن تربط بين قادم من جوهانسبرغ من أقصى جنوب القارة الإفريقية، وقادم من استوكهولم في أقصى شمال القارة الأوربية، وبين من أمضى طفولته في “الجوديريا”، حي اليهود في أسبانيا، ومن أمضاها في “القاع قاع” حي اليهود في اليمن.
ترى هل يمكن أن يخرج من كل هذا الخليط غير المتجانس تكوين سيكولوجي مُوحَّد لمُكوِّنات شخصية مُوَحَّدة المعالم؟!.. إن الإجابة على هذا التساؤل تقودنا بادئ ذي بدء إلى الحديث عن جيل “الحالوتس”، وهو الجيل الذي احتوت الحركة الصهيونية تمرده على الجيتو، وحولت وجهته التمردية هذه إلى فلسطين.
الفصل الرابع جيل الحالوتس
نشأت حركة الحالوتس كنتيجة طبيعية لانهزام حركة التنوير اليهودية، وانتصار الحركة الصهيونية الاستعمارية ونجاحها في احتواء واحتضان التمرد اليهودي على الحياة في الجيتو وعلى حكومة الجيتو. لقد كان مناخ هذه النشأة هو مناخ التمرد الناجم عن شعور التهديد بالفناء روحياً وحضارياً واقتصادياً وسياسياً، وعن الإحساس بالعزلة حتى في قلب دعوات الاندماج والذوبان في الآخرين، بعد أن تمكنت الصهيونية من ترسيخ الاعتقاد لدى اليهود، بأن المجتمع الحديث لا يمكنه أن يقبلهم أو يهضمهم، وأنه سيتعامل معهم على الدوام باستعلاء واحتقار، لذلك فقد مثل جيل الحالوتس الخلاصة السياسية لهذه البيئة الذهنية الانعزالية مُمَثَّلاً في هؤلاء الرواد الذين تمكنت الحركة الصهيونية من قذفهم إلى فلسطين ضمن مشروعها الاستعماري المُغَلَّف بالدثار اليهودي.. أي أن الحالوتس من الناحية الفعلية هم اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين تحت لواء الحركة الصهيونية.
لكن سؤالاً مهماً يفرض نفسه في هذا السياق، وهو.. هل التكوين السيكولوجي الذي ميز الحالوتس، والمتمثل في ذلك التمرد والخوف اللذين كانا سببا في وضعهم في أتون الحركة الصهيونية، هو الذي دفعهم للقفز باتجاه فلسطين؟!
إن هذا يقودنا إلى الحديث عن دور التكوين السيكولوجي لأفراد المجتمع في تحديد المسار التاريخي لذلك المجتمع. وفي هذا الشأن فإن أهل الاختصاص من علماء النفس وعلماء الاجتماع يؤكدون على أنه – أي التكوين السيكولوجي – لا يحدده – أي المسار التاريخي – بأي حال.. نعم، قد يُسهم في تكوينه وقد يدفعه إلى الأمام، أو قد يحاول الوقوف في وجه تقدمه، لكنه ليس هو المُحَدِّد له في المحصلة النهائية. إن التكوين السيكولوجي هو مجرد إمكانية مُتَوَقَّعة، يتحول توقعها إلى واقع موضوعي بفعل الظروف الاجتماعية المحيطة بذلك التكوين والمرافقة له. كما أن شكل ذلك التكوين وليس مجرد وجوده، يتوقف أيضاً على تلك الظروف. إذن فالتكوين السيكولوجي المُحَدَّد والمُوَحَّد، يتوقف وجوداً وعدماً من جهة، وشكلاً ومضموناً من جهة أخرى، على مجموعة الظروف الاجتماعية التي يَتَخَلَّق ذلك التكوين إنْ تَخَلَّق في محيطها.
وإذن فقد كان من الممكن لحركة التمرد اليهودي على الجيتو في أوروبا، ألا تتحول إلى فلسطين، لو كانت تلك الظروف التي نتحدث عنها غير تلك التي دفعت إلى تحويل ذلك التمرد إلى حركة حالوتس. فلقد كان من الممكن لحركة التمرد هذه مثلاً، أن تنتهي بمجموعات من الشباب تجوب أوروبا معلنة رفضها لحياة آبائها، متمردة على تقاليدهم وأساليبهم في الحياة، وعلى أساليب وتقاليد العالم المحيط بهم أيضاً.. ثم، لا شيء بعد ذلك.
وكان يمكن للعالم أن يشهد على سبيل المثال ظهور حركة أشبه بحركات “الهيبيز” الأوربية عقب الحرب العالمية الثانية، ولكن في زمن متقدم عما شهد فيه مثل تلك الحركات بقرن من الزمان أو يزيد. وكان من الممكن للتاريخ ألا يُسجل آنذاك سوى ملاحظة خافتة عن ارتفاع معدل الأمراض النفسية بين اليهود في وسط أوروبا وشرقها في تلك الفترة. بل كان يمكن لتلك الحركة أن تندمج آنذاك في تلك الثورة العارمة التي شهدتها أوروبا مع بداية الثورة الفرنسية التي لم تكف أحداثها عن التفجر حتى مطلع الثورة الاشتراكية في روسيا.
إن عبارة “كان يمكن” التي أوردناها أكثر من مرة فيما مضى، تعنى أن حركة الشباب اليهود المتمردين في أوروبا، تجعل لأولئك الشباب التكوين السيكولوجي نفسه لدى تلك الأجيال من الشباب في فترات التحول والأزمة، والذي لا يعدو أن يكون نوعاً من السلوك المختلف بصورة أو بأخرى عن سلوك الآباء، وهو أمر لا يكاد يخلو منه مجتمع، بل لعله يكاد يشكل السمة التي تميز ما يعرف بصراع الأجيال كشرط من شروط التقدم.
ويحدث أحياناً أن يتخطى ذلك التكوين الصراعي حدوده الطبيعية، فيشتد متخذاً صورة الثورة الاجتماعية بكل ما تعنيه من أبعاد، وبكل ما يمكنه أن يترتب عليها من تداعيات نفسية وسلوكية. كما يمكنه أن يتخذ صورة السلوك الجماعي فيما يعرف بحركات الشباب، أو صورة الأمراض النفسية أو حتى العقلية. إن جيل الحالوتس كان جيلاً من هذا النوع، إنه جيل كان يود أن يمضي بعيداً إلى أي مكان يكفل له ممارسة تمرده على ما هو متمرد عليه، ولقد عَبَّرَ أبناء هذا الجيل عن هذا التمرد بمنتهى الوضوح عندما انتشرت بينهم معادلة تحكم نظام تفكيرهم مفادها..”إن أساس نظامنا بالغ البساطة، أن نفعل عكس ما خبرناه أو تعلمناه ونحن أطفال”.
إن جيل الحالوتس الذي أصبح هو العمود الفقري لحركة الاستيطان التي رعتها وغذتها الحركة الصهيونية، لم ينشأ صهيونياً منذ البداية، فالحالوتس وهم الأقلية اليهودية ليس على صعيد العالم فقط، بل حتى على صعيد وسط وشرق أوروبا، الموطن الأساسي للأزمة التي ولدتهم وأدت إلى ظهورهم، هم جيل من الرافضين لكل ما يمت بصلة لحياة الجيتو.
ولكن هل معنى هذا أن العناصر الأساسية لتكوينهم السيكولوجي تتناقض تماماً مع عناصر التكوين السيكولوجي للغالبية اليهودية الجيتوية؟!
لقد كان الإحساس بالتميز والإحساس بالاضطهاد، هما عنصري التكوين النفسي الرئيسيين لليهود آنذاك. ولقد وَجَدَ عنصر الإحساس بالتميز لدى الأغلبية اليهودية تعبيراً صادقاً عنه في تمسك هذه الأغلبية بالإقامة في الجيتو، وفي تمسك أفرادها بارتداء الشارات التي فرضت عليهم من قبل الأوربيين المسيحيين، حتى بعد أن أصبح في وسعهم الإقلاع عن كل ذلك بسبب حركات التحرر التي انتشرت في أوروبا في تلك الفترة. أما عنصر الإحساس بالاضطهاد فقد تجلى في أصرح صوره فيما عُرِفَ عن يهود الجيتو من استسلام وخضوع حيال الإجراءات الموجهة ضدهم.. لقد كان هذا هو حال الأغلبية، فماذا عن الأقلية؟! أي الحالوتس؟!
هل اختفى هذان العنصران، وحلت محلهما عناصر جديدة لدى هذه الفئة المتمردة على ثقافة الجيتو المذلة؟!
الأمر هو على العكس تماماً، فكل ما حدث أن هذين العنصرين، “الإحساس بالتميز” و”الإحساس بالاضطهاد”، قد أعيدت صياغتهما وأعيد إنتاجهما على الصعيد السيكولوجي في صورة جديدة تتناسب والظروف الجديدة، كما تتناسب واتجاهات التمرد لدى الحالوتس. فبدلاً من التميز المُذِل بالإقامة في الجيتو وبارتداء الشارات المميزة لليهود والمفروضة عليهم من مُذِلِّيهم، فليكن التميز، تميزاً عنصرياً هذه المرة، يقوم على تبني فكرة الامتياز العقلي لليهود، والدعوة إلى تفوق الجنس اليهودي ونبوغه. وبدلاً من الشعور بالاضطهاد المعبر عن نفسه في الخضوع والاستسلام للأمر الواقع، فلتتح الفرصة لهذا الشعور كي يعبر عن نفسه في صورة جديدة، تتمثل في الفرار من موطن الاضطهاد. أي ليكن هذا الشعور بالاضطهاد فراراً من الجيتو وفرارا من الاندماج في غير اليهود أيضاً. أي فراراً من النقيضين معاً، العزلة الاجبارية والاندماج الاختياري. وليكن التعبير عن ذلك من ثمة بإقامة نظام جديد في مكان ما، نظام متناقض مع نظام الانعزال الجيتوي من جهة أولى ومع نظام الاندماج التنويري من جهة ثانية.
التقط الفكر الصهيوني الرجعي، ومن ورائه الحركة الإمبريالية الأوربية متمثلة في الاستعمار البريطاني آنذاك، هذه النزعة الاضطهادية والعنصرية التي غذتها عناصر عديدة معظمها مصطنع ومقصود، وبُحث لها عن جذور تاريخية ودينية سبق أن ثار عليها هذا الفكر نفسه، عندما أراد أن يحارب مؤسسة الجيتو وما قامت عليه من دعاوى دينية وتاريخية، فاحتوى الحالوتس وجعل منهم مادة الهجرة إلى فلسطين، بعد أن جعلتهم الدعاية اليهودية الصهيونية أولاً والفعل الاستعماري المُغَذَّى سراً ثانياً، نهبا للحيرة والخوف. الحيرة من شكل التمرد المفترض والخوف من النقيضين المتاحين، الجيتو والاندماج.
ولكن هل تحقق الحلم الصهيوني بخلق مجتمعٍ يتمتع أبناؤه بتكوين سيكولوجي موحد في إسرائيل التي أريد لها أن تكون البوتقة البديلة لكل من مؤسسة الجيتو وفكر الاندماج؟! وبمعنى آخر هل يكفي توافر عنصري الشعور بالتميز والشعور بالاضطهاد لدى جيل الحالوتس للقول بأن التكوين السيكولوجي الواحد متوافر فعلا في إسرائيل، سواء لحظة التأسيس أو الآن أو مستقبلاً؟!
إن إسرائيل تضم اليوم جيل الحالوتس، وهو الجيل الذي نزح إليها من وسط وشرق أوروبا، مُسْهِماً بالفعل في إقامة هذا الكيان المُسَمى “إسرائيل”. والحالوتس الآن أقلية بالقياس لإجمالي عدد يهود ذلك الكيان، كما أن إسرائيل تضم علاوة على هذه الأقلية الحالوتسية التي تناقصت وستستمر في التناقص مع مرور الوقت، أغلبية يهودية ينتمي أبناؤها إلى أكثر من مائة قومية، تسود بينهم علاقات هي أقرب إلى الجفاء والعداوة والصدام منها إلى التفاهم والتوافق.
وإذن فإن وحدة وتكامل التكوين السيكولوجي للحالوتس – إن سلمنا بوجود هذه الوحدة أصلاً – لا تعني وحدة وتكاملاً في ذلك التكوين السيكولوجي للإسرائيليين المعاصرين الذين يضمون من نزحوا إلى إسرائيل في ظل ظروف مختلفة قطعا عن ظروف نزوح الحالوتس. فالتسليم بوجود عناصر مشتركة تلعب دوراً في التكوين السيكولوجي للإسرائيليين المعاصرين، لا يعني بأي حال التسليم بوجود وحدة وتكامل في ذلك التكوين السيكولوجي. إن جيل الحالوتس رغم أنه كان جيلاً متمرداً على أسلافه من سكان الجيتو، فإن العنصرين الأساسيين في تكوينه السيكولوجي هما نفسهما العنصران الأساسيان للتكوين السيكولوجي لأولئك الأسلاف. وما كان الاختلاف إلا في جوهر التعبير عن هذين العنصرين.
وإذن أفلا تتيح لنا هذه الملاحظة القول بإن القوميات المائة التي ينحدر منها الإسرائيليون سَتُغَذي المجتمع الإسرائيلي بمائة تكوين سيكولوجي حالي ومستقبلي هي امتداد سيكولوجي لمائة تكوين سيكولوجي مرجعي، لا يمكنها أن تتغير بين عشية وضحاها، ولا بين جيل وآخر أو حتى كما يقول علماء النفس، ولا بين قرن وآخر في الحالات الطبيعية للتغير في النفس البشرية؟..
فإذا كان التكوين السيكولوجي
للحالوتس هو نفسه التكوين السيكولوجي للجيتو الذي تمردوا عليه وكفروا به وخجلوا
منه، رغم ذهابهم إلى أرض الميعاد، فهل يُعْقَل أن يتغير التكوين السيكولوجي لليهود
القادمين إلى فلسطين من مائة مجتمع، ليس بينهم وبين أي منها تناقض جوهري كذلك الذي
حكم العلاقة بين الحالوتس والجيتو؟! [1]

أقراء أيضا الأوضاع السياسية للجماعات العرقية والدينية في إسرائيل
[1] الآراء الواردة تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات.