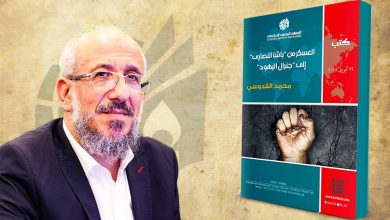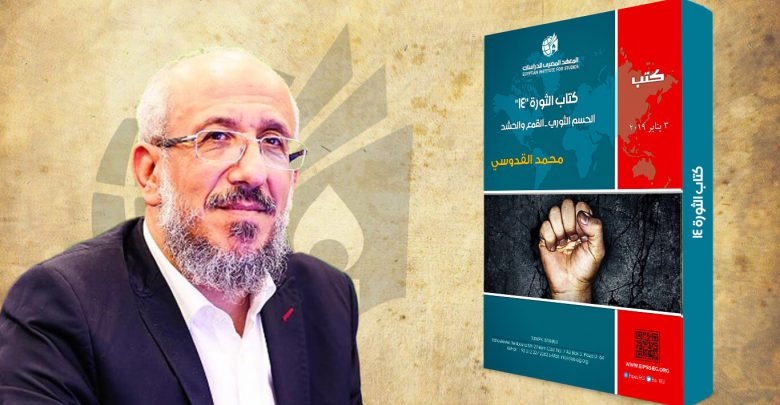
كتاب الثورة 14 الحسم الثوري ـ القمع والحشد
يعني “الحسم” نهاية مواجهة مصيرية بين “طغمة حاكمة” و”ثورة”، وبديهي أن كلا من طرفي المواجهة يملك فرصة الحسم لصالحه، حسب قدرته على إدارة عوامل الصراع، مع ملاحظة أن الحسم لصالح الطغمة يكون مجرد انتصار في “جولة”[1] أما الحسم لصالح الثورة فهو إعلان نهاية دولة [2] والشروع في إقامة دولة. وفي هذا الصراع تعول الطغمة على “القمع”[3] بينما تعتمد الثورة على “الحشد”.تعتمد الطغمة على “القمع” لإشاعة “الخوف”[4] بين الجماهير لتعطيل قدراتها وحسم المواجهة معها، وذلك على نحو ما ينصح به “ميكافيللي” في كتابه “الأمير” قائلا: “وهنا يقوم السؤال عما إذا كان من الأفضل أن تكون محبوبا أكثر من أن تكون مهابا، أو أن يخافك الناس أكثر من أن يحبوك؟ ويتلخص الرد على هذا السؤال في أنه من الواجب أن يخافك الناس وأن يحبوك ولكن لما كان من العسير الجمع بين الأمرين، فإنه من الأفضل أن يخافوك على أن يحبوك، هذا إذا توجب عليك الاختيار بينهما”.
ويصف ميكيافيللي الجماهير، التي تقف على جانبي المواجهة وصفا يليق بالعبيد (هكذا هم في عين الطغمة الحاكمة) قائلا لأميره: “إنهم ناكرون للجميل، متقلبون، مراءون ميالون إلى تجنب الأخطار، شديدو الطمع. وهم إلى جانبك طالما أنك تفيدهم فيبذلون لك دماءهم وحياتهم وأطفالهم وكل ما يملكون طالما أن الحاجة بعيدة نائية، ولكنها عندما تدنو يثورون. ومصير الأمير الذي يركن إلى وعودهم، من دون اتخاذ أي استعدادات أخرى، إلى الدمار والخراب.. ولا يتردد الناس في الإساءة إلى ذلك الذي يجعل نفسه محبوبا، بقدر ترددهم في الإساءة إلى من يخافونه.. إن الحب يرتبط بسلسلة من الالتزام التي قد تتحطم بالنظر إلى أنانية الناس عندما يخدم تحطيمها مصالحهم، بينما يرتكز الخوف على الخشية من العقاب، وهي خشية قلما تمنى بالفشل”[5].
القمع إذا، وفي حده الذي يلغي الإرادة، هو النصيحة التي يقدمها ميكيافيللي لأميره، مشيرا إلى ضرورة إبقاء ما يريده الناس بعيدا عنهم، حتى لا يطمعوا في الحصول عليه من الأساس، فهم سيثورون إذا ما شبعوا، بل إذا اقتربوا مما يشبعهم “جوع كلبك يتبعك”. كما يؤكد أن الخوف هو الأساس الأفضل للحكم، وليس الحب، فالحب يحتاج إلى الرضا، و”إرضاء الناس غاية لا تدرك” حيث إن حاجاتهم لا نهائية، تتعدد لا بقدر عددهم فحسب، بل بقدر حالاتهم أيضا، أما قمعهم فوارد دائما، بأقل تكلفة وبأبسط الأدوات.
لهذا فإنه، وخاصة في الدول التي لا تملك طموح التقدم، يكون الخوف هو الطريق الأسهل للسيطرة على الشعوب، والقهر هو الأساس الوحيد المحتمل لشرعية الحكم، ولا يمكن ـ في مثل هذه الدول التعويل على سد الحاجات (التي سيتفاقم العجز عن تلبيتها ـ في الواقع ـ جالبا المزيد من التخلف) [6].
ومن دون “جماعية المسؤولية والمشاركة” فإن غضب الجماهير، التي تدرك عجز السلطة عن تلبية حاجاتها لا يمكن مواجهته إلا بالقمع، حيث إن سيفا واحدا يكفي للسيطرة على رجل طول الوقت، بينما من المستحيل تقريبا إبقاؤه مطيعا عبر تلبية حاجاته، وهي ما يصعب عده من الطعام والشراب والدواء والمسكن والملبس ووسائل الانتقال والاتصال والترفيه، إلى غير ذلك من السلع والخدمات التي سيحتاجها طول حياته. ويشرح “فريدريك إنغلز” صورة الدولة هذه قائلا “وتوجد هذه السلطة العامة في كل دولة. وهي لا تتألف فقط من رجال مسلحين، بل كذلك من ملاحق مادية، من السجون ومختلف مؤسسات القسر التي كانت معدومة في المجتمع المنظم على أساس القبائل”[7].
ليضعنا أمام صورة مجردة للقوة، وإن تسمت دولة، وهي قوة تزداد انفصالا عن الجماهير لتزداد استعلاء عليها، وتزداد استعلاء لتزداد انفصالا، في دوامة ـ تبدو لا نهائية حتى تقاطعها الثورة ـ من التغذية والتغذية المرتجعة.
ومن المفارقات، وللمفارقات حضور طاغ في سياق الثورات، أنه وبينما يسود العجز وحده العلاقة بين طغمة حاكمة وجماهير تبادلها إياه، حيث الطغمة عاجزة عن تلبية حاجات الجماهير، والجماهير عاجزة عن إزاحة الطغمة، فإنه، وفي ظل غياب “الإرادة الثورية الواعية” تصل هيمنة الطغمة إلى قدرتها على فرض منهجها ودفع الجماهير إلى تبني أدواتها، لتصبح “القوة المسلحة” مجردة هي العنصر الأكثر حضورا عند الحديث عن “الحسم”، على نحو يتخذ مسارا، يطول أو يقصر، لكنه يضعنا في نهاية المطاف أمام فكرة “الانقلاب” الذي يمثل نقيضا للثورة وتهديداً للقائمين على السلطة، أو فكرة “الحرب الأهلية” التي يعني إطلاقها تأزيم الثورة وزيادة رثاثة الدولة.
ولا شك في أن تمكن الطغمة من فرض أدواتها على الجماهير هو نجاح مزدوج لها، من ناحية لأنها تظل الأقدر على استخدام هذه الأدوات، ومن ناحية أخرى لأن الجماهير بهذا تنصرف ـ كليا أو جزئيا ـ عن استخدام أدواتها هي، ما يعني تأجيل المشروع الثوري بالكامل، وتحقيق هدف “شراء الوقت” وهو مسعى دائم للطغمة.
على أن النظر إلى “القوة المسلحة” في صورتها المجردة باعتبارها أداة للطغمة لا يعني الإدانة ـ المجردة أيضا ـ لقوة السلاح، ولا استبعادها من دائرة خيارات الجماهير، لكنه يعني بوضوح التفرقة بين ما هو “أداة” وما هو “بنية”. وبديهي أن القوة المسلحة ـ كما أشرنا من قبل، وكما هو ملحوظ ومتداول ـ هي الركيزة الأساسية في بنية الدولة، حيث “الجنرال في القلب”، بل هي الركيزة التي تدور معها الدولة وجودا وعدما.
أما بالنسبة للثورة فإن السلاح مجرد أداة من أدوات نضالها، تكتسب أهميتها من طبيعة المرحلة والظرف الذي تمر به. السلاح هو “عمود خيمة” الجنرال الذي لا تقوم إلا به وتنهار بانهياره، بينما هو سيف معلق على أحد جوانب خيمة الثورة، فلا هو ـ لذاته ـ “مطلب” ولا هو “مستبعد”. وهو معنى يذهب إليه حتى “لينين” زعيم الثورة البلشفية (المسلحة) في كتابه “الدولة والثورة” حيث يقول: “من المعروف أن ماركس قد حذر العمال الباريسيين قبل الكومونة بعدة أشهر، في خريف سنة 1870، مبرهنا أن محاولة إسقاط الحكومة تكون حماقة اليأس. ولكن عندما فرضت على العمال المعركة الفاصلة في مارس سنة 1871، وعندما قبلها هؤلاء وغدا الانتفاض أمرا واقعا، حيا ماركس الثورة البروليتارية بمنتهى الحماسة رغم نذير الشؤم”.
وهنا يشير “لينين” إلى “نذير شؤم” لم يغب عن ماركس وهو يرى “اللجنة المركزية للحرس الوطني” المكونة من عمال باريس تعلن ـ بقوة السلاح ـ استلامها للسلطة في كل فرنسا، وهو ما أمكن هزيمته ـ بل سحقه ـ بقوة مسلحة أكبر استعان فيها العسكر المحليون بقوات الاحتلال البروسي. وحتى الاستدراك الذي يقدمه لينين بعد ذلك لا يملك أكثر من الثناء على “الخبرة التاريخية” و”الإضافة النظرية” التي قدمتها الكومونة، وهي خبرة وإضافة مفتاحهما معا هو “نقد التجربة” وطرحها كأمثولة لا تحتذى، حيث يقول لينين: “ففي هذه الحركة الثورية الجماهيرية، وإن كانت لم تبلغ الهدف، قد رأى خبرة تاريخية ذات أهمية كبرى.
وقد وضع ماركس نصب عينيه مهمة تحليل هذه الخبرة واستخلاص الدروس التكتيكية منها وإعادة النظر في نظريته على أساس هذه الخبرة. فـ”التعديل” الوحيد الذي اعتبر ماركس من الضروري إدخاله على “البيان الشيوعي” قد استوحاه من خبرة الكومونيين الباريسيين الثورية. إن آخر مقدمة لطبعة ألمانية جديدة من “البيان الشيوعي” وقعها مؤلفاه معا تحمل تاريخ 24 من يونيو/حزيران سنة 1872.
وفي هذه المقدمة يقول المؤلفان كارل ماركس وفريدريك إنغلز إن برنامج البيان الشيوعي “قد شاخ اليوم في بعض أماكنه”. وبوجه خاص برهنت الكومونة أن “الطبقة العاملة لا تستطيع أن تكتفي بالاستيلاء على آلة الدولة جاهزة وأن تحركها لأهدافها الخاصة”، حسبما قاله ماركس في كتابه “الحرب الأهلية في فرنسا””.
***
واستطرادا فإن الأكثر أهمية بين ما أكدته خبرة “الكومونة” هو أن “الحشد” ركن الثورة وسلاحها الذي توجد بوجوده وتغيب بغيابه، حيث إن اقتصار الحشد على باريس وحدها، برغم إعلان اللجنة المركزية للحرس الوطني استلام السلطة في فرنسا كلها في أول بيان لها، أدى إلى وضع “الكومونة” وهي في لحظة الميلاد، على طريق النهاية، التي يراها ابن خلدون نتيجة تمدد الدولة إلى أطراف لا يستطيع المركز أن يدافع عنها. وكان غياب التنظيم “الحزب” الثوري هو الخطأ الفادح الآخر.
ولأن “الشيء بالشيء يذكر” تجب الإشارة إلى أن كل التجارب التي قامت في ظل الربيع العربي لم تنجح حتى في الوقوف عند حدود خطأ كومونة باريس، ناهيك عن الاقتداء بصوابها. فلا هي نجحت في قطع الصلات بينها وبين سلطة الجنرال، ولا سعت لإقامة سلطة الثورة، ولا نجحت في تحقيق الحد الأدنى من الحشد، بل إنها لم تسع ـ منذ البداية وطوال الطريق ـ إلى تكوين حشد ثوري حقيقي، مكتفية بمحاولة الالتحاق بنخبة الجنرال (دائرة أقلياته) والانتساب إلى مؤسساته.
وفي مصر تجلى هذا في تنصيب “المجلس العسكري” رئيسا في ظل حراك ثوري يهتف “يسقط حكم العسكر”! ما ضمن للجنرال أن يبقى في القلب برغم “الثورة” وهتاف حراكها، كما أدى تمرير أقليات الجنرال المتساندة تحت مسمى “الأحزاب والقوى السياسية” إلى تمكين هذه الأقليات لا من البقاء فحسب، بل من إعادة إنتاج جنرالها في نسخة أسوأ. كما أن هذه الأحزاب ـ غير الحقيقية والمصنوعة سلطويا ـ ذات التمثيل الأسوأ في الميادين، والتي لم تخض انتخابات، فرضها العسكر بديلا عن الجماهير عبر تمثيلها في مؤتمرات وهيئات، مؤقتة ودائمة، أشهرها ما سمي “المجلس الاستشاري” ووصف بأنه “المساعد للمجلس العسكري”، وبهذا تمكن العسكر من “ترميم” الركن الثالث من أركان دولة الجنرال، ركن “استبعاد الأغلبية”.
إجمالا قطع ائتلاف أحزاب “الثورة المضادة” وحركاتها السياسية، التي لا يحمل أي منها شرعية الثورة ولا ينتمي إليها، الطريق أمام إمكانية قيام حزب ثوري، يحمل على عاتقه مسؤولية نشر الوعي وتنظيم الجماهير، ولما كان الحزب هو شطر المقومات المادية للحشد، حيث الجماهير هي الشطر الآخر، فإن قطع الطريق أمام قيام الحزب صادر إمكانية تكوين الحشد، لتظل “الثورة” حبيسة حراك باهت، من دون رؤية ولا وعي ولا قيادة، بل مجرد “جموع” تهتف مرددة ما تسمعه عبر “مكبر الصوت” مع افتقارها إلى الحد الأدنى من القيم المعنوية للحشد، والتي يلخصها وعي يدرك طبيعة الصراع ومنطلقاته وتحيزاته ومقوماته وأدواته، مع إدراك معطيات اللحظة والخيارات المتاحة، وترتيب هذا كله من ركائز الأساسي إلى تفاصيل الثانوي.
ولا عجب أن تخلو انطلاقة “الحراك الثوري” من حشد يحركه وعيه الجمعي الناضج ويقوده تنظيم، فالثورات ـ عموما ـ تنطلق عفوية، وفي هذا السياق يمكن الاستشهاد بانطلاقة الثورة الفرنسية مع هدم سجن الباستيل، وبداية الثورة الروسية (1905م) باشتباك دموي بين جيش القيصر ومعه الشرطة من جهة، وبين محتجين بينهم رجال ونساء وحتى أطفال من جهة أخرى، يقودهم الكاهن غابون، الذي سرعان ما انكشف أمره واتضح أنه كان عميلا للقيصر دوره هو دفع الجماهير إلى أتون ثورة، بانت نذرها، قبل أن يتهيأوا لها، حتى تجهض الثورة قبل أن يكتمل جنينها، وهو مسار يشبه، من هذه الزاوية، انطلاق الحراك الثوري في مصر إلى أعلى درجات التشابه.
لا عجب أن تخلو انطلاقة “الحراك” من حشد ثوري، فإضراب سان بطرسبورغ الجماهيري في يناير/كانون الثاني 1905، والذى تطور إلى مسيرة لقصر الشتاء، بدأ رفضا للاستغناء عن عاملين في مصنع، ثم تتالت الأفعال الجماهيرية من دون استعداد مسبق، ولا خطة ولا دعوة من حزب أو تنظيم، بل اعتمادا على المبادرة وما أبدته الجماهير من تضامن وشجاعة واستعداد هائل للتضحية، وكانت استغاثتهم ـ شديدة السذاجة ـ بالقيصر تؤكد أن هذا الحراك العفوي كان “مجرد أعلى نقطة فى خمس سنوات من الغليان قضتها روسيا مشتعلة بالإضرابات الجماهيرية” كما تقول “روزا لوكسمبورغ” وكما يمكن في المقابل أن نقول عن حراك 25 من يناير 2011 إنه كان “مجرد أعلى نقطة فى سبع سنوات من الغليان قضتها مصر مشتعلة بالاحتجاجات الجماهيرية”.
الثورة ـ في شرارتها الأولى ـ تنطلق عفوية، لكن قدرتها على إحداث “التغيير الجذري في بنية المجتمع” تولد مع امتلاكها لسلاحها الأساسي “الحشد” الذي هو ـ باختصار ـ تيار جارف من الجماهير الواعية المستعدة للتضحية في سبيل تحقيق هدفها المحدد، بقدر ما يحتاجه الإنجاز من بذل. وفي هذا السياق تجري الموازنة بين استخدام مختلف أدوات الصراع، من المسيرة الصامتة إلى الكفاح المسلح، مع تأكيد أن أيا منها مجرد “أداة” بيد “الحشد” وليست بديلا له، فالحشد (بقيمه المعنوية ومقوماته المادية) هو الذي ينطلق في المسيرة الصامتة، وهو الذي يردد الهتافات، وهو الذي يحتل الميادين، ويحمل السلاح.
وكان غياب الحشد هو “كعب أخيل” الربيع العربي، نتيجة عدم الوعي بحتمية إقامة التنظيم الثوري، لإدارة الثورة باعتبارها: عملا يوميا، وعملا جماهيريا واسعا، وعملا يدويا بمعنى الممارسة على الأرض وليس في أفق الفكرة فحسب، ما يستوجب التعامل مع الظروف القائمة باستثمار المناسب والعمل على تغيير المعاكس منها، وهي المهمة الأكثر أهمية بين مهام التنظيم الثوري، التي تتضمن أيضا صياغة الأطر الفكرية للحراك، ونشر الوعي، وتنظيم الحشد، وكلها مهام لا يمكن إنجازها إلا في وجود تنظيم جماهيري حقيقي قادر على النهوض بعبئها، وليس مجرد “إطار شكلي” لا يمكنه تكوين حشد لم يلتفت إليه من الأساس، وعجز حتى عن الحفاظ على تظاهرات الهتاف خلف “مكبر الصوت”!
لم ينجح الربيع العربي في تكوين الحزب الثوري القادر على استيعاب وإعادة تشكيل تناقضات الصراع لصالح الجماهير، ما جعل الكفة تحافظ على ميلها لصالح الطغمة التي تعتمد على سلطة تملكها بالفعل، بينما تراهن الجماهير على حشد لم تفكر في خلق أدوات الوصول إليه. كما تمتلك الطغمة مؤسساتها المحصنة إلى حد كبير، برغم تصدعها، والقادرة على اختراق صفوف الجماهير (بحكم بقائها من دون مؤسسة)، بينما الجماهير لا تملك مؤسساتها ولا حصانة لصفوفها. وتستخدم الطغمة سلطتها القائمة فعلا، مقابل أن الجماهير ليس لها إلا تجاوز حشدها “الكتلة الحرجة” ليكون مؤثرا، بينما هي لم تقطع الخطوة الأولى على طريق تكوين هذا الحشد بعد![8]
وتمتلك الطغمة أدوات “القهر” ويمكنها تجاوز العقائد والأعراف والتقاليد، أما نصوص الدستور والقانون فليست أكثر من “خرقة” تمحو بها أدلة جرائمها، مقابل التزام الجماهير في حراكها بثوابت “العقل الجمعي” من عقائد وأعراف وتقاليد وقانون. وهي نقاط يعكس ظاهرها تفوقا ساحقا للطغمة، لكنها ـ في الوقت نفسه ـ تنطوي على نقائضها: فالوقت الذي تشتريه الطغمة عبر الإجهاض المستمر لمعطيات الحشد هو نفسه الوقت الذي يؤدي مروره إلى إنهاكها وكشف قدرتها المحدودة على حشد الأنصار مقابل القدرة غير المحدودة للجماهير. والانتهاكات المتتالية للثوابت المجتمعية تزيد من عزلة الطغمة وتضاؤلها وتآكل أطرافها (التي تحترق بنيران انتهاكاتها). وكما نرى فإن استثمار هذه التناقضات لصالح الجماهير وإدارتها لصالح الثورة رهن بوجود المؤسسات القادرة على هذا، وهي الأحزاب الثورية، التي يفسر غيابها ـ حتى الآن ـ حالة الفوضى العارمة التي يغوص فيها الربيع العربي.
ومنذ 11 من فبراير/شباط 2011 (يوم وقوع الانقلاب المتفق عليه وتسليم السلطة للمجلس العسكري) إلى الآن يبدو المشهد في مصر أشبه بفريق لكرة السلة نجح ـ في الثانية الأولى من المباراة ـ في تحقيق رمية ثلاثية نادرة بقذف الكرة من أول الملعب إلى آخره (من السلة إلى السلة) فظل طوال المباراة يحاول تكرار الرمية نفسها غير ملتفت إلى أن فشله في إصابة الهدف لا يرجع إلى “سوء الحظ” ولا إلى وجود مؤامرة ضده، ولا لمهارة الفريق المنافس، لكن السبب ـ ببساطة ـ هو أن كرة السلة لا تلعب بهذه الطريقة.
الهامش
[1] ذلك أن الطغمة لا تستند إلى دولة قائمة أو تسعى إلى قيامها، فدولتها التي ولدت في ظلها سقطت ولم تعد قابلة للترميم ولا للاستمرار في الحياة، وهكذا تظل الطغمة في العراء، تستهلك “مخزون القوة” غير القابل للتجدد الذي تمتلكه، أو تتلقى مساعدات من خارجها، حتى ينفد هذا ويتوقف ذاك
[2] هي تلك الدولة التي سقطت وتحللت من قبل، وعبثت رياح الثورة بأشلائها
[3] القمع هو فرض أمر واقع خارج “العقد الاجتماعي” اعتمادا على أدوات السلطات: التنفيذية (العنف المسلح)، والقضائية (التلفيق والجور والانحراف بالأحكام، والتشريعية (سن قوانين هدفها حماية “التسلط” وليس إقامة العدل)، والإعلامية (التضليل والتشهير)، والاقتصادية (الاحتكار والاستغلال وسوء التوزيع).
[4] يمكن اختصار دوافع السلوك الإنساني في دافعين أساسيين: حفظ الذات، وحفظ النوع. وكلاهما يقوده الخوف، حيث حفظ الذات يحركه الخوف من الموت، وحفظ النوع يحركه الخوف من الفناء.
[5] يقول الأديب السوري “أحمد الهواس” في تعليق نشره على فيسبوك: حين تمّت السيطرة المطلقة لحافظ أسد بعد مجازر حلب وتدمر وحماة، فإن أول شيء فعله للشعب (المستكين) هو طحنه بالبحث عن الأشياء الرئيسة، فأينما تتجه ببصرك تجد الناس طوابير على الأفران، طوابير عند المؤسسات، كل شيء مفقود وبالقطارة، مع إطلاق كلاب الأمن يفعلون ما يريدون، ويبثون الرعب في النفوس. وهكذا بقي الشعبُ في بحث عن لقمة عيشه قانعًا بما يناله حتى لا يكون حاله كحال من قال لا، وقد ارتسمت صورة سجن تدمر أمام عين كل مواطن! حتى منّ “الأب القائد” عليهم بعد ثمانية أعوام بإصدار قانون الاستثمار حيث سمح للقطاع الخاص باستيراد السمن والزيت والسكر والشاي ومواد البناء! وها هو بشار يقرأ من كتاب أبيه وأول شيء بدأ به إعادة الشعب “المتجانس” لحياة الطوابير بانتظار الحصول على أساسيات الحياة، مرددًا حكمة أبيه: جوّع شعبك يهتف لك بالروح بالدم! ممثلة في القوة المسلحة (العسكر والشرطة) ومنصات القضاء، وسلطة إصدار القوانين، والإعلام، والهيمنة على المرافق والوظائف والتجارة، وقيمة المدخرات وأسعار السلع.
[6] إن مسلحا واحدا يمكنه أن يسيطر على مئات المحرومين رغم حرمانهم، بينما هم يحتاجون ـ لتغطية حاجاتهم الأساسية ـ إلى مئات أضعاف تكلفة المسلح
[7] كمستثمر يسعى إلى إقامة مشروع تكلفته الحدية مليون دولار بينما هو لا يمتلك دولارا واحدا ولا هو يسعى إلى هذا
[8] هي حيلة “الجادون” أو “مقود الدراجة” تتكرر مرة أخرى، إذ كانت مصر كلها تبحث ـ بلا جدوى ـ عن صورة “الجادون” تحت أغطية زجاجات المياه الغازية، لتضعها مع صور بقية الأجزاء التي جمعتها وتربح الدراجة. وراح الملايين يندبون حظهم العاثر، وهم يعبون أطنان المياه الملوثة تحت مسمى “كولا” ولا يجدون “الجادون”، غير متفطنين إلى أن الصورة غير موجودة أساسا، وأن الدراجات لا تختبئ تحت أغطية الزجاجات، وأن بعضهم كان بوسعه شراء دراجة بالأموال التي أنفقها بحثا عن “الجادون”، الذي لم تجده مصر، لكنها وجدت زيادة في أمراض الكلى والكبد والمعدة والقولون نتيجة شرب كل هذه المياه الملوثة!