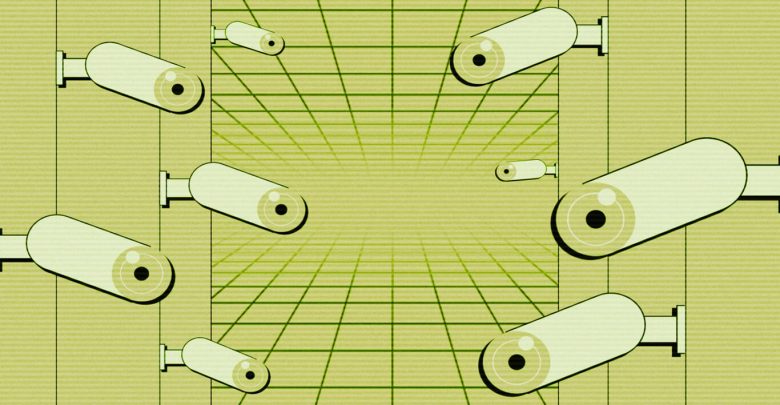
الإعلانات الموجهة تدمر الإنترنت وتمزق العالم
نشر موقع مازر بورد، وهو منصة إلكترونية متخصصة في الوسائط المتعددة، تقريراً أعدته الدكتورة ناتالي ماريشال، كبير الباحثين في مركز “تصنيف الحقوق الرقمية”، بعنوان “الإعلان الموجه يدمر الإنترنت ويكسر العالم”. وقد قام المعهد المصري بترجمة التقرير كاملاً على النحو التالي:
أصبحت “رأسمالية المراقبة” والإعلانات الموجهة هي الأساس على الإنترنت، وهي تؤذينا جميعاً
في شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في الربيع الماضي، شدد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، على أن شركته لا تبيع بيانات المستخدمين، كما لو أنه كان يريد طمأنة صانعي السياسة والجمهور بهذه الكلمات. لكن الحقيقة – أن فيسبوك، وجوجل، وتويتر، وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى تبيع حق الوصول إلى مواضع اهتماماتنا – وهو أمر يثير القلق. وقد لا تنتقل معلومات المستخدم الفعلية إلى أيدي أطراف أخرى، ولكن النموذج الذي تبرزه أعمال الإعلانات يقود عملية صنع القرار في الشركات في نهاية المطاف إلى مسارات تُشكل خطورة شديدة على المجتمع. وكما قالت عالمة الاجتماع زينب توفيكجي في حديثها عن “تيد” (وهي فيديوهات قصيرة مركزة تناقش قضايا في التكنولوجيا والترفيه والتصميم ومجالات أخرى) لعام 2017: “نحن ندفع المجتمع إلى عواقب مأسوية لمجرد جعل الناس ينقرون على مثل هذه الإعلانات”.
وتُعتبر شركات التواصل الاجتماعي في الحقيقة هي مجرد شركات إعلان. وبالطبع لم يكن هذا سراً في يوم من الأيام. وكانت شركة جوجل رائدة في نموذج الأعمال الإعلانية الموجهة منذ أواخر التسعينيات؛ ثم قامت شيريل ساندبرج بإدخال هذه الممارسة إلى فيسبوك في عام 2008 عندما انضمت إلى الشركة على رأس فريق التشغيل فيها. وظلت السيولة تتدفق، واعتمدت الشركات في جميع أنحاء “سيليكون فالي” (وهي منطقة شمال كاليفورنيا في وادي سانتا كلارا تعد موطناً لعدد كبير من الشركات المبتكرة من الناحية التكنولوجية بما في ذلك أبل وجوجل وفيسبوك ونيتفلكس) وخارجه نفس الاستراتيجية الأساسية التي تتلخص في:
أولاً، تنمية قاعدة المستخدمين بأسرع ما يمكن دون القلق بشأن العائدات؛
ثانياً، جمع أكبر قدر ممكن من البيانات حول المستخدمين؛
ثالثاً، تحقيق الدخل من هذه المعلومات عن طريق إجراء تحليلات البيانات الكبيرة من أجل إظهار الإعلانات التي تتناسب مع اهتمامات المستخدمين المعلنة وخصائصهم الديموجرافية؛
رابعاً، جني الأرباح.
كان ذلك يبدو لفترة وكأنه بمثابة تحقيق مكاسب للجميع: فالناس في جميع أنحاء العالم يمكنهم مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالقطط – على سبيل المثال – ورؤية صور أطفال بعضهم البعض وهم يرتدون أزياء الهالوين؛ ويمكنهم التواصل مع العائلة، والأصدقاء، والزملاء في جميع أنحاء العالم، وأكثر من ذلك بكثير. وفي المقابل، ستعرض الشركات لهم إعلانات ذات صلة بها فعلاً من خلال رصد اهتماماتهم المختلفة. وقد دعمت الإعلانات السياقية الموجهة وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية على مدى عقود، لذا كانت هذه هي الخطوة المنطقية التالية.
أين إذن يمكن أن يكمن الخطأ؟
هناك كثير من مواطن الخطأ، كما اتضح فيما بعد. ومن النتائج التي وصلنا إليها مؤخراً، تبرز ثورات الربيع العربي وكأنها أيقونة لرسالة تحذيرية عما يمكن وصفه بمدينة التكنولوجيا الفاضلة التي اتخذت في النهاية المسار الخاطئ ولم تحقق نتائج تُذكر على أرض الواقع. كان الثوار، والمصلحون، والمدافعون عن حقوق الإنسان بكل تأكيد من بين أوائل من أدركوا القوة التي تمثلها ما اعتدنا على تسميته بـ “ويب 2.0″، لكن السلطات أدركت ذلك بسرعة واستخدموا الأدوات الجديدة للقضاء على التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها عروشهم. وبنفس هذه الطريقة، كانت حملة أوباما للانتخابات الرئاسية عام 2008 هي الأولى التي سخرت الإعلان عبر الإنترنت لإيصال الرسالة الصحيحة التي يريدونها إلى الناخبين المناسبين بدقة متناهية؛ ولكن بعد مرور 10 سنوات، رأينا كيف أن نفس هذه الأساليب دفعت بالسلطة اليمينية السلطوية إلى سُدة الحكم في الولايات المتحدة، والفلبين، والبرازيل؛ واستخدموها في إذكاء نار رُهاب الأجانب، والكراهية العنصرية، وحتى الإبادة الجماعية في جميع أنحاء العالم، والتي كانت أشد تدميراً في ميانمار. فكيف بالله عليكم وصلنا إلى هذا الحد؟
بدأ الأمر كله بالإعلانات الموجهة. وتماما مثلما ابتكرت الشركات التي ازدهرت في القرن العشرين مثل جنرال موتورز وفورد “الإنتاج الضخم” و”الرأسمالية الإدارية”، ففي ظل النظام الاقتصادي الجديد تم ابتكار ما تُطلق عليه شوشانا زوبوف، الباحث في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، “رأسمالية المراقبة”، حيث نجحت جوجل وفيسبوك في تسويق “واقع الناس” نفسه واستخدموه كسلعة تباع وتُشترى، وذلك من خلال تتبع ما يفعله الناس (وليس فقط مشتركيهم) عبر الإنترنت (وامتد ذلك مؤخراً ليشمل تتبع المستخدمين حتى لو كانوا غير متصلين بالإنترنت)، مما يتيح التنبؤ بما قد يفعلونه في المستقبل؛ ثم ابتكار طرق للتأثير على السلوك من حيز التسوق إلى حيز التصويت في الانتخابات، وبيع تلك الميزة القوية لمن يرغب في الدفع.
قالت لي زوبوف في مقابلة أجريتها معه عبر الهاتف: “نحن كمجتمعات، لم نتفق في يوم من الأيام على أن يتم استغلال تجاربنا الخاصة وتحويلها إلى بيانات سلوكية؛ حيث يتم إدخال الكثير منها ضمن عمليات التصنيع التي تعتمد في الأساس على التنبؤات السلوكية لمستخدمي الإنترنت”.
ويناقش كتاب زوبوف الجديد: “عصر رأسمالية المراقبة – الكفاح من أجل مستقبل إنساني على تخوم السلطة الجديدة” عشرين عاماً من تاريخ رأسمالية المراقبة، منذ بداية تفعيل الإعلان عبر الإنترنت في أواخر التسعينيات وحتى عصر التراجع الديمقراطي في وقتنا الحاضر. وقالت زوبوف: “لقد تم اختراع رأسمالية المراقبة في سياق الإعلانات الموجهة”. وأضافت: “كان هذا هو السياق المادي والتاريخي الذي نشأت فيه في لحظة من لحظات الطوارئ المالية أثناء انهيار شبكة الدوت كوم. كانت جوجل شركة ناشئة آنذاك، وكان مستثمروها يهددون بتحميل التكاليف (على المستخدمين) على الرغم من وجود محرك البحث فائق القدرة. ولكن جوجل اتجهت عوضاً عن ذلك إلى سجلات البيانات التي كانت تتجاهلها سابقاً وقامت بإعادة توجيهها واعتبارها كـ “فائض سلوكي” (عن المشتركين والمستخدمين) يمكن استخدامه والتربح من ورائه؛ ولكن بدلاً من استخدام هذه البيانات السلوكية من أجل تحسين المنتج، فقد تم توجيهها نحو هدف جديد تماماً وهو: التنبؤ بسلوك المستخدم”.
وتتنبأ زوبوف أنه إذا تُركت “رأسمالية المراقبة” دون رقيب، فإنها ستكون مدمرة مثلما كانت المتغيرات السابقة للرأسمالية، وإن كانت بطرق جديدة تماماً. وقالت: “نحن نتحدث عن القيام من جانب واحد باستغلال تجربة إنسانية خاصة كمادة خام لتطوير المنتجات وتبادل السوق”، وأضافت “إن الرأسمالية الصناعية أساءت استخدام الطبيعة لمصلحتها، والآن فقط نحن نواجه عواقب ذلك التصرف. وفي هذه المرحلة الجديدة من تطور الرأسمالية، فالمادة الخام هنا هي الطبيعة البشرية التي يتم استخدامها في دفع ديناميكية جديدة في السوق، حيث يتم في البداية الإفصاح عن التنبؤ بسلوكنا ثم يتم بعد ذلك بيعه. إن الضرورات الاقتصادية لهذه الرأسمالية الجديدة تنتج تناقضات شديدة في المعرفة والقوة التي تتراكم من خلال تلك المعرفة. وتُعتبر هذه سابقة خطيرة لها عواقب وخيمة على المجتمع في القرن الحادي والعشرين”.
إن التتبع عبر الإنترنت موجود في كل مكان، وقد أبلغني تيم ليبرت، من معهد الأمن والخصوصية السيبرانية، التابع لجامعة كارنيجي ميلون، في رسالة عبر البريد الإلكتروني أنه: “بين كل مليون موقع من تلك المواقع الأكثر تداولاً، سيتم تتبعك على 91% منها. لقد كنت أقوم بهذا النوع من عمليات المسح لسنوات وكانت النتائج التي أحصل عليها تتكرر دائماً: لا يمكنك تصفح الويب دون ان يتم تتبعك. فتقوم الشركات بتتبعك عند زيارة مواقع طبية أ ومواقع إباحية أو مواقع إليكترونية للمحامين أو مواقع للسياسيين أو مواقع صحفية، وينطبق نفس الشيء على التطبيقات المختلفة التي يتم تحميلها واستخدامها. وهناك عدد قليل جدا من الأشياء التي لا يبحث عنها الناس أو يتشاركون في استخدامها من خلال جهاز الكمبيوتر والتي تفلت من إمكانية التتبع؛ حيث يتم تعقب كل شيء تقريباً، طوال الوقت، من قِبل الشركات العملاقة التي يُقدر رأسمالها بمليارات الدولارات والتي تراها في نشرات الأخبار بالإضافة إلى مئات الشركات التي لم تسمع بها من قبل”.
تقوم الشركات بجمع هذه المعلومات من أجل استثمارها: في حين قد لا نرى نحن قيمة كبيرة في نقاط البيانات الفردية حول سلوكنا، إلا أنها في مجموعها تضيف مبالغ كبيرة لمن يقومون باستغلالها.
فعندما تزور صفحة ويب تستضيف محتوى إعلانياً، تختار شبكة الإعلانات – على سبيل المثال في شركة جوجل من خلال النقر مرتين – تختار بين عرض عدة إعلانات عليك. ونظراً لأن جوجل تعرف الكثير عنك وعن أصدقائك وأذواقك وعاداتك وقوتك الشرائية، فإنه بمجرد النقر المزدوج يمكن للشركة تحديد الإعلان الذي من المرجح أن تختار النقر عليه وكذلك المنتج الذي يُتوقع أن ترغب في شرائه.
وقال ليبرت “هذا بعض ما يحققه الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لهذه الشركات: الحصول على النتائج الأفضل في مجال توقع وتحديد الإعلانات التي يمكن إظهارها لك”. “فكل جزئية صغيرة من البيانات تزيد من فرص عرض الإعلان”المناسب”، ولذلك فهم لا يتوقفون أبداً، ولا ينامون أبداً، ولا يحترمون خصوصيتك أبداً لتحقيق أهدافهم – وفي كل يوم فإن جميع موظفي شركة جوجل يعملون بشكل جماعي من أجل هدف واحد وهو: الوصول إلى نسبة مئوية أفضل في مجال الإعلانات “الصحيحة” التي يتم عرضها على المستخدمين مهما كانت هذه النسبة متدنية”.
ويكاد يكون من المستحيل أن نعرف على وجه الدقة كيف أن “آلة التأثير الرقمي” هذه، كما وصفها تقرير حديث لمركز أبحاث “البيانات والمجتمع”، تعمل في حالة معينة على وجه التحديد، تماماً مثلما هو من المستحيل معرفة كيف يساهم تغير المناخ في حدوث أعاصير في وقت محدد؛ لكن العلاقة على وجه العموم في ذلك واضحة ولا يمكن إنكارها.
وقد ذكر جوان دونوفان، المختص بالبحث في التلاعب بوسائل الإعلام ومحاسبة المنصات الإعلامية في مركز أبحاث “البيانات والمجتمع” في رسالة عبر البريد الإليكتروني أنه: “في ظل تكنولوجيا الإعلانات، تغيرت الاتصالات السياسية بشكل كبير”، وأضاف: “إذا كنا نبحث عن ثورة رقمية، فإن ذلك قد حدث بالفعل من خلال الإعلان عبر الإنترنت. فمعظم الإعلانات عبر الإنترنت غير خاضعة لأية قواعد تنظيمية ولا يتم إدارتها من هذه الناحية بشكل كامل. لقد أدرك صانعو الاستراتيجيات السياسية هذه الفرصة الجديدة واستفادوا منها من خلال تقديم المعلومات الرقمية في استخدام الإعلانات كنظام للتسليم. ولا يمكن لأي سياسي أن يدير هذه الحملات بشكل أخلاقي في ظل هذه الظروف لأنه في الوقت الذي سينشغل فيه بذلك سيتم استهدافه من قِبل أولئك الذين هم على استعداد لاستخدام هذه الأنظمة من أجل إلحاق الضرر بالآخرين.
وفي نقل النموذج التقليدي للأعمال التجارية القائمة على الإعلانات، أهملت شركات الإنترنت تبني قاعدة شديدة الأهمية وهي: الفصل بين العمليات التجارية وما يخص القرارات التحريرية. فعلى الرغم من أن هذه القاعدة كانت بعيدة كل البعد عن أن تحظى باحترام عالمي، فإن مدونة القواعد الأخلاقية للصحافة في القرن العشرين حظرت أن تؤثر الاعتبارات المالية على التغطية الإخبارية؛ بينما سمحت هذه القاعدة الأخلاقية للرأسمالية الأمريكية بدعم الصحافة، مما ساعد بدوره على الحفاظ على مصداقية الحكومة والشركات: في تحقيق الضوابط والتوازنات أثناء أدائها لعملها.
ولكن كل ذلك تلاشى مع الإعلان المستهدف، الذي سرق أموال الصحافة واستخدمها في الحفاظ على المنصات التي لا تهدف في الأساس إلى التعليم، أو الإعلام، أو مساءلة أصحاب النفوذ؛ بل تستهدف إبقاء الناس في حالة “اشتباك” وانشغال دائم. ويتم تحفيز منطق “الاشتباك” هذا من خلال أمرين مقترنين هما: جمع المزيد من البيانات وإظهار المزيد من الإعلانات، ويتجلى ذلك المنطق في خوارزميات حسابية تفضل الانتشار وتحقيق الشهرة على حساب الجودة والقيمة. وفي خلال أقل من 20 عاماً، استبدل وادي السليكون تحكيم التحرير بمقاييس حسابية من أجل تحقيق الشعبية والانتشار، وزعزعة الاستقرار في الأنظمة الديمقراطية التي تضمن تحقيق الضوابط والتوازنات من خلال إعاقة السلطة الرابعة، ودقت مسماراً تلو مسمار في نعش الخصوصية.
ويحفز نموذج الأعمال الإعلاني الموجه الشركات على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عما يفعله مستخدموها على منصاتهم نفسها وما يفعلونه في أي منصات أخرى على الإنترنت؛ حتى إن جوجل وفيسبوك يتابعون ما يفعله الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات إليكترونية لديهم، ويستخدمون تلك المعلومات في نمذجة البيانات الخاصة بهم وعرض إعلاناتهم عبر الويب. وفي الآونة الأخيرة، بدأوا كذلك في شراء بيانات حول مشتريات المستخدمين من خلال بطاقات الائتمان وغيرها من الأنشطة الأخرى غير المتصلة بالإنترنت. وتحتوي هذه الملفات الرقمية على معلومات تكشف عن كل واحد منا بشكل فردي وعنا جميعاً بشكل إجمالي. ولذلك فليس من المستغرب أن تتوق الحكومات إلى الحصول على تلك البيانات. فعلى سبيل المثال، احتوى ما كشفته شركة إدوارد سنودن (للكمبيوتر) لعام 2013 على تفاصيل حول العديد من البرامج التي تستخدمها وكالة الأمن القومي الأمريكية، بما في ذلك برنامج “بريزم” الذي تقوم وكالة الأمن القومي الأمريكية من خلاله بالحصول على البيانات من شركات التكنولوجيا الكبرى، سواء بعلمها أو بدون علمها. ويمكن العثور على علاقات مشابهة بين شركات التكنولوجيا (بما في ذلك شركات الاتصالات) والجهات الفاعلة التابعة للدولة في الدول الأخرى أيضاً. وتشمل الأضرار التي تلحق بحقوق الإنسان المراقبة والتصنت خارج نطاق القضاء، والتنكيل، وإلحاق الأذى الجسدي، فضلاً عن الآثار المخيفة الناجمة عن إدراك هذه المخاطر.
وعلى مستوى المجموع، يقوم الإعلان المستهدف بأتمتة التمييز (تفعيله بشكل آلي) وتطبيعه حتى يحقق النتيجة التي يرغبها المعلن من المعادلة تأسيساً على قاعدة التحيز الفردي. وكما يبين كريس جيليارد في مقال أخير له، فإن “رأسمالية المراقبة تتحول إلى ربح من خلال جعل الناس أكثر تقبلاً للتمييز، ويتجلى ذلك من خلال ممارسات مثل التمييز الرقمي في الخدمات (وهو مصطلح يُستخدم في الولايات المتحدة ليدل على ممارسة تمييزية تتمثل في رفض تقديم الخدمات، إما بشكل مباشر، أو من خلال رفع الأسعار بشكل انتقائي على المستهلكين)، والتسعير التفاضلي، والنتائج العنصرية للبحث، وفلترة شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت صفية نوبل، الأستاذة المساعد في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس ومؤلفة كتاب “خوارزميات الاضطهاد”، في رسالة تلقيتها منها عن طريق البريد الإلكتروني: “نحن نعتمد على محركات البحث التجارية لفرز الحقيقة من الخيال؛ ومع ذلك، فإن هذه المحركات أيضاً غير موثوق بها للوصول إلى الحقيقة في العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية. وفي جوهر الأمر، فإننا نشهد انعداماً تاماً في الثقة في المنصات الإلكترونية في الوقت الذي تُعتبر فيه هذه المنصات أكثر القوى تأثيراً في تقويض أو حماية المثل الديمقراطية في جميع أنحاء العالم”.
إن الإعلانات الموجهة تجعلنا ننظر إلى الإنترنت، وبالتالي إلى العالم كله، بطرق مختلفة بناء على ما تعتقد رأسمالية المراقبة أنها تعرفه عنا. وهذا بالتأكيد ليس وصفة من أجل العدالة والمساواة، أو من أجل تحقيق مجتمع عادل على الإطلاق.
وأخيراً، فإن الإعلانات الموجهة والممارسات الحسابية المرتبطة بها تضر بالديمقراطية نفسها. لقد أدى التحول في الإعلان إلى النظام الرقمي إلى تدمير إيرادات وسائل الإعلام، وبالتالي إضعاف المجال العام بأكمله. كما أن ربط الإعلانات بنسب المشاهدة للصفحات يحفز المؤسسات الإعلامية على إنتاج مقالات تؤدي أداءً جيداً من أجل رفع نسب المشاهدة، ويكون ذلك أحياناً على حساب المواد التي تقدم التعليم، أو التسلية، أو التي تُحمل أصحاب السلطة المسؤولية. وتوفر الإعلانات الموجهة الأدوات للمعلنين من السياسيين وأصحاب الدعايات المختلفة مما يؤدي إلى شرزمة الجمهور إلى شرائح صغيرة بشكل يحول دون تحقيق الفهم المشترك للواقع. ويتسبب هذا الأمر في خلق ظروف مثالية للشعبويين السلطويين أمثال رودريجو دوتيرت ودونالد ترامب وجايرو بولسانارو للاستيلاء على السلطة، مع العواقب الوخيمة التي يسببها ذلك على حقوق الإنسان. ويرى ديبايان جوش وبن سكوت، مؤلفو سلسلة تقارير “الخداع الرقمي”، أننا قد “سمحنا للتكنولوجيات التي تقدم معلومات تستند إلى الملاءمة والرغبة في تحقيق أقصى قدر من جذب الاهتمام أن تحل محل الوظيفة المعيارية للمحررين وغرف الأخبار”.
وعلى مدى عقود ، قام مفكرون مثل هانا أرندت وكارل بولاني والعديد من المفكرين الآخرين بالتحذير من أن الفاشية هي النتيجة المباشرة لإخضاع احتياجات الإنسان لاحتياجات السوق. وبعد أن تجاهلنا الدروس المستفادة من التاريخ، سمحنا لطمع الشركات بتحويل نظامنا الإعلامي الإيكولوجي (المرتبط بالبيئة) إلى نظام يفضّل النزعة الاستبدادية السلطوية. ويتطلب إنقاذ الديمقراطية أكثر من مجرد إصلاح شركات الإنترنت، بالطبع؛ ولكن الوصفة الدقيقة للنجاح تختلف من دولة إلى أخرى. ففي الولايات المتحدة، نحتاج إلى إلغاء ثلاثين عاماً من رفع القيود عن وسائل الإعلام، وزيادة الدعم الشعبي لإعلام المصلحة العامة، والتعامل مع أوجه عدم المساواة الهيكلية في نظامنا الانتخابي الذي يمنح السلطة لحزب يدعمه أقل من نصف الناخبين.
إعادة هيكلة نموذج العمل الإعلاني:
يختلف الخبراء حول ما إذا كان النظام الإيكولوجي الإعلاني الموجه يمكن إصلاحه بشكل هادف، وهل سيكون ذلك كافياً لمنع تأثيره الضار على المجتمع. وقالت زوبوف، التي صدر كتابها الجديد في يناير الماضي: “لم تعد رأسمالية المراقبة تقتصر على الإعلانات الموجهة فحسب، كما أن الرأسمالية الإدارية كانت تقتصر على إنتاج طراز ت فورد”. وأضافت: “لقد تجاوز منطق التراكم هذا أصوله ووصل إلى قطاعات جديدة وأشكال جديدة من العمليات التجارية. وقد سُمح لرأسمالية المراقبة بأن تترسخ وتزدهر في الفضاء الخارج عن القانون لعقدين من الزمن، فاستفحلت وأصبحت الآن تشبه النباتات البرية الزاحفة التي لم تطأها أي قدم من قبل.
ويبدو ديبايان جوش الذي يدرس الهندسة الخصوصية في كلية جون ف. كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد أكثر تفاؤلاً، لكنه لا يستبعد الحلول التنظيمية من خلال سن القوانين للوصول للنتائج المرجوة. وكما تقول شركات التكنولوجيا نفسها، فقد يجد مستخدمو الإنترنت الفائدة في الإعلانات الموجهة التي يتم ربطها بمصالحهم وتساعدهم على اكتشاف الفرص أو الأحداث ذات الصلة بهم. ولكن نفس البنية الأساسية التي تتيح لك معرفة متى ستعزف فيه فرقتك المفضلة في مدينتك تقوم بتمكين الجهات الفاعلة الشريرة من نشر الأفكار الشائنة بنفس الطريقة”.
وقال جوش، الذي عمل مستشاراً لسياسة التكنولوجيا في البيت الأبيض في إدارة الرئيس أوباما، وعمل قبل ذلك كمستشار للخصوصية والسياسة العامة الأمريكية في شركة فيسبوك، “هذا النظام التجاري مسؤول عن التهديدات الأمنية الضخمة”. وأضاف: “سنحتاج إلى التعامل مع نموذج العمل باستخدام تدابير سياسية بطريقة تحفز نشر الخير وتستأصل الشر. وإذا لم ينجح ذلك، فقد نضطر إلى اللجوء إلى سن القوانين التي تحول دون استفحال هذه الإعلانات الموجهة. أعتقد أنه يمكننا إيجاد طرق للسماح للإعلان الموجه الذي تقوم به مواقع مثل شانيل أو إن بي ايه، وتقليص ظهور المضمون الشنيع الذي تروج له شركات الدعاية الروسية”.
يقع العبء على وادي السليكون لإثبات أنه يمكن حماية الشركات ضد الأضرار الشنيعة التي تسببها رأسمالية المراقبة دون اجتثاث نماذج أعمالها بالكلية – أو الأفضل من ذلك، العثور على مصادر دخل جديدة لا تعتمد على تحويل سلوكيات الأفراد الخاصة إلى سلع تباع وتُشترى. ويُعد هذا الأمر هو الأكثر أهمية حيث أنه لا يُتاح للأفراد اختيار عدم المشاركة في تلك الإعلانات.
وعلى الرغم من أن جوجل وفيسبوك تسمحان للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في رؤية الإعلانات الموجهة، إلا أنه من المستحيل الإفلات من إمكانية التعقب أو تضمينهم في مجموعات البيانات المستخدمة لإنشاء منظومات أخرى لإعلانات موجهة. ووفقاً لتصريح ليبرت من كارنيجي ميلون، “أنه يمكن أن تفترض أنك إذا لم تشاهد إعلاناً موجهاً عن الأحذية، أنهم قد توقفوا عن تتبعك، ولكن ليس هذا هو الحال على الإطلاق. فهناك طرق تكنولوجية لمنع مستوى معين من التتبع، ولكن الأمر أشبه بتناول الأسبرين لعلاج مرض السرطان؛ فقد يجعلك الأسبرين تشعر بتحسن قليل لبضع ساعات ولكنك لا تزال تعاني من مرض السرطان. إنما الطريقة الوحيدة للقضاء على سرطان الإعلانات الموجهة هي سن اللوائح لذلك. وبينما تُجري أوروبا تجربة كبرى الآن في صياغة “اللائحة العامة لحماية البيانات”، نجد أن بقية العالم يراقبون”.
يدرك صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك صانعو السياسات في واشنطن، أن الخصوصية وحماية البيانات مرتبطة بشكل وثيق بالهيكل الأساسي للمجتمع. وليس هناك احتمال أن يقبلوا – لا هم ولا الجمهور – أن يستمر الوضع الراهن على حاله لفترة أطول (* ).
(*) الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات



